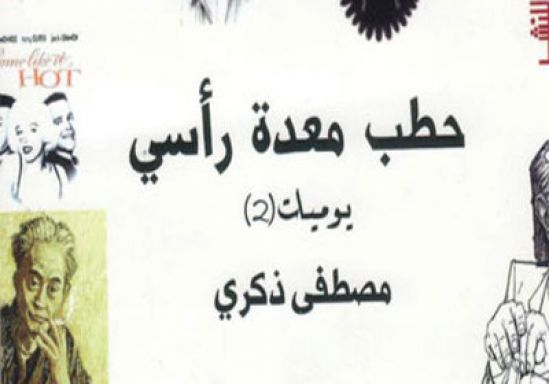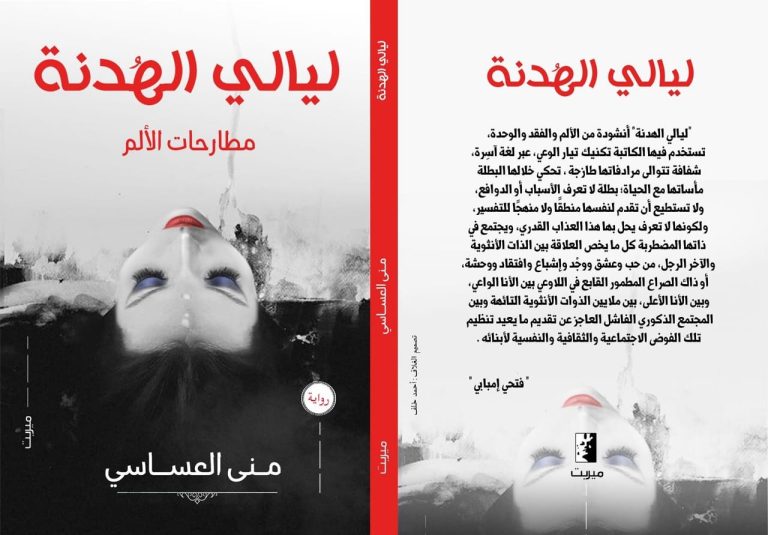جمال القصاص
تسترجع مي التلمساني في روايتها «هليوبوليس» الصادرة هذه الأيام عن دار شرقيات بالقاهرة شريط حياتها وهي طفلة لم تتجاوز السنوات الخمس في كنف أسرة من الطبقة المتوسطة، وبوعي النضج الشقي تقلِّب طبقات هذا الشريط، وتتمثله ككينونة حية لم تنته بعد. ومن خلال الإيهام بلعبة قناع الماريونيت التي تورط فيها بطلتها، تكتسب هذه الكينونة طابعاً حلمياً تتناسل فيه مجموعة من الصور والذكريات المتلاحقة عن واقع الحياة المنزلية التي عاشتها وسط هذه الأسرة الصغيرة، وصور أخرى عن الواقع الخارجي تعلق فيها بعض مفارقاته وتوتراته السياسية والاجتماعية في تلك الفترة، وما بين خطين زمنيين متعاقبين يجسدهما موت عبدالناصر المباغت في سبتمبر (ايلول) 1970، وموت السادات التراجيدي في حادث المنصة الشهير في اكتوبر (تشرين الاول) 1981. وفي ظل هذين الخطين يتفتح وعي البطلة على صورة متقلبة ووعرة للعالم والأشياء، صورة يقبع في فضائها الموت كثقب أسود، ويظللها التاريخ كمرادف للتعاسة والشقاء.
ولأن لعبة استرجاع تلك الكينونة، أو بمعنى آخر، لعبة الطفولة الجديدة تبدأ من لحظة متخيلة، وفي سياق وضعية كتابة مهمومة بالمواضعات الحداثية، فإن حلم البطلة يذهب أبعد من حدود اللعبة نفسها، من مجرد الخروج على كلية النظام، وكسر منطق النمو في هوية التقاليد بمحدداتها الاجتماعية والأخلاقية، التي تفرضها آلية الحياة النمطية المكرورة، سواء في محيط العائلة، أو في حركة الواقع الخارجي الذي تتضاءل مصداقيته أمام توق البطلة للمجازفة والبحث عن نسق فردي خاص، تتوحد فيه بحلمها وتتنفسه، بلا خوف أو تردد. إنها تريد أن تعيش منطق النمو من داخل الحلم نفسه، حيث تنحل الفواصل والعقد السميكة في الزمن والأشياء.
لكن كيف تخلق «ميكي» بطلة الرواية طفولتها الجديدة، وتخلصها من وشائج الماضي وسير الآخرين، بل من منطق الكتابة نفسه، في سياق وعيها الآني الملتبس والمعقد، وحتى تحقق حلمها في التحليق نحو مطلق الصعود.. ولأن الأشياء لا تولد فينا من تلقاء نفسها، بل إننا في الغالب ما نفكر فيها بواسطة الآخرين. ولأن ميكي نفسها لا تشارك غالباً في صنع الأحداث، بل تسردها عن الآخرين، وتتأملها من موقع المراقب الحذر، وتتلذذ بها حين تتحول الى صورة، يمكنها أن تختزل العالم والأشياء فيها، يمكنها أن تكبرهما وتصغرهما، تنفيهما أو تثبتهما بمنطق تداعيات الحلم نفسه.. إذن فلا بد من مسافة ما، لا بد من فاصلة، تبرز مكابدات حلم الصعود. وحتى لا يظل هذا الحلم محض نتوء مثالي في لعبة مبنية على تعارضات العقل. لذلك تجد «ميكي» في قناع الماريونيت إغواء خاصاً لابراز هذه التعارضات/ هذه المسافة، بين الواقع والحلم من ناحية، وبين أنا متمركزة على ذاتها شديدة الوعي بها، وفي الوقت نفسه، ترفض أن تتحول صورتها، أو حتى حلمها الى صورة مطابقة تماماً لهذا الوعي، أو بمعنى آخر مطابقة للأصل، لأنها تتخيل صوراً عديدة لهذه الذات، وتحت وهم القبض على فاعلية هذه الصور، تبدل الأدوار والأزمنة، وتخلط البداية بالنهاية، بل تتعمد شكلاً من الازدواجية الاختيارية، حتى وهي تصف حقائق الحياة العائلية البسيطة، أو حين تتأمل التقلبات السيكولوجية للشخوص الرئيسية في الرواية، الجد والأم والعمتين والخادمتين. إنها لا تحكي لنا قصة، وإنما تريد أن نعيش معها مغامرة مفتوحة، تنفلت من أزمنة السرد، ومن مواضعات الماضي والحاضر والتاريخ، مغامرة تبقى دائماً على حافة حلم غامض دائماً على وشك التحقق، تماماً مثل حلم التحول الى ماريونيت الذي يفرض عليها شكلاً من التماثل الضدي لا تكترث به حتى وهي تصغي لنصيحة والدها التي تسردها عنه.. «اذا كان من الضروري ان تلعبي الدور، فليس أقل من أن تتفرجي بنفسك على نفسك وأن تستمتعي بالدور قدر المستطاع».
الأنا والموضوع في سياق هذا المأزق الوجودي الذي تورط «ميكي» نفسها فيه والذي يبدأ بمنطق اللعبة المزدوج، وكأنه محاولة للبحث عن الأنا في الأنا ذاتها، وبعيداً عن فكرة القدرية المبتذلة التي ترشح بها اللعبة، أتصور أن الإيهام الدائم بتحول «ميكي» الى «ماريونيت» نجح الى حد ما في خلق حالة مغوية من التشتت الدلالي والبصري، أكسبت اللعبة مسافة أكبر من التوتر النفسي والزمني، وأصبح للذات القدرة على التوغل فيما وراء التخوم الواقعية للأشياء، وإحالتها الى واقع متخيل، واقع لا تكمن كينونته في الأشياء في ذاتها، بل في ظلالها، في توجهها نحو هذه الظلال، وكأن ثمة علاقة مفقودة، أو غامضة بينهما، لا يمكن القبض عليها عبر مدركاتنا العادية.. «فميكي التي تخاف السكون تتحرك فيتحرك الكلام، وتبدأ الحكي من حيث يبدأ البحث عن معنى في ظل الأشياء».. وهي أيضاً التي تقرر ساخرة.. «أنا الصورة والقناع، أنظر عبرهما وإليهما في الوقت نفسه، فتزدوج الرؤية، وتدمع عيناي وأحتاج الى نظارة».
لكن، وعلى الرغم مما يوهم به القناع من مسافة ما تتضاعف فيها الرؤية بين الأنا وموضوعها، وما يغري به من مساحة زلقة للمناورة، على الرغم من هذا إلا انني أتصور أن اللعبة في الرواية ليست لعبة قناع في الأساس، فالقناع يظل في جوهره نسقا عقلانيا، فبقدر ما نتخفى خلفه لنتجاوز الطبيعة الزائفة في الأشياء، أو حتى في أنفسنا، بقدر ما نمارس نوعاً من التضليل والتزييف لهذه الطبيعة.
علاوة على هذا كله، فإن القناع في الرواية ظل محض فكرة مجردة، محض وسيط ذهني مستعار من مرجعيات مختلفة، ولم نعثر على حيوية خاصة يكتسبها من داخل تفاعلات الرواية نفسها. ولا يمكن ان تندرج في ظل القناع بعض المقابلات اللفظية الساخرة مثل: فكرة تحول «ميكي» الى «ماريونيت»، وتحت وطأة شعور غامض في الطفولة ظل يطاردها على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، أو تمثلها فكرة «الدمية» لطبيعة خاصة بمكوناتها الجسمانية، أو الصفة المزدوجة للأم «زوزو» التي تخلت عن اسمها الأصلي «زينات» لتجاري متطلبات الطبقة الجديدة التي انتقلت إليها بعد الزواج.. وغيرها من التضادات التي تنتمي الى حقل الفانتازيا والكاريكاتير ولا ترقى الى مستوى الانفصامات الحافزة والمكونة.
وربما تعي مي التلمساني كل هذا، وربما أرادت أن تحيد القناع كفكرة خارجية مستعارة لحساب فكرة أخرى، أتصور أنها شغل الرواية الأساسي ونسغ الطفولة الجديدة التي تحاول اصطيادها، وهي العلاقة بين المادة والصورة، ومبرر ذلك في رأيي التموضع الفكري الذي يغلف نسيج الرواية، ويشكل نوعاً من الحصانة للذات ضد أوهامها، وعزلتها، ولامعقولية الواقع والحياة من حولها. من هنا تستثيرنا تأرجحات وتطوحات «ميكي» الممسوسة بومض من إشراق العقل والتباساته، وسعيها النزق للخروج من منطق النمو، الى ديناميكيته المفتوحة على جدل العناصر والأشياء في حركة المجتمع والحياة، الخروج من التاريخ والتدوين والتوثيق، الى الزمن في صيرورته التي تذوب فيها نقطتا البداية والنهاية، وتنمحي الفوارق بين الأصل والصورة، بين الحركة والسكون.
الطفولة والصور لكن المأزق نفسه يتجسد ـ هنا ـ بصورة أخرى، فـ«ميكي» التي تنحاز للقناع بقوة العقل وسطوته، تكره فكرة الدور، كفرضية شبه حتمية لهذا الانحياز، ولأن هذه الفكرة ذاتها لا تتيح سوى معرفة مؤقتة ومبتورة بالعالم والأشياء، فانها تبحث عن انحياز أكثر اتساعاً وعمقاً، انحياز يدوم، تتماهى فيه خبرة الحواس بالجسد والروح، وينفتح على طاقة الخيال كثمرة متجددة من ثمرات الطفولة. ولأن الطفولة ـ كما تتبدى في الرواية ـ مخزن رؤوم للصور، فإن انحيازها الأعمق والأكثر جاذبية، بل الأصلي ـ في تصوري ـ هو للصورة. ففيها تتعرى الأشياء من ظلالها، ويتقاطع وعي الكتابة مع لا وعي اللعبة نفسها، لعبة السرد المنداحة من مرآة ذات لا تثبت الصورة وإنما تعكس نفسها عليها في كل اتجاه. ومثلما تقول «ميكي» في مونولوج حارق ـ يشبه المراثي ـ عن نساء العائلة.. «سنشبه أشياءنا التي تشبهنا، ونكرر أنفسنا بتكرار ظلنا فيها ونتعرف على وجوهنا المتكسرة في انعكاساتها، وسنحافظ على التركة طالما حافظنا على حياتنا نحن نساء العائلة».
وفي كينونة الصورة تتضافر خبرات وحيوات خاصة للتخيل والذاكرة والحلم. حيوات لا يمكن ان نقيسها باستعارات مجازية للمكان، أو بنظرة تقليدية للزمن، وإنما تباغتنا كنقط ضوء خاطفة في انساق السرد المشربة بأنفاس من الكلاسيكية والواقعية السحرية، والقص الساذج أحياناً.
وخلال فصول الرواية بصفحاتها المائة والستين تطالعنا طرائق متنوعة لمنظور الصورة، وترفد مي التلمساني هذا المنظور بمجموعة من الخبرات والوسائط الخاصة، المستقاة من فن السينما خاصة التقطيع الزمني لحركة المشهد، وتنويع زوايا اللقطة في حزم سردية مفصولة بفجوات فراغية شفيفة، تتعدد مستوياتها وحركتها حسب الطبيعة الخاصة لكل فصل. وتلعب أيضاً على فكرة الدور درامياً في المسرح، وعزل الشخصية المؤقت وراء القناع، كما تتماس مع فكرة الكتلة والفراغ وتداعيات المنظور من الأسفل الى الأعلى تاركة مساحة مفتوحة لافتراضات الخلفية، مثلما نرى في الفن التشكيلي، (إشرح موطن الجمال في العبارة التالية ـ اسمه «البيك آب» يمتد بعرض حائط كامل ويبدو مثل صندوق ضخم). ومن علم الاجتماع تستقي رؤيتها للعالم المعيش كمفهوم افتراضي يعطي صدارة لفاعلية الأشياء في منظومة النشاط الانساني، ومن فلسفات الوجود والعدم تكون فكرتها عن الموت كلحظة انفتاح عبثية على الحياة (موت اللعبة وصانع الصور). كما تطالعنا نتف من الشطح الميتافيزيقي والصوفي، ومخايلات لفلسفة الروح، خاصة في تجسيد فكرة مطلق الصعود، كما تتردد أصداء قوية للميثولوجيا الفرعونية مثل طقوس العبور من الأرض الى السماء في أسطورة «أوزير» و«رع» أو اقتفاء أثر اسم هليوبوليس في غبار الثقافات القديمة التي وفدت الى مصر، كما تطعم شرائح السرد ـ أحياناً ـ بموتيفات من أغاني وحواديت الطفولة والأمثال الشائعة في التراث الشعبي، أو بلطشات نصية واخزة معاصرة (الوسادة الخالية ـ عبدالحليم حافظ ـ محمد عبدالوهاب ـ عواد باع أرضه).. وغيرها.
ان هذه الوسائط والمرجعيات لا تندرج في مشاعية التناص، وإنما تقوم بتوسيع فراغات الخلفية التي تكونها الصورة، وتعدد امكانية التأويل وتنويع منافذ الذهاب والإياب من والى النص. كما انها تكسر منطق السرد الأفقي الذي يتهادى من عين الكاتبة الساردة في غلالة «الأنا» الحاضر دائماً، وتصنع في الوقت نفسه نوعاً من الإيقاع الخفي المرح، يتولد من جدل الوصل والقطع بين وحدات الرواية المتجاورة.
وفي الفصول الأخيرة تمارس الرواية نوعاً من الغوص في جغرافية المكان (حي مصر الجديدة)، ترصد حواشيه وتضاريسه الخارجية: الشوارع، البشر، المباني، المحال، الميادين، المقاهي، دور السينما، أكشاك الكتب.. ويتراءى المكان كخلفية أوسع لصورة العائلة، وكمخزون بصري حي لتداعيات أحلام الطفولة التي تسترجعها البطلة بوعي الكاتبة الراهن في لحظة الكتابة. والمفارقة المدهشة هنا هي التغير في تقنية الوصف كمقوم سردي. ففي الفصول الأولى التي تم التركيز فيها على استعراض حياة العائلة بكل دقائقها وتفاصيلها اتسم الوصف بنزعة كلاسيكية طبيعية شديدة الدقة والاحكام الواقعي. تقول مثلا في وصف قطعة أثاث: (قطعة الأثاث الوحيدة في المكان «النيش» أو البوفيه، مكونة من جزءين يربط بينهما لوحان من الخشب مشغولان برسوم هندسية ملونة، الجزء العلوي يضم جراراً زجاجياً تستقر خلف زجاجه المغبش الأكواب…إلخ). بينما في هذه المغامرة يتجاوز الوصف حدود المقوم السردي، ويقوم بدور المخطط والمهيىء لاستكناه روح المكان، وتجاوز صورته وتجلياته كقيمة مستدعاة، من المعارف والرؤى والتصورات، وإنما كقيمة متحققة بالفعل من منظور حضور الشيء الغائب، ومن ثم يتحول الوصف من قيمة رصدية الى قيمة توليدية، لا يقتصر عملها على مجرد استيلاد الصور وتكرارها أو استنساخها، وإنما خلق مجالات ادراك جديدة لها. ولذلك يتسم الوصف هنا بخاصية شديدة الأهمية فعلاوة على انه يقوم بتوثيق سيرة المكان من داخل أشيائه وحيواته الخاصة فانه في الوقت نفسه، يقوم بدور التشتيت والدمج لبؤرة عدسة السرد. لذلك تصبح له القدرة على دفع الصورة المسترجعة باتجاه الماضي أو الحاضر، وكأنها ليست قيمة مسترجعة، بل تولد من تخوم حدس اللحظة بالفعل.. يتجلى ذلك على نحو لافت في مغامرة «ميكي» برفقة أخيها وصديقه لدخول قصر البارون امبان مؤسس ضاحية مصر الجديدة، وكذلك مغامرة دخول قصر الأرملة الشابة الثرية «ميكائيلا» بميولها العاطفية السادية، والتي انتحلت «ميكي» اسمها منها، وتشير إليها في الرواية وكأنها الظل الهارب من ذاكرتها. ان كينونة المكان في المغامرتين لا تتراءى كمجرد خلفية، أو ظل لصورته، وإنما كفاعلية مضافة، لها حيويتها الخاصة في نسيج التكوين الذي تشكله لعبة السرد المراوغة في النص.
وفي نهاية الرواية تتشبث «ميكي» بأهداب يقين يشبه الوهم، ربما لأنها تدرك ان الوقوف على الحافة ليس بديلا عن الوقوع فيها، فتهمس بصوت متهدج.. «لا بد ان ثمة غاية تخيم بظلها على الوجود، لا بد ان بلوغ الغاية يعني الاجابة عن السؤال»، لتنفتح الرواية من جديد على سؤال البداية الصعب: هل مطلق الصعود هو مطلق الحرية، هل حداثة السرد تعني حداثة الطفولة بمياهها الدافئة البعيدة.
لقد نجحت «مي التلمساني» في روايتها الممتعة والمتميزة في اثارة كل هذه الأسئلة.