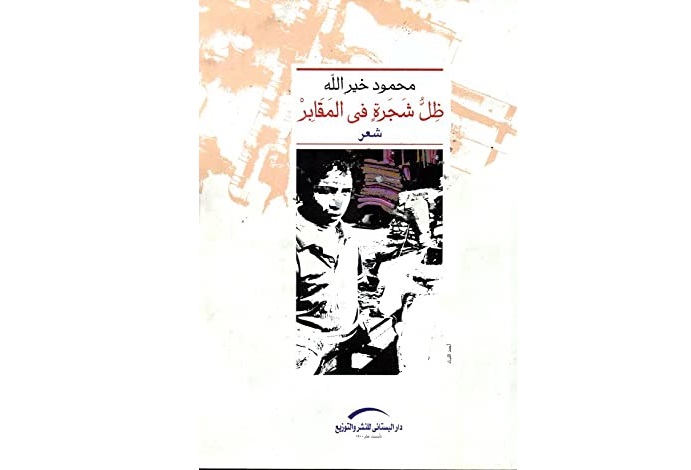يَلفُّ بعيون زائغة
كانت أمي تقبضُ على لساني بإصبعيْها الرفيعيْن كأنهما مخلبيْن ثم تشدُّهُ لآخرِهِ وتُسمِّي اللهَ ثم تقطعهُ بسكيِّن مطبخها الحبيب.. تقبضُ عليَّ من وسط السوق أمام الناس جميعاً كلما جمعتُ الأولاد في الحقل وألَّفتُ حكاياتٍ تجعلهم يسهرون لحد وقوع الصبح على رؤوسنا فتتثاءبُ العفاريت بصوتٍ يهزُّ البلدة كلها ثم تطير معنا لنسرق أكواز الذرة.. كما أنني كنتُ في أحيانٍ أتسلل وأخفي في قميص بطل حكاياتي الطيب، نظرةً من نظرات أبي الغامضة، المعلقة على رأس السرير.. كان الفراغ الذي تركهُ لساني في فمي مازال يلفُّ بعيون زائغة في انتظار أن يظهر أولُ اللسان ثم ينمو رويداً رويداً وكنتُ أنا تحت الغطاء أرتعشُ وأراقب كفي وهي تتضاءل كي تهرب من مسح الدموعِ التي قد تفضحُ فراشي.. عندما ماتت أمي توقف لساني عن النمو لكني لم أصر أخرسَ أو مجنوناً.. صرتُ تمثالاً بحجمٍ صغيرِ، كأنه حجم طفلٍ أو يزيدُ قليلاً، يحشو حوائط دكانِهِ بحكايات أهل البلدة وأكاذيبهم، ثم يبتسم بغرور كأنهُ كلامٌ ملون يملأ السماء.. ولولا أن طلقاتٍ طائشةٍ أصابته، لما كان يجوسُ حتى الآن.. ويهمهمُ بلا فم..
طريقٌ نائية
وسط النوم، تكون الهمهماتُ موسيقيةً وأليفة ويكون الكلام مرتباً و مفروداً على سجادة ناعمة، على عكس ما يظن الناس جميعاً.. أخبرني جَدِّي وهو ينظر لعيني، ربما ليبحث عن جَدِّهِ الذي أخبرهُ يوماً، أن الإلهة يحبون العالم في النهار بوضعيةٍ سحريةٍ كأنهُ مقلوبٌ أو مصدورٌ من الحُمَّى كي يظلوا يهزوا رؤوسهم برويَّةٍ وهم يشاهدوا الأعاجيب.. ثم لا يتركونه لينفلت ويعتدل إلا في الليل، في الظلام العميق، المنسيِّ الحكيم.. وهكذا تعود الرؤوسُ العظيمةُ لثباتها الفخم الشبعان.. لحظة البهاء المتوهجة هذه، ربما تكون الأقدار قد كرهتها من قلبها، لأنها لم تجد في الجرابِ إلا الأحاجي والألغاز، فاضطرت أن تردد لنفسها طول الزمن بأنها هكذا تصنعُ الحياة.. و ربما تكون قد عَلِمت من جَدِّها هي الأخرى أن الوضوح وحشٌ باردٌ وبلا قلب.. لا حدَّ لطول أظافرِهِ أو لصوتهِ الغليظ.. خاصةً بعد أن ظهر الحبُّ في الحكاية، وهو يسعى في طريقٍ نائية..
كفٌ ممزقة
أظافري هشةٌ، تتكسر باستمرار، لكنها ما أن تلمس جِلْدي حتى تُسرع وتدميه..
كأنها تنحتُ صرخةَ المقتولِ
قبل أن نمضي بعيداً
..