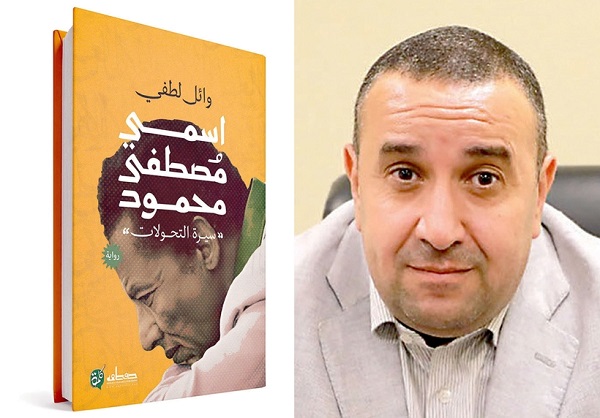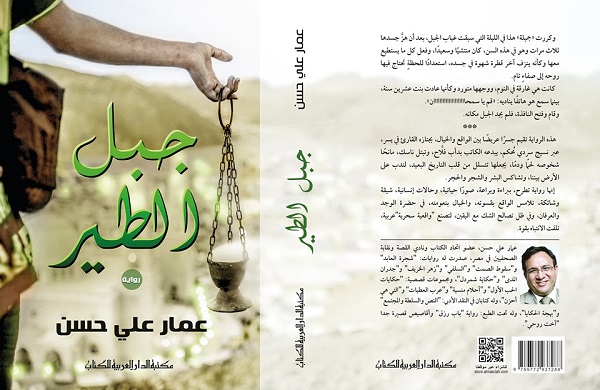منى أبو النصر
تفتتح رواية ” فاكهة للغربان” مجالها الصوتي بأصداء قلقة، لها نشيج مُعذّب “كان صراخي يمتد إلى أعماقي ويتلاشى” هكذا يأخذك صوت البطلة في مطلع الرواية، التي تتناوب السرد، مع راوِ عليم، وأبطال يتواتر ظهورهم، فيتشاركون أطياف الحكاية.
تبدأ رواية “فاكهة الغربان” للكاتب والروائي اليمني أحمد زين، الصادرة عن دار “المتوسط للنشر -إيطاليا”، بذكرى لا تُفارق بطلة الرواية، وهي اختفاء زوجها “جياب”، لنعرف فيما بعد أنه تعّرض للاختطاف بوصفه أحد قيادي الحزب الاشتراكي اليمني، في سياق زمني وتاريخي تدور في أحداثه الرواية، ما بين عام (1968 إلى 1986)، التي شهدت فيه جنوب اليمن، وعاصمته عدن آنذاك، ما عُرف بالحرب الأهلية التي تسبب فيها التناحر الحزبي بين “الرفاق” في أجنحة الحزب الاشتراكي، وقاد للمجزرة الشهيرة بين قادته في يناير كانون الثاني 1986.
تُضيء الرواية، التي تقع في 232 صفحة، ظلال تلك المرحلة التاريخية ومصائر من عاشوا فيها من بشر، صانعًا مُفارقات سردية للتركة الإمبريالية التي كانت لازالت آثارها مُقيمة داخل كيانات مدموغة بشعارات الشيوعية الجديدة في عدن، من بعد سنوات الاحتلال الانجليزي الثقيلة لليمن لنحو 150 عامًا : “كان زمنًا بين حربين طاحنتين، الأولى ضد الاستعمار، والثانية التي لا تزال مشتعلة ضد بعضهم البعض”.
سنوات الخفّة والعطب
يدفع الكاتب ببطله “صلاح” لأحد محكّات هذا التشوّش، بعد أن تقوده الأحداث لمهمة كتابة مذكرات “نورا” زوجة قائده في الحزب الشيوعي “جياب”، فتتوالى زياراته لبيتها، ليخرج من كل زيارة بانطباعات ومُعطيات تدفعه لمراجعات ذاتية تخص الهُوية، والعقيدة الحزبية، ليكون فعل تدوينه في حد ذاته أقرب لفض اشتباك أربطة تاريخية وأيدولوجية مُعقدة، فهي تبدأ الحديث من حيث تُسعفها الذاكرة: ذاكرتيها السعيدة والتعيسة، تستدعي أيام سطوعها كراقصة باليه في بولندا ضمن أفراد الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بعدن التي كانت تطوف العواصم الشيوعية آنذاك، وكانت هي واحدة من أبرز بطلاتها، تتساءل مع انثيال ذكريات الرقص والمسرح “ما جدوى هذا الآن؟”، لاسيما بعد أن تعرضت يوم اختطاف زوجها، المُتورط في الصراع الحزبي، لحادث تنكيل بها ممن قاموا بخطفه، أصاب قدميها حتى عطبت، ليترك لها هذا الحادث مشيّة ثقيلة بعد سنوات من الخفّة، التي منحها لها الرقص، والحب الحنون.
“نورا” التي باتت تتحرك بالكاد من مكان لآخر، تُثقلها أيضًا هُويتها المُنقسمة، بين انتماء أيديولوجي شيوعي، ونشأة على يد والدها الأرستقراطي صديق الإنجليز، الذي يرثى ما آل إليه حالها، ومعها يرثي وطنه بعد سنوات الكولونولية، يقول الأب العجوز “أرى مدينة أخرى.غارقة في الفقر والشعارات”، يصنع الكاتب في بيت نورا مواجهة بينه وبين “صلاح” الشاب الريفي، ابن الحزب الشيوعي، كصورة مُصغّرة لهذا الصراع الطبقي والأيديولوجي الذي تجذّر في طبقات عدن آنذاك، أما نورا فقد زادت تلك الازدواجية ذاكرتها تشظّيًا “فكرّت حينئذ كام ماضٍ لها؟ واحد قبل رحيل الإنجليز وآخر بعده”.
تلصص الغربان
لم ينقطع نعيق الغربان الساري في فضاء السرد، ولا سياقهم الأسود الكثيف، فهي تقف بنظراتها الحادة خلف نافذة “نورا” وكأنها تتلصص على حكاياتها عن “جياب”، وكأنها دائمًا طرف في الحكاية، في حضور تغمره رائحة النذير، والهلاك الوشيك، و سيناريو دموي تُحيل له عنوان الرواية، فالفاكهة بطبيعتها اليانعة، أقرب ما تكون لأحلام عدن قصيرة العمر، التي لم تلبث أن تستفيق من إرث استعماري طويل حتى سقطت في جُب الحرب الأهلية الذي عجّلت به “غربان” الاقتتال الحزبي في تلك المدينة المُتشظية.
وفي بحر تلك السنوات القلقة، كان يُشارك مصير أهل عدن أفراد من جنسيات متعددة، استقبلتهم عدن بطابعها “الكوزموبوليتي” الرحب آنذاك، حيث كانت محّط شيوعي العالم، والعالم العربي كذلك، الذين ضاق بهم بطش حكوماتهم، أو نكبات بلدانهم، فوظّف الكاتب ظهورهم كرديف إنساني للحالة الشيوعية في العالم العربي في تلك الفترة وانعكاساتها الإنسانية على بشر مُبعثرين، فجعل “صلاح” منذ بداية الرواية مُحاطًا بدائرة من أصدقاء: “عباس” العراقي، و”بقطاش” الجزائري، و”نضال” و”سناء” الفلسطينيين، القادمين من خلفية المذابح والمخيمات، والشعور الدائم بالتهميش، تقول سناء “في كل بلد أقمنا فيها يعمدون إلى تذكيرنا بأننا غرباء. أن سوريا للسوريين ولبنان للبنانين والأردن للأردنيين، كأننا لا نعرف ذلك. كأنما هذه المعرفة لا تُشعل النيران في أجسادنا ليل نهار”.
مرايا المشاعر
يجعل الكاتب الروائي أحمد زين من “ألبومات” الصُور، والروايات الأدبية، وحتى اللوحات الفنية، مرايا لدواخل شخصياته واستبطان ذاكرتها، فالبطلة تتأمل غلاف “آنا كارنينا” فتُذكرها بومضة حكاية مرّت، كما تتذكر لوحة “شاغال” التي أهداها زوجها نسخة مقلدة لها من كشك لبيع أشياء قديمة في موسكو، تتأمل ذاتها ومآلاتها في خطوط شاغال الفانتازية، أما صلاح فيمر في رحلة موازية خلال الاستماع لحكايات البطلة، فيرى في استرسال نورا انعكاسات لوحدته، ومراجعة لتساؤلاته الحزبية المُرتبكة، وذاته التي تركها في ريفه المُهمش وهو يبحث عن كيان في عدن الجديدة وانتمائه الحزبي الشيوعي.
تتشوش بالتدريج رؤيته “المثالية” لزوجة رئيسه في الحزب، مع اقترابه من الانتهاء من تدوين مذكراتها، يتطلع لها بعيون ناقدة وحادة، صارت ملامحها تُزعجه من بعد افتتان، وحتى مشاعره حيّال قدمها المعطوبة تغيّرت، وبدأ يجد تفسيرًا لروائح العطر الثقيلة التي كانت تعبأ بيتها في كل زيارة، فقد بدأت تتلاشى لتحل محلها روائح عفونة تفوح من قديمها المعطوبتين، لا يمكن تفاديها.
يذوي كيانه وهو يتأمل ما قد دوّن من أشلاء حكايات، ويرى أصدقائه سناء وبقطاش وعباس وهم يرحلون من عدن على متن سفينة روسية ويودعون “جنة عدن” ليبدأوا شتاتًا جديد، فيما يشعر هو أن حياته تؤول إلى فراغ “أقصى ما يحاول فعله الآن أن يسترد نفسه”.
فيما تتخيّل “نورا”، صاحبة الصوت الأنثوي الذي استهل الرواية، قدميها وقد استيقظتا من سُباتهما، وتقومان أخيرًا بحركة راقصة “كأنما غير آبهة بكل ما يُحيطها من حطام”.