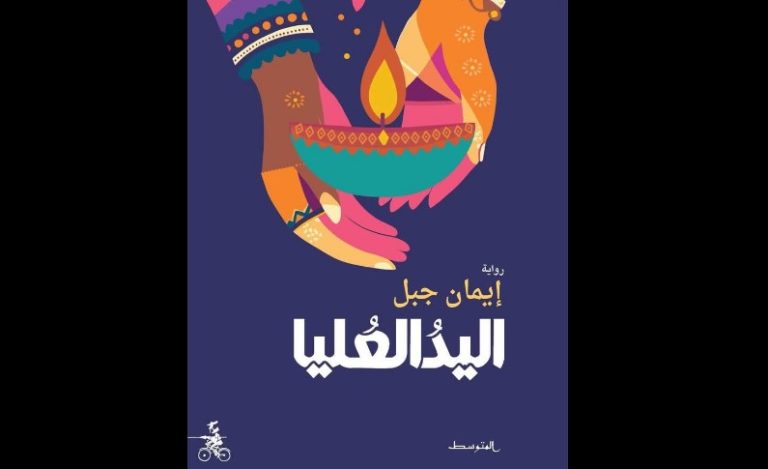الأمر محيّر بالفعل، إذ اختار هذا المصير للجسد الشخصي رجلان من ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية، ساراماجو وإدوارد سعيد، رغم أن الديانة المسيحية لا تنادي بإحراق الجسد البشري أو إباحته أصلا. إنما إذا كان طلب إدوارد سعيد أن تُوارى زجاجة جسده إلى جوار أمه في مدفنها في لبنان، بينما ساراماجو قد اختار أن يُدفن أسفل جذع زيتونة. ما يعني، وفقا لتأويل تتدخل المخيلة في صياغته، أن ساراماجو قد اختار له أمّا أخرى هي الشجرة المتوسطية؛ شجرة الزيتون. والأرجح أن وجود شجرة الزيتون قد يُجلي قَدْرا من الغموض عن اختيار الدفن أسفل جذع زيتونة، فهذا -الدفن- ليس وليد رغبة صارت -طقسا- أو ما هو أقرب إليه بل هو جانب أصيل من الثقافة الشعبية المتوسطية التي أوجدها حضور هذه الشجرة قبل أن تأتي الأديان السماوية إلى هذه المنطقة بالشرائع فتحرم إحراق الجسد ودفنه في جرار فخارية ثم يتم دفنها في مقابر ظلت تُعرف حتى عهد قريب في بلاد مثل فلسطين باسم -الفسقية-.
أيضا ليس من المستغرب حتى اليوم أن يوارى جسدا الأب والأم في قبرين إلى جوار بعضهما البعض في حديقتي، أو حاكورتي (مفردها حاكورة)، منزلهما تحت ظلال أشجار غالبا ما تكون من أشجار الزيتون فتفيئهما طوال العام بظلالها.
وقد يصح أن اختيار شجرة الزيتون لممارسة هذا الطقس قد انبنى على خبرة شعبية بشجرة الزيتون وعلاقة الناس اليومية بها على ضفاف المتوسط، إنما لشجرة الزيتون أيضا خصائص أو طبائع منقطعة النظير تخصّها وحدها دون أشجار العالم، تقريبا، فهي لا تموت، وكلما قُطعت، ولم تُقتلع من جذورها، نمت من جديد، وكلما بلغت من العمر ألفا نما لها جذع جديد. ففي جبل الزيتون في القدس أو في باحات الأماكن المقدسة ذاتها يرى المرء زيتونة بجذعين بينهما فراغ يمكن لطفل أن يدور حوله كما لو أنه يطوف. فضلا عن أن ظلالها تمتد على طول السنة ولا تتأثر بتعاقب الفصول أو الليل والنهار عليها سلبا، بل تأخذ كل ما يمنح الحياة لجسدها من الطبيعة. بعبارة أخرى هي شجرة ولّادة لا تطرح ثمرا من زيتون وزيت فحسب، بل تطرح نفسها كلما شاخت أيضا. هذا ليس بمتخَيَّل أو شعر؛ إنه واقع الحال. لكن هذا الأمر كان أشبه بالبوابة التي دخلت منها شجرة الزيتون إلى المتخيل الأسطوري أولا ثم الشعري لاحقا، عربيا ولاتينيا، ولا تزال كذلك.
هي -حالة- شعرية صميمية، بل سلوك شعري يومي مع واحدة من مفردات الطبيعة. ولم يكن لهذه الحالة الشعرية أن تنتقل إلى القول الشعري -المتوسطي- بيئيا، إذا جاز التوصيف، لولا صرخة -لوركا- القتيل التي تردد صداها على الضفة المقابلة من المتوسط، فدخلت إلى متن الشعر العربي مع عبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السيّاب والشاعر الشاب محمود درويش في بدايات تكوُّنه الشعري مطلع الستينات، وسواهم من الشعراء العرب الذين أدخلوا الشاعر الاسباني فيدريكو غارسيا لوركا شهيدا إلى فلسطين وإلى الحلم العربي بخلاصها من الاحتلال.
ففي تلك الأزمنة التي كانت واعدة بحال أفضل وتغييرات وتحرير لأوطان من الاستعمار يطال العالم بأسره، كان يكفي تذكر -لوركا- ليأخذ الشاعر القتيل مكان الشهيد في القصيدة. فلقد غدا رمزا عالميا وقُضيَ الأمر؛ أمام عينيّ الجنرال فرانكو الذي بدا أنه غير آبهٍ بذلك.
كان أوّل ما كتبه محمود درويش عن لوركا قد نُشر في ديوانه -أوراق الزيتون- (هل هي مفارقة أن يحتل الزيتون عنوان الديوان؟) الصادر في النصف الأول من ستينات القرن الماضي، وتحديدا في قصيدة -لوركا-:
-لم تزل إسبانيا أتعس أُمّ
أرخت الشعر على أكتافها
وعلى أغصان زيتون المساء المدلهمّ
علقت أسيافها!
……..
يحفر الشاعر في كفيه قبرا
إن تكلم!
نسي النسيان أن يمشي على ضوء دمك
فاكتست بالدم أزهارُ القمر
أنبل الأسياف… حرفٌ من فمك
عن أناشيد الغجر!-
ولم يكن ذلك أجمل ما كتب محمود درويش في لوركا، لكنه عاود الكتابة عنه منتصف الثمانينيات في أسبوعية -اليوم السابع- في مقالة مطولة -خمسون عاما بلا لوركا- ثم أعاد نشره الموقع الإلكتروني -الحوار المتمدن- في أكتوبر من العام 2009 وفيه يتحدث درويش عن تأثير لوركا فيه بمعنى ما دون أن يصرّح بذلك بوضوح، لكنّ هذا المقال يبقى نصا تخييليا مفتوحا على الأشكال الشعرية وعلى الأنواع الأدبية دون أن يحدّ من المخيلة المتدفقة أيُّ موقف فضلا عن أنه نص ـ مرافعة في الدفاع عن الموسيقى في الشعر وزنا وإيقاعا ـ والدفاع عن علاقة الشعر ذاته بالموسيقى والغناء.
يقول درويش: -هو الذي أخذني إلى هذه الظلال، إلى هذا المزيج الناري، وإلى تسليط القلب على -الطبيعة الميتة- كما يقول الرسامون، وعلى إغراء العقل في التسلل العلني إلى القصيدة. هو الذي علمني شد الوتر من الحجر، والسير في غابات الزيتون. هو الذي دلني إلى طريق الخيل والمطر فوق منحدرات الجيتار. وهو الذي علمني الرحيل إلى قرطبة-.
غير أن درويش في هذه المقالة ـ النص، كما لو أنه كان يكتب في تلك الأثناء قصيدته ذائعة الصيت -أحد عشر قمرا على المشهد الأندلسي الأخير- في ديوانه -أحد عشر كوكبا- الصادر عام 1992 تزامنا مع مرور خمسمائة عام على رحيل العرب من الأندلس، ففي تلك المقالة ـ النص يقول درويش: -ولما اقتربت منه رأيت وجهه معفراً بالدم والتراب الأحمر. كانت عيناه جاحظتين. قال بصوت خافت: أنا ما زلتُ حيّاً. حشوت مسدسي، وصوّبته إلى الصدغ. انطلقت رصاصة، ونفذت من البطن. ودفناه عند جذع شجرة زيتون-.
أما في في القصيدة فيقول:
-فاطردوني على مهل،
واقتلوني على عجل،
تحت زيتونةٍ
مع لوركا
وهنا يذكر درويش لوركا لمرتين في القصيدة في سياق القتل والزيتون، لكنّ شعراء آخرين أكثروا من ذكر لوركا أكثر بكثير من درويش في قصيدتيه، والفارق ليس في الجماليات وحدها بين القصيدتين: -لوركا- أوراق الزيتون و-لوركا- أحد عشر كوكبا، ففي الأولى لم يكن صوت درويش نقيا خالصا، لكن في الأخيرة كانت خبرة درويش وأدواته الشعرية والموسيقية تنسابان كنهر رقراق، فما أجمل هذه القصيدة إذ يُصغى إليها بصوت درويش وبطريقته في الإلقاء. والفارق بين ما كتب محمود درويش والشعراء العرب هو أن درويش قد ربط حضور لوركا -شهيدا- بشجرات الزيتون وتمنى لنفسه المصير ذاته حالَما شعر أنه -زفرة العربي الأخيرة-، بعد أن آلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى إلى ما آلت إليه.
شجيرة لوركا
تترجم ناديا ظافر شعبان من أشعار لوركا قصائد عديدة من بينها شجيرة، شجيرة التي يقول فيها:
عندما أصبحت العشية
بنفسجية، وضوؤها مبهم،
مر فتى كان يحمل
وروداً وريحان قمر
تعالي إلى غرناطة يا صبية
لا تستمع إليه الطفلة.
ظلت الطفلة الجميلة الوجه
تقطف زيتوناً
والذراع الرمادي للريح،
يزنرها من الخصر
شجيرة، شجيرة
يابسة وخضراء
والحال أن الترجمات الكثيرة لأشعار لوركا التي حظيت باهتمام عربي واسع ولا تزال مليئة بمفردات عديدة من البيئة المتوسطية الأمر الذي أسهم في أن يجعله قريبا من الروح الشعرية العربية فضلا عن أصوله الأندلسية وتأثيرات موسيقى الغجر وأغانيهم فيه، حتى لكأن لوركا يقف على ضفتي المتوسط بالقدمين نفسهما في وقت واحد معا. الأمر الذي يجعل من دراسة هذه المفردات المتوسطية في شعر لوركا يحتاج وحده إلى كتاب مستقل بذاته، إذ ينوّع لوركا في استخدامها مثلما ينوِّع في توظيفها في سياقاته الشعرية والغنائية وبتقنيات عديدة في طرائق القول الشعري، لعل من أبرزها أن لوركا يطرِّز مشهده الشعري بها، أو يرسمها، حبَّة حبَّة، مثلما كانت تفعل فلّاحة من ريف غرناطة عندما كانت العرب هناك.
الشجرة وأمها
-ذهب إلى حديقة بيته. هناك بضع شجرات: أشجار تين وزيتون. ذهب إليها واحدة واحدة واحتضن الأشجار ليقول لها وداعا، لأنه كان يعرف أنه لن يعود. إن رأيت شيئا كهذا وإن عشته ولمْ يترك فيك ندبا إلى آخر العمر، فإنك رجل بلا إحساس-. هذا ما قاله ساراماجو وكأنه يتحدث إلى نفسه؛ نفسه المنفصلة عنه أو أمكن له أن يراها من بعيد.
وصغارا؛ كنّا نسأل أمّنا: ماذا كنتِ تفعلين في بلادكِ يا كبيرة. فتردّ: -كنت أسقي شجرات الزيتون-. تقولها كأنما باعتزاز وفخر؛ وكأن سقاية الزيتون في حاكورة بيت ريفي، في قرية كانت تغفو على كتف المتوسط، ليست بمهنة تزاولها أي امرأة، حتى كأنها سادنة في معبد. لقد كانت أمّنا حينها عروسا، ومن النادر لامرأة شابة في الرابعة عشرة من عمرها أن تخرج بعيدا عن أسوار بيتها الواسع.
لما كبُرنا صرنا نتفهم ما تقوله قريبا من الصراخ والألم: -تنقلع ارواحكو من شروشها انشا الله- حين ترى جنود الاحتلال فيما يقتلعون شجرات الزيتون من أمها الأرض. والشروش هي الجذور وهي أيضا الأوعية الدموية في جسد الإنسان.