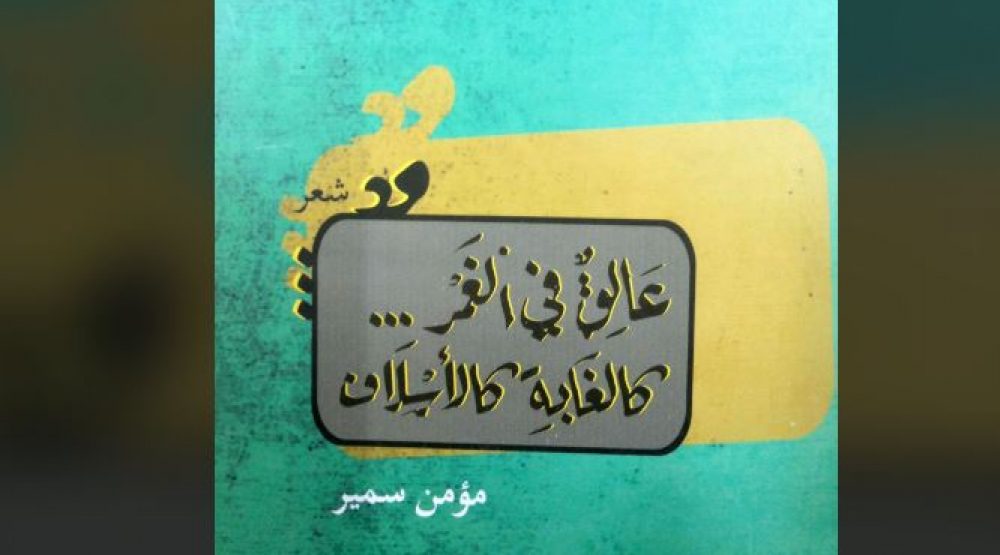أيمن بكر
ما الذي يطلبه النص الشعري من القارئ المرتبك أمام طوفان تصوير صعب يشكل عوالم أسطورية مدهشة وغرائبية؟ سؤال يفتح الباب لأسئلة أخرى تتفرع عنه: كيف ولماذا يشكل الشاعر عوالم أسطورية تدعي قدرة على تقديم تفاسير جديدة لظواهر العالم؟ هل حقا يقوم بذلك أم أنه يهوم في ارتباكاته التي تفضي إلى لا شيء؟ وفي محاولة إثارة أسئلة من هذا النوع، تقدم هذه المقالة قراءة لديوان الشاعر المصري مؤمن سمير “عالق في الغمر كالغابة كالأسلاف”، الذي يبدو ساعيا لتشكيل أسطورة تنفلت من تراث الأساطير الموروث. وهي قراءة تتساءل في الوقت نفسه عن منطق تجاور النصوص في ديوان شعري حديث من هذا النوع المحير، ساعية في خلال ذلك إلى مناقشة بعض مشكلات النقد؛ خاصة ما يتصل بالتعامل مع مقدمات التأويل، وسيادة التوجه التأويلي الباحث عن معان جديدة للنصوص على الدراسات النقدية الحديثة، بأكثر مما تفعل التوجهات الجمالية أو المنصبة على فعاليات القراءة.
ــ ١ ــ
دعونا أولا نعيد النظر في مقدمات التأويل عند مؤمن سمير.
يكاد لا يخلو ديوان للشاعر مؤمن سمير من مقدمات تأويل Thresholds of Interpretation (ما يُطلق عليه استسهالا عتبات النص) تؤدي دورا بعينه. تمثل مقدمات التأويل في ألاعيب مؤمن الجمالية حضورا كثيفا لنصوص آخرين من مختلف الحقب والثقافات ومجالات المعرفة على اتساعها، كأنما ترك الشاعر لديوانه ـ بعد أن اكتمل أمام عينيه كيانا مستقلا حيا ـ حرية النظر في تراث الإنسانية كلها لينتقي ـ الديوان ـ ما يصلح عباءة تلتحف بها نصوصه بكثافة لافتة للنظر، أو ربما هي مقدمات تشبه أحجيات تفتح باب اللعب مع من يريد التفاعل مع تكويناته الجمالية.
لكن اللعبة التي اعتادها النقد هي كيف يمكن أن تكون نصوص المقدمات مفتاحا للفهم والتفسير، وإجلاء غوامض التجربة الشعرية ذات الرموز اللغوية الكثيفة بحثا عن كنز المعنى؛ إذ المعنى عبر تاريخ الدراسات النقدية العربية هو الهاجس الأكثر إلحاحا: ما الذي تريد أن تقوله؟ سؤال يواجه الشاعر المعاصر كثيرا، وإجابته الوحيدة هي أن يعيد الشاعر على مسامع السائل نص القصيدة دون زيادة أو نقصان، ليكسر فكرة أن الشعر خطاب يجب أن يقترن بمسودات تفسيره.
وربما كانت النصوص التي تغلف تجربة الديوان تعبيرا عن فقدان ثقة في القارئ، وربما مارست سخرية عميقة ليس من الناقد التقليدي فحسب، بل من قواعد الكتابة المعتادة نفسها، وأحسب أن مراجعة مقدمات التأويل عند مؤمن سمير تؤيد هذه الفكرة بطرق مختلفة.
ـ ٢ ـ
عوالم السحر والأسطورة في شعرنا العربي المعاصر الذي يدّعي التجريب لها تجليات محددة، صارمة، شحيحةُ ماءِ الشعر. عوالم الأسطورة والسحر معظمها، لدى من يجرؤون على اجتراحها، مستدعاة مستخدمة لصالح مبالغة شعورية، أو منحوتة بعنت لصالح ترميز أحادي ساذج بحيث يمكنك أن تختصر أسطورةٌ جهد الشاعر في نسجها أو استحضارها أو صياغة بعض أجزائها في كلمة أو عبارة تبدو الهدفَ النهائي للنص الملتحف بهذه الأسطورة أو المستخدم لبعضها من مثل: الانكسار، الإحباط، النشوة أو ربما النضال الوطني. وهنا يسقط الشعر والنقد كلاهما في فخ الهدف التقليدي: المعنى.
قلما ستجد في الشعر العربي التجريبي ما يشبه صناعة أصيلة لعوالم سحر وأسطورة ليست قابلة للاختصار في حدود أيقونية دالة، ولا تسعى للأخذ بيد القارئ نحو رؤية سامية علوية مفارقة ومتعالية ومحددة بصورة رسولية مسبقا، تنتهي بمعنى لا يختلف عن مخرجات نصوص الشعر العمودي. النماذج كثيرة لتلك الاستخدامات المنهكة للقارئ.
الأهم من التعرض لتلك التجارب أو التعريض بها هو سؤال لماذا يبدو الخيال الشعري لدينا قريب الغور؟ لماذا لم نشهد في فترات نسج فيها شعراء من مختلف أنحاء العالم عوالم شعر أسطورية كثيفة عميقة وموحية مطورة للوعي والشعور (ليس فقط ما صاغه دانتي في كوميدياه الإلهية) لماذا لم نشهد تكوينات أسطورية شعرية مشابهة في الثقافة العربية؟ هل هي غير موجودة أم أن النقد هو من تعجز عينه الكليلة عن رؤية الغور؟
الأزمة من زاوية تكمن في انفصال طبقات من تاريخ المنطقة المعبأ بأساطير طازجة أفاد منها العالم إلّانا. طبقات كثيفة من تاريخ المنطقة، عميقة ومبدعة في تخليقها للأسطورة وعوالم السحر، تم فصلها بجراحة تاريخية مجرمة عن وعي الأمم، بالإنكار والتجاهل والتشويه في مؤسسات التعليم، أو بالأحكام الأخلاقية المسطحة، أو بالعجز الإبداعي والنقدي عن إحيائها وكشف غورها، فلم تعد تغذي الروح أو تغني العقل، بل أصبحت مثار فزع ووصم إقصائي يشعل الريبة تجاه من يقترب منها، ليُترك الإنسان في صحراء رؤية وتصورات قاحلة، تصفر فيها رياح العجز وفقر الروح، والتطرف والعنصرية والتشدد الديني من بعدهما.
لكن ما يفعله مؤمن سمير ـ وهو ما اجترحه قبله عفيفي مطر، ثم بعض الشعراء بصورة أحسبها أقل عمقا ـ هو التجرؤ على خلق عوالم أسطورة وسحر لا تنتمي سوى لتاريخ وعيه بالعالم. يتحرك مؤمن سمير ضمن منظومة رؤية للعالم والذات والتاريخ والكائنات الحية تبتعد خطوات عما اعتدناه من تصورات جاهزة لا تقدم سوى تكرارات مبدعة في تخفيها.
هل يمكن لأحد صناع السينما أن يحول عوالم الشعر التي يقدمها مؤمن سمير إلى فيلم يشبه الأوديسا؟ ربما.
ـ ٣ ـ
سأقف عند ديوان “عالق في الغمر كالغابة كالأسلاف” لأناقش فكرة واحدة: مؤمن سمير يخلق عوالم من السحر والأسطورة ليس الأهم فيه أن يتم ترجمتها إلى مقولات ثقافية راهنة، أو معان إنسانية تجد مصداقها في اللحظة التاريخية التي يعيشها الشاعر. أقول: ليس الأهم، أي إن من أراد البدء في قراءة تجربة مؤمن بعين الباحث عن ترميز ممتع في حل شفراته، لينتهي به إلى عين ماء المعنى مستمتعا بالنظر فيها إلى صورة وجهه أو قناعاته أو واقعه فسيتمكن من ذلك بصورة ما. الفرضية إذن هي أن الشاعر يقدم عوالم أسطورة وطلاسم سحر لا تقف عند هذا الحد الضيق. فما الذي يقدم مؤمن في نصوصه؟ والأهم: كيف؟
عالق في الغمر كالغابة كالأسلاف، عنوان يلقينا في أفق أسطورة تتشكل؛ في البدء كان الماء/الغمر، وكان الأسلاف عالقون في الغابة كأي من حيواناتها:
الأسلاف
الذين فصلوا جلودهم
خلف الظلال الدافئة
ونغموا السكينة
لما شموا المخالب
وانتهبوها
سابوا في آخر الكهف
سوطا
لزيت الحنين والحنطة
دقوا تحت عصا الراعي
هلال
التل
البعيد ………….
………………..
……………….. (الديوان/٥)
هكذا نبدأ من البداية لا كما شاع فهمها بالضبط، ولكن كما يريد الشاعر أن ينسجها مقدما لعالم أسطورة تخصه. وكي لا نضل الطريق تمتد مقدمات التأويل آخذة بيد القارئ نحو عوالم السحر كخطوة أولى. المقدمة التأويلية الثانية إهداء:
إليها..
“أليس” …
كلما تخطو إلى العجائب
تفوتُ رعشةً..
ينسانا فيها
الظل…. (الديوان/٩)
ينسحب عنا الظل إذن بقدر ارتعاشات “أليس” المندهشة بعوالم الأسطورة الطازجة التي تراها بعين طفل. ينسحب الظل الدافئ الذي فصل الأسلاف جلودهم خلفه، ثم وجب أن يخرجوا من خلفه بعد أن صاغوا جلودهم، هنا تحديدا تتبدى شمس لم يرد لفظ يدل عليها، لكن ألا يجب أن يخرج الأسلاف من ظل دافئ إلى شمس دهشة تخطو تحتها أليس متخلية عن أمان الظلال؟
مقدمة تأويلية ثالثة تبدو كأنها معلومة عن المدى الزمني للكتابة لكن الشاعر يقدمها هكذا:
تم قنص النصوص بدءا من ٢٠٠١ (الديوان/١٠)
إصرار على العودة نحو غابة الأسطورة تخليقا ومعايشة، النصوص صيد هائم في البرية والشاعر قناص يوهمنا أنه لم يفعل سوى اصطيادها مكتملة. هل الأسطورة سوى كيان فني مغلق مكتمل، يريد إيهامنا طوال الوقت أنه تفسير الظواهر الآتي من ثقوب الكون السوداء حاملة الحقيقة، وأنّا لسنا سوى قناصيه؟ لكن الصياد/الشاعر هنا ليس مجرد قانص لحقيقة موجودة مسبقا، إنه صانعها.
ـ ٤ ـ
لكن كيف نهيم في غابة أسطورة دون اتخاذ المعنى دليلا هاديا وهدفا نهائيا نلقي من بعده النص ممتلئين برضا من أنجز مهمته؟ يبدو أننا نحاول مستحيلا، المعنى هناك دائما، كامن بين الأحرف، إنه محتوى اللغة ووظيفتها، فكيف الخلاص من ضغطه الشديد لتحقيق طموحنا العميق في السيطرة على النص والعالم من ورائه؟
محاولات الفلسفة والنقد الملتحف بها قدمت الكثير من الأفكار والآليات الساعية لكسر صنم المعنى الأوحد النهائي، الذي يجب أن يتحقق حوله إجماع قراءٍ يشبه إجماع الفقهاء. المعنى يمكن أن يتعدد والنص قابل للتأويل والتأويل المضاد، ثم التأويل المضاد ثانية، عبر خلق بنية بعد بنية للمعنى يقوم كل منها على مركز نصي لا يتسم بالثبات النهائي المطلق. وحتى لا نقع في محاولة أخرى لشرح التفكيك دعونا نقارب متلاعبين الأسطورةَ التي يصنعها مؤمن سمير ساخرا فيها من المعنى ومخلصا للتشكيل الأسطوري نفسه.
في قصيدته الأولى يتشكل عالم مواز لعالمنا باختصار مربك لكنه يبدو مريحا لمن أراد الإمساك بمعنى:
الإقطاعي
يرسم الغابة
ثم يهيم
يفوت الخدم والذهب والموسيقى
ويغمغم .. تحفظني حيواناتي
وبعدما طالت الرقصة في مرايا البهو
شدت المخالبُ الشكَّ
وقالت موتا تموتُ …. (عالق في الغمر/ ١٣)
الغابة مسرح الأسطورة التي تتخلق هنا، تماما كقصة الخلق في التوراة، ويمكن لمن شاء أن يحول الكلمات إلى رموز أحادية مسطحة تحيل إلى الأسطورة السابقة، كأن يرى في الإقطاعي الإله الخالق، وفي الغابةِ العالمَ، وفي عملية الرسم عملية الخلق التوراتية التي استراح بعدها الرب، ثم في الحيوانات التي أشهرت مخالب الشك البشرَ الذين تمردوا على خالقهم وأوسعوه خمشا حد القتل. هكذا سيبدو مؤمن عبقريا في اختصار أسطورةٍ والإشارة إليها في أسطر معدودة تنتهي بصيغة تنتمي للأسطورة القديمة “موتا تموت”. كما يمكن للناقد المفتون بالمعنى أن يتساءل عن مرجعيات الضمائر في السطر الأخير: من ذا الذي “موتا يموت؟ أهو الشك، أم من يتوجه إليه الشك؟ لكن الأسطر هي افتتاح للعوالم الموازية التي يرسمها مؤمن (لا أحسب فعل الرسم هنا اعتباطيا أو مجرد صدفة) مستمتعا بالرسم وتتبع الصورة المتحركة التي تقدم أسطورة تتشكل في لحظة الكتابة دونما هدف مسبق يحدده المعنى المقدس.
لكن دعونا نتحرر من فكرة الترميز السخيفة تلك، ودعونا نقلب العلاقة: ليس تسعى قصيدة مؤمن لصنع رموز تقود إلى الأسطورة القائمة في الوعي وفي تاريخ البشر، الأقرب أنها تسعى لتحويل الأسطورة القائمة في الوعي إلى رمز يقود إلى أسطورته هو. بعبارة أخرى؛ يستخدم نص مؤمن الأساطير الموروثة لصنع أساطير جديدة.
بعد ما يبدو اختزالا للأسطورة التوراتية في الأسطر السابقة تتحرك الكائنات التي يشكلها نص مؤمن مبتعدة عن مسار الأسطورة الموروثة، راسمة عوالم مبهرة في تفصيلاتها (مرة أخرى أدعو صناع السينما الشباب لتحويل عوالم الأسطورة هنا إلى فيلم مجنون)، ولنلاحظ التفصيلات التي تتأبى على التفسير الحسابي الأحادي الباحث عن معنى:
إقطاعي يرسم غابة ثم إن لوحته تدب فيها الحياة فتتحرك كائناتها وتخرج معملة أدوات الشك في رسمها، وهو، الإقطاعي، كيان خرافي كالعنقاء:
من الظل
المجدول
يسحب حفرة
ويعلق بالرائحة ..
يخلع الريش وساقيه
وساعة عض الندم رجاءه
ينهش بصيرته
كي لا يضطر راكبا روحه الأخرى
أن يرنم في المحفة
للتي ظلت سنين الرعشة
ترف على الغدير (الديوان/ ١٤)
خطيئة كبرى هنا أن يحاول القارئ/الناقد البحث عن دلالات الإقطاعي والحيوانات والحفرة والرائحة أو تلك التي “ترف على الغدير” أو “الأشباح الذين شرعوا تحتنا المراثي” (الديوان ص ١٦)، فعوالم النص تتشكل أمام عينيك بطزاجة تدعوك لأن تكشط طبقات فهمك للعالم وللشعر، تلك الموروثة بلا وعي أو مراجعة، وأن تتحلى بطزاجة شبيهة لتلك التي بزغت في روح الشاعر ووعيه، وأن تسير معه تماما مثل “أليس” لاكتشاف عجائبه والمشاركة في صنعها أحيانا، دونما سؤال عن المعنى، وإنما بتأمل هادئ ــ وما أصعب التأمل الهادئ ــ لكل ما يتجلى هنا للمرة الأولى متحديا، أو راغبا في تحدي، كل ما ورثناه من أساطير وأبنية معنى جاهزة. خطيئة كبرى ألا نرى أساطيره كما أراد لها أن تكون: طازجة مدهشة متخلصة بصورة كاملة مما ورثه الوعي الإنساني. ولكن هل هذا بالإمكان؟ هل نحن أمام رغبة تطهر خرافية مستحيلة؟ وهل الصوت الشعري أو الذات الشاعرة على وعي باستحالة تلك الحالة التطهرية، الراغبة في العودة بكل ركام الحضارات الإنسانية إلى لحظة براءة أولى يكون فيها الشعر قابلا لصياغة أساطير جديدة، جديدة تماما؟ وهل أساطيره الجديدة ستختلف عن القديمة أو تقود إلى مصير مختلف؟ لا تغيب تلك الأسئلة عن أفق الديوان ومع عركها الموجع للوعي تتجلى رغبة في الموت، لكنها ممزوجة بالرغبة المحركة للديوان في صنع أسطورة لا مثيل لها، أسطورة تخصه هو وحده.
كل ما أبتغيه
مراسم دفن
تنوب عن وجهي
وعجائبي
تبدأ الطقوس
مثلا ..،
بسرب من الطبول، وطيورها المجرمة ..
ثم تحش كل فصيلة
رقصة
ويرمي كل نبات بذوره
في حجر الفضاء
تحضن الكوة الزرقاء الأرض
وترتعد الضغينة .. (الديوان/٣٧)
النقاط بعد كلمة “مثلا” تمثل لحظة بداية تشكل الأسطورة في وعي الشاعر الآن/هنا، لتصبح مراسم دفنه هي آخر ما يطلبه من العالم المحبط الغبي المتعامي عن أساطيره. لكن اللعبة لا تتوقف؛ فمراسم الدفن تلك هي جزء من تكوينه الأسطوري المرهق لوعي العالم، الذي عليه أن يتفهم/يطيع ولو للمرة الأخيرة تلك الأساطير بمنطقها الخاص.
ــ ٥ ــ
“عالق في الغمر … كالغابة كالأسلاف” كتاب يضم ثلاث حالات شعرية بإمكان كل حالة منها أن تنفصل في ديوان مستقل، لكن ما الذي سيحدث لو جمعناها؟ لا شيء، فنحن مذهولون عن كل شيء في انخراطنا المدهش المربك من عوالم سحر صعبة، وبصعوبة وعنت ستجد قدرات التأويل والبحث عن المعنى مخرجا لها. لكن ما الذي يمنع أيضا أن تتجاور تلك الحالات الشعرية حتى لا تبدو كل حالة ــ إن هي طبعت منفصلة ــ صغيرة لا تنهض بتسويق الديوان؟ لا شيء.
الحالة/الديوان الأولى هو ما تناولناه في المقاطع السابقة ويبدأ بإهداء ل “أليس”، وينتهي عند الصفحة ٧٨. تبدأ بعدها حالة ثانية تقدم نصوصا قصيرة تتم عنونة كل نص فيها بكلمة كأنما سيقدم النص تعريفا لها: الدولاب/ التمثال/ القمر/ المسبحة/ الشاطئ/ الحجرة ..الخ.
لا تكتمل الحالة الثانية بانسجام بسيط؛ إذ تقتحمها حالة غريبة لا عنوان لها (هي الحالة الثالثة) تمتد من ص ١٢١ حتى ص ١٤١ مقدمة خطابات شعرية مختلفة ما بين فصيح وعامي، عمودي وتفعيلي ونثري. ثم تعود الحالة الثانية التي تقدم مقاطع قصيرة ذات عنوانات تعريفية للظهور مختتمة الديوان: الملاك/الهاتف/رجل بعيد/ ملاك بعيد/الزجاجة/ الأسماء/المقهى..الخ.
تبدأ الحالة الثانية ــ التي لن يخطئ القارئ في إدراك اختلافها عن حالة صناعة الأسطورة الأولى ــ بمقدمات تأويل أخرى كمن يبدأ ديوانا جديدا. يقدم الشاعر للحالة الثانية في ديوانه بمقتطف لبودلير وآخر لهيرمان هسه، لكني انتويت تجاهلهما تماما، كي لا أسقط في فخ البحث عن المعنى، ومحاولة ربط دلالات مقدمات التأويل بالنصوص التي تليها. يأتي بعد المقتبسان السابقان عنوان كأنما يبدأ ديوان جديد، ثم إهداء، وتصدير من أغنيات محمد عبد المطلب وقعه الشاعر بكلمة “طِلِب” وهو الاختصار المصري لاسم المطرب الشعبي المشهور. الشاعر مصمم على أن يفصل الحالتين الأسطورية وما يعقبها، أو ربما هما منفصلتان وأجبر الشاعر على جمعهما نظرا لإرغامات النشر والسوق.
النصوص في الحالة الثانية قصيرة، تعريفية، لكنها تعاريف تتصل بحالات خاصة، وجميعها مرتبط بالموسيقى، ما يتسق مع عنوان الحالة الثانية: “بقرابة الموسيقى”. يقول في البداية تحت عنوان الشجرة:
العصارة
تشيل العواصف
من الهابطين في الجب ..
والموسيقى تزيح لها
ملامح الورقة .. (الديوان/٨٧)
هكذا لا يخلو مقطع في الحالة الثانية من كلمة تحيل إلى الموسيقى: نغمة/ موشح/ دفوف/ كورس/ لحن/دندنة/ بيتهوفن/، وغير ذلك. إلى أن تأتي الحالة الثالثة مقتحمة تلك التعاريف المموسقة.
ــ ٦ ــ
الحالة الثالثة تبدأ فجأة دونما عنوان وتمتد بلا منطق شكلي محدد يرتبط بالسطر النثري، أو الأسطر المقطعة المتفاوتة الطول، أو الشكل العامودي للشعر، إذ تجمع تلك الحالة كل ذلك في إهابها. تبدأ بقوله:
هذا صباح جميل
الشمس ضاحكة كفستان أنثى
وثمة
موسيقى
تنزل
السلالم (الديوان/١٢١)
وبعيدا عن اللعبة المكرورة لتقطيع الكلمات كي تحاكي معنى النزول، يبدو أن ما ينزل السلالم ليواجه القارئ هو طوفان خطابات من مختلف العصور والأشكال تتمحور جميعا حول الموسيقي. هناك في هذا المقطع الممتد لحوالي العشرين صفحة:
١ــ سرد عن الموسيقى العربية منذ الرشيد والأندلس حتى اللحظة المعاصرة للديوان والشاعر.
٢ــ سرد عن الموسيقى الغربية في مراحل مختلفة.
٣ــ كلمات أغان عربية فصيحة وبالعامية المصرية وعاميات عربية أخرى.
٤ــ نصوص عِديد مصرية.
٥ــ تنظيرات عن الموسيقى من التراث العربي القديم والحديث.
٦ــ نصوص غنائية من تأليف الشاعر.
لدينا إذن خطابات نقدية وإبداعية/شعرية وغنائية، وتاريخية تدور كلها حول الموسيقى، لكنها في حالة اختلاط يدعو للتساؤل: ما سر تركيب تلك الخطابات بهذه الصورة؟ وما السبب في دخولها ضمن ديوان شعر؟
هذا مما سيجيب عنه كل قارئ على حدة، ولا أحسب أن له منطقا واحدا قادرا على رسم خارطة تلقٍ وحيدة/صحيحة له. إن الكثافة المربكة التي يقدمها هذا المقطع هي في ظني محاكاة لصخب مدوخ عانى منه الشاعر ووجد معادلا له في تتبع عوالم الموسيقى التي تتعالى على اللغة، بل وتستخدمها، وتقترب بذلك من تعالي أساطير الشاعر الذي يقدمها في الجزء الأول من الكتاب. هذا المقطع موحٍ بقوة بأن الذات الشاعرة تتعرض للتاريخ الإنساني وتحاول تقديمه بتلخيص مرعب في اختصاره، وهو ما يتناسب مع الموسيقى تحديدا؛ ذلك الفن الذي يموج خلف الفنون جميعا. ولا أدل على رغبة الشاعر في الإحاطة بتاريخ الموسيقى كمعادل مقترح لتاريخ الإنسانية من عشرات الإحالات التي سيجدها القارئ في نهاية الكتاب لكتاب ومطربين وموسيقيين من كل الحقب.
ولا أستبعد في هذه الحالة ــ لو توفرت للشاعر الأدوات المناسبة ــ أن يكون في مكان هذا الجزء في الديوان مقطوعة موسيقية مطولة من تأليف مؤمن سمير، تحاول أن تجمع في طياتها نماذج من موسيقات العالم عبر تاريخه برؤية تخص الشاعر. إن صح التصور السابق، ألا يعد هذا المقطع إعلانا عن ضيق التجريب الشعري العربي بحدود اللغة الألف بائية؟ ربما.
يختتم الكتاب الحالتين الأخيرتين بقوله:
تم ترنيم النصوص بدءا من ٢٠٠٢.
ما عدا الصفحات من”هذا صباح جميل ..الخ” وحتى” “لا لأحد” والتي كانت في الفترة ما بين (١٩٧٥و .. حواف الرعشة …..) ……. (الديوان/١٨٠)
أراد الشاعر أن يفرق بين الحالات الشعرية التي وقفنا على تقسيمها، مكررا ربط الحالتين الأخيرتين بالموسيقى، معلنا عن طموحه في أن تتحول القصائد إلى غناء أو موسيقى ليتم “ترنيم النصوص”. وأخيرا هو يميز الحالة الثالة التي تمتد من ص ١٢١ حتى ص ١٤١، ليجعلها مرتبطة بعمره، إذ تبدأ من سنة ميلاد مؤمن سمير نفسه وتصل إلى حواف الرعشة التي أحسبها لحظة كتابة هذه الحالة الشعرية التي يتم إغلاق القوس عليها الآن، لكن النقاط بعد القوس تقول إن هذه الحالة ممتدة بعد هذا الديوان ما امتد عمر الشاعر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناقد مصري