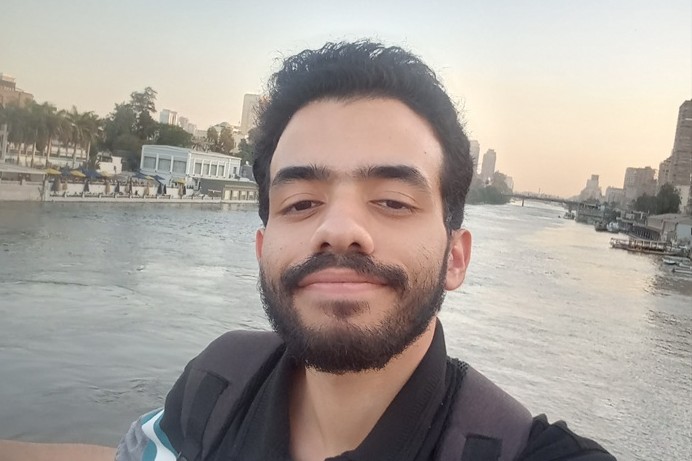بهذه الأسطر، كما تحضرني من الذاكرة، من مفتتح ديوانه الأول “والجسد عالق بمشيئة حبر”، والصادر عام1990، دشَّن علاء خالد مشروعه الشعري. كان ذلك الديوان، إلى جانب ديوان أحمد طه “إمبراطورية الحوائط”، على ما بينهما وما بين الشاعرين من اختلاف عظيم، بمثابة نقلة في اللغة الشعرية في مصر. نقلة مهدت لشكل قصيدة النثر كما عُرِفَت وسادت في التسعينيات. لقد اتخذ النثر سمته المديني بعيداً عن الغنائية الريفية المثقلة بالمجازات، لو جاز هذا الربط المتعسف.
كان ديوان “والجسد عالق…” حالة تقصّي للإحداثيات التي ترتسم عندها حدود ذات فرد من الطبقة الوسطى المدينية، في تقاطعاتها مع إشكاليتها الداخلية، ومحاولة لبلورة تبديّات السلطةالواقعة عليها، والاصطدام معها شعرياً. ولذا فقد جاء مثقلاً بالهواجس النظرية، لكن جدة اللغة، وموقع الشاعر في النظر إلى العالم هما ما شكّلا حداثته الجمالية وأعطيا للديوان فرادته وريادته.
وفي شهادة شعرية له من نفس الفترة، نشرتها مجلة “الشعر” إبان رئاسة الراحل خيري شلبي لتحريرها، سيقول علاء جملةً شديدة الدلالة: “على كل اجتراح لغوي أن ينفذ من خلال واقعه اللغوي“.
****
حكاية
تعرفنا بعلاء خالد وأسامة الدناصوري القادمين من الإسكندرية على مقهى زهرة البستان في القاهرة أنا وأحمد يماني ومحمد متولي، وكنا لا نزال ندرس بكلية الآداب. دعانا يومها علاء لزيارته في الإسكندرية على أن يستضيفنا في بيته. ولم نكذب خبراً، ففي صباح من شتاء عام 1992 ذهب ثلاثتنا إلى الإسكندرية، واستقبلنا علاء بالفعل في بيت عائلته القديم، 45 شارع إبراهيم راجي، بولكلي، رمل الإسكندرية. استقبلنا في غرفته التي تطلّ على حديقة البيت. وقضينا نهاراً تعرفّنا فيه على والدته صاحبة الابتسامة البشوشة، وعلى مفردات عالمه القريب: مكتبته، وبورتريه لصلاح جاهين معلق بجوار السرير، ولوحات علي عاشور الشائكة، ورسوم مهاب السيّد بهشور الحبر الأسود، وشفافية ألوان سلوى رشاد المائية. وثمة تفصيلة أخرى أذكرها بوضوح من ذلك الصباح البعيد، وهي أن علاء أطلعنا على مجلّة كان يحررها الشاعر العراقي عبد القادر الجنابي من أوروبا بعنوان “فراديس” ربما كانت نسخته هي النسخة الوحيدة في مصر. كانت المجلة تحتفي بإنتاج شعراء النثر العرب حول العالم، ولا سيّما من يعيشون في المهجر. وكانت تلك الحركة في أوجها بذلك الوقت، فسركون بولص وصلاح فائق ووديع سعادة وفاضل عزاوي وغيرهم، كانت أسماء مثيرة للخيال. وكانت المجلة مبهرة سواء في نصوصها أو في إخراجها الطباعي. كان صباحاً مُلهماً لنا نحن طلبة كلية الآداب الذين جاءوا ليزوروا صديقاً لهم شاعراً يكبرهم بعدة أعوام وسبقهم لنشر الدواوين. وفي الليل ترك لنا علاء غرفته لننام فيها، وذهب لينام في ركن آخر من البيت. كان والده مريضاً، وهو يراوح بين مكان نومه وغرفه أبيه للاطمئنان عليه. ولم يستطع يماني النوم ليلتها، وقام منتفضاً عدة مرات من كوابيس كانت توقظه مرتعباً، ليدخل علاء علينا في النهاية ليقول لنا إن أباه قد توفي…
***
1995 عام حافل
في وقت تلك الزيارة، كان علاء قد أصدر حديثاً ديوانه الثاني “وتهب طقس الجسد إلى الرمز”، وهذا الديوان في جمالياته، امتداد بشكل ما للديوان الأول، وإن بالعمل على رموز أكثر غوراً في النفس، وبمنحى يذكّر بفرويد أو بيونج، وفي جانب آخر يذكّر تناوله للرمز الديني للأب بكتاب “خوف ورعدة” لسورين كيركجارد.
وكان بصدد مراكمة قصائد ديوانه الثالث “حياة مبيّتة” الذي استخلصه من بين عشرات أو ربما مئات القصائد، كان يكتبها طوال الوقت، وهو مع الناس، وعلى المقهى، بخط دقيق وأنيق، في ورقات بيضاء منفصلة. وحتى في السهرات الصاخبة قد ينتحي جانباً ويخط أسطراً. كان علاء يعيش في تلك الأيام وكأنه يتحرك داخل فضاء شعري، وكانت تلك الحالة متناغمة تماما مع فكرته عن “شعرية الحياة اليومية”. وقد صدر الديوان فعلياُ في عام 1995. كتاب “حياة مبيّتة” هو التجربة الأكثر صفاءً في شعر علاء بهذه المرحلة، جاء متخلّصاً من الكثير من الهموم النظرية التي كانت تجثم فوق القصائد، بعد أن تمت تصفيتها في منحنيات حياتية، وخبرات كتابية أخرى. سيتوقف علاء بعدها عن إصدار الشعر لسنوات، وسيقول في إحدى لوحات كتابه القصصي “طرف غائب يمكن أن يبعث الأمل”الصادر في عام 2003، مشيراً إلى تلك اللحظة الماضية، وليضع حدوداً بين مرحلتين في رحلته مع الكتابة: “… عندما انسحب الشعر من الحياة”. هناك مرحلة أذن، كان الشعر فيها محايثاً للحياة، لكنها انتهت.
وأيضاً من علامات تلك الفترة، كتاب صغير جميل هو “رسائل عن سيزان” للشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه، وقد ترجمت سلوى رشاد الرسائل فيما علّق عليها علاء في نهاية الكتاب. كانت رسائل شاعر لصديقته التشكيلية حول فنان يحبّان أعماله، وبين سطور التعليقات على خطوط وألوان سيزان، كان ريلكه يبث عاطفته نحو صديقته، في نوع من الحب يرتكز على استقلال الأنا، حب بين ذاتين مستقلتين. ومن بين ثنايا الرسائل اقتطعت سلوى جملة لتجعلها عنواناً للكتاب: “كأن ينظر كلب في المرآة ويفكر: هناك كلب آخر”. كان ذلك الكتاب بمثابة إكليل لقصة الحب بين الشاعر والمصورة، عُقِدَ قبل أن يعقد قرانهما الرسمي أيضاً في عام 1995 ؛ عن علاء وسلوى أتحدث.
وفي العام نفسه قام علاء بما يشبه “الرحلة الوجودية” إلى واحة سيوة، ليصدر بعدها تجربته مع تلك السفرة في كتاب “خطوط الضعف”، في مراوحة بين ارتحاله إلى الواحة وارتحال داخلي، في حوار مع كل الإشكاليات والرموز التي كانت تؤرقه في ديوانيه السابقين، ومحاولة لتصفيتها كتابةً فيما يشبه المراجعة النظرية. كانت تلك الرحلة وذلك الكتاب مقدمةً لما سيتطوّر بعد ذلك إلى مشروع مجلة “أمكنة”.التي كرست مفهوماً جديداً لأدب الرحلة في الكتابة العربية، وفتحت أفقاً لأشكال أكثر حرية من النصوص المتعلقة بالمكان وثقافته.
***
ويستند مشروع علاء الأدبي في مجمله، على كتابة “الخبرة الذاتية”. هو مشروع لكتابة سيرة ذاتية طويلة، وفي أشكال أدبية متنوعة، كمرايا مختلفة الأحجام والأشكال، لكنها تعكس دائماً حقيقة واحدة.سيرة تتقاطع مع الواقع والتاريخ دون ضجيج أو غرض خارج الفعل الأدبي. ووضع الخبرة الذاتية، أو السلوك الإنساني تحت عدسة الجمالي يحيلنا دائماً لمحور آخر من القيم، هو “الأخلاق”. وفي الفترة التي تعرفت فيها على علاء والمجموعة المحيطة به والمجايلة له (أسامة الدناصوري، مجاهد الطيب، مجدي الجابري) كانت تكثر في أحاديثهم النقدية والتنظيرية عبارة “الأخلاق الجديدة” وبمعنى نيتشوي. ولكن ذلك الطرح قد خفت لاحقاً، وتبقى فقط الإرث الجمالي لتلك الحقبة، سارياً في موجات متلاحقة.
عاد علاء إلى إصدار الشعر عام 2006، بعد توقف استمر لتسع سنوات تقريباً، أصدر خلالها كتابيه النثريين “خطوط الضعف” و “طرف غائب…”. عاد بديوان “كرسيّان متقابلان” بنبرة أخف حدة، وتأمل هادئ وشفيف للحياة، بعد أن اكتسب الشاعر مكاناً واثقاً للنظر، متخلصاً من أشباح الماضي، فـ “الأسوأ قد مضى” كما سبق وقد أعلن مقتبساً من ماركيز. لقد اتسعت رؤية الشاعر فلم تعد القصيدة مرتكزها الوحيد، صار للشعر منازل أخرى أكثر اتساعا…