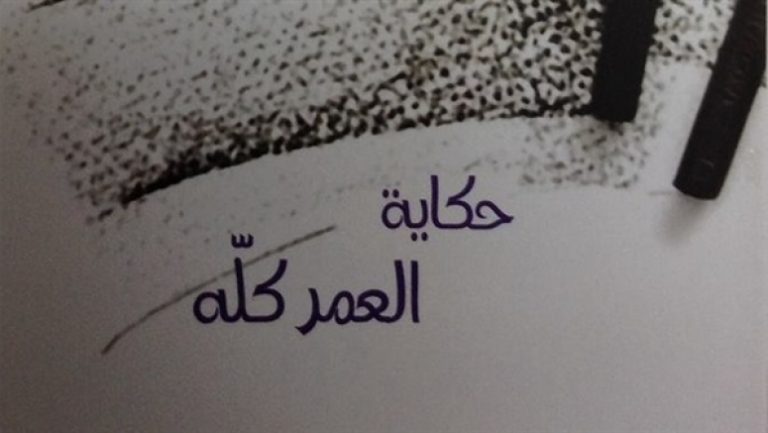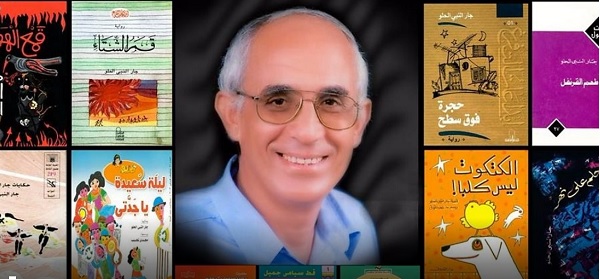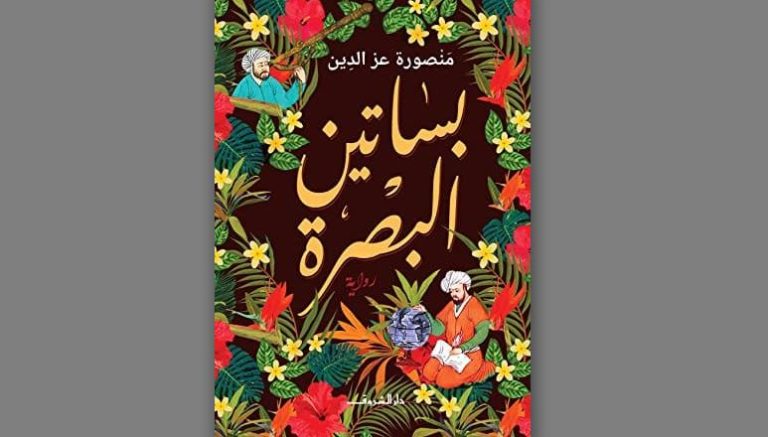مليم الأكبر كتابان، مقدمة ورواية. المقدمة تحكي قصة تالية على قصة مليم الأكبر، وكيف تقدّم الأستاذ عادل كامل بها إلى إحدى المسابقات الأدبية التابعة للجامعة، إلى جوار رواية السراب لنجيب محفوظ، ولم تنل أي من الروايتين حظوة عند المحكمين، ولا أي عمل آخر، فتم مد أجل التقدّم للمسابقة. في المقدمة، يتخيّل عادل كامل حواراً مطوّلاً يدور بينه وبين بطله، مليم، الذي لا يحب الكلام الكثير، وخصوصاً كلام المثقفين، الذين لاقى منهم الكثير، كما سنرى خلال الرواية، ولكنه هنا مكسور الجناح، عاتب على مبدعه لأنه ربما يكون قد قصّر في تصويره وتشكيله فكان مصيره من اللجنة الرفض والاستبعاد. وعبر صفحات عديدة يسوق عادل كامل الحجة بعد الأخرى، بذات اللغة الجليلة والجزلة، ضد المنطق الذي يحكم عمل تلك الجائزة، بروحٍ لاذعة السخرية ونبرة غاية في الخفة والطرافة. غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فإن المقدمة التي بدأت حواراً بينه وبين بطل روايته حول الجائزة ونصيبهما منها ومن عالم الأدب، سرعان ما تتحوّل إلى ما هو أعمق وأخطر، إلى بحث أدبي صغير يعرض فيه عادل كامل، عبر أكثر من مئة صفحة، أفكاره وآراءه حول العديد من القضايا الأدبية. هذه المقدمة، أو هذا البحث، أقرب إلى كتاب منفصل، عن الأدب والفكر واللغة، والمقارنة بين ما قدمه تراث الأدب العربي خلال مئات السنوات وتركيزه على اللفظ دون الفكر وبين أطروحات الأدب والفكر الغربيين، ولن يخفى تحامل عادل كامل على الأول وتحيّزه للثاني، ونبرة السخرية المرة من أفكار الجاحظ وأبي هلال العسكري صاحب الصناعتين، حول البلاغة والشعر والنثر، منتهياً إلى أن الفكرة في تراث الأدب العربي كانت ضئيلة كالنملة والعبارة ضخمة كالفيل، واللغة غاية تتخذ لذاتها. تلك مقدمة شائكة كلها حقول ألغام، وتحتاج إلى قراءات خاصة بها دون الرواية، وأيضاً في علاقتها بالرواية وإلى أي مدى انعكست تلك الأفكار والآراء في عمل عادل كامل السردي مليم الأكبر.
لا جدوى من تلخيص الحكاية المتشعبة هنا، غير أن ملمحاً أسلوبياً أساسياً قد يفاجئ القارئ الجديد لهذه الرواية، وقد يستغربه على كتابات تلك الحقبة، أربعينات القرن العشرين، وهو طاقة السخرية العفية التي يتشبع بها العمل كله. شيءٌ قد يذكّرنا من بعيد بالتهكم السردي الهادئ في روايات ألبير قصيري، لكنه هنا ليس تهكماً يميل للعدمية بابتسامة كسول لا مبالٍ، بل سخرية تضمر مرارة ونقمة على حال أمة وشعب ومجتمع. تعرف السخرية هنا أهدافها جيداً، إنهم هؤلاء المثقفين والفنانين المدعين الذين امتلأت رؤوسهم بالأفكار وكؤوسهم بالخمر، إنهم سكان القلعة، أو فندق نصيف، بشخصياتهم المضحكة العجيبة. وبمزيد من التحديد، هناك خالد، ابن الباشا الذي درس القانون في بريطانيا ودار في أوروبا حيث دار رأسه كذلك مع المذاهب المادية الجدلية وعاد شخصاً آخر، وتتقاطع حياته مع حياة مليم، ابن الشعب العملي غير الميّال للكلام، في أكثر من نقطة عبر الحكاية.
السخرية من أقدم وأشجع أسلحة الرواية الحديثة، منذ دون كيشوتى وحتى كونديرا، وعادل كامل هنا يدرك قوتها جيداً فلا يتردد عن استخدامها لكشف أقنعة وتناقضات أبطاله الذين يعيشون بأدمغتهم في زمن ومكان، وبأجسادهم في زمن ومكان آخرين. إنها الازدواجية نفسها التي عبّر عنها بطل الرواية خالد بوضوح، في مونولوجه بالمشهد الأخير دفاعاً عن نفسه أمام الرسامة الأوروبية هانيا اللعوب، التي أحبها هو وفاز بها مليم بعد أن صار من أثرياء الحرب وغيّر اسمه.
جميع سكّان القلعة، شلة “الرفقاء الأنذال” كما أطلقوا على أنفسهم، يملكون ضعفاً خاصاً أمام مليم، الصورة الصادقة الحية للإنسان ابن بيئته والمتعايش معها، الذي لا يدرك هو مقدار جماله وفتنته. يكتبون عنه القصص والمسرحيات ويرسمونه، وتقع هانيا في هواه. حتى إن الأستاذ شتا – أحد سكان القلعة الظرفاء – يكتب مسرحية بعنوان هذه الرواية ذاتها، مليم الأكبر، فكأن عادل كامل ولو من وراء حجاب مستتر لا يستبعد نفسه من ورطة هؤلاء المنقسمين بين أفكارهم وطبيعة العالم الذي يعيشون فيه. إنها وثيقة إدانة مازالت سارية حتى لحظتنا الراهنة، لكنها لا تحمل شيئاً من تجهم وجدية الوثائق، بل تحمل كل شيء من خفة وطرافة الفن.