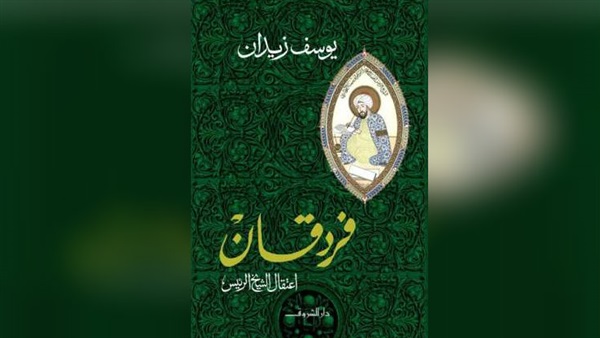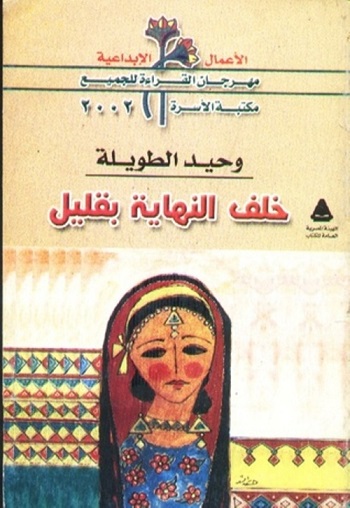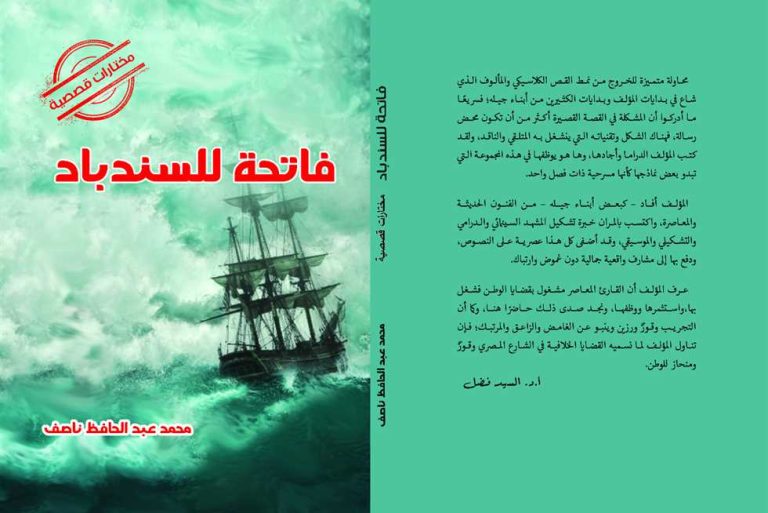كانت شريعة القطة بمثابة ذروة لطابع سردى فائق التخييل بدأه طارق إمام منذ مجموعتيه القصصيتين الأوليين ( شارع آخر لكائن وطيور جديدة لم يفسدها الهواء ) منتصف التسعينيات، وهو تخييل يكاد يكون مفارقا لكل مواضعات الواقع وإن ظل مشيرا إليه أو رامزا على نحو ما يقول سعيد الوكيل فى معرض تناوله لشريعة القطة : “.. تتجلي رمزية القطة في كل أنحاء الرواية. القطة لا تبدو كائنا حيا متجسدا، بل تبدومعني غامضا، أو روحا خفية تعبر عن ‘الوعي الجمعي الانساني أو الوعي الجمعيالشعبي أن صح التعبير. الرواية تعبر عن التقلبات التي تمر بها تلك القطة، أو لنقلتلك الروح الكامنة التي تعبر عن نفسها في صور مختلفة وتجليات شتي.من السهل أن تختزلتلك الروح، فنفهمها تعبيرا عن الروح المصرية التي تشكلت عبر العصور، ومرت بأزماتحضارية متعددة ومحاولات دءوب من قوي مختلفة لخنقها ووأدها، لكنها بسبع أرواح،لاتكاد تفقد روحا حتي تبعث من جديد”
وبغض النظر عن هذه القراءة الرمزية المحكمة التى حولت الرواية إلى معادل موضوعى لتاريخ وواقع التجربة المصرية، فإن كتابات طارق تمنح ناقدها مساحات عديدة ومختلفة من التأويل نتيجة للمفاجئات والفخاخ التخييلية التى يشغل بها النص، فنصوص طارق إمام ليست غامضة كما يذهب البعض، ولكنها مراوغة، لعوب، ترغب فى التحليق بعيدا عن معيارية الواقع، فتبدو شخصياته وكأنها كائنات كارتونية تتمازج فى عالم كرنفالى من الطيور والحيوانات والقراصنة والأمراء والشياطين،فكأنها تأتى من عالم الأحلام والأساطير والحكايات الشعبية ولا تأتى من الواقع المعيش. وهى تتمتع بقدرات خاصة ومهارات فائقة، وتدخل فى تجارب ومغامرات بروح ساخرة لعوب، إنها شخصيات تذكرنا بكائنات كليلة ودمنة، لكنها لاتحمل حكمتها ولا رمزيتها ولا تدعونا إلى تأملها بقدر ما تدعونا إلى معايشتها وتصديقها والتعاطف معها، وهكذا يمكن للقارىء أن يشفق على الشيطان فى (شريعة القطة ) كما يرى القتل فعلا إنسانيا وشعريا جميلا فى ( هدوء القتلة ).
وحتى هدوء القتلة تظل تجربة طارق إمام تمنحك هذا الشعور بالخيال الفائق اللعوب، على الرغم من أن وصلات الربط بين المتخيل والواقعى فى هذه الرواية أكثر مما اتاحته لنا شريعة القطة، وظنى أن هذا ناتج للحضور المتعين للشخصية الروائية فى هدوء القتلة، فنحن فى هذه الرواية أمام شخصية مركزية تقوم على إدارة السرد وتوجيهه، فهى مسؤلة عن كل الأحداث التى تدور حولها، وهى شخصية من لحم ودم. لها ملامح وحاجات إنسانية، ولكنها رغم ذلك تتمتع بقدرات فائقة تجعلها أقرب إلى الخلود فلا تموت، فكلما قتلت أحدهم منحها الموت حياة جديدة . هكذا تبدو أقرب إلى شخصية مصاص الدماء المستعارة من السينما. ومن ثم فإن كل ما يحدث فى الرواية يقع فى منطقة مراوغة من الوعى، بين الشك واليقين، بين الحقيقة والخيال.
فهدوء القتلة” تمنحك تفاصيل جديده مثل الانسان الذى يموت اكثر من مرة.والميت الذى يشاهد جنازته ويطمئن على أنه يدفن فى القبر الصحيح. هذا موطن جمال تمنحنا اياه الروايه. إنها عالم يلعب بنا وكانه طفل أو إله إغريقى يعيد ترتيب العالم والازمنه مثل طفل يلعب لعبه تركيب المكعبات. وتطرح أسئلة طفوليه مثل ماهو مصير المانيكانات البلاستيكيه بعد الموت؟ اين تذهب ؟الرواية تخلق عالمين مختلفين على مستوى اللغة والادراك. الاول واقعي يدركه الشخص العادى والبسيط .الآخر محمل بكل جمال اللغة والتخيل فى آن واحد حتى تجد نفسك داخل عالم من الاسطورة”2 دروب هشام الصباحى .
هذا التقديم بشريعة القطة ثم هدوء القتلة ضرورى هنا ، لننتهى إلى تصور معاكس لما نشير إليه، بأن الرواية الجديدة تتحرك فى اتجاه الخيال مفارقة للواقع، فمع رواية ( الأرملة تكتب الخطابات سرا) نرى أن منحنى التخييل ينحدر من شريعة القطة إلى هدوء القتلة، ثم نراه فى ( الأرملة … ) يكاد يرتطم بالواقع أو يتماهى فيه تماما. حتى لانكاد نعرف حدودا بين الواقع والمتخيل إلا عبر لمسات رهيفة يوزعها طارق مندسة بين السطور. هذا الاقتراب من الواقع يوحى إلى البعض بأن طارق إمام يتخلى عن مشروعه. لكننا نراه درجة من النضج الفنى .والتفاعل الحى مع التجربة الإنسانية التى مهما كانت فهى تعيش على الأرض. ويعكس وعيا تفكيكيا بدحض الثنائية الضدية بين الواقع والخيال . بمعنى أن كل منهما يسكن الآخر ويعيد إنتاجه . فما قصدناه بقوة الخيال فى الرواية الجديدة لايعنى رغبتها فى الانفصال عن الواقع بقدر ما يعنى تماهى كل منهما فى الآخر ، فالاستغراق الكامل فى المتخيل قد يحول الرواية إلى مجموعة من الأحاجى والرموز التى تقبل الإسقاط أو التأويل الرمزى .
ومن هذا الاعتبار ننظر إلى ( الأرملة تكتب الخطابات سرا ) بوصفها درجة من درجات نضج الوعى الجمالى لدى طارق إمام ، فاللحظة التى يعيشها العالم ألان نتيجة للتفوق العلمى والتكنولوجى المعجز، جعل إمكانات الواقع اليومى فائقة حد التماهى فى الخيال. وجعل الأجيال التى عاصرت هذه المتغيرات، وترى هذا التحول للواقع من العادى إلى واقع فائق القدرة فى لحظة مربكة وموزعة بين الشك واليقين أو بين الواقع والخيال أكثر حساسية لهذا التحول ، فلا أحد منذ خمسين عاما مثلا ،كان يصدق أن شخصا يسير بشارع فى مصر، يمكنه أن يتحدث إلى، ويرى فى نفس اللحظة شخصا آخر مسترخ على مقعد بمقهى فى مدينة استرالية صغيرة. فما بالنا بأجيال أحدث شهدت هذا التحول وانهمكت فى صنعه وأفادت منه حتى تربى وجدانها عليه .
ولعل هذا التماهى بين المتخيل والواقعى فى رواية ( الأرملة .. ) هو الذى يكسبها طابعا أقرب إلى واقعية ماركيز السحرية بدءا من العنوان، والحقيقة أننا نشعر بأنفاس ماركيز قابعة فى كثير من جوانب السرد، ليس بالضرورة على مستوى الحكاية ، ولكن على مستوى اللمسات والإحالات الأسلوبية التى تكسب الواقع بعدا غرائبيا والتى يسميها طارق إمام ( العناصرالتى تصنع الدهشة)، ففى حوار له بجريدة القبس يقول: “المجد ليس للحكاية بل لعناصر الدهشة “.3 .
ومع ذلك فعلى مستوى البنية التحتية للحكاية، تذكرنا الأرملة عند طارق، بفرمينا داثا( الحب فى زمن الكوليرا ) التى عاشت قصة حب قوية فى مراهقتها لكنها تزوجت من رجل لاتحبه ولاتكرهه واستسلمت لهذه الزيجة الروتينية المستقرة تماما، ومنحتها كل عمرها فى صمت وتفان، وبعد أن يموت الزوج، وتظن الزوجة أن عليها أن تتهيأ للموت أيضا يباغتها حبها الأول من جديد وكأنما تستكمل ماتوقف من عمرها.
إن هذا التناص الماركيزى الذكى لرواية طارق إمام مع رواية ماركيز، لايحرمنا من تلق متفرد لرواية الأرملة تكتب الخطابات سرا. وهو الذى يفتح أفق التوقعات لدى القارىء لها، بحيث يستعيد خبرات قرائية سابقة تضاعف متعة التلقى. وتثرى زمن القراءة بتقاطعات تأتى من خارجه.والحقيقة أن طارق إمام من الكتاب الذين يملكون وعيا قرائيا خاصا ومميزا يظهر فى ممارساته النقدية لأعمال آخرين،ومن ثم فهو قادر على الوصول إلى البنى التحتية للنصوص، لهذا فالتناص عنده لا ينشغل بالمعانى الظاهرية للنص، إنه ليس التناص الصريح الذى وجدناه عند أحمد ناجى فى ( روجرز )، لهذا نصف الأرملة بأنها مشبعة بروح ماركيزية من غير أن نمسك بتشابهات واضحة بينهما.
إن أزمة فتاة أنتزعت من حبها الأول هى أزمة الأرملة عند طارق ، فى حين أن ماركيز اهتم بأزمة الفتى العاشق، وهو انحراف جوهرى وأصيل فى تجربة طارق إمام يميزها تماما عن رواية ماركيز، كما أن طارق لم ينشغل بتاريخ الشخصية على نحو ما يفعل ماركيز مع شخصياته، ولكنه ركز على لحظة محددة فى حياة الأرملة،هى الأيام الأخيرة قبيل موتها، وهى لحظة يقف فيها الإنسان على الأعراف بين الموت والحياة والحقيقى والمتخيل والجوهرى والعابر والراسخ والزائف. المتعة والألم . إنها لحظة مثيرة ومربكة ومدهشة بطبيعتها. أثارت دهشة ماركيز نفسه عندما تمنى أن يكتب رواية تضاهى الجميلات النائمات لكاوباتا.
هكذا يمكننى القول أن الإدهاش لم يتوفر فى عناصر الحكى فحسب كما يقول طارق إمام، ولكنه أيضا فى بنية الحكاية التى اختارها. فليس من قبيل المصادفة أن اختار طارق هذه اللحظة الزمنية الغامضة فى حياة الأرملة، التى يتداخل فيها الموت والحياة، وسوف نرى كيف تنهار الحدود الفاصلة بين كثير من ثنائيات الوعى فى حياة الأرملة. وكأن الأرملة تعيش لحظة أقرب إلى فقدان الوعى.
هذه الحيلة البسيطة مكنت طارق إمام من العبور السلس فوق كثير من اليقينيات من غير أن يعلق بها، فتتداخل الأزمنة ويتداخل المرئى فى اللامرئى ويتداخل المعيش فى الحلم والواقعى فى المتخيل والحقيقى فى المجازى. انها حقا تجربة تقف على الأعراف حقا.
كانت الأرملة فى مراهقتها، قد أوقفت قصة حبها الأول، واستردت خطاباتها الغرامية بمجرد أن ارتبطت بزواج روتينى باركه الأب، واحتفظت بالخطابات فى دولابها طوال سنوات زواجها : ” اكتفت دائما بقرائتها كطقس سرى أثناء زواجها من رجل ـ لم تحبه ولم تكرهه أيضا ـ وهو من وجهة نظرها الأسوأ”.
كان الأسوأ فى هذا الزواج أنها لم تكن أى مشاعر تجاه زوجها، بما يعنى أن تيار المشاعر الحية فى فتاة مقبلة على الحياة قد توقف فجأة . لهذا تنصح تلميذتها: ” إذا فشلت فى الزواج من رجل تحبيه، تزوجى من رجل تكرهيه .. لكن أياك والزواج من رجل لاتحملين له مشاعر خاصة .. لأن يوما سيأتى عليك لتكتشفى أنك لاتملكين فى حياتك مايصلح للتذكر”.
لهذا كانت كل سنوات الزواج فى حياة الأرملة، بمثابة زمن مقتطع من عمرها ومن مشاعرها، أو زمن بلا أشياء تصلح للتذكر إنه ـ فى الحقيقة ـ نوع من الموت، لهذا، فإن موت زوجها جاء ليحررها من الموت. ويستعيد تيار المشاعر الذى انقطع. بإمكانها الآن تبدأ الحياة من جديد وكأنها ابنة الثانية والعشرين، قبل أن يراها الزوج ( الصائغ) عندما ذهبت مع أبيها لتشترى حلية ذهبية، عندئذ ، وفى اللحظة التى وضع الصائغ سلسلة ذهبية فى عنقها، كان يطوقها بها ويسحبها من أحلامها الغرامية إلى واقع ميت بلا ذكريات. غير أن الرسائل هى التى حفظت لها هذا الذكريات.
وهنا.. يمكننا الإشارة إلى إحدى الالتماعات، التى يسربها طارق إمام، وهو يقارن ( على لسان الأرملة ) بين رسائل الغرام فى زمنها، ورسائل الغرام الآن، عبر الهواتف المحمولة فى أيدى تلميذاتها، فالرسائل الأخيرة، عاجلة إخبارية معيارية، لاتحمل مشاعر ودفء ونبضات كاتبها، ولاتبوح بأكثر من معناها المباشر. لكن الأهم من ذلك، أنها لاتصلح لخزنها فى دولاب الملابس ـ حيث يقبع العالم السرى للنساء ـ واستعادتها وقراءتها عند الحاجة. إن رسائل ينات هذه الأيام على الهواتف المحمولة ميتة، لاتحفظ الذكريات. هكذا ، فعندما تقرر مدرّسة البنات (الأرملة ) أن تكتب الرسائل الغرامية نيابة عن بناتها، ليرسلنها إلى أحبائهن. فهى بهذا تمنحهن شيئا صالحا للتذكر. فربما تتزوج إحداهن من رجل لاتحبه ولا تكرهة. عندئذ ، لن يعينها على استعادة ذاتها سوى هذه الرسائل.
تعيش الأرملة زمنين :
ـ زمن نفسى / شعورى / سرى. إنه مستمر، لأنها تحتفظ به فى دولابها الخاص.هو زمن لم يمت تماما. تعيشه طقوسيا، على نحو سرى أيضا، عندما تقرأ الخطابات الغرامية التى كانت ترسلها لحبيبها، ثم ردها إليها من باب الشرف.” هذه المرأة لاتزال تحتفظ بقلب مراهقة تتهيأ للحب “.
ـ زمن واقعى يمضى بها فى رحلة اغتراب طويلة بعد الزواج ، ثم يتوقف فجأة بموت الزوج، وفى تلك اللحظة تظن أن بإمكانها استئناف حياتها الأولى، وأن تحرر زمنها الداخلى. زمن الخطابات الغرامية والمشاعر المتدفقة. هذه إشارة إلى طابع نوستالجي يسكن الأرملة ، إن زمن الخطابات الغرامية هو زمن الرومانسية حيث الحب له طعم حريف. غير أن الأهم ، أن الأرملة ، يمكنها الآن ، أن تعاود كتابة الخطابات الغرامية على الأقل لتلميذاتها، بل ويمكنها أن تتلقاها، على الأقل فى أحلامها، وهذه المعايشة النفسية العميقة لممارسات المراهقة التى احتفظت بها الأرملة تصل من القوة حد التجلى كحقائق .
هكذا تنهار الحدود بين الداخلى والخارجى، الحقيقى والخيال، سيبرر لنا هذا الوضع ، الموقف البينى للرواية كلها،وقوفها المثير بين أعراف بلا يقين، كما سيبرز لنا عمق المأساة التى تعيشها الأرملة وهى ترى أنه : لا الماضى يستعاد بنفس ملامحه، ولا يموت تماما ، سيظل شبح زوجها الصائغ يتجول فى الشقة ليذكرها بمضى الزمن، وبأنها لم تعد ابنة الثانية والعشرين ، هى الآن أرملة عليها أن تنتظر ـ بدورها ـ الموت . وستظل أحلامها تمضى فى زمنها الداخلى الذى توقف فى الثانية والعشرين. لتجد نفسها تكتب الخطابات الغرامية من جديد بروح مراهقة. لكنها فى لحظة تكتشف “أن اليد التى همت بالكتابة ليست يدها ” ليست هى يد ابنة الثانية والعشرين التى تعيشها فى زمنها السرى، بل هى يد أرملة مسنة تنتظر الموت.
هذه هى البنية النفسية العميقة لحكاية بسيطة متكررة عن قصة الحب الأول لفتاة تتزوج رجلا لاتحبه ولاتكرهه لتجد نفسها تنام فوق وسادة خالية ـ مع الاعتذار لإحسان عبد القدوس ـ من الذكريات والأحلام. وكأن حياتها مع هذا الزوج كانت صفحة بيضاء، عندئذ يمكنها أن تستكمل ذكريات حبيبها، وأن تبدأ فى كتابة هذه الفصحة البيضاء. صحيح أن الزمن الداخلى للأرملة يشبه صفحة بيضاء لم تسطر بعد، لكن زمنها الواقعى / الخارجى، كان يمضى بالرغم من كل ذلك، يعبر طارق إمام عن هذه المفارقة : ” كانت الصفحة المنبسطة أمامها مصقولة ، هيىءلها أنها ترى وجهها فيها . التقطت القلم لتكتب شيئات ، ولكنها توقفت فجأة ، قبل أن تخط حرفا.. لأنها تأكدت ـ مرتعدة ـ أن اليد التى همت بالكتابة ليست يدها “.
يشير المقطع السابق إلى أحد الالتماعات التى تصنع الدهشة كما يشير إلى طبيعة التجربة الجمالية وهى تقف فى منطقة بينية مراوغة تماما كما تجربة الأرملة نفسها. وأزمتها مع الزمن التى تتجلى فى شكل أزمة موازية مع الجسد . ففى الوقت الذى مازال جسدها يشبه صفحة بيضاء لم تسطر بعد، وفى الوقت الذى مازالت مشاعرها ورغباتها هى مشاعر ورغبات ابنة الثانية والعشرين ، فإن الزمن الواقعى قد وضع بصماته على هذا الجسد ، إنه الآن جسد عجوز . هذا ما انتبهت إليه . فهذه اليد التى تهم بالكتابة ليست يد ابنة الثانية والعشرين التى تعيشها، إنها يد امرأة عجوز .
فبطريقة ما يمكن تحريك البنية الحكائية إلى بضع ثنائيات : الموت والحياة ـ الماضى والحاضر ـ الواقع الداخلى ( الحلم ) والواقع المعيش . زمن الرومانسية والأحلام المحلقة وزمن الواقع المتشظى والأحلام المجهضة. ومع ذلك لايمكننا الزعم بأن الرؤية الجمالية للكاتب تسعى إلى تأكيد هذه الثنائيات الضدية بقدر ماتسعى إلى تماهيها وتداخلها. ويعكس هذا الملمح درجة وعى الكتّاب الجدد بالعالم، إنه وعى مفارق لوعى الحداثة التى بنت مجدها على ترسيم الحدود بوضوح بين الثنائيات من قبيل ( الذات والموضوع والأنا والآخر. والمجسد والمغيب والحقيقى والمجازى ) وغير ذلك من ثنائيات. وهذا الوعى المفارق لوعى الحداثة ، هو مايمكن أن نشير إليه بوصفه وعيا ما بعد حداثى .
بعد موت زوجها عادت الأرملة إلى مدينتها الأولى، كانت تهيىء نفسها لتنهى حياتها نهاية واقعية جدا، بضع سنوات أخيرة تمضيها كمدرسة بمدرسة بنات، تشغل ماتبقى لها من عمرها فى تنظيم الدروس الخصوصية بشقتها( يبدو التصاقها ببنات فى هذه السن بمثابة استعادة لما تقوف )، فيما تهيىء قبرا مناسبا لمرقدها الأخير. هذه سيدة شديدة الواقعية، شديدة الوعى بحاضرها كأرملة مسنة لم تنجب، عليها أن تعيش بضعة سنوات وحيدة قبل أن تموت. لكنها داخليا ، كانت تعرف أن الزمن لم يمض بها لأبعد من تلك اللحظة التى تلقت فيها آخر الرسائل الغرامية، لكن ، هاهى ، وبعد كل هذا العمر ، تأتيها رسالة أخيرة ” استطاع الخطاب الغرامى أن يهشم زجاج نافذة غرفة النوم السميك، وأن يستلقى بالداخل ، بالقرب من الجسد النائم للأرملة التى تحلم ” .
هذه العبارة الافتتاحية للرواية تحملنا على الظن بحدث واقعى ، يحدث خارج أحلام الأرملة، لكن أحلام الأرملة لاتختلف كثيرا عن واقعها ( ص13 )، لهذا ، فكل شىء فى حياتها ملتبس بين الحلم والواقع،هذه هى الحالة الجمالية التى تطرحها الرواية على القارىء ، فتضعنا طوال الوقت فى واقعية شديدة حد الوصفية المباشرة والترتيب الزمنى للأحداث الذى يقوم على علاقات منطقية ،على حو ما نجد فى كل القسم رقم( 4 ) من الرواية ، لكن شيئا يخترق كل هذا، وبلمسة رشيقة يرتفع بنا إلى المتخيل والحلمى، فالأرملة حين تستيقظ تجد خطابا غراميا مفرودا وملتصقا بجسدها، وترى زجاج نافذتها قد تهشم فعلا، لكنها لاتجد الحجر الذى هشم الزجاج ، ولاتعرف أى يد وضعت الخطاب مفرودا على جسدها. هل هى يد شبح الصائغ الذى مازال يتجول داخل شقتها ؟
على أى حال ” جاء الخطاب ليكمل ماضيها فجأة “ص18
جاء الخطاب فى حلم ، أثناء نومها لثلاثة أيام بعد واقعة المضاجعة التى تأتى فى الظلام ، ومع شخص غير متوقع وفى مكان غير متوقع أيضا ، فتبدو المضاجعة نفسها ، كما لو كانت قد حدثت فى الحلم .” أحاطت اليدان القويتان بخصرها ، وواجهها الوجه الشمعى بلا تعبير ، ووجدت نفسه ترتفع لتستريح مؤخرتها على حافة المقبرة، قبل أن تجد ساقيها ترتاحان على ذراعيه .هطل المطر من جديد ، أشد حدة ، واستقبله جسدها العارى بينما تركت لتأوهاتها العنان . رغم ذلك قل شعورها بالابتراد ومع استسلامها للحمى ، لم تعد تميز حدود اللذة والألم .”ص87.
لايمتلك القارىء يقينا بأن واقعة المضاجعة قد تمت فى الحقيقة .بالرغم من دقة التفاصيل الموهمة بالواقعية . فذات ليلة باردة ممطرة ، فيما كانت تكتب خطابا ، فكرت أنها لم تر مقبرتها ليلا ، هكذا خرجت إلى المقابر، وكادت تضل الطريق فى الحارات الموحلة بين المقابر،ثم ” بدأت تشعر بالحمى تجتاح عظامها ، وهيىء إليها أن الصباح ظهر فجأة، وأن يدا استوقفتها، يدا كانت بحاجة لها ضغطت على كتفها فزاد انغراس قدميها فى الوحل . وجه الخفير فى الليل لايختلف عن وجهه فى النهار ، وكان جزء من القمر يختفى مع كل انحرافة ، وتصير السماء أشد عتمة ، بينما ترى مقبرتها على البعد أكثر وضوحا. كان خلفها يدفعها بيديه للأمام، وهى كضريرة ، منومة، ووحيدة أمامه ..”ص77
هذا المقبوس، هو التالى ـ مباشرة ـ للمقبوس السابق. يضعنا فى منطقة لايقينية من حدوث المضاجعة، تتحقق هذه اللايقينية عبر عناصر أسلوبية مراوغة تستفيد من المجاز اللغوى وتنميه فتصل به إلى حدود الحقيقى، عندما تنبنى عليه سلسة من الأحداث المهمة فى السرد، فجملة مثل :” بدأت تشعر بالحمى تجتاح عظامها ” تبدو كتركيب مجازى شائع الاستخدام حد الابتذال، وهذا الشيوع للمجاز لايجعلنا نأخذه على محمل الجد. فنظن أنه مجرد تعبير عن حالة من الألم والمعاناة لأمرأة مسنة فى ليلة مطيرة باردة. ولكننا نرى، أن كل مايترتب من أحداث بعد ذلك، معطوف أو مرتبط بطريقة ما بهذه الحمى، ومن ثم يدخل فى منطق الهذيان والهلاوس الحسية. فالنهار يظهر فجأة، والقمر يختفى، والسماء أشد عتمة، ويد خفير المقابر تضغطها، وتريحها على حافها المقبرة، ثم يضاجعها هذه المضاجعة الخرافية التى أطلقت تأوهاتها المخزونة طوال العمر. فلا تشعر بالابتراد، ولاتعرف حدودا بين اللذة والألم.
لكن جملة تأتى من سياق آخر هو سياق الوعى لتخترق سياق الهذيان هذا ، تجيىء على لسان الأرملة : ” يومها فضلت نايمة ثلاث أيام .. مش قادرة أقوم .. كأنى مت .. وصحيت لقيت ورقة لازقة فى جسمى ” ص77.
سنفهم من ذلك ، أن حلم الخطاب الغرامى الذى حطم نافذتها والتصق بجسمها ، ذلك الذى رأيناه فى أول الرواية ، حدث أثناء نومها لثلاث أيام بعد واقعة الزيارة إلى المقبرة ليلا . سيشير هذا إلى التمويهات الزمنية التى يشتغل عليها السرد ، وهو ملمح مهم ، يكتنف كثيرا من مناطق السرد ، فيزيد من قدرته على مفارقة الواقع .
وفى سياق سابق ، سنفهم شيئا مختلفا تماما ، فثمة واقعة مضاجعة سابقة قد حدثت على سرير الأرملة وفى بيتها ، عندما عادت إلى شقتها فجأة ، فوجدت خادمتها ( رجاء ) وخفير المقابر على سريرها ، وترتب على ذلك أن ردت إليها رجاء مفاتيح الشقة ، وقامت الأرملة ببيع المكتب الحديدى الذى خصصت لرجاء بمدخل الشقة ، لتتمكن من متابعة تسجيل مايتعلق بالتلميذات اللاتى يحصلن على دورسهن الخصوصية . وهكذا يمكن تصور أن مشهد مضاجعة الخفير ورجاء أثار شهية الأرملة لمضاجعة أخيرة، فذهبت بالفعل إلى المقابر ليلا لعلها تحظى بمضاجعة تحتاجها لتستكمل ماتوقف من عمرها على نحو حسى أيضا ، بعدما تمكنت من استكماله على نحو وجدانى بكتابة الخطابات الغرامية للتلميذات .
إن هذا التسلسل للأحداث يحملنا على تصور أن مضاجعة المقابرة واقعة حقيقية وليست على سبيل الهلوسة الحسية. وأن على إثرها ، نامت الأرملة لثلاثة أيام . وعندما استيقظت وجدت خطابا غراميا ملصقا بجسدها.
لكن شيئا أخيرا يحملنا إلى منطقة أكثر مراوغة .
كانت رجاء قد تركت خدمة الأرملة قبل واقعة المضاجعة فى المقابر، بما يعنى أن الأيام الثلاثة التى نامت الأرملة ووجدت بعدها الخطاب ملتصقا بجسمها ، لم تكن رجاء موجودة فيها ، ولكننا ـ فى سياق آخر ـ سنعرف أن رجاء كانت شاهدا على واقعة الخطاب الغرامى الذى هشم زجاج النافذة السميك ووصل إلى سريرالأرملة والتصق بجسدها. لقد رأت رجاء الزجاج المهشم وجمعته ، وبعد ايام سألتها الأرملة إن كانت قد رأت الحجر الذى حطم الزجاج ؟
وهكذا فنحن لا نعرف يقينا ، إذا كان الخطاب قد وصل للمرأة بعد مضاجعة المقابر، أم قبلها ؟
أم أن هناك أكثر من خطاب جاء للأرملة ؟
هل كانت الخطابات حقيقة ؟ أم ظلت جزءا من أحلام الأرملة كلما نامت ؟من كان يرسلها ؟ ويضعها على جسدها، أو تحت مخدتها ؟ هل هو شبح زوجها الصائغ الذى كان يتجول فى الشقة ؟ هل استعادت الأرملة مشاعرها المنقطعة مع شبح زوجها بعد أن مات، لتعوض نفسيا لم لم تحققه معه فى حياته؟ هل تعيش الأرملة أزمة نفسية بين الوفاء والخيانة ؟ هل خانت حبيبها الأول بالزواج؟ أم خانت زوجها عندما عاشت فى عالما السرى مع خطاباتها الغرامية كطقس يومى ؟
تعلق الرواية كثيرا من الإجابات عن أسئلة تمنحنا يقينا بواقعيتها ، فتدفعنا إلى منطقة مراوغة ، ومحلقة فوق الواقع الذى يسم ـ فى نفس الوقت ـ الرواية كلها . هكذا تقف الرواية بين الأعراف بلا يقين من أن ما يحدث قد حدث فعلا . وكأننا ننتقل من استعارة الواقع ، إلى واقع استعارى.