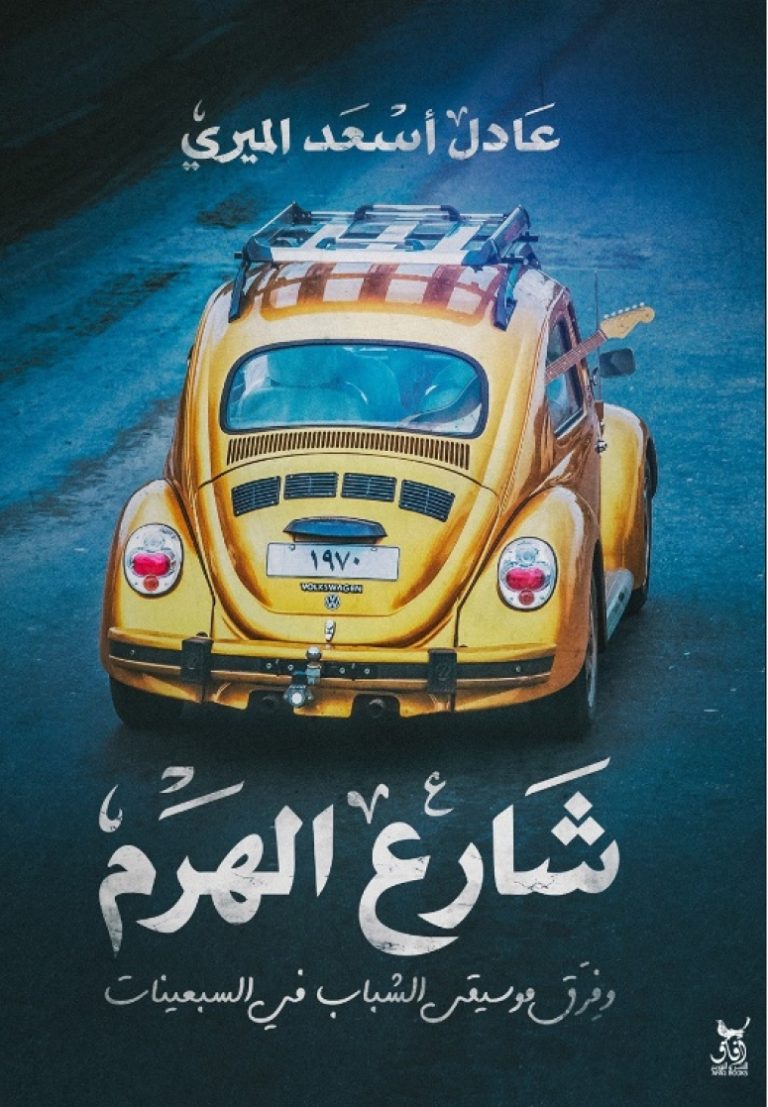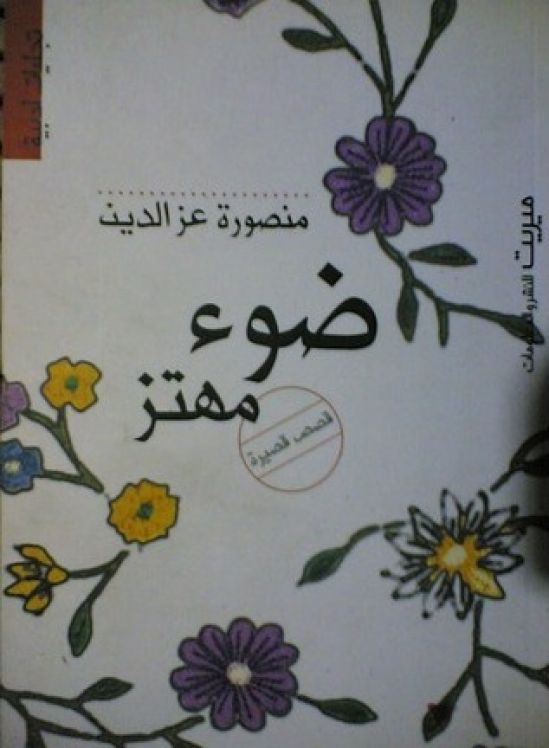حسن إدحم[1]
“تاريخيا، رعت المرأة خطاب الغياب: لأن المرأة من الحضر والرجل صياد متنقل. المرأة وفية (تنتظر)، بينما الرجل متسول( يتنقل، ويتحرش). المرأة هي التي تعطي شكلا للغياب وتعد منه الخيال، لأن لديها متسعا من الوقت، تنسج وتغني.”[2]
انتهت هذه الأظرفة بين يدي، ولازلت عاجزا ـ رغم انقضاء عمر طويل ـ عن استيعاب الطريقة الغريبة التي سيقت بها إلي. لا أريد أن يكون كلامي الاستهلالي هذا طاغيا، ولا أرغب أن أفسد على القارئ متعة الاطلاع على هذه الترانيم. سأكتفي في هذه البداية بتوضيح بسيط، ثم بعدها قبل كل رسالة أحاول تبيان سياقها وكشف بعض ملابساتها حسب ما تحصل لي من معلومات جمعتها من الهوامش التي أتلف الكثير منها.
أما توضيح البداية، فهذه الرسائل هي كومة من أوراق أمدني بها صديق قديم لأبي، كان ساعي بريد في بلدة ريفية منتصف القرن الماضي، كان لهذا الرجل مهنتان غير متجانستان بالمرة، فهو مهووس بتوصيل البرقيات والرسائل، ولكن هذه المهمة لم تكن تدر عليه الا دنانير معدودة لا تكاد تكفي لاقتناء أدوية زوجته المقعدة، لهذا فحينما ينتهي من توزيع “الأمانات” كما كان يسميها، يعود لقبو منزله المطل على البلدة من أعلى تلة، لكي يواصل خياطة – أو بمعنى أدق – رتق أتواب النسوة والأطفال.
كان لأبي طبعاـ قبل أن يغادر الحياةـ الفضل في معرفتي لهذا الرجل، نذهب معا إليه ليرتق ثوب أمي الممزق، وسراويلي البالية…
في لحظة ما، يوماً، لا أذكر حيثياتها، امتدت يدي لركن من قبو هذا الرجل، وبينما كان هو غارق في مناقشته مع أبي، استخرجت أنا كومة أوراق من زاوية قصية، – فضول الطفولة كان يسكنني- حينما سقطت الرزمة في يدي أحدثت صوتا وانتبه لحظتها العجوزان، همَّ أبي بالنهوض لكي يوبخني كما هي العادة في مثل هذه المواقف، غير أن يد صديقه أدركته، أفلتُ أنا الرزمة لتسقط على الأرض. سؤال واحد وجهه صديقنا لأبي، كان حول مدى إجادتي للقراءة، أجابه أبي بالكثير من التواضع أن لابأس بي، سمح لي بعدها الرجل بأخذ تلك الحزمة من الأوراق بكل بساطة دون حتى أن يفحصها. أمسكتها فرحا لا ادري بما ستنفعني. اطلعت عليها عندما خلوت لنفسي، ولكن صغر سني لم يسعفني على فك شفرتها ولا حتى استيعاب عبارة واحدة منها.
كما كانت تلك الأوراق رزمة منسية في قبو ذلك الرجل، نُسيت مرة أخرى في درج من أدراج بيتنا. لم اكتشفها إلا حينما اقترح علي طبيب نفسي مشرف على حالتي أن أغير هندسة طابق منزلي العلوي الذي يزيد من تأزيم حالتي على حد قوله. اقترح الطبيب هندسة أخرى كان الهدف منها توسيع الشرفة الضيقة لكي ينفذ المزيد من الضوء للغرفة.
لا أريد أن أضيف المزيد من التفاصيل، فقد أطلت ولم أكن أنوي فعل هذا، غير أنني لم أوفق لإيجاز أقصر. المهم أن التغيير الذي اقترحه الطبيب استدعى تغيير مكان المكتبة التي كانت تغطي مجمل جدران الغرفة، عندئذ فقط وقعت بيدي مرة أخرى الرسائل التي طواها النسيان.
كانت هذه بإيجاز قصة هذه الأوراق. قرأتها هذه المرة كاملة، لكن لا يمكن أن أنكر بعض المشقة التي واجهتها أثناء فك بعض العبارات واستيعابها، فالتلف مس جوانب الكثير منها.
لم أشأ مرة أخرى أن تنسى هذه الرسائل خصوصا بعد أن أحسست نفسي تعافيت نسبيا من نوبات المرض الذي لا يسعفني كثيرا على القراءة والبحث. فقلت لعل هذه الرسائل أو قل ما تبقى منها وقاوم ثقل الزمن و زحفه، وهو في الحقيقة قليل، إذ لم أنجح في فك رموز إلا أربعة أوراق كانت في ثلاثة أظرفة، أما الباقي وهو نفس عدد الأوراق الذي استوعبته، فلم يعد إلا خطوطا لا يُفهم منها إلا بعض الكلمات وفي أحسن الأحوال بعض الجمل المقطوعة من السياق، قلت أنه قد يكون من المفيد إعطاء هذه الأوراق حياة جديدة بنشرها، من يدري؟ قد تستوقف أحدهم، قد توقظ في أحد شغفا خبا أو يرى فيها أحد أخر أشياء لم أنجح في القبض عليها…تلكم كانت بعض الهواجس التي دفعتني إلى تحرير هذه الشذرات من درج مكتبتي كما حررتها دون علم مني من قبو ذلك العجوز.
بعدما فتحث الظرف الأول للمرة الثانية لكي أعيد النظر فيه، قرأت ما نصه:
” في البدء لم تكن الكلمة ولكن كان الحب..
أتساءل حبيبي…ما جدوى تلك المبادئ التي تبنيتها ودافعت عنها منذ زمان؟ وفيما ستنفعني؟. اليوم فقط عرفت أنها ما وجدت إلا لكي أضربها عرض الحائط حينما أحب…أو ليس الحب سيد المبادئ؟ لا أعلم أي ريح أتت بك إلي…لكن صدقني أنا ما ندمت على معرفتك ولا على زيارتي لك… ندمت على شيء واحد فقط…ما ضاع من وقتي وعمري قبلك.
ولأن الذي أحمله لك في قلبي أكبر من أن تحمله الكلمات المبتذلة، أكتفي إن أنت قرأته في عيناي…يكفيني أنني أحبك…أننا عشنا ما عشناه.
يتعبني الكلام، ويتعبني التفكير في المسافة التي تفصل بيننا…مسافة تمدد شوقنا لتبدده…مسافة تقطع وصلنا.
حبيبي البعيد، أبدا لست بالبعيد وأنت الساكن في.”
رجحت أن تكون هذه الرسالة الأولى التي بعثت بها هذه العاشقة التي تصوغ عباراتها بإتقان لحبيب التقته، ولكن كما سيدرك القارئ دون كبير جهد، فهذا الحب ترهقه المسافة والبعد. هي تحسرت على الأيام التي ضاعت من عمرها دون هذا الحب، غير أنه حينما نأخذ مسافة من الرسالة، سيظهر أن العاشقة تتحسر أكثر على المسافة التي تفصلهما وتمزقهما. لم أتأكد من هذا الافتراض الأخير إلا حينما فتحث الظرف الثاني واستخرت الورقة التي تحوي شذرة قصيرة فيها تقول:
” تخونني الكلمات في عز حاجتي إليها…الكلمات…أقفال ومفاتيح…بها أربطني و أقيدني بك…بها أفك قيدي وأطلق سراحي لأفر إليك على أجنحة هذا الهوى الغلاب…ولا أريد غير هذا التيه الذي يتسبب لي فيه حبك…
حبيبي لا تنسى أنني أحبك.”
تُذكر الحبيب بحبها، وأفترض أنها تُذكر نفسها أيضا. عباراتها حتى في هذه الشذرة الثانية قصيرة ومركزة، وتفصل بينها نقاط ثلاث. قد يكون هذا راجع لعسر فعل الكتابة لديها، أعني أنها لا تكتب مسترسلة، وإنما تدون كل عبارة بانفصال ثم بعد ذلك تقوم برصها وترتيبها، هذا تأويل ممكن، لا يهمنا كثيرا مدى وجاهته. ما هو واضح أن الكلمات تشغلها تسبب لها وجعا ما، مسكونة ومشغولة بها. تفتش عليها لكي تُحملها هواجسها، تتحسر أحيانا من ضيق الكلمات التي لا تستطيع أن تحمل كل ما بدواخلها. قاصرة هي اللغة أمام العشاق الذين تشغلهم الكلمات.
إن مزاجي و حالتي النفسية لا يستحملان كل هذا الكم من المشاعر والانفعالات، خصوصا وأنني عشت مع هذه الأوراق ليالي طوال مفككا رموزها، أفرح كالطفل إن أنا تمكنت من تبين رسم كلمة أو جملة ما، لهذا فبعدما كتبت هذه الهوامش على هاتين الشذرتين، لم أعد قادرا على مواصلة التعليق على الورقتين الأخيرتين رغم أنني اطلعت على شيء منهما دون تأمل كبير. لم أواصل إلا بعد أيام طوال، ولكن متأكد أنها لم تصل حدود شهر من الزمن، عندما استعدت عافيتي نسبيا، قلت لابد وأن أستأنف هذه المهمة وأصفي حسابي مع ما تبقى من رسائل هذه العاشقة. أخذت الأوراق وألقيت نظرة على الهوامش السابقة التي لم أكن راضيا عليها كفاية، بعدها قرأت الورقة الثالثة التي تقول كلماتها:
” أقاسمك حبنا الكبير وهو في بداياته الحلوة، بدايات لا أريد لها نهاية…حبيبي أنا سعيدة كذلك لأنني رزقت بك بعد مخاض عسير وأنا أعلم بوجعه…أنا لا أهديك الكلام، لأنه مهما تشكل لن يوفيك حقك…أنا أهديك نفسي وكل ما في وكل ما أملك…أهديك قلبي المتصدع وأنا لك ما حيا هذا الحب، وأنا لك إلى أن يتبخر.”
حينما قرأت هذه الأسطر، لم يحظر في ذهني إلا قول الشاعر: “على هذه الأرض ما يستحق الحياة…أول الحب.”[3] تحتفي هذه العاشقة بالبدايات وتعلم علم اليقين أن لها خصوصياتها، هي تخاطب العاشق كأنه طفلها، أنجبته بعد معاناة لكي يصير لها. مخاض الولادة لا يختلف كثيرا عن مخاض الحب. رغم هذا كله تظل هي عاشقة واقعية كالسماء. وفية ستظل، لكن لا تخفي أن الحب قد يتبخر في وقت ما كما تتبخر وعود العشاق أنفسهم.
غمرني فرح كبير حينما لم يتبق في حوزتي إلا هذه الورقة الأخيرة، فالنوبات المرضية التي تزورني فجأة حتمت علي أن أفرح بهذه النهاية. هذه الشذرة الأخيرة تبدو فيها العاشقة أكثر شاعرية، تسرح بخيالها بالكثير من الافتتان الإيروتيكي، مشتهية ومستعيدة جسد العاشق. كلماتها لا تدع لي فرصة التعليق عليها بإسهاب، فهي خير من يتحدث عن نفسها.
” يأتي الليل حبيبي…فأتعرى من كل شيء إلا منك ومن هوسي بك…أضم خيالك إلى حلمي و أشتهي شفتاك تنثران لهب حبك على جسدي.. أشتهي الغرق في عينيك، حتى أنسى نفسي وأنساك.. أشتهي صدرك بحرا أسبح فيه كحورية لا تكل..أشتهي يدك تسبر خبايا جسدي وتتحسسني ببطء…أشتهي ندوب عشقك على رقبتي…وأشتهيك حبيبي طفلا أنجبته من رحم قلبي، ينام في حضني ويرضع من ثديي نبيذ عشقه المضني…وأفكر في عشنا…فخذني اليه…مهد حبنا ولحده…فيه يبعث ويحيا من جديد…فيه أدفنه ريتما يتسنى لنا اللقاء…لنحيى ليالي الانس والعشق في حضنك. خذني إليك…إنني لا أعرفني إلا فيك.”
صورة هذه الأوراق ستظل ناقصة دائما، ما دمنا لم نطلع ولو على رسالة واحدة للعاشق، هذا إذا افترضنا أنه كاتبها هو أيضا، ويجيد مثلها رص الكلام. هذا ما فكرت فيه طويلا حينما كنت أسير بهذه الشذرات إلى الضوء بعدما ظلت في العتمة زمنا طويلا، غير أنني ما ندمت إلا على جهلي، وقلة حيلتي حينما لم أتمكن منذ زمن طويل من فعل هذا.
لم أقم بعملية تأويل لهذه الشذرات، فقد أزيغ عن جادة الصواب وأظلم هذه العاشقة، ولو أن النص لم يعد ملكا لها منذ كتبته، لم يعد من المفروض أن يُفهم منه ما تريد هي وما قصدته. لذلك فقد حرصت منذ البداية ان تكون تعليقاتي بسيطة وسطحية تاركا للقارئ الحكم الأخير. أكتب هذه الكلمات الأخيرة مقاوما هذا الاجهاد النفسي الذي يستزف قوتي أو ما تبقى منها، أكتبها وصورة ذاك الشيخ العجوز تحضرني وهو في قبوه منهمكا في إعادة الحياة لملابسة بالية، أذكره ولا أستطيع وصفه إلا هكذا: كل شيء فيه كان قديم، ما عدا عينيه، فقد كان لونهما لون البحر، لا أثر للهزيمة فيهما[4].
……………………..
أستاذ الفلسفة بمديرية الصويرة المغرب. [1]
رولان بارط، شذرات من خطاب في العشق، ترجمة إلهام سليم حطيط، حبيبب حطيط. الطبعة الأولى الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2000. ص.25.[2]
البيت الشعري هو لمحمود درويش.[3]
إرنست همنغواي، الشيخ والبحر، ترجمة علي القاسمي، المركز الثقافي العربي، ط، الأولى 2016،ص.12.[4]