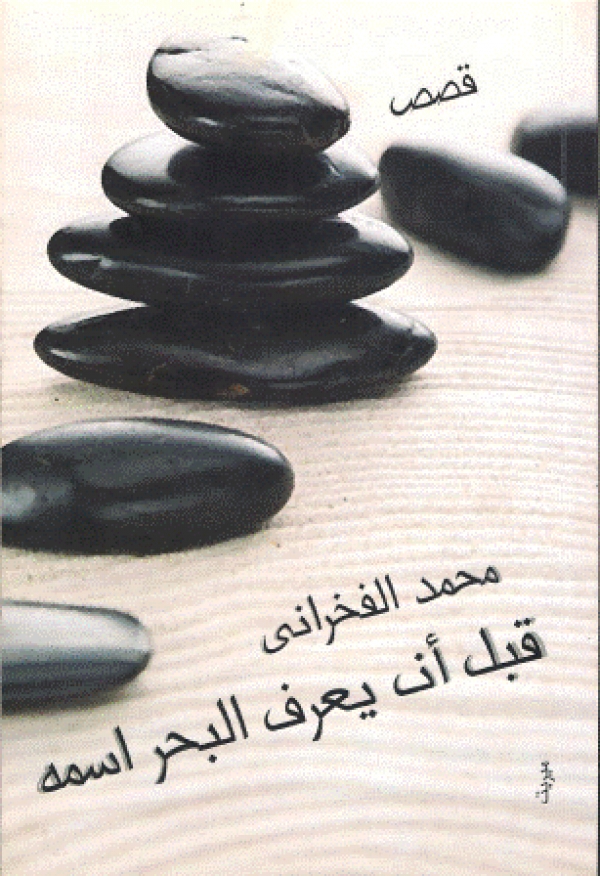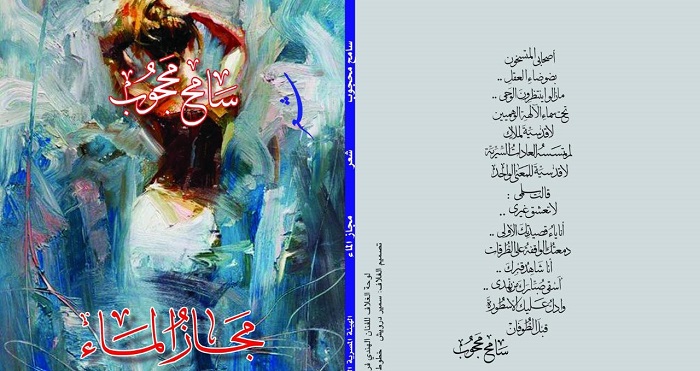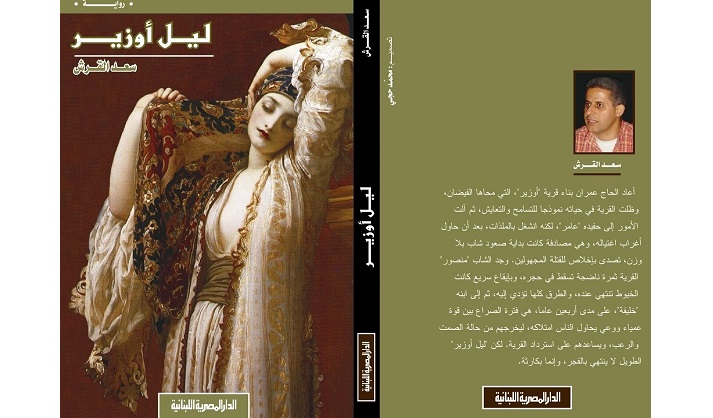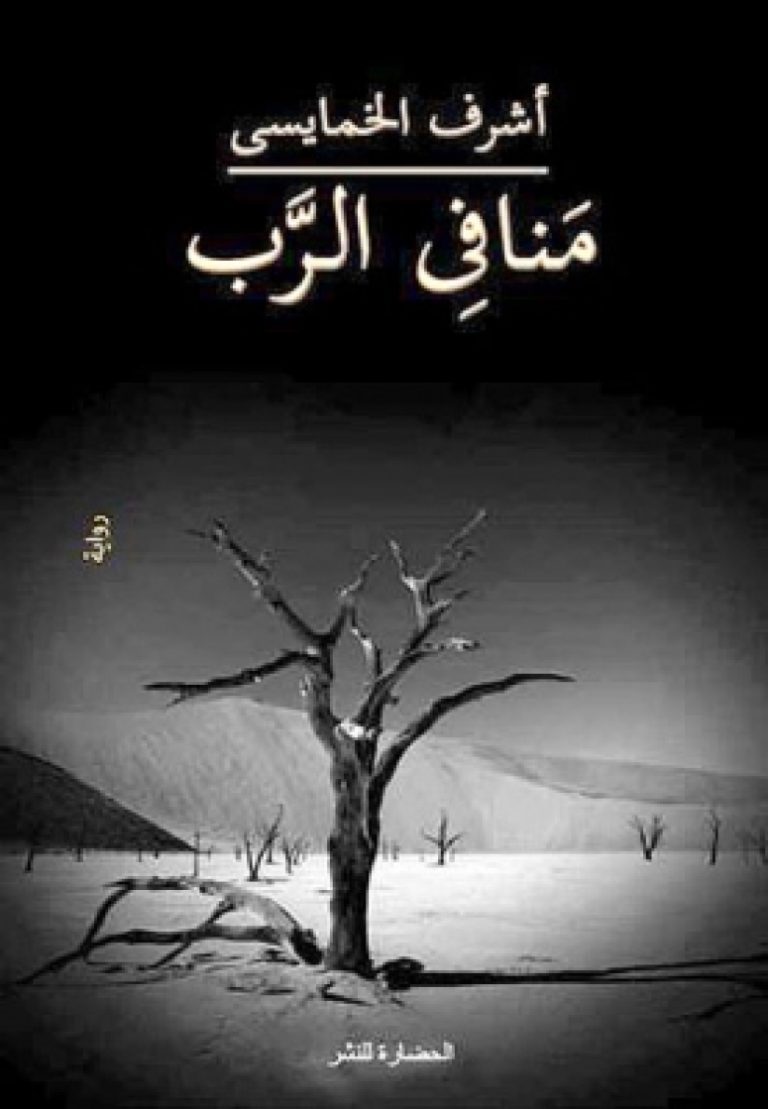إلا أنه أمسك بكل خيوط اللعبة، ونوّم قارئه بفعل لغة شاعرية محكمة، وقدم له بها اكسير متعة، تجعل المتلقى ينسى هذا التنويه، ويستسيغ الطرح المغاير، ولا يشعر بالكاتب وهو يتلذذ بتأمل وقع ذلك على القارئ، إذ أنه يقول فى “قارب وسحابة” ص36 (اكتشفت أن من أجمل الأشياء التى يمكن لأحد أن يفعلها أن يتأمل حبيبه أثناء نوم) فما نوّمنا “الفخرانى” إلا بلغة شاعرة، تجعلك تقبل تراسُل الحواس بمتعة شديدة وأنت تقرأ (من أين يأتينى صوت الضوء؟ وإحساس الماء؟ والألوان المسكوبة؟) أو (يرش على الأشياء مرحاً خفيفاً، وشجناً له ملمس شعر خشن)، كما تجعلك تتقبل استخدامه المونتاج المتوازى لغة تصنع المفارقة، أو الملازمة بين الأشياء، كأن يقول ص 58 (امرأة لها جسم تحبه الحياة، تتوقف وتضع يدها على وسطها، فيضع ثلاثون رجلاً يعملون فى الصحراء الحجارة عن أكتافهم، ويرتاحون بشكل مفاجئ) ص18، وكذلك تقبلنا لمنطق خاص تمنحه مخلوقات الأديب لنفسها، متخذة، مثلاً، تقويماً مغايراً يمنحها خصوصية ما أراده الكاتب لها (ولدت يوم” الحب فى قلبه” وهو اليوم التاسع من أيام الاسبوع، قبل أن تصدر قوانين بتسميات وتقويمات جديدة وفيه عاش العالم احتفالاً كبيراً من المطر والريح)، أو وهو يمنحنا معرفة مثل: “جاءت أول قيثارة موسيقية للحياة فى ليلة “يحبا السهر والسفر” وهى ليلة الثلاثاء حسب التقويم الجديد) ص 51، وكذلك قوله: (لا أنام سوى الساعة الوحيدة التى لا يكون الليل والنهار موجودين فيها، حتى لا أفقد منهما دقيقة) ص 96.
والكاتب، إضافة لما سبق، لا يتوقف لحظة عن “منتجته” للقارئ ، فيقدم له القصة تلو الأخرى، فى متعة تترى، وتتابع جميل، ليفاجئنا بأنه يمكنك إيجاد رابط بين هذه القصص، التى تبدو متناثرة أو متواترة فى “حلقة قص”، بما يجعلها فى نهاية حلقة من الحلقات “المَنتَجَة” المقصودة، تقوم مقام الفسيفساء، ففى قصة “البحر” يقول: “وبدأت تظهر كلمات مثل كلمة عميق، ورائحة مثل اليود، وطيور مثل النورس”، لكنه لم يمنح البحر لونه إلا فى قصة “أزرق”، أو أن يجعلك تُوجِد تسلسلاً مترابطاً بين آخر مقطع فى قصة وبين عنوان القصة التالية له، فيقول فى آخر قصة “أزرق” (أزرق يريد أن يكون وحيداً) ص29، يداعب (سماء سحرية بالمطر) ص31، “حياة” (تبتسم لأول ثلاثة وترقص مع الرابع)، وهكذا وصف طفل السعادة ص38 بأنه “قلب يرتدى البنفسج” و(منحت الحياة مائة قيثارة) ص54 “موسيقى متجولة وشارع مغامر” ص55 .
فى مرحلة وسطى من “المَنْتَجَة” يقدم “محمد الفخرانى” عنواناً للقصة، تكتشف بعد قراءتك لها أن هذا العنوان يكاد يكون المقطع الختامى لها لا العنوان! “دافئة، تستعملها المرأة والعصافير وأسماك النهر، يمكن أن تكون بيتاً أو قارباً أو عشاً على شجرة، وتقول أحبك أحبك”.
كذلك يقدم جملاً فى قصص تفسر أخرى سابقة عليها فى قصص آخرى، فيقدم تفسيراً لاختفاء الشمس فى قصة “بحر فى حصان” ص94 .
يقوم الكاتب بحيله الأدبية، معيداً تشكيل هوية المخلوقات، أو كما يسميها “الأشياء” أو لتقل شخوص قصصه، مُبيناً طريقة اكتسابها لكينونتها (ملح الوحدة ص8)، (هوية الغابة والذئب ونار الغابات والنمر.. ص 101:107)، ورغم أنه يقدم ذلك بطريقة مغايرة لما هو بمثابة الثابت المعرفى لدى القارئ، إلا أن محمد الفخرانى بلغته الشاعرة وبمنطقه الذى يمنحه للأحداث، يجعلك تتقبل هذا التفسير المغاير، وقد لا تناقشه تحت وطأة المتعة الأدبية، وسَبك المنطقية الذاتية للأشياء والأحداث، كأنه يمسك بكاميرا محمولة يسجل بها الحدث الأول فى الوجود، بما يكاد يشبه وجودها فى عالم المثل لا عالم الماديات..(سأشكل العالم من جديد، أتخيله، وأمنحه أصوات، وألواناً، وأشكالاً جديدة، أبتكر للدنيا خطوات وإيقاعات تُفاجئها وتحبها، فتفاجئنى هى أيضاً بإيقاعات جديدة تبتكرها لى وأحبها فوراً).
مُعتقد أخير أن “محمد الفخرانى” بكتابته يؤسس لمشروعه الخاص، وربما لمشروع القصة الشعرية أو المكتوبة كقصيد النثر، فليت أعيننا لا تبتعد كثيرًا عن خطوه الإبداعى وهو يكمل مسيرة الإمتاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ناقدة مصرية