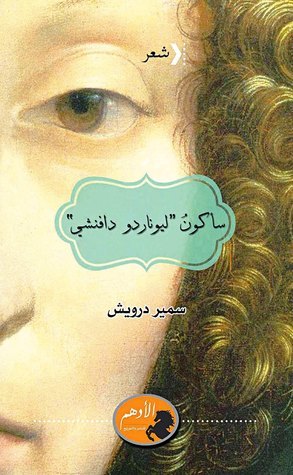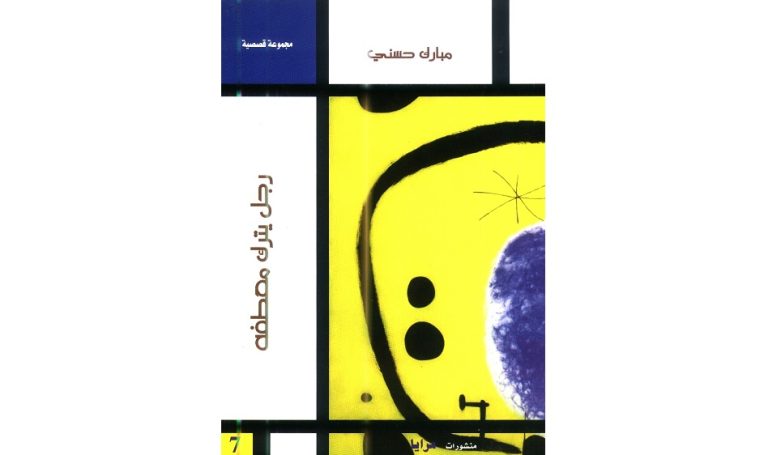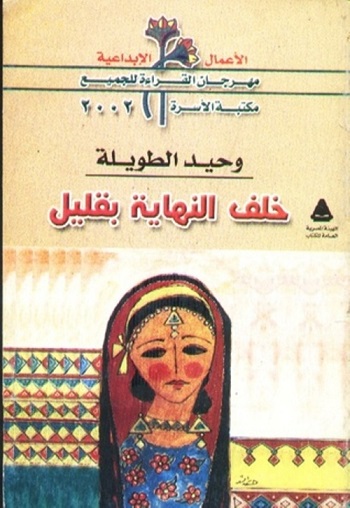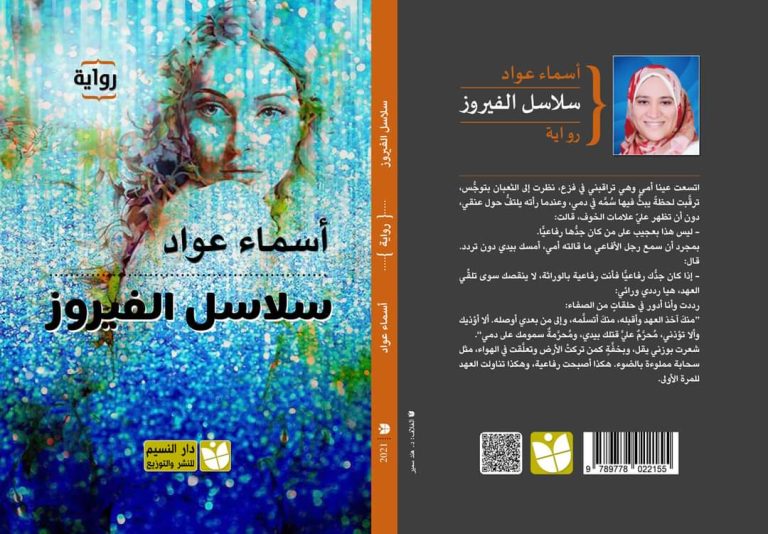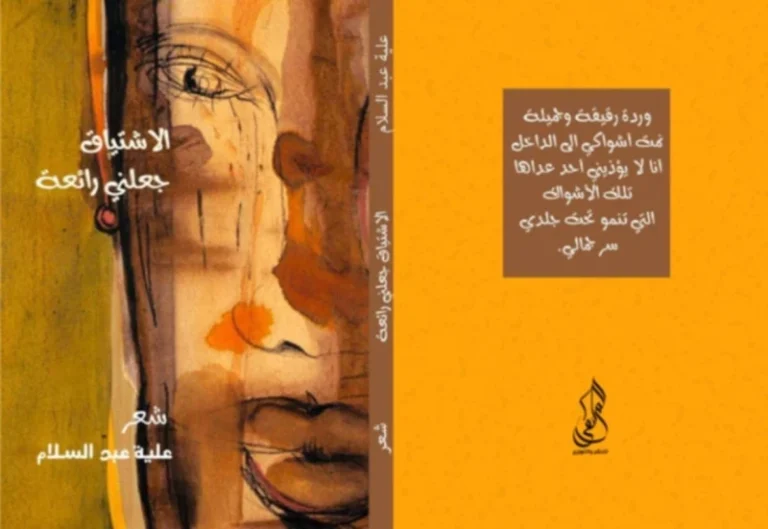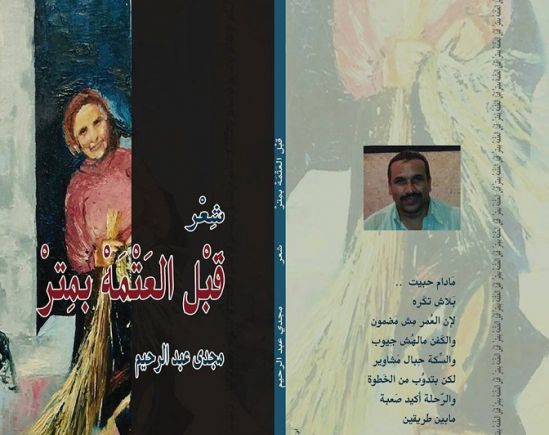د. حمزة قناوي
الإنسان «مخلوقٌ في حيزٍ زمانيٍّ ومكانيّ»([1])، ومن ثم فهو يتأثرُ بكلٍ من الزمان والمكان ويؤثر فيهما أيضاً، وتفاعلُ الزمان والمكان هما ثمرةُ التاريخ. والعمل الروائي يتقاطع مع الزمان والمكان والشخصيات ويصف الأحاسيس المختلفة، والمشاعر الإنسانية المتقلبة، فيشير إلى المسكوت عنه، ويحلل الشعور الإنساني الغريب والمضطرب، وفق هذه تأتي رواية «ثوب زفاف»([2]) للروائية (هناء الدرويش) ذات العمق الإنساني، والتأويل التاريخي، والتحليل المتعمق في الشخصية وتقلباتها مع الزمان والمكان، ورغم ما يبدو من ظاهرها من كونها رواية رومانسية عن تقاطعات الحب المعقدة بين (سعاد) و(فؤاد) و(عامر)، فإنها في الحقيقة إبحارٌ بعيدُ المدى في التاريخ اللبناني، وفي الأزمة البيروتية، ورصد لكيفية استمرار الحياة رغم كل محاولات إيقافها من حولهم، ورصدٌ لصمودِ الشعب اللبناني في مواجهة محاولات قسمهِ، وتفتيته طائفياً، وتدمير أرضه، وجعله يعيش محروماً من كل مقومات الحياة، وفي قلب هذا المشهد شخصية (سعاد) التي وبرغم معاناتها العاطفية، إلا أنها شخصية رمزية تحمل دلالات كبيرة وعميقة.
ونبدأ من رثاء الروائية (هناء الدرويش) لأخيها (طلال الدرويش)، وقد أشارت إلى أن جميع الأشعار الواردة في الرواية من تأليفه، كما أشارت إلى مراجعته لما كانت تكتبه، ومرافقته لها في ثنايا عملها الروائي، حتى وفاته في 2018، ونحن نترحم معها على روح شقيقها، ونشيد بما جاء من أشعار في ثنايا النص الروائي، فضلاً عن توظيف هذه الأشعار في المواقف التي أبرزتها لنا أحداث الرواية، وكأن هذه الأشعار كتبت فعلاً لتلك المواقف التي تم الاستشهاد بالشعر فيها، مما خلق حالة من حالات النغمية والخطابية أضفت على شخصيتي (سعاد)، و(عامر) حالة تذوق شعري وإبداع لغوي، وتحليق رومانسي، يؤكدُ أسطورةَ الشخصيتين، مما أضفى على الرواية بعداً جمالياً، أسهم في زيادة جاذبية التشويق، والتعلق بالأحداث.
تبدأ الرواية من لحظة تقترب قليلاً من خاتمتها، لكنها لحظة تصلح توجهنا لاسترجاع الذكريات من ناحية، وتتناص مع عتبة العنونة من ناحية ثانية، وهنا نستحضر مقولة (ليو هوك) عن العناوين بأنها: «مجموعة من العلامات اللسانية من كلمات وجمل، وحتى نصوص، قد تظهر على رأس النص لتدل عليه وتعينه، تشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف.»([3])، فالرواية المعنونة بـ«ثوب زفاف» في بدايتها الفعلية بعد «مقدمة» الروائية، والتي تحمل عنواناً جانبياً: «من الشرفة» تبدأ من لحظة بحث (همسة) المخطوبة إلى (رائد) عن ثوب زفافٍ لها، وبينما تبدو لنا علامات التغير في الزمن عن ذي قبل، وهو ما يظهر في الشكوى من استقلال الأبناء بآرائهم عن أمهاتهم، يتم تقديم شخصية (أم سامح) والتي سنكتشف فيما بعد أنها (سعاد)، وقد التهمها القلق لتأخر ابنتها (همسة)، وسرعان ما نعرف بوجود أخت أخرى لها (لميس)، وهي متزوجة في مكانٍ بعيد – سنعرف فيما بعد أنه الولايات المتحدة – ثم عبر تقنية الاسترجاع، نبحر في ذاكرة (سعاد) لنعود أربعين عاماً للوراء، وهي المساحة الزمنية التي تقع فيها مسارات الرواية، وهو الثقل الرئيسي للزمن الروائي هنا، فما يتم بعد هذه البداية الثانوية للرواية من أحداث لا يتجاوز بضعة أشهر، أما في الاسترجاع والعودة بالذكريات نعود لنجد أنفسنا تقريباً مع مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وهو اختيار تاريخي له حساسيته الخاصة في مسيرة التاريخ اللبناني.
مثلما بدأت الرواية من استرجاع ذاكرة (سعاد)، والتي لم يُذكر اسمُها صراحةً في البداية، والتقديم لها بأنها (أم سامح) لنظل طوال الوقت نبحث عمن يكون (سامح)، لكننا سنكتشف بعد مُضيّ فَضاءٍ نَصيٍّ كبير تشابكَ هذهِ العلاقات المتداخلة معاً، لكن المهم أن (أم سامح) أو (سعاد)، هي محورُ الأحداث، وهي الشخصية التي تبلغ حد الأسطورة في بنيتها، والتي على أساسها ومن حولها تدور كل الأحداث التي يتم تقديمها هنا، وهو ما يذكرنا بمقولة (جورج لوكاتش) حول بناء الشخصية في المتن الروائي من أنها تعد: «أحد المقاييس الأساسية التي يعتمد عليها للاعتراف بكاتب الرواية أنه روائي حقيقي.»([4])، وفي هذا الصدد نجد أن (هناء الدرويش)، قد أبدعت في تصميم هذه الشخصية، ورسم أعماقها المتناقضة والمتداخلة، وتقديم صراعاتها النفسية، وآمالها وطموحاتها بصورةٍ تجذب القارئ للاستغراق في كل تفاصيل العمل الروائي.
إذاً فالحبكة في مجملها بسيطة، فتاة تظن نفسها تعشق ابن عمها الأصغر منها، والدها يعرف بذلك، ثقةً في أخيه، يذهب لكي يخطب لابنته، ويوافق أخوه على الخطوبة، لكنه يعتقد أن المقصود هو الابن الأكبر (عامر)، وهو الأكثرُ منطقيةً، وهو أيضاً يحب ابنة عمته، وفي مواجهة ذلك لم يستطع الأب تعديل الأمر، ليجد نفسه مضطراً على الموافقة، وتبدأ أولى اضطرابات الشخصية وتعقيداتها في الشعور المتناقض بين حبها لابن عمها الأصغر، وخطبتها لابن عمها الأكبر، تقول: «ما هذا الشعور الغريب الذي ينتابني؟ لِمَ أهتم كثيراً لأمر عامر؟ وفؤاد؟ لا بد أنه قد علم بالأمر، كيف سيكون موقفي بين واحد يحبني ولا أحبه، وآخر أحبه ويحبني؟ لم أشعر أنني أخون فؤاد وأنني أبيع أحلاماً بنيناها معا في طفولتنا وشبابنا؟» ص34
هذه المشاعر المتضاربة لدى (سعاد) هي نواة الحبكة الرئيسية في الرواية، فهذه المفارقة العجيبة بين مشاعر الحب المختلطة هي ما تصنع للرواية دافعها القوي للمضي نحو الأحداث، فلنتذكر دائماً أن الأعمال الروائية تدور حول “عدم التحقق”، أو بتعبير (ميخائيل باختين) عن أفنسان: «لا يتطابق أبداً مع نفسه، لا يجوز أن تطبق عليه صيغة المطابقة: س = س…» ([5])، وقد أبدعت الكاتبة في بيان تناقضات شخصية (سعاد)، ونلاحظ هنا التسمية للشخصية بـ(سعاد) وهي تسمية نقيضة لما يحدث للشخصية، فهي طوال الرواية لم تحصل على سعادتها، ولم تجدها، حتى بعدما يمضي الوقت، وتكتشف أنها لم تكن تعشق ابن عمها (فؤاد) – ونلاحظ التسمية مقارنةً بكونه أول من تعلق به فؤداها، فهي تكتشف بعد فترة أنه لم يكن حباً ناضجاً بالمعنى الحقيقي، وليحتل (عامر) – وأيضاً نلاحظ التسمية حيث أنه سيعمر قلبها ويشغفه حباً- فيحتل (عامر) قلبها ويصبح هو الحب الحقيقي، لكن رغم ذلك لا يحدث في بداية الرواية التواصل والزواج.
بعدما رسمت لنا (هناء الدرويش) حدود الصراع الداخلي لشخصية (سعاد)، والتقلبات التي حدثت عند (فؤاد) بقراره الانضمام لصفوف الفدائيين الفلسطينيين، ومغادرته بيروت، ومع اقتراب تحقق النهاية السعيدة بين (سعاد) و(عامر) يتحقق الحدث الفارق بدخول بيروت مرحلة الحرب الأهلية، تقول الراوية: «الدماء تهرق على تربة وطن ما عرف إلا الوئام والتسامح، والإخوة من مختلف الأديان يجاهدون لتبقى العلاقات بينهم طبيعية، لكن ظروف الحرب وما فرضته من تقسيم مذهبي وطائفي، فرّقت الناس والأحبة، فلجأت كل طائفة إلى منطقتها، وأصبحت البلاد دويلات في دولة على الرغم من صغر مساحتها. مع ذلك ظلت النوايا طيبة بين الكثيرين ممن لم يستوعبوا سبب الحرب ولا معنى الحقد الطائفي، واستمر التزاوج المبني على قصص الحب بين المذاهب والطوائف المختلفة. ووجد اللبنانيون أنفسهم أكثر صلابة وقوة، فراحوا يتحدون كل ما يمكن أن يغير تشكيلهم الجغرافي ورغبتهم في التعايش.»ص82-83
تتخذ الرواية هنا منعطفاً آخرَ، وتخرج عن ذوات الشخصيات إلى هموم الوطن، وفي أسلوب يجمع بين بساطة الوصف والتعبير، ودقة التصوير، وعمق التحليل، لتنقل لنا الحرب الأهلية ببيروت، وصعوبة تعقيداتها وتشابكها، فترويها لنا من زاوية غير منحازة لأي جانب من جوانب أطراف الصراع، فالانحياز الأساسي للحب والإنسانية وللوطن، ومن ثم تبدأ (هناء الدرويش) في توزيع العلاقات، واستحضار كافة الأطياف اللبنانية من دروز ومسيحيين ومسلمين وغيرِهم، على ساحة المشهد الروائي، ولا تكتفي بهذا، بل تبدأ في متابعة علاقات الحب بين الطوائف المختلفة، حتى أن «ثوب الزفاف» الذي كانت أمها تعده أساساً لم يكن لـ(سعاد) رغم تشابه مقاسهما، ولكنه كان لـ(عفاف) المسيحية المخطوبة لابن عمها (جورج)، والتي اكتشفت أنها لا تحبه، لتعشق بدلاً منه جارها المسلم (حسن)، وترغب في الارتباط به، وهو ما يؤدي إلى غضب عائلتها.
هذه المشاعر العاطفية الجياشة والبحث عن الشريك الأفضل تدور في جو مليء بالقذائف والمتفجرات، والحروب، والموت المنتشر من كل جانب، ومع ذلك ترصد لنا الرواية جو الحياة في الملاجئ، وتحت نيران القصف، وصعوبة المرور من الحواجز، وبينما يضطر والد (سعاد) لترك منزله والذهاب للعيش مع أخيه الذي يقطن منطقةً أكثر أمناً، وبينما يذهبون للاطمئنان على منزلهم، يجدون من يعيش فيه، وتصور لنا حجم المعاناة، ومقدار ما فعلته الحرب من يتم وترميل وفقدان طال الجميع، وهو ما يأتي على لسان (أبي أحمد) جارهم فيقول: «لم نجد مكاناً نلجأ إليه فبقينا في منزلنا، ولم ندرِ أن الموت كان يحوّم حولنا؛ فقد انفجرت قذيفة على السطح واقتحمت شظاياها البيت، ماتت زوجتي وولدي وزوجته واثنان من أحفادي الثلاثة.»ص94، وفجأة يجد (أبو أحمد) نفسه من دون منزلٍ ومن دونِ أهل، وليس معه إلا حفيد يحمل مسئوليته، فسمة الحرب اللبنانية التي دارت في ثمانينيات القرن الماضي، أن أي إنسان كان عرضة في أي وقت لفقدان أي شيء، منزل، أسرة، أهل، أحبّاء، وبجانب ذلك تعاظمت الفرقة الطائفية، وكبرت الفتنة بين النسيج الواحد للمجتمع.
ربما كان هدف المؤلفة من تكثيف الفواجع التي تحول دون تحقيق التواصل الطبيعي بالزواج بين العاشقين في ثنايا الرواية توصيل مقدار الألم الذي عاشه سكان بيروت في ظل الحرب الأهلية، وكأن هذه الحرب كانت حائلاً دون تحقيق أي سعادة لأحد، قد تكون الحياة مستمرةً، وهناك زواج وإنجاب، ولكن ليس هناك سعادة، لذا نجد انقلابًا كبيراً يحدث في شخصية (سعاد) مع وفاة والديها، وبدلاً من التفكير المنطقي في مقاومة الوحدة بمحاولة الإسراع بالزواج من (عامر) نجدها تتخذ من تعلق (ضحى) به سبباً لغيرتها منها، ثم التفكير في اتهامه بوجود إعجاب وعلاقة بينهما، ثم اتخاذ القرار بتأجيل الزفاف لأمد طويل، ومن الناحية الأخرى، تحول كرامة (عامر) دون إمكانية تحمل تدلل (سعاد) أكثر من ذلك، ودون إمكانية الطلب منها والتواصل معها للقبول وتحديد موعد زفاف لها، لتكون النتيجة المنطقية طلاقها منه – إذ كانت قد كتبت كتابها – قبل أن ترحل مبتعدةً إلى مكان آخر، تمر فيه بتجربة قاسية باختطاف صديقتها من قِبل أحد المسلحين، فتنهار نفسياً، وتعود مرة أخرى لبيروت، لكنها تتفاجأ بما كان منطقياً من زواج (عامر) و(ضحى). فتقول الراوية عن (سعاد): «بماذا كانت تأمل سعاد؟ إنها تعيشُ اضطراباً وتخبطاً، كيف تريد أن تستأثر بعامر وهي التي رفضته وأبعدته عنها ورمته في حضن ضحى التي كانت جاهزةً لاستقباله في أي لحظة؟ ربما تشعر بالغضب والحنق لأنها كانت تظن أن عامراً سينتظرها مدى العمر…»ص191
لكن الأحداث تتخذ نحواً تراجيدياً قدرياً عندما نجد في نهاية المطاف، أن (سعاد) الغيورة من (ضحى) هي من تقف معها وتنقلها إلى المستشفى لتلد في ظل غياب (عامر)، بل هي من تقوم بتربية ابنها من حبيبها (عامر)، والذي أسماه (سامح)، حيثُ تجد نفسها فجأة في موقف مأساوي لافت، فبينما كانت تأمل في الزواج بــ (عامر)، ونتيجة لغيرتها من (ضحى) رفضت أن تتزوجه، وتركته لكي يتزوج (ضحى)، ثم فجأة تجد نفسها مسئولة عن تربية طفله منها، من غريمتها التي توفيت بحُمّى النِفاس، والمفارقة أن عاطفة الأمومة تغلب عليها مع ذلك الطفل الجديد (سامح)، والذي يظن للوهلة الأولى أن (سعاد) أمه، وأن (أبا إسماعيل) و(أم إسماعيل) هما جده وجدته، ولكن كأن القدر يعمل دائماً على فقدان الأحبّة بالنسبة لـ(سعاد)، فما إن تعلقت بـ(سامح) حتى صار الجميع يلقبها بـ(أم سامح)، إذ بها تفقده برغبة والده بأخذه منها، وسفره له في أمريكا.
تمضي الحياة ولا تتوقف، لتتزوج (سعاد) من (خالد) الذي كان متزوجاً من قبل، لكن زوجته تهرب بطفلتهِ إلى فرنسا، ونلاحظ في السرد ثنايا الشتات والوحدة، ودوران الأحداث، وتشابك العلاقات بين الأشخاص، لكن الموت طوالَ الوقت حاضر، وعلى امتداد العمل يتم التفريق بين الأحباءِ وبعضهم، إما من خلال الموت، أو من خلال الرحيل، فـ(عامر) رحل إلى أمريكا، و(فؤاد) هاجر إلى كندا، ووالداها غيبهما الموت، قبل أن يتوفى عمها وزوجة عمها، ولم يبق إلا (ندى) التي تعيش في جنوب لبنان، حتى غريمتها (ضحى) غيبها الموت، فهناك توجهٌ للشعور بالوحدة المطبقة حول الشخصية الرئيسية في الرواية بصورةٍ مجهدة.
لا تستقصي الرواية كيف هدأت الأحوال في بيروت، ولا تمضي لما هو أبعد من حقبة الثمانينيات في الشأن البيروتي، وكأن (هناء الدرويش) تدخر لنا روايةً أخرى ستكمل فيها مشوار التأريخ لبيروت في مطلع الألفية الثالثة، فهناك الكثير من الحكايات يتم طيُها زمنياً ومكانياً، بعدما كانت قد أفاضت في وصف الملاجئ والقصف والموت والحياة، لكنها تؤكد الفجوة الزمنية بين الأجيال، بين (سعاد) التي تجتر وحدتها وآلامها، وبين ابنتها خصوصاً (همسة) التي تعيش حياتها برفقة مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في خطٍ أموميٍّ نادرٍ، وكأن الزمن يعيد نفسه، تبوح (همسة) لأمها بأنها غير مرتاحة لارتباطها بـ(رائد)، وأنها تشعر بأنها لن تعيش معه مستقبلاً مشرقاً، خاصة أنها أكبر منه في السن، وتشعر بأنه غير قادر على اتخاذ القرار، وكأننا هنا نعود من الحزن على بيروت التي قسمتها الحرب الأهلية، والاجتياح الإسرائيلي إلى استمرارية الحياة من جديد، واستمرار توالد الحب في النفوس، فتقرر (سعاد) السفر إلى أمريكا للقاء ابنتها (همسة) التي تزوجت هناك، والتي ستعرف بعد سفرها لها بأنها انفصلت عن زوجها، وفي ثنايا هذا السفر تمر بباريس- في وفاءٍ نادرٍ- بحثاً عن ابنة (خالد) منى، والتي سوف تجدها فيما بعد في أمريكا، وكأن هذا الامتداد الجغرافي تعبيرٌ عن مدى الشتات الذي عايشه وكابده أبناءُ بيروت خاصة من اضطر منهم لمغادرة البلاد للنجاة بنفسه من زخم الحرب والتقسيم والطائفية.
ولأن “الدنيا صغيرة” فإن من يعالج (سعاد) في أمريكا هو ابنها (سامح) الذي تتعرف عليه، وتنجح في الوصول لابنة (خالد) زوجها الذي ماتَ من قبل، وعلى حين غرة تجد نفسها من جديد- بعدما تخطيا السبعين من العمر- في مواجهة (عامر)، وهذه المرة بعد كل هذا النضج والأحداث المهولة التي مروا بها، اكتشفا قوة الحب واستمراره بينهما، ليتخذا- من دونِ تفكير- قرار الارتباط والزواج من جديد، ولكن تصر (سعاد) على أن يحدث هذا الارتباط في بيروت، وتعود من جديد لفستان الزفاف الذي كانت أمها قد أعدته لـ(عفاف)، وتغسله لترتديه في عرسها، لكن الرواية تصر على أن تسير بنا في طريق النهايات الحزينة والمأساوية – ربما لرحيل شقيق (هناء) وتأثرها بذلك خلال كتابة الرواية دور في هذا التوجه النفسي- لتأتي النهاية مفجعةً جدا، حيث تقول: «إلى المقبرة، حمل عامر نصف روحه وأودعها الثرى وهو غير مصدق أن حكاية العشق قد وصلت إلى النهاية، وأن الأمل الذي أحيا مشاعره لم يواصل المسيرة. ألقى ثوب الزفاف الرطب على الضريح لعله يجف في نسيم عليل وأتون شوقٍ حارقٍ»ص254.
ماذا يبقى إذن من (سعاد) بعد رحيلها المكلوم هذا دون أن تظفر في دنياها بلحظات سعادة كالتي تحلم بها كل الفتيات؟ أليس لهذا ارتباطاً بمسار القدر في بيروت نفسها التي ذاقت من الحزن ويلاتٍ وويلات؟ هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، فلو نظرنا للجانبِ الإنسانيّ لشخصيةِ (سعاد) فسنجد أنها قامت برسالتها على أكملِ وجه، فقد ربت (سامح) عندما فرضَ الواجب عليها أن تكون أماً له، وانفطرَ قلبها عليه عندما غادرها، وحملت رسالة (خالد)، وبحثت له عن ابنته حتى وجدتها في آخرِ العالم، وأدت رسالتها من قبل معه في تشجيعه للعمل بشهادته، وتحملت رحيله، وقامت برسالتها مع (أبي إسماعيل) جارها عندما احتضنته هو وزوجته وابنتيه وجعلتهم يعيشون معها كأنهم أهل لها، وتابعت حمل الرسالة مع ابنتيها (همسة) و(لميس)، إنها مثال للشخصية التي تتحمل مصيرها وقدرها وأوجاعها في صمت، وتقوم بأدوارها مهما كانت الصعوبات من حولها، لذا تبدو (سعاد) أو (أم سامح) شخصية أسطورية بامتياز، قدمتها لنا (هناء درويش) لتجعلنا نفكر في مسارين متسقين معاً، فمن ناحية نفكر في مسار العاطفة والاختيارات والنجاح والفشل في الحياة، ومن ناحية أخرى نفكر في مسار بيروت ووجعها ووجع من يعيشون فيها، وإن أثبتت في كل مرةٍ قدرتها على البعث من جديد.
………………………………..
[1] – أحمد طاهر حسنين وآخرون: جماليات المكان، عيون باندونغ، الدار البيضاء، 1991، ص 5
[2] – هناء الدرويش: ثوب زفاف، دار الخليج للصحافة، الشارقة، 2020.
[3] – عبد الحق بلعابد: جيرار جينيت من النص إلى المناص، منشورات الاختلاف، الجزائر، 2008، ص67.
[4] – جورج لوكاتش: دراسات في الواقعية، ترجمة: نايف بلوز، ط3، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1985، ص 25.
[5] – ميخائيل باختين: شعرية دوستويفسكي، ترجمة: جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1986، ص 84.