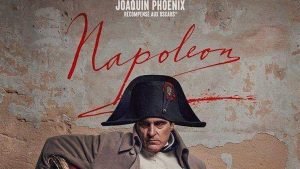ويعود «مكي» مرة ثانية في فيلم «سمير أبوالنيل» ليؤكد أنه لم يكتف بخسارة جمهوره فقط، بل يسعى هذه المرة ليخسر نفسه كممثل كوميدي له تواجد لطيف في مخيلة المتلقي.
استحق «مكي» هذا النفوذ الجماهيري عندما قدم شخصيات طازجة كسر بها الكثير من نمطية الأداء الهزلي، ليتحول إلى «جوكر» تمثيل له ألف وجه قادر على إضحاكنا دون ابتذال أو حماقة.
جاء أحمد مكي في فيلمه الجديد من فشل فني سابق لفشل فني جديد، تمامًا مثل محمد السبكي منتج فيلمه الأخير، الذي فشل في فيلمه الأخير «مهمة في فيلم قديم» في استدراج شرائح قاع المجتمع التي يفضلها، ليظهر كلاهما وكأن كلا منهما قرر وضع فشله على الآخر ليفشلا سويًا هذه المرة.
أول أسباب الفشل يكمن في اختيار كاتب للفيلم لا علاقة له بالدراما أو الكوميديا، بل تخصص في الاقتباس الفاتر والسيناريوهات العرجاء القادمة من أزمنة سحيقة لم تعد إفيهاتها تضحك، ولم تعد مواقفها تدعو حتى للابتسام، فقد ابتعد أيمن بهجت قمر بـ«مكي» عن منطقة قوته الكامنة في المحاكاة الساخرة، التي لم تستنفد طاقتها بعد مع الجمهور، خاصة أنها مساحة خصبة للعشرات من الأفلام والشخصيات والنماذج السينمائية، التي تعتبر أفضل من العودة إلى الأفلام القديمة أو الاقتباس من أفلام أجنبية.
ثانيًا، «الكوميديا تنبع من الشخصية وليس العكس»، هكذا وضع الخبراء تعريف بناء الشخصية قبل الشروع في بناء المواقف، لكن شخصية «سمير أبوالنيل» لم تكن سوى شخصية هزيلة أحادية البعد، تمامًا مثل شخصية أحمد حلمي في فيلم «إكس لارج»، التي تعتبر أيضًا أحد إبداعات أيمن بهجت، فبحكم كونه كاتبا متواضعا كان من الصعب عليه أن يصيغ شخصية خصبة متعددة الأبعاد، لذا نجده دائمًا ما يكتفي بصفة واحدة أو صفتين يبني عليهما مواقفه الهزلية وإفيهاته المستعملة، ففي فيلم «إكس لارج» مثلًا كانت «البدانة والشره في الأكل» صفتي البطل، وفي فيلم «سمير أبوالنيل» كان «البخل والغباء».
العجيب أن صفة البخل كشكل كوميدي تم استهلاكها كثيرًا عبر عشرات الأفلام المصرية منذ زمن الأبيض والأسود، خاصة في شخصيات اليهود المصريين، بل تبدو هنا صفة منقطعة عن تركيبة الشخصية وكأنها قادمة من فراغ، فنحن لا ندري هل هو طبع أم نتاج تربية أم سلوك شخصي؟ ولهذا بدت وكأنها مجرد إطار لوجود «إفيه» على الشخصية، وليس صفة أصيلة تستمر طوال الأحداث لتصبح جزءا من سماتها، إضافة إلى ذلك هناك خلط بين صفة البخل وادعاء الفقر والتسول الاجتماعي، ولا يوجد مبرر للضحك في شخص يريد الحصول على إيجار شقته التي يعيش من إيجارها، وما الذي يثير الضحك في رغبة شخص تحميل مستأجري شقته تكاليف الصيانة، إضافة إلى ذلك تبدو إضافة محمد السبكي في هذا المشهد تحديدًا واضحة، التي تجسدت في وجود شخص داخل الحمام يقضي حاجته ويخرج ريحًا بصوت، وهي إضافة «سبكية» نذكرها منذ الجزء الأول لفيلم «عمر وسلمى»، وليظهر وكأنه مشهد إجباري في سينما محمد السبكي.
نسى المؤلف كل تلك الصفات في النصف الثاني من الفيلم ليتجه إلى محاولة استلهام شخصية تليفزيونية معروفة ليكمل بها الأحداث بعد صعود «أبوالنيل» كنجم فضائيات بعد رشوته الجمهور بمسابقات وجوائز تافهة، وهنا تحديدًا يكمن جزء كبير من رداءة الشخصية والسيناريو، فهناك فارق بين المحاكاة الساخرة لشخصية، والنميمة الرخيصة والثرثرة الفارغة، فقد اعتمد المؤلف على أن الجمهور سيشير إلى شاشة العرض ضاحكًا وهو يقول: «ده توفيق عكاشة»، لكن للأسف هذا ليس كافيًا، سواء على مستوى الكوميديا أو على مستوى الموضوع، لأن الدراما تحتاج إلى أكثر من قيام «أبوالنيل» بتقديم كل البرامج، وتحتاج إلى أكثر من الحديث بلغة شعبية، فهذا «شغل أرجوزات» وتقليد سطحي، و«مكي» تحديدًا يعلم الفرق بين التقليد والنميمة، وبين المحاكاة الساخرة ذات العمق الدرامي والبعد الكوميدي.
ثالثًا، عندما اكتشف صناع الفيلم فتور الشخصية لجأوا إلى استغلال لمحات من أفلام أحمد مكي السابقة، خاصة في مسألة البرامج، مثل برنامج الجيم الشعبي الذي ذكرنا بشخصية «ميشو» في فيلم «طير إنت»، ومثل غرفة السطوح الشهيرة، التي ذكرتنا بغرفة «كالوشة» في فيلم «إتش دبور»، كما أن شعور «مكي» بأن الفيلم شحيح الإفيهات، ورخيص الأسلوب، جعله يقدم بعض الإفيهات الجسمانية حتى لا يخلو مشهد من إفيه، مثل تعثره أثناء صعوده على سلم النادي عندما أراد أن يستدرج أهل الحي إلى هناك بحجة تواجد هيفاء وهبي.
رابعًا، كانت المشاركة الأنثوية ضعيفة جدًا على عكس أفلام «مكي» السابقة التي لعبت فيها البطولة النسائية محورًا مهمًا وأساسيًا، فأين الشخصية التي تشبه دنيا سمير غانم في «طير إنت» و«لا تراجع ولا استسلام»، وأين الشخصية التي تشبه إنجي وجدان في «دبور» وأين شخصية مثل إيمي سمير غانم في «سيما علي بابا»؟ لم يكن هناك سوى مشاهد سمجة قليلة لنيكول سابا في دور مسؤولة شركة دعاية، ومنة شلبي في دور حبيبة «سمير».
إن أكثر ما كان يميز أفلام «مكي» هو فهمه كممثل للتوازن الذي تمنحه الشخصيات الأنثوية المؤثرة في أحداث أفلامه حتى لو كان ظهورًا متواضعًا، لكنه هنا يعيد إنتاج نفس آفات من سبقوه من الكوميديانات، الذين يقومون بتهميش الأدوار النسائية في أفلامهم بمجرد نجاحهم، والاستعانة بوجوه جديدة لا تزاحمهم الشاشة أو تيترات الفيلم أو الأفيش.
رابعًا، ما حكاية لثغة منة شلبي؟ هل هي إفيه آخر أراد به صناع الفيلم أن يجعلونا نتصور أن من تحدثه على الهاتف من أستراليا هو إيمي سمير غانم بلثغتها المحببة ثم يفاجئونا بأنها منة شلبي؟ وما علاقة اللثغة بشخصية الحبيبة الدرامية أو أبعادها طالما أن الممثلة سليمة اللسان صحيحة النطق؟.. ما فشل صناع الفيلم في استيعابه أن الصفات المجانية للشخصيات تؤدي إلى النفور من الشخصية نفسها والاستهزاء بها، كما يبدو أنهم لا يعلمون أن صناعة المفاجآت الدرامية لا تكون بهذه التفاهة والسذاجة الطفولية.
خامسًا، تخلي «مكي» عن مجموعة العمل التي طالما «خدّمت» على شخصياته ومواقفه في الأفلام السابقة بشكل متناسق، سواء في الأداء أو الطزاجة في التقمص، وعلى رأس هذه القائمة محمد سلام، هشام إسماعيل، ومحمد شاهين، والغريب أنه استبدل كل هؤلاء بممثل نمطي جدًا لم يعد لديه جديد لتقديمه وهو محمد لطفي، الذي جسد شخصية أمين الشرطة المُحال للاستيداع، ليظهر كمجرد سنيد بالمفهوم المصري الهابط وليس بالمفهوم الدرامي، الذي يوظف شخصيات الصف الثاني بشكل يضيف إلى مساحة الكوميديا، سواء عن طريق تدعيم حالة الطرافة العامة للفيلم، أو عن طريق مشاركته في رد الفعل على حدث ما.
كل ما فعله «لطفي» في هذا الفيلم أنه أضاف إلى جرعات الاستظراف والسماجة والنمطية التي بدت وكأنها استهزاء بالمتلقي، خاصة أن صناع الفيلم يعتقدون أن الإفيهات المقفاة والموزونة لا تزال سارية المفعول.
سادسًا، جاءت موافقة «مكي» على الزج بالإعلانات بشكل فج ومباشر في الفيلم بما سبق أن فعله أحمد حلمي في فيلم «على جثتي»، ويبدو أن محمد السبكي قرر أن يستغل «مكي» في اقتحام سوق إعلانات الجبنة والعصير والشعرية، بعد أن سئم من إعلانات النظارات الشمسية في فيلم «عمر وسلمى»، كما يبدو في الوقت نفسه أن أحمد مكي لا يدري أن إقحام الإعلانات بهذه الطريقة الفجة قد يسبب له خسائر في صفقات إعلانية قادمة، خاصة عندما يكون الهدف من الإعلان ليس إلا التربح من وراء شعبية فنان داخل ما يسمى مجازًا فيلما سينمائيا.
سابعًا، أسلوب القطعات المونتاجية كان أقرب إلى أسلوب أفلام الكارتون، وهو ما يتنافى تمامًا مع أسلوب الفيلم، الذي يميل للواقعية من الناحية الكوميدية، أو لنقل الذي يدعي أنه نابع من الواقع، لأن المخرج عمرو عرفة لم يقدم لنا أسلوبا إخراجيا أو إيقاعا عاما يجعلنا نشعر بأننا أمام فيلم كارتون، إلا إذا كان يتصور خطأ أن دخول «سمير» إلى القسم المُحتل من قبل البلطجية، وتطفله السمج على عائلة خالته يجعله فيلمًا كرتونيًا، لأن هذه مجرد ابتذالات وهزل فاضح.
لا شيء يلفت النظر إخراجيًا في الفيلم سوى أنه كان فيلمًا عاديًا، فلو أننا حذفنا اسم عمرو عرفة من «تتر» الفيلم لكان الأمر أكثر منطقية وصدقًا مع النفس واحترامًا للمتلقي.