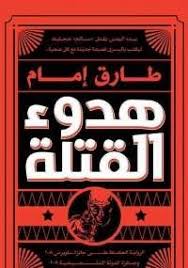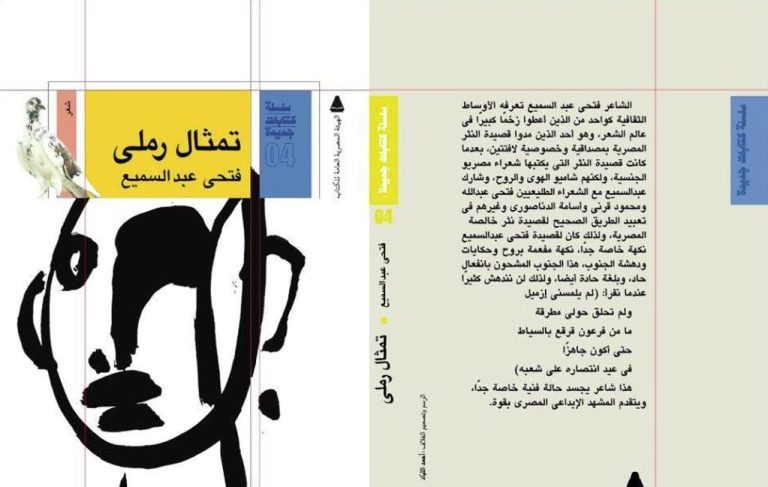لحسن باكور
شريف صالح كاتبٌ شديدُ الشغف بالقصة القصيرة؛ يكتبها بكثير من البراعة والحبِّ، وهو أمرٌ تشهد به النصوصُ العديدة التي أنجزها تحت يافطة هذا الجنس الأدبي الجميل، والتي توزَّعت على مجاميعَ قصصية عديدة، كرستِ القناعةَ لدى عُشاق وقراء القصة القصيرة بأنه قاصٌّ مُجيد يتمتع بقدرةٍ على بناء عوالمَ قصصية شديدة التنوع والثراء.
ولقد أُتيح لي الإطلاعُ على مجموعته القصصية الجديدة “مدن تأكل نفسها”، فقرأتها باستمتاع كبير، حيثُ روَتِ بعضًا من عطشي للقصة القصيرة الجيدة التي لم يعد من السهل العثور عليها وسط كل هذا الركام من “القصص” الذي يُنشر ويتمُّ تداولُه خاصةً في مواقع النشر الإلكتروني، حيثُ غدا استسهالُ كتابةِ القصة القصيرة أمرا سائدا، وحيثُ “أصبحَ كلُّ من هب ودبَّ يعتقد أنَّه كاتب ]قاص]”، مثلما يقول شريف صالح نفسه ــ قصة الضبع الماركيزي، ص 136 من المجموعة.
استفزتني المجموعةُ بقصصها المتنوعة، لغتِها وقضاياها، فجاء هذا المقالُ المتواضع تعبيرا عن إعجابي بها واستمتاعي بعوالمها.
ولا بدَّ أن أشيرَ هنا إلى أني لستُ ناقدا، ولا أدعي لنفسي هذه الصفة؛ وبناء عليه فإن ما أوردُه هنا يبقى مُجردَ عرض لأفكار ولانطباعات شخصية غايتُها الوقوف على بعض خصائص الكتابة القصصية لدى شريف صالح كما تتبدى من خلال نصوص هذه المجموعة.
قصصٌ بنفَسٍ طويل
أول ما لفت انتباهي في هذه المجموعة من حيثُ الشكل، هو حجمها (تجاوزت ال200 صفحة)، مع أنها لا تضم بين دفتيها أكثر من 11 نصا قصصيا. وهو أمر لا بد من التنويه به والوقوف عنده. أجدُ في الأمر نوعا إعادةِ الاعتبارٍ للقصة القصيرة الحقيقية، خاصَّةً في ظل موجةِ القصة القصيرة جدا والأقصوصة التي ابتُلي بها المشهد القصصي العربي في السنوات الأخيرة، والتي جنَت ـ في نظري ـ على كتابة القصة القصيرة التي استُهينَ بشروطها وخصائصها الفنية، تحت ذرائع عديدة: التجريب، التحرر من أشكال الكتابة الجاهزة والتجاوز..الخ.. ولا بُدَّ أن المهتمَّ سيلاحظ كيف تردَّتْ تلك الموجة بالقصة إلى أن غذت مجردَ نكتة مكتوبة أو مفارقة سطحية أو لعب ساذج باللُّغة.
ويبلغ متوسط طول قصص مجموعة “مدن تأكل نفسها” عشرينَ صفحة، لكنها مع ذلك قصصٌ مكتوبة بلغة مكثفة، وبحرصٍ على وجود حبكة قصصية تُخلف لدى القارئ، في النهاية، ذلك الأثرَ الكُليَ المرجو.
إن كتابة قصص قصيرة بهذا الحجم والنَّفَس، دون الوقوع في استطراداتٍ مُخلة أو فائضة عن حاجة النص، مع الحرص على حبكة جيدة تفضي بالقصة إلى إنتاج ذلك الأثر الكلي المنشود الذي لا تستقيم القصة ــ في تصوري ــ دونه؛ إن ذلك ليعدُّ اختبارا للكاتب ولقدرته على كتابة نص قصصي جدير بهذا الاسم، فالأمرُ يتطلبُ صبرا وعملا دؤوبا، كما يمنحُ الكاتبَ ــ من جانبٍ آخرَ ــ مُتسعا للاشتغال على الشخصيات والمواقف واللغة والرؤية للعالم؛ أي كل ما يتضافرُ من عناصرَ لصُنع قصصية النص.
إن الأمرَ ليؤشرُ، من ناحية أخرى، على أخذ شريف صالح ِ كتابةَ القصة القصيرة مأخذَ الجد، باعتبارها جنسا أدبيا بديعا شديدَ الخصوصية، يسمحُ للكاتب بالاشتباك مع مختلف القضايا والأسئلة التي قد تعني الكاتبَ أو المُثقفَ بشكل عام.
كما يؤشرُ أيضا على تصوُّرٍ خاص للقصة القصيرة يتبناهُ الكاتب. ودون أن ينطوي الأمر ـ بالضرورة ـ على أي نوع من أنواع المقارنة، أستحضرُ هنا تجربةَ القصة القصيرة الأمريكية التي أرسَتْ تقاليدَ في كتابة القصيرة لا زال الوسط الأدبيُّ متمسكا بها إلى الآن؛ حيث القصص القصيرة لا بد أن تمتدَّ على عشرات الصفحات، وأن تشتبك مع مختلف المشاكل والاختلالات التي يعاني منها المجتمع وأن تتألقَ وتتميزَ على مستوى اللغة والبناء الفني.
من المعروف أن شريف صالح قد كتب أيضا القصة القصيرة جدا، وأتمنى حقيقة لو أعرف تقييمَه لتلك التجربة الآن، وموقفَه من القصة القصيرة جدا بشكل عام.
يخيلُ إليَّ أن كاتبا يبدعُ قصصا في حجمِ وطبيعةِ النصوصِ التي تضمُّها مجموعة “مدن تأكل نفسها” لن تستهويَه كثيرا كتابةُ القصة القصيرة جدا.. قد يكتبُها على سبيل التجربةِ لكنها لن تُشفيَ غليلَه كاتبا، كما لن تقنعَه قارئًا للنُّصوصُ التي يكتبها الآخرون. هذا مجردُ تخمين، وقد يُجانِبُني الصوابُ.
كتابة الحرية وحرية الكتابة
يكتب شريف صالح ويبني عوالم قصصه بكثير من الحرية التي تُخول له هامشا واسعا للمناورات الفنية؛ وهي حرية متأتية ــ في تصوري ــ في جانب منها من تمكن القاص من أدوات وعناصر بناء النص القصصي؛ تلك الأدوات والعناصر التي يحرص عليها الكاتبُ، دون أن يدعَها تعيقُه أو تحدُّ من حريته.
يكتب شريف صالح قصصَه مُتحررا من إِسار الشكل من جهة، ومن ثقلِ وكبْح التابوهات من جهة ثانية.
تنطلق قصص المجموعة من الحياة لتعودَ إليها، وإن توسلتْ بالرمز وجمحَ بها الخيال بهذا القدر أو ذاك، لذلك فلا بد أن تكتبَ عن السياسة والجنس والدين.. لأن هذه العناصرَ منصهرةً مع بعضها تمثل عصبَ الحياة، وأيُّ كتابة تتجاهلها لن تكون إلا كتابة زائفة محكومة بالنقصان والضعف.
نجدُ في المجموعة قصصا تلتزم بخطية السرد، وأخرى تلعب بالزمن تقديما وتأخيرا، وتعجن الواقع بالخيال، وقد يقسم الكاتب نصَّه الواحدَ إلى عناوين فرعية أو فقراتٍ مرقَّمة.. لكنه في النهاية يكتبُ النصَّ القصصيَّ نفسَه (لا أقصد هنا التكرار، فقصص المجموعة ـ على العكس ـ يمثل كلُّ منها تجربةً خاصة مستقلة).. بهذا المعنى فإن الشكلَ الذي قد تتخذُه هذه القصةُ أو تلك ليس معطى مُسبقا أو جاهزا، بل إنَّ النصَّ هو الذي يفرضُ أو يقترحُ شكلَه في النهاية.
يُعلي شريف صالح من قيمة الحرية ويبوئها موقعَ الصدارة في قصصه، إذ تحضر موضوعة ” الحريةُ” في المجموعة بشكل لن يُخطئه القارئ؛ ولا غرابة في ذلك ما دامت الحريةُ رهانا أساسيا من رهانات الكتابة، وقيمةٌ كبرى تستدعيها جميعُ القيمٌ الأخرى التي لا تكتسبُ قوةً إلا بحضورها.
تضمر قصص المجموعةُ الدعوةَ إلى الإعلاء من قيمة الفرد، والدفاع عن حريته في الاختيار والاختلاف (العيش في الأغاني، الضبع الماركيزي، ما رواه ابن المقفع..) ضدا على التنميط والوصاية والتوجيه، كما يمارس الكاتبُ حريتَه في بناء قصصه كما يشاء، ما دامت الكتابةُ في حدِّ ذاتها فعلاً حرٌّا بامتياز..
إبداع وإمتاع
معلومٌ أن الإمتاعَ غاية من غايات الكتابة الأدبية، بل هو مقياس من مقاييس جودةِ النص القصصي. وأقرُّ أني أصبتُ من المتعة قدرا طيبا بقراءتي لنصوص مجموعة “ مدن تأكل نفسها “.. ولقد تأتَّت هذه المتعةُ ـ من وجهة نظري ـ من تضافرِ مجموعةِ عناصرَ داخل المتن القصصي، منها اللغة، القضية والسخرية. وسأحاولُ إلقاءَ بعض الضوء على العنصرين الأوليين.
ــ اللغة:
تُعد اللغة من نقط قوة النص القصصي لدى شريف صالح، ليس في هذه المجموعة فقط، بل ينسحب الأمر على معظم أضموماته القصصية الأخرى السابقة.
وتتجلى هذه القوة في جمع لغة الكاتب بين الجمال والإيحاء والدقة وصفا وسردا، وهو أمر يتأتى من قدرة الكاتب على التحرك بمهارة في ذلك الحد الدقيق الفاصل بين اللغة كأداة وظيفية حاملة لدلالة معينة، وبينها كعنصر جمالي مستقل..
إن اللغةَ في مجموعة “مدن تأكل نفسها” تحرصُ على جمالها الخاص، لكن دون إفراط، حيثُ يبدو واضحا حرصُ الكاتب على إيجاد ذلك التناغم بين الدورَيْن الوظيفي والجمالي للغته، حتى لا يطغى أحدهما على الآخر.
أعتقد أن شريف صالح يكتب القصة القصيرة مستندا إلى وعيٍ جلي بإشكالية اللغة القصصية وأهميتها القصوى، ويخامرك الشعور وأنت تقرأ له، بأن عباراتِه الجامعةَ بين الدقة والجمال، وجملَه الحاسمة والمكثفة؛ كلُّ ذلك يُخفي عملا دؤوبا من الحذف والتشذيب ومقاومة إغراء ومكْر اللغة أيضا، وهو أمر تهبُه التجربة وتطوُّر علاقة الكاتب باللغة موازاةً مع مراكمته لمزيد من القصص. نقرأ من قصة الضبع الماركيزي “ الإبداع يكمن في إضافة قد لا يلحظها أحدُ، في شجاعة الحذف ودقة الإضافة “ ص 139.
إن سحرَ القصِّ في مجموعة “مدن تأكل نفسها” مدينٌ في جانبٍ كبيرٍ منه للغة الكاتب التي تستمتعُ بها وأنت تقرأ القصصَ وتتابع أحداثَها المتوالية بسلاسة، مثلَ خلفية موسيقية عذبة في فيلم سينمائي: تُمتعكُ وتضاعف فرجتَك دون أن تصرفكَ عن تتبع أدق تفاصيل الفيلم.
ــ القضية:
يبدو شريف صالح في هذه المجموعة كاتبا صاحبَ قضية، ومنشغلا بأسئلة مستقاة مما يُهم الناسَ ويشغلهم وهم يتراكضون في دوامة اليومي الحافل بالصراع والمتغيرات ومختلفِ أشكال القهر والمعاناة؛ لذلك بوسعنا القول إن القاصَّ شريف صالح كاتب مُلتزم، ويعتبر الكتابةَ صوتَه للجهر برأيه في مختلف القضايا التي تُهمُّ مجتمعَه وتُهم الإنسانَ بشكل عام في صراعه من أجل حُريته وتحقيقِ وجودِه.
مَهما شطَّ بالكاتبِ الخيالُ وهو يكتب قصصه، ومهما أوغلَ في أساليب التجريب الفني وهو يبني تلك القصص، فإنه يكتب وعينُه على أعطاب واختلالات مجتمعه وعلى قضايا الإنسان الذي يبقى المنطلق والمنتهى لأي كتابة جادة.
لذلك فقصص المجموعة ليست قصصا مُهادنة أو من قبيل الترف الفني، بل إنها قصصٌ قلقة غاضبةٌ تسعى إلى النقد والتعرية والفضح؛ فضح غول الفساد الذي ينخر المجتمع المصري والعربي عامة، مثل لعنةٍ قدريةٍ لا فكاك منها.. الكتابة عن البيروقراطية التي تعطلُ مؤسساتِ الدولة وتحولها إلى عبء على المجتمع واستهتار بمصلحة المواطن (قصة: عيد جميع المخلصين).. الاستئثار بالسلطة وخنق الأنفاس والأحلام والرغبات بالمتاريس وشتى أشكال الوصاية والمنع (قصص: العيش في الأغاني، الضبع الماركيزي، ما رواه ابن المقفع..) المتاجرة بالدين وزواج المال والسلطة ( مسمط الشيخ مسعد فتة، بلد أم الولي..).. كلُّها قضايا تحضرُ في صلب اهتمام الكاتب وتشكل خلفيةً لقصصه ذات البُعد الإنساني البيِّن.
الفانطاستيك كامتداد للواقع
الفانطاستيك تقنيةٌ من تقنيات الكتابة تمنحُ النصوصَ قيمةً مضافة وترقى بأبعادها الدلالية، لكنَّ توظيفَهُ يتَّسم بكثير من الحساسية والدقة، وقد يتحول إلى عنصر مُقحمٍ يسيءُ إلى النصِّ مبنًى ومعنَى.
ويوظفُ شريف صالح الفانطاستيك في كثير من قصصه ببراعة لافتة، إلى درجة أنه يبدو داخل النصوص امتدادا للواقع وليس مُفارقا له.. ذلك أنَّ المَشاهدَ أو الوقائعَ ذات البعد الفانطاستيكي أوالعجائبي تردُ في قصصه بشكلٍ سلس ومُستساغ، وتمنحُها قيمة جمالية إضافية.
ويمكن التمثيل لذلك بقصتي عيد جميع المخلصين و العيش في الأغاني؛ إذ تنتهي القصة الأولى بمشهد سوريالي مُدهش لسرب من الموتوسيكلات تمتطيها مختلفُ الشخصيات التي رافقت الرَّاوي في رحلته الطويلة داخل دهاليز الإدارات لإعداد ملفَّه كي يهاجرَ.
يقول الرَّاوي “.. ظهرَتْ وراءنا بضعةُ موتوسيكلات يقودها أشخاص كانوا جميعا يرتدون تيشيرتات خضراء على بنطلونات جينز رمادية (…) فركتُ عيني فوجدتُ الموتوسيكلات تزداد وتقترب منا. لمحتُ بوضوح “أم جامبو” نفسها ترتدي التيشيرت الأخضر والبنطلون الجينز وتقود الموتوسيكل، وخلفها السحلولي نفسه بنظارته الريبان المقلدة على موتوسيكل آخر. ثم انضمت إليهما “أم ذوق” وأيضا عاملة النظافة وخلفها المظفة الشابة التي قضيتُ معها نصف ساعة في غرفة سرية، وغير بعيد ظهر “شهبور رخصة”.. كل المخلصين الذين صادفتهم خلال عامين انتشروا حولنا على الموتوسيكلات. الجميع كانوا يصيحون ويمرحون ويلوحون لي بأقلامهم” ــ ص 97.ى
لقد انبثق العجائبي من رحم الواقع والمألوف بشكل سلس ومقبول، على نحو ولَّدَ المتعةَ ومنحَ النصَّ نهايةً مضيئة ورائعة كفيلةً بصرفِ القارئِ تماما عن التساؤل عن مدى ” واقعية ” المشهد أو التفكير في استحالة تحققه على أرض الواقع.
وينهي الكاتب قصة العيش في الأغاني على هذا النحو الساحر: “على مهل نهضتْ من فراشها. وقفت أمام المرآة بقميص نومها الأزرق الشفاف. لمت شعرها الطويل إلى الخلف، ثم وقفت على حافة النافذة المفتوحة. ستارة النافذة تتطاير، ثوبها الأزرق يتطاير. هي الأخرى طارت. تشبثت بيديها في الإفريز الخارجي، وبكل قوتي مددتُ إليها يدي. لا يا إنجي!.. فردَتْ يديها ورجليها وطارت.. طارت بظهرها إلى أسفل، فقفزتُ وراءها.
كانت سرينة الإسعاف تدوي بالقرب. وبخفة مدهشة وقفنا في الشارع ويدي في يدها. ابتسمت وأمالت خدها كي أعضها. ثم انطلقنا معا نجوب كل أغاني العالم، وفي يد كل منا شوكة ديدية نطعن بها كل ما لا يروق لنا” ص ـــ 80.
وتبقى الإشارةُ إلى أنَّ المقطعين المستشهَد بهما أعلاهُ يكتسبان قيمتهما ويحققان دلالتَهما داخل سياقهما النصي، وليسَ وهما مُجتزآن من القصتين. ذلك أن أجواءَ النص ومختلفَ تفاصيله تهيئ القارئَ لتقبُّل تلك النهايات وتجعلُها مُبرَّرةً من الناحية الفنية.
***
وعلى هامش إعجابي بهذه المجموعة، أود تسجيل ملاحظتين اثنتين:
ــ الأولــى:
عن مدى أهمية وضرورة تلك النصوص الموازية التي صدَّر بها الكاتبُ كلَّ قصة من قصص المجموعة على حدة؛ حيث حرص على افتتاح كل نص ب ” مفتاح” و”باب” هما عبارة أقوالٍ أو مقاطعَ مُجتَزأة من كتب، لِكُتاب مختلفين..
هل هي نصوصٌ ضرورية فعلا؟ إذا كانت كذلك فما هذا الدورُ الوظيفي الذي يُكسبها تلكَ الضرورةَ، بحيث إنَّ حذفَها قد ينجمُ عنه نقصٌ ما أو إِضرارٌ بالنص؟
أعتقد شخصيا أن النصَّ القصصي الجيدَ، ليس بحاجة إلى نصوص موازية يتعكز عليها أو تقدمُه إلى القارئ.. عليه أن يكون نصا مستقلا ومكتفيا بذاته، يستضيفُ القارئَ إلى عالمه دونما حاجةٍ إلى مُوجِّه من أي نوع.
أكثر من ذلك أعتقد أن مثلَ هذه ” العتبات” قد تشوشُ ـ أحيانا ـ على القراءة وتوجهها توجيها مُحدَّدا منذ البداية.
أسوقُ هذه الملاحظةَ مع احترامي الكامل لاختيار الكاتب وقناعته.
ــ الثانية:
أعتقد أنَّ النصوصَ القصصيةَ التي اشتبكتْ بشكلٍ “مباشر” بالواقع اليومي لغةً وفضاءً ووقائعَ (عيد جميع المخلصين، العيش في الأغاني، بلد أم الولي…) جاءت أكثر إمتاعا وإقناعا مقارنةً مع نصوص أخرى اعتمدت بشكل أساسي على الرمز (مملكة الضحك، ما رواه ابن المقفع..).
نصوصٌ تخلقُ لدى القارئِ إيهاما قويا بالواقع، وتستضيفه إلى أجواء يعرفها أو هيَ مألوفةٌ لديه، لكن القاصَّ إذ يمتحُ من معين اليومي، فإنه يفعل بحس المبدع الذي يسبرُ عمقَ الأشياء وينفذُ إلى ما هو خفي، دال ويمسُّ جوهرَ الحياة.
لا جدالَ في أن شريف صالح يتمتع بقدرة على كتابة قصة قصيرة تمزجُ بين الواقع والخيال في توليفةٍ منسجمة ترقى بذلك الواقع إلى مستوى الرمز، وتميطُ اللثامَ عمَّا يحفلُ به من دلالات وأبعاد تتخفى وراء ابتذال اليومي ورتابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شريف صالح: مدن تأكل نفسها، منشورات دار بتانة للنشر ـ القاهرة 2019.