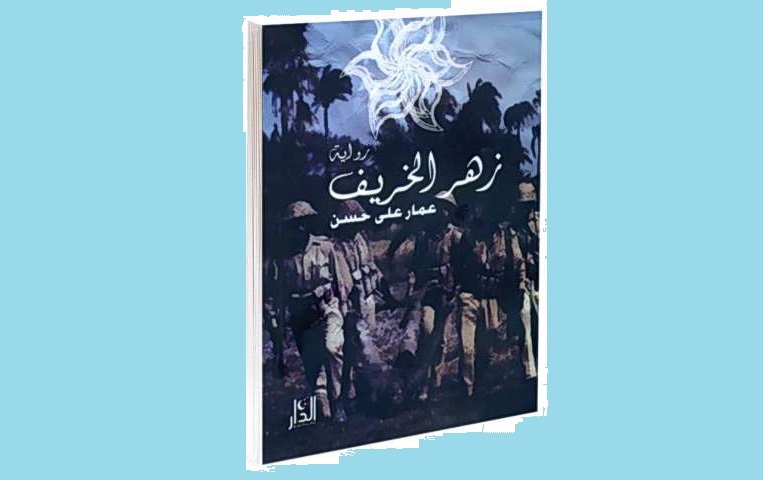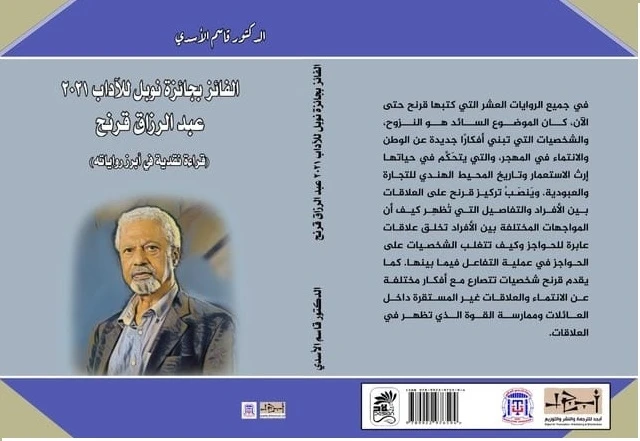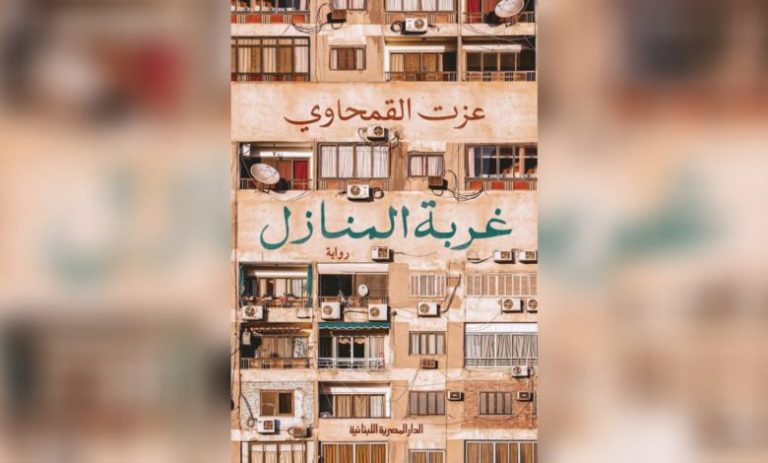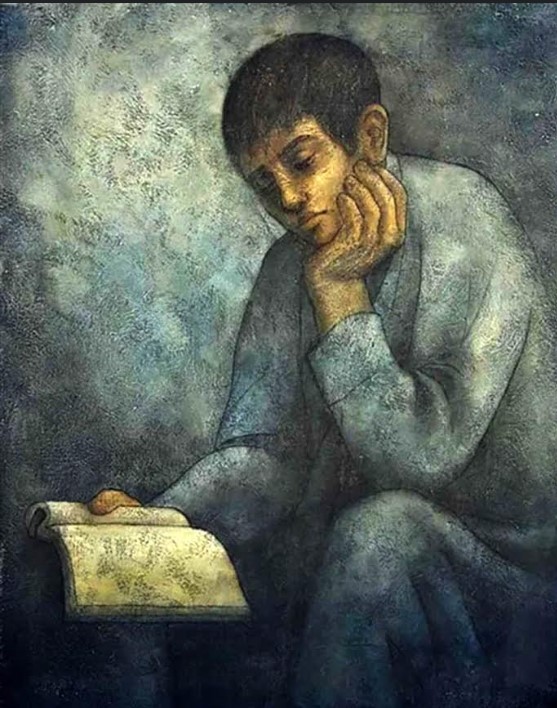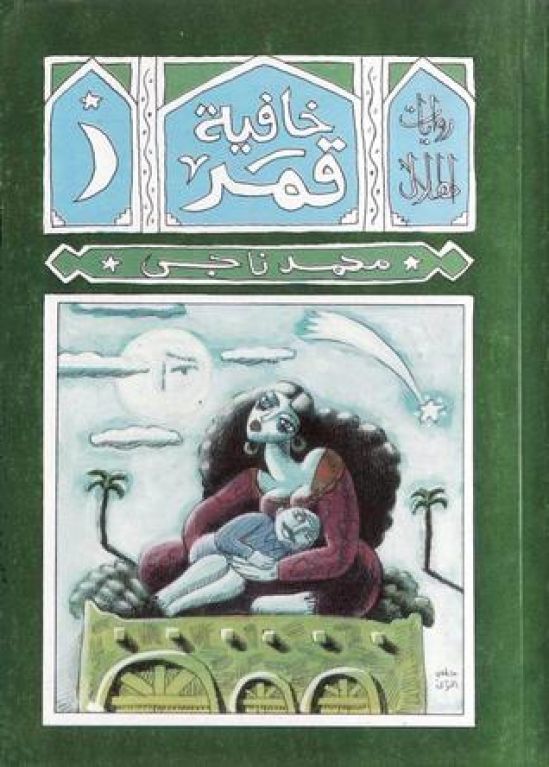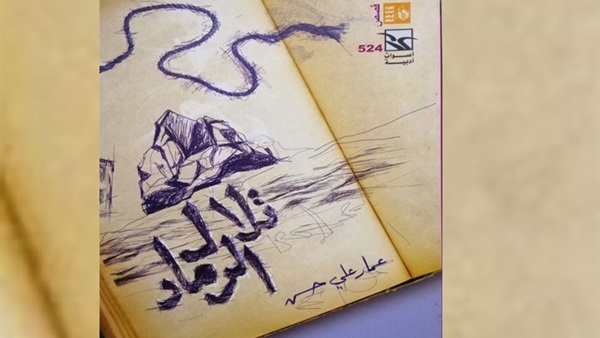شوقى عبد الحميد يحيى
رغم مرور خمسة عشر عامًا على ثورة 25 يناير 2011، فإنها لم تزل تطرح العديد من الأسئلة، التي تختلف إجاباتها، ولم تزل في الضمير الجمعي للإنسان المصري، بل العربي؛ حيث اجتاحت الثورة أربع دول عربية، ولا بد أن جميعها كانت تشعر بالظلم والانحراف، وتسعى إلى العيش والكرامة، التي فقدها في وطنه.
وحين هبّت الثورة في 25 يناير، سارع الكُتّاب إلى تسجيل اللحظات التي شعروا فيها بالأمل، والتطلع إلى السماء أن تقف بجانبهم. فمنهم من كتب القصيدة، التي كانت تهتم باللحظة، ومنهم من كتب القصة القصيرة، وهي الأقرب إلى القصيدة، والكثير منهم عبّر عن الموقف بالمقال أو الخاطرة. أمّا الرواية، فقد مرّت بالعديد من المراحل، التي بدأت من قبلها، فكانت تحفيزًا للثورة، وتحول فيها الخطاب إلى استخدام لغة خشنة، وتكسير كل التابوهات المحرّمة في الإبداع (العربي)، وكأنها ثورة على الورق تدعو للثورة على الواقع. فتمثلت في الفترة الأولى في شكل يوميات للميدان، وتحول البعض، الذي كان قد بدأ كتابة رواية، ليكملها بما يحدث على الأرض. ثم بدأت العملية في الهدوء (النسبي)، ليلتقط الروائي أنفاسه، ويتدبر ما حدث، في ظل التسارع في التحولات المجتمعية.
وفي العام 2019، كتب عزت القمحاوي روايته «ما رآه سامي يعقوب»، وكان العنوان حينها يتماشى مع الحالة التي لم تكن قد هدأت نيرانها، حيث المعايشة والمشاهدة التي لم تزل حاضرة في ذهن الكاتب، فكتب «ما رآه» وكأنه شاهد على الواقعة.
وإن كانت «ما رآه سامي يعقوب» قد بدأت بداية موحية، لم تتضح في «بخلاف ما حدث»، حيث نقرأ في بدايتها:
{بيتها في إمبابة يبعد عن النيل بالمسافة نفسها التي تفصل بين النيل وبيته في جاردن سيتي، لكن بين الحيّين شاسع. في سماء جاردن سيتي بوسعه أن يرى اليمام والعصافير الصغيرة، الوروار وأبو فصادة، والهدهد الذي صار ظهوره عزيزًا. لا تغامر العصافير بدخول إمبابة، بينما يمكن ملاحظة الطيور الكبيرة تنبش الفضلات على الشاطئ، وتكتفي بالتحليق فوق مسطح الماء، حيث يتسع النيل مثل بحيرة ضخمة في مواجهة أبو الفدا: نوارس ضاحكة، فراخ هيش صامتة، وغربان يفلق نعيبها الماء، وتنقض على العوامات والمطاعم النيلية} (ص7).
ويستثني من هذه القاعدة «الحمام»، الذي يرمز للسلام، وهو الذي يجمع بين ساكن جاردن سيتي وساكنة إمبابة. الأمر الذي يوضح الفرق بين الحيين، وهو ما سعى الكاتب أن يذيب هذه الطبقات، أو أن يقرب ما بينها.
فـ«عيسى»، الذي رأيناه في («السراب»، و«الساخط»، و«حيث السرايا»)، يتبسط مع العاملين، ويتخذ منهم أصدقاء، وحتى الحيوانات، وينظر إلى حفيدة «صلاح» –عمه– «نعمة»، حتى أثارت غيرته «فريدة» وصديقاتها، والتي نستطيع القول بأنه بالفعل أحبها، ورغم ذلك تزوج من «فريدة»، التي لديها طفلتان، وعاشا معًا عيشة لم يعكرها شيء. الأمر الذي يمكن معه قراءة الروايتين على أنهما رواية واحدة، فضلًا عن كثير من الأمور المتشابهة، والتي تعمق من شخصية «سامي»، مثل أن يتعايش مع الجميع، ويتعايش مع رؤاه وتهيؤاته، منسجمًا مع الحياة بوصفها عرضًا مسليًا.
الأمر الذي يوحي بأن «سامي» منذ طفولته يبتسم، وينظر للحياة على أنها عرضٌ مسلٍّ، لذا كان جالسًا في البيت بينما ذهب شقيقه «يوسف» إلى الميدان، حتى أصابته رصاصة القناص. كما أن شجار والديه الدائم طبع خصائص الشخصية بالتوحد والابتعاد عن الناس. كما كان موت الأب، الذي عاش معه بعد سفر أمه إلى ألمانيا، وإصابة أخيه من القناص في 25 يناير، قد ساعدا على ترسيخ تلك الصفة والانطواء.
وكأن الكاتب يرى أنه لم يوفِّ شخصية «سامي» الكثير من الأضواء التي تكشف أبعادها، فكانت روايته الجديدة «بخلاف ما سبق»، ولتتسع الرؤية حول ما كان من 25 يناير، لتبتعد عن الفضاء الأسري، والبعد الإنساني، وتشمل الوطن كله. حيث يلاقي هناك العديد من المشكلات، التي كان أولها من جاءوا ليستردوا ميراثهم، كعودة إلى الماضي، بينما كان «أمين عسكر» هو الرجوع إلى الحاضر، والذي لاقى منه كل المشاغبات والتطفيش.
حيث أصبحت 25 يناير علامة في التاريخ، وحفرت الكثير من الجروح الغائرة في النفوس، وتوقظ الضمائر الباحثة عن مستقبل أفضل لهذا البلد، فظلت تؤرق الكاتب، حتى كتب في العام 2025 روايته «بخلاف ما حدث»[1]، وكأنه يعيد كتابة الرواية نفسها، ولكن بعمق أكبر، حتى إن القارئ، عندما يتناول الرواية ويجد أنها 412 صفحة، يصيبه التردد، إلا أن من يبدأ القراءة يجد نفسه لا يستطيع مغادرتها قبل أن ينهيها حتى الصفحة الأخيرة، معتمدًا على النقلات السريعة، وبداية الفصل الجديد دون أن ينهي الفصل السابق، وخلق الحركية والتسارع في التنقل، الأمر الذي يمسك به حتى النهاية.
حيث تبدأ الرواية بما يدفع القارئ إلى التساؤل منذ السطر الأول فيها، والذي يدفع إلى تذكر السيمفونية الخامسة لبيتهوفن، المسماة بـ«القدرية»، وكأننا أمام قدرية جديدة، استطاع الكاتب فيها أن يستخدم التنقلات السريعة، واللغة السهلة والسليمة، ليمسك بقارئه حتى النهاية، ليجد أنه يذهب إلى عمق المشكلة، فيُحيي الباشوات من قبورهم، وكأنه يبحث عن الجذور التي أدت إلى 25 يناير؛ فما من شيء إلا وله جذور مخبوءة في التربة، وما الثمرة إلا وتتغذى، وتستمد حياتها من تلك الجذور.
فتبدأ «بخلاف ما سبق» وكأنها تقود قارئها منذ العتبة الأولى إلى مسار التجربة، وتعلم أن هناك مواجهة، أو مقابلة، بين ما كان وما هو كائن.
تبدأ الرواية بـ{كان شتاءً.. وكانت الشمس تشرق واهنة دون أن تبدد ظلام الشقة، ثم تمضي إلى حيث تغرب، وتترك لليل زاده من الخوف}. فتحمل {لتترك زاده من الخوف} شحنات كبيرة من القلق والتوتر؛ حيث الشتاء بظلاله يفرض على القارئ الانكماش والتخفي تحت الأغطية، ويبدأ الخوف من اللصوص، ومن زوار الفجر، يداعب أفكار المذعورين والخائفين من ماضٍ غير مريح.
وبالفعل، نتبين أن «سامي يعقوب» يكمن في شقته بجاردن سيتي، مذعورًا، لموت أبيه في السجن – بعد سلسلة بحثه لتبرئة الجد مما نُسب إليه –، وموت أخيه بعد إصابته من قناص – في الميدان –، رغم أنه – الكاتب – لم يقل صراحة إنه مات، غير أنه يترك ذلك لاستنتاج القارئ. واختفائه سبع سنوات، دون أن يعلم عنه شيء، لكنه يأتيه ليوضح جزءًا مما خفي عن القارئ، دون أن يوضح – أيضًا – هل عاد بجسده أم بروحه. لذا فقد كمن في شقته شهرين وعشرة أيام، مذعورًا من أي خبط على الباب، حتى حبيبته لم يجرؤ أن يفتح لها، مما أغضبها، وكادت تحدث بينهما الفرقة.
ولنعلم بعد ذلك أن جده كان ضلعًا أساسيًا في (الوفد)، ارتقى إلى أن يكون وزيرًا، دون أن يحدد – الكاتب – أي تواريخ تفيد الزمن الذي تجري فيه الأحداث، وإنما تركها للقارئ ليفهمها من تلقاء نفسه. وقد اتخذ هذه الوسيلة في الكثير من صفحات الرواية، كثغرة على القارئ ملؤها.
فيأتي من يسلم له رسالة يخبره أن يذهب إلى السرايا، ويحدد له العنوان: {عند بنزينة الأبطال، اسأل عن سرايا أم الغلام، أو السرايا البيضاء، وستجد من يدلك}. حيث (السرايا البيضاء) توحي بالتفاؤل والبِشر. فهل كان بالفعل في رحلة إلى الأمل؟
ويختفي الغلام مرة أخرى، فكأننا من جديد أمام افتتاحية القدر، والتي توحي بالمزيد من الخوف من القادم، ليقع الإنسان هنا في التيه والقلق، وسط الخوف الذي يعيشه، والأمل الذي يكمن في (السرايا البيضاء). خاصة أن أخاه «يوسف» أخبره: {وهبك الله نعمة التنبؤ يا أخي، وقد تكون نعمته الآن أن يحرمك منها، فالقادم سيئ جدًا} ص107. فلم تكن نفسه في احتياج إلى المزيد من القادم، ومن الخوف.
فيستجيب «سامي» للهاتف الغريب الذي جاءه، ويذهب فيقابل القيّمة بالسرايا – «أم الغلام» –، فتناوله «أم الغلام» عقدًا: {وجده عقدًا من جده مكتوبًا بخط جميل، ينص على أنه وهب الأفدنة الخمسة، ومن ضمنها السرايا، إلى صابر عبد الستار الفشن وزوجته نجفة محمود الفشن، وعليه توقيع الواهب وبصمة إصبعي الموهوب لهما، وفي الفراغ أسفل الصفحة الأخيرة تنازل الأخير صابر عن حصته لنجفة، مع بصمتيهما} ص30.
وعند سؤال سامي للمرأة عن سبب وهب جده لهما، أجابت: {لم يهبنا وحدنا، كل هذا الزمام كان لسالم باشا. وعندما هاج الضباط على الملك، وعرف جدك أنهم سيأخذون أراضي الباشوات ويوزعونها على الفلاحين، قال: سأسبقهم وأوزع أراضيَّ بنفسي على الذين تعبوا معي في استصلاحها. أعطى كل أسرة خمسة أفدنة، وميزنا نحن بالسرايا} ص30.
ونلاحظ هنا أن الباشا استصلح هذه الأرض، ولم يرثها عن آبائه أو أجداده، وأيضًا أن الباشا وزع الأرض بالتساوي على الفلاحين، ولم يميز إلا «أم الغلام» وزوجها بالسرايا، لعلة في نفسه.
فيقيم «سامي» في السرايا، ويقوم بإصلاح ما بها وتنظيفها، والاعتناء بالحديقة حولها، وشراء العديد من المواشي، دون أن يذبح أحدها، بل يقوم بعلاج ما يمرض منها.
ويعود الكاتب إلى الماضي ليسأل سامي «أم الغلام»، بعد أن أصر أن تظل مقيمة معه في السرايا، فيجر معها الحديث لتقول له: {زمان، أول ما اشتغلنا عند الباشا جدك، كنا نأكل في الغداء حبة طماطم، نغمس كل قضمة منها في الملح مع اللقمة. كنا لا نرى اللحم إلا في العيد.
– والطيور التي تربونها؟
– نبيعها. حتى البيض نبيعه. كنا فقراء فوق ما تتصور.
– وعندما أصبحت الأرض ملككم؟
– أصبحنا فقراء أصحاب المُلك. الأرض ما تعطي} ص97.
وفي حديث آخر بين «سامي» و«أم الغلام»، تعترف له بما كان بين جده الباشا وبينها، في لقطة يرمي بها الكاتب على الوضع الحالي:
{يعني نعمة ابنه ابن عمي!
– تحل لك، النصيب.
كنتِ تعرفين أن جدي وزير؟
منذ عرفناه كان له وضعه في حزب الوفد، حكاية وزير جاءت فيما بعد. وفي أيامه كان الوزراء متواضعين، الآن ملازم في النقطة شايف نفسه رئيس ديوان} ص211.
ثم يأتي أخوه يوسف، دون سابق موعد، فيسأله عن حاله، دون أن يوضح – الكاتب – أنه مات، فيقول الأخ: {لست بخير يا سامي. الحرق بجبهتي، لكن ألمه في قلبك أنت} ص104. وهنا تتضح العلاقة بين «سامي» و«يوسف» كشقيقين، لتكشف الجرح الذي سكن في قلب «سامي» لوفاة أخيه.
ليصبح ما ترسّب في أعماق «سامي» – الإنسان – إلى جانب كثرة الخلاف بين الأم والأب، وموت الأم والأب، وموت الجد بعد أن خرج في التطهير، وتعرضه شخصيًا للسجن والاتهام لمجرد أنه صوّر القط والقطة في «ما رآه سامي يعقوب»[2]، ثم موت الأخ، الأمر الذي جعل من «سامي» شخصية غير سوية، بدأت عليها الانطوائية والانعزال عن الناس. وهو ما أجاده الكاتب في تصوير «سامي» الإنسان.
ويقول «سامي»: {وهنا تغيرت حياتي. هل تعيش أنت وزملاؤك التسعة والثلاثون معًا؟
– لسنا تسعة وثلاثين.
– هذا ما قيل عن عددكم.
– لا، لا، العدد أكثر كثيرًا، ولم نكن كلنا ثوارًا، بيننا مخبرون وبلطجية، بيننا قناصة تمت تصفيتهم بعد أن أدوا مهامهم، وعبر معنا في تلك الليلة رجل وامرأتان عجائز من سكان العمارات المحيطة بالميدان، صعدوا آمنين من أسرّتهم بينما كانت تجري أمام النوافذ جريمة لم يعرفوا بها إلا هناك. كل من عبر الحاجز من المنطقة في تلك الليلة يعيشون معًا.
– تعيشون مع البلطجية والقناصة وجهًا لوجه؟
نراهم، كأننا نلتقي للمرة الأولى} ص106، 107.
وهنا تكمن نقطة التأثير الكبير على حياة «سامي»، والتغير الذي أدى به إلى أن يقول: {وهنا تغيرت حياتي}.
وهنا يستمر الحديث عن ثورة يناير، دون أن يفصح الكاتب، ليستخرج أحد أصدقاء «سامي» أحد الكتب في مكتبة الباشا، التي أعادها سامي إلى موضعها.
{قال سامي:
– فكيف تصنف ثورة 25 يناير؟
قال كامل: طبخة غير ناضجة من الرغبة في الثأر والتطلع للحرية.
– قال فهمي: شيء الله يا ثورة!
– قال سامي: هناك ثأر لا يزال معلقًا.
– قال كامل: اقرأ محمد بك عبد الله وستعرف لماذا أخفقت الثورة، ولماذا لم يتحمس لها شخص ضعيف.
قال فهمي: يتحدث عن مبدأ عام يفسر نجاح أو إخفاق أية ثورة في أي مكان. إذا لم تكن حرية الفكر عقيدة الغالبية، وتستطيع أن تحميها، تكون الثورة مجرد انتفاضة، وحتى لو تمخضت عن أفضل الدساتير، سرعان ما تتحول تلك الدساتير إلى أوراق لا تساوي الحبر الذي كُتبت به} ص311، 312.
ويستمر حديث المكتبة، لتعبر عن السرايا، وكيف كانت بيوت الباشوات في تلك الفترة، وكيف كان الناس، وكيف كان المؤلف يبث انتقاداته حول المجتمع قبل العام 1952. وليعلن لفهمي سؤالًا عابرًا يكشف عن السر داخل «سامي»، الذي يحمل الكراهية منذ قتل أبيه داخل السجن، حيث قال:
فهمي: وبالرغم من الهزيمة لم يتوقف التصفيق لعبد الناصر، وانتحر البعض لموته.
ووجّه السؤال إلى «سامي»: هل تؤمن بالكراهية بأثر رجعي؟
ليرد سامي: لم أعرف الكراهية إلا بعد مقتل أبي في الحبس.
فقال كامل: قبل يوليو كنا في طريقنا لأن نكون بلدًا عاديًا. كنا محتلين، وكان لدينا أحزاب وبرلمان وقضاء.
فقال فهمي: لم يكن هناك فساد.
فرد عليه كامل: كان الفساد موجودًا، لكنه كان صغيرًا، حتى ليبدو الآن نكتة.
وقال فهمي طنطاوي – والد «فريدة» الذي انتقل معهم إلى السرايا –: من واقع الكتاب الأسود الذي أعدّه مكرم عبيد على النحاس، أن زوجته استغلت سفارتنا في لندن وموظفي السفارة لشراء بالْطو فرو} ص249.
وفي حوار حول المكتبة، تحدث «فهمي» و«كامل»، ووضع أمامه كتابًا:
{مطبوع عام 1951، وقت مولدي. انظر أولًا من المؤلف! مجرد محامٍ، لكنك تقرأ فتجد نفسك أمام مفكر سياسي وفقيه قانون عظيم.
قال سامي: وقت كان لدينا تعليم توقف كامل على الفهرس، مشيرًا:
انظر: ليس كتابًا عاديًا، بل سفر ضخم مقسم إلى ثلاثة كتب، الأول منها نظري يشرح فيه تاريخ فكرة الحرية، وكيف تتحول بعد طول ممارستها إلى عقيدة، وكيف تنتكس عقيدة الحرية. أحيانًا يتسلل الاستبداد من تحتها، ويشير بوضوح إلى تجارب كالبلشفية والفاشية والنازية} ص311.
ولا يفوتنا التأمل في تلك الأمثلة التي يضربها، حيث كلها تشير إلى الديكتاتورية.
وفي إشارة أخرى إلى ما يصيب واقعنا من المآسي، ففي حديث لعطا الله مع «أم الغلام»، يقول:
{أنتِ عملتِ مشكلة خارج زمام سالم يعقوب. كسبه للقضية (يقصد محمد عطية المحامي) سيفتح شهية ورثة الباشوات الآخرين، والحكومة أصبحت تأخذ من الفقير لتعطي للغني} ص191.
فترد «أم الغلام»:
– اطمن. الآن أصبحت تأخذ من الاثنين!!
وفي الميدان، وخلال الثورة، كان العَلَم في يد الجميع، ليصبح رمزًا بما له من قداسة، وليكشف عن العوار الذي أصاب المجتمع، والتحول في البنية الاجتماعية، ويكشف عن إحدى محطات (الثورة) التي تحمل العار والفشل، بعد نكسة 1967، التي كانت أكبر نكسة في التاريخ، فيقول سامي:
{كل جريمة تلف في العَلَم تصبح مبررة؟
فيرد فهمي: كانوا يخفون الجرائم ببناء المساجد.. أصبح الآن الأمر سهلًا، تلوين الحائط لا يكلف شيئًا. العَلَم رمز، ويجب أن يبقى عاليًا. ليس ستارًا أو واجهة يتعفن الواقع خلفها.
وقال كامل: لا تحكِ عن العَلَم لمن رآه مهددًا. كانت رفرفة علم العدو بالنسبة لي أسوأ من غارات طائراته.
وقال فهمي: ألم تُهجروا بعد النكسة؟} ص246.
رحلة طويلة، أجاد فيها الكاتب المزج بين الهم الشخصي والهم العام، في تداخل واندماج غير قابلين للانفصام. حيث انتقل سامي من جاردن سيتي إلى السرايا، ليواجه الكثير من المشكلات، كان أولها «أولاد ناجي» المطالبين بحقهم في الميراث، وثانيها «أمين عسكر»، المستخدم للدين في فرض سطوته على المحيطين به.
التقنية الروائية
اعتمدت الرواية على الحوار بنسبة كبيرة منها، وكأن الكاتب يقيم حوارًا مع الشخصية المتوحدة والانطوائية والباسمة، وكأنها أقرب إلى البلاهة منها إلى الطيبة، مع العالم الضاج الصاخب من حولها. أو كأنه يقيم علاقة بين الطيب والشرير، موحيًا بأن الطيبين أقل كثيرًا من الشريرين في هذا العالم.
ومن مجريات الرواية، نستطيع القول إن الكاتب أراد أن يقيم مواجهة بين الشقة في جاردن سيتي، والمعيشة في السرايا. فبينما كان يعيش الخوف والتقوقع، والحذر من مواجهة أي إنسان، في انتظار المجهول الذي يأتي – بالضرورة – بالشر، نجد أن حرية الحيوانات المشتراة، والتي اشتراها عندما ذهب إلى السرايا في (السراب)، والتي تزايد عددها يومًا بعد يوم، غلبت حرية المواطن في دولة ناصر.
بينما صاحبها يعيش الخوف والقلق الذي كاد يُفقده حبيبته «فريدة»، بدأت الحيوانات في المعلف الذي أقامه في حديقة السرايا تجري في عِشّة الدجاج، أو خلف أمهاتها في ساحة المعلف أو في البستان، سواء كانوا معيزًا أو خرافًا أو كلابًا أو جمالًا؛ كلهم صاروا أصدقاءه، وهو الذي لم يكن له أصدقاء – سوى الخوف – في جاردن سيتي. وتصورهم «فريدة» وتنشر الفيديوهات التي اجتذبت مليون متابع.
مع ملاحظة أن جاردن سيتي قريبة من ميدان التحرير، بينما السرايا تقع في الفضاء الواسع، بعيدًا عن صخب الميدان.
كذلك كانت هناك مناظرة، أو مواجهة، بين حرية الإنسان (قوانين الإصلاح الزراعي وتوزيع الأرض على الفلاحين، وموت الأب داخل السجن، حيث عاش «سامي» شهرين وعشرة أيام في عزلة)، وحرية البهائم في المكان نفسه الذي كان يسكن فيه الباشا الجد، وتوزيع الأراضي فيها.
يضاف إلى ذلك أن «سامي» يعالج هذه المواشي بنفسه، ويشعر بآلامها، ولا يقبل أن يُذبح أحدها، ويفضل أن تموت وتُدفن في حديقة السرايا، أي إنها تُكرم وتشعر بالحرية، حتى إنها تدخل السرايا، بل وحجرة نوم سامي وفريدة.
{بعد الإفطار ذهب «سامي» إلى المعلف، رأى «رفقة» و«سمعان» وسط قطيع الماعز الذي عرف حريته أخيرًا. وكذلك الدجاج، بعد أن أصبح الباب الداخلي لا يُغلق ليلًا أو نهارًا، وأصبح بوسع الماعز أن تختار بين الظل والشمس}.
فضلًا عن أن الشقة في جاردن سيتي، رغم أنها من أفضل الأماكن – رقيًا – في العاصمة، فإن السرايا بلا أسوار، أي إنها مفتوحة. أي انتقاله من الحبس إلى الحرية والبراح. ولذلك نرى «سامي» وقد أصبح مبتسمًا، حتى لفتت ابتسامته الآخرين.
لتأتي المواجهة الأكبر، التي – في تصوري – لم تُكتب الرواية إلا لتوضيحها، وهي تلك المشكلات التي واجهته عندما ذهب إلى «السرايا»، والتي بدأت بمحاولة أبناء «ناجي» – ابني شقيق «أم الغلام» – البحث عن ميراثهم، وأن «سامي» ما جاء إلا مغتصبًا لحقهم. وإن كانت قد باءت بالفشل، فظهر «أمين عسكر»، والذي أتصور أن الاسم مقصود من الكاتب؛ فلم يكن أمينًا، والإضافة إلى الاسم أيضًا لها مغزاها، إذ تفصل بين «سامي» وما يمثله من الماضي، و«أمين» وما يمثله من الحاضر.
حيث بدا «أمين» يمثل الإنسان الوصولي، إنسان الحاضر، والذي انتحل له وظيفة (مزيفة) ليسود بها بين الناس، ويمنحوه الاحترام، وهو يشتريه بأمواله. فقد بدأ «أمين» في شراء أرض الإخوة الثلاثة، والمجاورة للسرايا، وبدأ يقيم فيها أشياء مجهولة الحقيقة، ويضع مكبرات الصوت لإزعاج من بالسرايا، ويسرق أجزاء من أرض الجنينة، بدأت بالمدق. كل هذا بدفع الرشاوى للموظفين الذين يسهلون له الأمور، والتي وصلت إلى أعلى الرتب والموظفين. لنصبح هنا أمام مواجهة بين الماضي والحاضر، والتي انتهت بتغيير مكان الجلوس بالسرايا، وإغماض العين عما يجري بالجوار.
وتتحسن العلاقة بين «سامي» وأولاد ناجي – أخي «أم الغلام» – ويتبين منهم أنهم باعوا الأرض كلها لأمين، الذي منع أي أحد من الشراء إلا هو، حيث تبقى بضعة قراريط، ويصر على ألا يشتريها غيره، ليستمر في «تطفيش» سكان السرايا. وهنا تستقيم الحياة وتستمر.
عندما بدأ الكاتب روايته بـ(وكان شتاء)، توارد إلى الذهن مباشرة يناير 2011. فإذا كان هذا في البداية يحيلنا إلى يناير وما حدث فيها، فإن إنهاء الفصل الأخير بذات الجملة (وكان شتاء) يجعلنا ندرك أن الشتاء يغلف الرواية بأكملها، وهو ما يُدخل القارئ في أجواء الشتاء، بالكمون والخوف والترقب. غير أنه في النهاية يتغير الجو، حيث قارب يناير على الرحيل، والاستعداد لقدوم الربيع بما فيه:
{تسلل البرد اللذيذ، وصار كل شيء ممتعًا، الأكل والنوم والغزل… وعادت حبات الندى تظهر في الصباح على أوراق البرسيم وأوراق الشجر، وتلمع تحت أول شعاع شمس مثل حبات فضة} ص402.
الأمر الذي يوحي بتفتح الحياة، وكأن شيئًا لم يكن من تلك المنغصات التي واجهته، سواء على المستوى الشخصي، مثل موت الأم والأب والأخ، أو على المستوى الجمعي، مثل أولاد ناجي، أو «أمين عسكر»، أو الرشاوى التي تزكم الأنوف.
وإن كنت أتصور أن الكاتب أراد أن يقول إن الحياة تستمر، رغم وجود الخير والسماحة والطيبة، وبسمة «سامي»، وبين الشر (أبناء ناجي أولًا)، ثم الرشوة والعمل «الوسخ» ممثلًا في «أمين عسكر»، إلا أن حبكة الرواية – وإن لم يكن لي أن أقترح أن تكون الرواية مختلفة – وصولًا إلى غرضها، كان يمكن اختيار نهاية بين حالتين، حتى لا يستمر وجود «سامي» سليل الباشوات، وانطلاقًا مما ورد بالرواية نفسها من انتكاسة الثورة، أن تكون النهاية أحد خيارين:
إما أن يُجن «سامي» ويدخل مستشفى الأمراض العقلية بدلًا من صديقه والعامل عنده «سمعان»، وكان هذا – في تصوري – منطقيا مع شخصية «سامي» الإنسانية وظروف حياته السابقة، أو أن يعود إلى بيته في جاردن سيتي، ويقبع فيه مثلما بدأت الرواية. وهذا ينطبق مع ما آلت إليه ثورة 25 يناير وفق ما قالت الرواية، كما ينطبق مع طبيعة الإنسان المصري المسالم؛ فقد انتهت 25 يناير بالانتكاسة، وعاد كل شيء إلى ما كان عليه قبلها.
أما أن يظل «سامي» و«أمين» كلاهما موجودين، فهو ما لا يتفق مع ما آلت إليه الحياة؛ حيث تبدل وضع الباشوات، الذين انتُزعت منهم ألقابهم، بينما أصبح من يُنادى بها أشخاص آخرون.
كما صنع الكاتب تشابهًا – مقصودًا – بين كل من «سامي يعقوب» و«سامح» أو «حمادة». ففي حديث بين «سامي» و«حمادة» – العلاف – يقول حمادة بعد أن سمعا الكثير من الأغاني النوبية، التي يصر حمادة على تشغيلها:
{سامي: لا بد أن في النوبة سرًا يجعلكم تتمسكون بها إلى هذا الحد.
– لا أظن أنها كانت أجمل من هذه البساتين، يبدو أن التميز في أننا فقدناها} ص177.
ويأتي «سامي» على ذكر الاسم الجديد للنوبة، التي تلاشت تحت المياه بعد بناء السد العالي، فيرد «حمادة»:
– نصر النوبة، هل تأملت الاسم؟ بعد خمسين سنة من ترحيلنا إلى كوم أمبو، لم يزل الصعايدة يعتبروننا غرباء… أبي نفسه كان طفلًا وقت التهجير. لكن أين كنا نحن عندما خرج آدم من الجنة؟ هل نسيناه؟} ص178.
فكلا من «سامي» و«حمادة» يعيشان في الماضي. فقد عاش «حمادة» منعزلًا بين شرب الشاي والقهوة والبانجو، ويعيش في معزل عن الناس. وبعد مغادرته وجدوا في حجرته روايات لمعظم كتاب النوبة: محمد خليل قاسم، يحيى مختار، حجاج أدول، حسن نور، كما وجدوا أوراقًا تبين أنها بانجو، وكأن «حمادة» يحاول النسيان بها. لذا كان تعاطف «سامي» معه مبررًا، وهو ما تصوره «سامي» عندما هجر شقة جاردن سيتي، وأنه في السرايا سيكون بعيدًا عن المشاغبات والخوف الذي يعيشه في شقته.
وصنع الكاتب أيضًا تشابهًا بين «سامي» و«سمعان» المسيحي، الذي يشبه «سامي» في العطف، حتى إنه لا يأكل – تقريبًا – سوى الباذنجان، وكأنه نباتي، أي لا يقرب اللحوم. وهو الذي ضرب «أمين عسكر» بفرع شجرة على رأسه، وحُوِّل إلى مستشفى الأمراض العقلية لبحث مسؤوليته عما فعل، وكأن «سامي» هو الذي فعل هذا مع «أمين عسكر».
خاصة أن «سامي» عانى في بعض الفترات من العودة إلى الطفولة، التي تحلم بالكثير مما لا تستطيع تنفيذه في الواقع. فتقول «فريدة» لصديقتها عنه:
{ثم بدأ فتوره تجاهها، وعندما يستلقي بجوارها يشرع في مص أصابعه حتى يستغرق في النوم، ويكلم نفسه في الحلم} ص374.
الأمر الذي كان يوحي بنهاية غير النهاية التي جاءت في الرواية.
وعلامة أخرى استخدمها الكاتب للتأرجح بين الداخل والخارج؛ حيث نجد أنه بينما ينهمك في حديث مع آخر، نراه يغوص في أعماقه ليخرج مكنونها، وكأنه يضيء لمبة تكشف ما غمض من الوقائع، أو تكشف حقيقة هو وحده من يعلمها. وقد ساعده الناشر في تمييز مثل هذه العبارات بالبنط الأسود، الذي يميزها عن غيرها، أو أنه يحاور ذاته، الأمر الذي يجعله يعيش مع نفسه كثيرًا.
مثلما يربط بين الثورة – 25 يناير – وما يحدث في «السراب»، وبعد حلم رأى فيه «سامي» ميدان التحرير وما يجري فيه:
{إما أن تشرب الوحوش دمنا دفعة واحدة، أو يمتصه البعوض قطرة قطرة} ص373.
ففي داخل أعماق «سامي» يقول إن الإنسان – المصري – يعيش بين نارين: نار الميدان والجلوس في شقة جاردن سيتي، ونار العيش في السرايا.
وفي لحظة غيرةٍ، يهرب بها «سامي» من فريدة، معبّرًا عن غضبه:
{ليس أفدح من غضبها إلا رصاصة قنّاص تستقر بين عينيك} (ص260)،
وكأنه يستحضر الرصاصة التي استقرت في كتف أخيه في الميدان، وكأنها الخلاص من العذاب.
وحين أرسل رسالة عبر «واتساب» لحبيبته «فريدة»، وظهرت إشارة قراءة الرسالة، قال في نفسه:
{لو كان الرقم بحوزة غريب، لدفعه الفضول وسألك: من أنت؟} (ص111).
لم تأتِ هذه الإشارات عفوًا، بل جاءت لتعميق الرؤية حول شخصية سامي الانطوائية. فمن طبيعة الشخصية الانطوائية أن ما يختلج في داخلها يخرج تلقائيًا، أيًّا كان من تحدثه، فضلًا عن كونها كاشفة لما يكمن في أعماق بعض الشخوص، الذين يُفترض أنهم مطّلعون على الأمور.
ويتجلى ذلك في مقابلة «سامي» مع المأمور؛ حيث ذهب إليه، وعانى حتى دخل، ليجد الحجرة واسعة جدًا. وبعد عدة مكالمات، قال له المأمور:
– لا، أعذرني، لكنك سلسال… رجل دولة، تُقدّر ثقل المسؤوليات.
– أبي لم يكن رجل دولة.
– جدك؟
عاد المأمور بكرسيه إلى الوراء، وأخذ يتأمل ابتسامته، وبدت عليه الحيرة، ثم عاد إلى الأمام وقال:
– رجل الدولة رجل دولة، وأبوك كان مهندسًا مرموقًا، وربما كانت لديه مشاغل أضعاف ما لدى رجل دولة.
– كان مهندسًا حرًّا.
ضحك الرجل وقال:
– دعنا من «حرًّا» هذه يا سامي… كلمة «حر» تجلب المشاكل.
– أقصد أن أبي كان يعمل لحساب نفسه (ص344).
ولا يخفى ما تحمله كلمة «حرّ» هنا من دلالات، إذ تكشف عن ذهنية ترى في الاستقلال خطرًا، وفي الحرية شبهة.
وفي النهاية، تنكشف أفكار تلك الفئة التي لا تعرف سوى التبرير لما يدور، وكأنها تلخّص رؤية الرواية القائمة على المواجهة بين الحاضر والماضي القريب. يقول رئيس الموظفين لسعيد عبد الخالق (المحامي):
{أنا ابن المنطقة، وسمعت الحكايات عن طيبة سالم باشا يعقوب وكرمه. حكايات حافظ عليها الآباء كما حافظوا على الأرض التي أهداها إليهم، لكن الجيل الجديد لا يعرف كيف يحفظ الجميل} (ص369).
إلى جانب شخصية «سامي» التي نجد شبيهاتٍ لها في كثير من أعمال عزت القمحاوي، والتي تتسم بالتصالح مع الكون من حولها، تحضر الفانتازيا بقوة، لا سيما في هذه الرواية، حيث يُصهر الخيال بالواقع المعيش. وهو ما يؤكد اضطراب شخصية سامي وخلطه بين الواقع والتذكّر، بين ما هو قائم على الأرض وما ترسّب في الذاكرة.
ورغم علم القارئ بأن جميع هؤلاء قد سبقوا إلى الحياة الأخرى، فإن الكاتب يُدخله في دائرة الشك، عبر استحضار الأب والجد والأخ في مشاهد تتزامن مع تأزم البطل، فلا يعود القارئ قادرًا على التمييز: أهي حقيقة أم خيال؟ وهي إحدى الوسائل التي يدفع بها الكاتب قارئه إلى التفكير والتأمل، ليكون شريكًا لا متفرجًا.
ويتأكد هذا المنحى منذ بداية الرواية، في وصف حامل الرسالة، والعودة إلى الماضي عبر السراب:
{من ظهره بدا جلبابه باليًا، بمزقٍ في الطوق تحت القفا. وتراءى لسامي دمٌ يدفق من جرح في ذلك الموضع، لكنه لا يسيل على الجلباب، بل يتذبذب في مكانه، لا يفيض ولا يغيض} (ص7).
تشي هذه الصورة بالفانتازيا التي يفتتح بها عزت روايته، دالةً على عمق المعاناة التي يعيشها الفلاح، أو من هم بعيدون عن العاصمة، وكأنهم الهامش المنسي. فالدم موجود، لكنه لا يسيل؛ أي إن الصمت يجعله شبه غير موجود. فضلًا عن أن هذا الفتى «قد مات بالفعل»، وهو «الغلام» الذي كُنيت به من أعادت السرايا إلى أصحابها: «أم الغلام». وكأن الكاتب أراد منذ البداية أن ينبه القارئ: انتبه… نحن داخلون لعبة فانتازية، في أرض السراب، وفي تلّ المساخيط، عند بنزينة الأبطال.
لقد استطاع عزت القمحاوي أن يعيدنا إلى زمن الرواية الطويلة لمعالجة قضية حاضرة، متغلبًا على إشكالية الإطالة بالإيقاع السريع، وتعداد المثالب التي اعتورت المجتمع، في أحدث إصداراته «بخلاف ما سبق». وكأنه يقطف الثمار بعد ذهابه إلى جذر المشكلة التي عاشها المجتمع، والتي ما تزال حاضرة في الذاكرة والتاريخ المصري.
مستعينًا بإحضار الأموات من قبورهم ليدلوا بشهاداتهم، وبالأحلام التي تعبّر عن المكبوت في الصدور، بنى معمارًا من الشخصيات التي يسعى الكاتب إلى أن يكون المجتمع على شاكلتها، وفي مقدمتهم «سامي»؛ الطيب، المحب لكل الكائنات.
في مدينة من «السراب»، وفي موضع من «المساخيط»، يحيل القمحاوي الخيال إلى أرض الواقع، متسلحًا بمعارف جعلته يبدو خبيرًا بعلم الحيوان والزراعة، في رحلة ممتدة بين المتن والهامش، لبيان ما بينهما من فوارق وغياب. فكانت، في جوهرها، رحلة بحث عن «الإنسان»: كيف كان… وكيف أصبح.
………………………
[1] – عزت القمحاوى- بخلاف ما سبق- الدار المصريى اللبنانية -2025 ط2.
[2] – عزت القمحاوى – الدار المصرية اللبنانية – 2019.