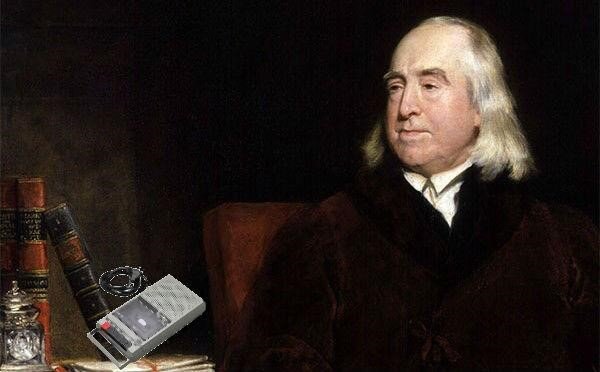أسامة كمال أبو زيد
كانت تؤمن أن الحياة والمقاومة والوطن خيطٌ واحد لا ينفصم، وأن القلب الذي يخفق للحياة هو نفسه القلب الذي ينهض لحماية الوطن. كانت إذا ضحكت صار العالم أجمل، وإذا خافت – إن خافت – انبعث في داخلها بريقٌ نادر يدفعها في جسارة إلى الأمام. بدت دائمًا كأنها ابنة لحظةٍ يلتقي فيها الملح بالنار، والبراءة بالشجاعة، والأنوثة بقوّة لا تظهر إلا حين يحتدم الخطر. وفي حضورها تشعر أن المقاومة ليست مجرد بندقية ومنشور، بل ضوءٌ يخرج من عيونٍ تعرف أن الوطن ليس شيئًا معلّقًا فوق الخرائط، بل هو البيت، والناس، ونسيم البحر، والذاكرة التي نحملها مثل عهدٍ قديم لا يبلى. وكانت ترى أن كل ما تحبه جزء من الوطن، وأن حماية هذا الحب فريضةُ عين وحقٌّ وواجب؛ لذلك صارت حياتها رسالةً واضحة صفحاتها تقول إن العطاء أشد بأسًا من الرصاص، وإن الروح حين تعشق الوطن وتقدّس الحياة تصبح قوة لا تلين ولا تُقهر.
في الخامسة عشرة من عمرها كانت زينب مقبلةً على الدنيا من بابٍ واسع، تذهب إلى مدرسة المعلّمات، تمارس الرياضة، ويتوق قلبها إلى أيام هادئة تشبه وعدًا بالطمأنينة، حتى جاء صباح التاسع والعشرين من أكتوبر سنة ست وخمسين. في ذلك اليوم انقلبت المدينة على صفحة النار؛ احترق حيّ المناخ، ودوى القصف، وتشقق الهواء حتى بدا كأنه يكتب قدرًا جديدًا على جدران بورسعيد. قبل ذلك بعامين، وفي ظل توتر السنوات السابقة على العدوان، تلقت زينب تدريبًا أوليًا على البندقية القديمة “الأنفيلد” التي كانت أثقل من ذراعها بقليل، لكنها أمسكتها كما يمسك المرء جزءًا من مصيره. تعلمت أن تثبّت كتفها، وأن تسمع الرصاصة في خيالها قبل أن تراها، وأن تلمس خشب السلاح بشعور يشبه عهدًا داخليًا بأنها إن وقفت يومًا أمام الخطر فلن ترتجف يدها.
وفي صباح العدوان استدعى النقيب مصطفى كمال الصياد أباها، الصول محمود الكفراوي، وطلب منه مجموعةً من الفتيات لمهام لا يثير وجودهن الشك. لم يتردد الأب لحظة، كأنه يسلّم ابنته إلى طريق اختار قلبها أن يسير فيه قبل أن تعيه: “بنتي موجودة… وهتلاقي بنات غيرها.” جمعت زينب ست فتيات من قلب المدينة وروح البحر: زينب أبو زيد، أفكار العوادلي، نجدة عبد الغفار، ليلى النجار، سلوى الحسيني، واعتماد عبد المحسن. بهن تكوّنت المجموعة العاشرة في المقاومة الشعبية؛ مجموعة تتحرك بخفة وذكاء تحت عين المحتل، وتعرف أن لكل خطوة ثمنًا، ولكل نبضة شجاعة أثرًا أبعد من صداها.

كان محل الملابس الرياضية قرب سينما ماجستيك مركزَ تسلّم المنشورات، يديره تاجر يوناني أحب المدينة حتى اندمج في ناسها. كانت الفتيات يأخذن المنشورات ثم ينتشرن في الشوارع يلصقنها على الجدران، كأنهن يكتبن بيانًا مفتوحًا باسم شعبٍ يرفض الانحناء. ومع اشتداد العدوان تطورت المهام إلى نقل السلاح من مخزنٍ في عزبة فاروق إلى رجال المقاومة. وفي مرةٍ حملت زينب بنادق وذخائر وقنابل في عربة أطفال، وضعت فوقها ابن شقيقتها الرضيع، وغطّت كل شيء ببطانية صغيرة، وسارت في شارع الروضة كأي أمّ لا تريد سوى عبور الطريق. استوقفتها دورية إنجليزية وسألها الضابط عن اسم الطفل. كان اسمه الحقيقي رؤوف، لكنها أجابت بثبات اتسع له الهواء من حولها: “اسمه جمال.” كان الاسم وحده، في تلك اللحظة، أشبه بطلقة في قلب المحتل، وأقوى من أي سلاح.
واستمرت زينب طوال تسعة أيام من الجحيم تقوم بما يوكل إليها دون تردد. مرة حملت قنابل على كتفها وقفزت فوق جدار لإنقاذ رجال كانوا على وشك الوقوع في الأسر، ومرة سارت وحدها في شارعٍ يخلو إلا من رائحة البارود، كأن الأرض تعرف خطواتها وتفتح لها الطريق. كانت شجاعتها هادئة، بلا خطب ولا ادعاء؛ شجاعةٌ تشبه يقين البحر بأنه يعود كل صباح مهما طال الليل.
ومع الوقت راحت تحكي تلك الأيام بروحٍ تتوهج كلما استعادت التفاصيل. كانت تزور المدارس، تخاطب الصغار، وتروي لهم كيف يمكن لفتاةٍ في الخامسة عشرة أن تقف أمام جيش بثبات قلبها، وكيف يمكن لحب الوطن أن يجعل اليد الضعيفة يدًا من نار. وفي عام ٢٠١٨، وبمبادرة من الدكتورة مايا مرسي، اجتمع رمزان من رموز النساء العربيات في المقاومة: زينب الكفراوي من بورسعيد الباسلة، وجميلة بوحيرد من بلد المليون شهيد؛ فكأن الوطن العربي أراد أن يلمّ بين جناحيه امرأتين صارتا درتين في عقد واحد، يلمع بالحياة والصلابة وحب الأرض.
ولم تكن بطولتها حكرًا عليها؛ فقد تركت في أبنائها امتدادًا إنسانيًا وروحيًا لما حملته.
فابنتها الدكتورة داليا حفني كانت تمثل امتدادها الأنثوي الأصدق؛ أخذت عنها حب الحياة، والدفاع عن كل جميل فيها، وأخذت عنها يقينًا راسخًا بأن لا فرق جوهريًا بين ذكر وأنثى، فالكل تحت سماء واحدة، والكل عند نداء الوطن يقفون صفًا واحدًا. هي أستاذة الموسيقى العاشقة لفنها، والرياضية التي ورثت عن أمها شغف الحركة والقدرة على تحدي الجسد. كانت زينب قد مارست خلال الخمسينيات والستينيات رياضات عدة: كرة اليد، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، وفي رحاب الرياضة تعرّفت على شريك حياتها، المهندس أحمد حفني. أما داليا فاختارت الكرة الطائرة، كأنها تحمل شعلة أمها وتضيف إليها خفة جناح لا يخبو.
وابنها الدكتور محمد حفني، أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة قناة السويس، حمل عنها جوهر رسالتها: أن مداواة الألم لونٌ من الدفاع عن الحياة، وأن إعادة الجسد إلى سلامه مقاومة ضد كل ما يكسر روح الإنسان.
لكن أكثر حكاياتها وجعًا كانت مع أصغر أبنائها، محمود، ذلك الفتى النادر الذكاء في عالم الكمبيوتر، الذي صعد سريعًا حتى تولّى إدارة هيئة المعونة الأمريكية في مصر، ثم رحل فجأة عام 2002 وهو في السادسة والعشرين، كأن عمره رحلة قصيرة مضيئة. منذ رحيله وضعت صورة كبيرة له على الحائط، صورة لم تغب عنها يومًا طوال ثمانية عشر عامًا؛ تبدأ صباحها بالوقوف أمامها، تحدثه كأنه في الغرفة المجاورة، وكأن الموت لم يستطع يومًا انتزاعه من قلبها. لم تتخلّف عن زيارة مقبرته أسبوعا واحدًا، تمضي إليه بخطى أمّ كانت قد أعدّت له كل تجهيزات الزواج قبل الرحيل المباغت، وظلّت تضع تلك الزيارة في قلب حياتها كما تضع الصلاة.
وحين رحلت زينب وهي في الثمانين شعر أهلها أن المدينة فقدت نافذتها المطلة على زمن العزة والكرامة؛ زمن كانت فيه فتاة صغيرة قادرة على أن تغيّر مجرى الحرب ببساطة قلبها. وقف زوجها المهندس أحمد حفني عند قبرها وقال: “النهارده فقدت أمي.” قالها بصدق رجلٍ عرف أن الحنان الذي عاش معه لم يكن عاديًا، وأن البيت بعد رحيلها فقد صوته الداخلي. أبناؤها أيضًا شعروا أن العالم صار أضيق، وأن وهجًا كان يشعّ في حضورها خبا وانطفأ.
خرجت جنازتها في هيئة تشبه قدرها؛ جنازة عسكرية بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وكانت آخر جنازة تمر قبل إغلاق المقابر بسبب الجائحة، حتى إن ابنتها كانت تزورها بصعوبة شديدة، بمعونة العاملين بالمقابر الذين أحبوا والدتها لأنها لم تتخل يومًا عن مساعدتهم ومساعدة عشرات غيرهم.
ولم يكن ذلك غريبًا؛ فامرأة مثل زينب الكفراوي حين تغيب تترك في الهواء فراغًا يشبه الضوء الغائب، كأنها كانت آخر شعلة من زمنٍ نادر؛ زمن يذكّرنا بأن امرأة واحدة تستطيع أن تكون وطنًا كاملًا، وأن تكون حياةً تمشي على قدمين، وأن تكون مقاومةً إذا اشتد الخطر.