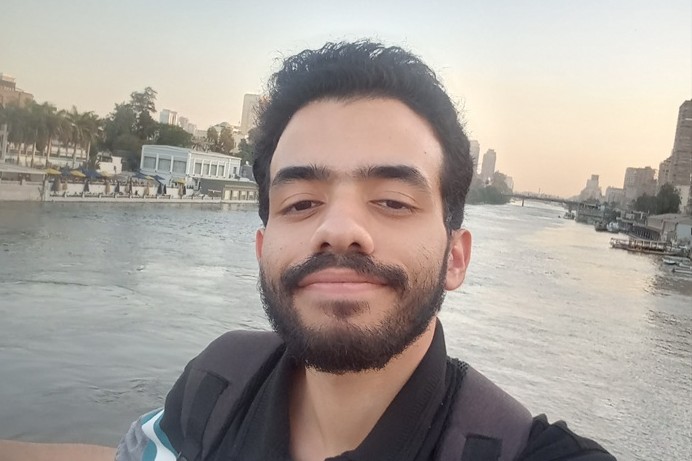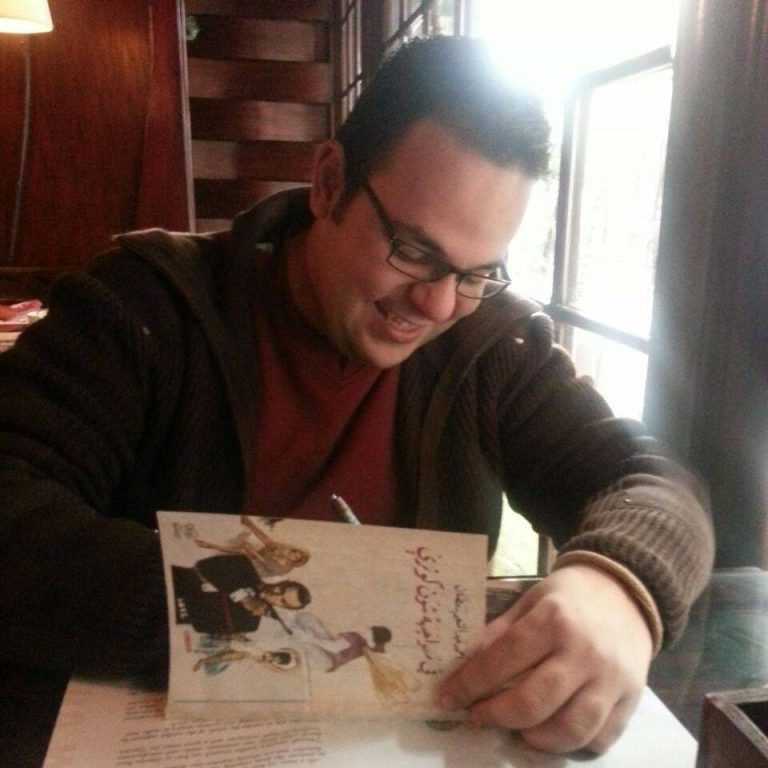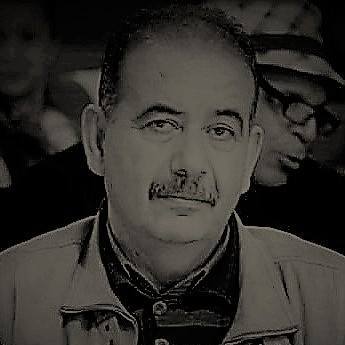أنكرَ الرّجلُ الصّوت، ثمّ تجاهله. ظنّه صوتاً من جوقة الأصوات التي تملأ رأسه بفوضاها من زمان، صوتاً يشذّ عن الجوقة المحبوسة، ويقفز إلى أذنيْه. لكنْ، مع الطّريق، غدا ذلك الصّوتُ صوتَ أحدهم، حقيقياً ينفذ عبر الفضاء بتكوينه النّغميّ الخاصّ، حاملاً نداءه المحكم الذي لا يمكن إنكاره، أو تجاهله، وهو يقذف بكتلته في أذني الرّجل، ويتغلغل بصداه في كيانه كلّه.
شَعَرَ الرجل إزاء من كان يناديه، ولا يراه بالرّهبة، ثمّ بالإشفاق، ثمّ بالانزعاج. كان جسده يختضّ ما أن يسمع صيحته، ومن دون إرادة منه كانت قدماه تتسمّران، ورقبته تلتوي إلى الوراء.
“صوت مَنْ هذا الذي يسعى ورائي ويُلحّ في طلبي، ولا أراه؟ ” سأل الرّجل نفسه… ومع كلّ التفاتةٍ مرهقة إلى الوراء للقبض على صاحب الصّوت، قبل أن يتبخّر في الهواء، ويختفي، حاول الرّجل، مراراً، وضع الصوت في صورة شخصٍ ممَنْ عرفهم في حياته، لكنّه لم يفلح في أيٍّ من محاولاته. وعبثاً توسّل مُناديَهُ أن يكفّ عن تعقّبه ومناداته، وأن يتركه لطريقه التي عليه أن يقطعها على قدميْه.
دخل الرّجل بعظامه، ولحمه، ظلماتِ ليالٍ لم يأبه لعديدها، وأضواءَ نهاراتٍ مثلها، وهو يدفعُ قدميْه، برفقة تابعه، الصّوت. نام ليستريح هنا، وهناك. وحتى في منامه سمع الصوت يخترقه مقلقاً كصوتِ نبيّ.
كم مرة أصيب الرّجلُ بالهلع من شعوره باختفاء الطّريق من تحت قدميْه، وبأنّه تجمّد في نقطة فراغ راكدة. كم مرّة شعرَ بالحاجة إلى أن يهبط بروحه إلى قدميْه، ليتأكّد من أنّهما ماتزالان تمسكانِ بالطّريق، وتأخذانِهِ إلى مداه الأبعد. وحيث كان نهارٌ من النهارات يتآكل، ثمّ يضمحلّ كانت أشباحُ الطّريق تنتفض، وتطير حائمة فوق رأس الماشي، وتكتب بفقاعاتٍ ملوّنة عبارةَ الاحتفاء التي لم يُقدَّر له أن يقرأها: “أهلاً بالقادم إلى مملكة الصّمت “.
فكّر الرّجلُ بمَنْ يعترضه، ويسألُهُ «مَنْ أنت »؟ وساعدتْه طريقه الطويلة على اختراع أجوبة عديدة، وجد فيها تسليةً تخفّف عنه أهوال متعقّبه المتواري. واختار بعد حيرة وتردّد أن يقول: إنّني جَذرٌ قديم رمى بنفسه على الطريق بعدما تملّص من التّراب”.
كانت الطّريق بالنسبة للرّجل، وذلك ما اعتنقه حقّاً، قدّ عُبِّدَتْ، وسُوّيَتْ، وشقّتْ سبيلَها في بريّة مترامية بأقدام مَنْ مشوا عليها وحدهم، أو برفقة أشباح الأصوات المتعقّبة. وهؤلاءِ، جميعاً، هل كانوا، مثلَهُ، جذوراً قديمة تملّصتْ من ترابها؟ لاحظ الرّجل أنّ نبرة صوت مَنْ يناديه كانت تتغيّر. تكتسي بلونٍ له وقعُهُ المميّز بتأثير شكل استجابته لها. كانت تلك النبرة تمتدّ وتطول، أو تنضغط، وتتلّقص. تلين، وتخفت، أو تتصلّب وتقوى. ترقّ وتعذُب، أو تحتدّ وتعنُف. وكان وراءها من يحملُ بشارة. تحذيراً. استغاثة. تهكماً.
أحياناً كان الرّجلُ يرى مادة الصّوت فوق رأسه في صورة طير بمنقار مرتجف، أو قطرة مطر منهارة، أو برق، أو مسدّس. لكنّ الصّوت بأيّ شكلٍ ظهر، كان لكائنٍ واحدٍ بعينه. هذا ما أكده الرّجلُ لنفسه. كائن عجز، تماماً، عن التعرّف عليه. جرّب الرّجلُ التشويش على الصّوت، ليقطعَ سبيلَه إلى أذنيْه، وليقول لصاحبه المجنون إنّه قادر على زحزحته عن طريقه متى أراد، فغنّى أغنيته الصّاخبة:
را را را.. ري ري ري.. رو رو رو
لكنّ صوت الكائن المجهول سرعان ما جاء خاطفاً مثلَ رصاصة فخرق الأغنية ملعلعاً، وقضى على حياتها. بعد ذلك وجد الرّجلُ أنّ عليه أنْ يتقبّل مصيبته مع هذا الصّائح اللّجوج المتواري. إنّها مشقّةً أخرى من مشاق الطريق التي يجب أن يتحمّلها كلّها حتى يبلغ هدفه. فلْيُطعْ هذا المتطفّل. ليستجبْ لصيحته. ليتوقّفْ عن المشي فور سماعها. ليستدِرْ إليها. لينظرْ صوبَها في المدى حيث توجد، ولا توجد. إنّه لَمن الشؤم ألاّ يفعل.
“إنّها أشباحُ الطّرق البعيدة ” فكّرَ الرّجل. “وعليَّ أن أحسن اللّعبَ معها ” ” المهمّ! ” وهذه نقطة أضافها إلى رصيده: “إنّني محظوظ. لا أحد يراني كالمخبول، يمشي أمتاراً، ويتوقّف جامداً، ويلتفت إلى الوراء” .
في الأيّام التالية كانت النهارات جافّة، وغالباً ما كانت ريحٌ مغبرّة تهبّ فيها. وعلى مدى تلك النهارات تسرّبتْ ذرّاتُ غبارٍ كثيفة إلى داخل أذني الرّجل، وتراكمتْ فيهما، وسدتْ فتحتيْهما تماماً. هل شعرَ الرّجل بأنّه غدا أصمّ؟ هل بوسع أحدٍ أن يراه وسط لفائف الغبار، فيؤكّد أنّه ما يزال يتوقّف عن المشي، ويستدير بجسده إلى الوراء، ويرمي ببصره بعيداً كلّما قطع أمتاراً من الطّريق؟ أين هو الآن؟ هل التهمَتْه الأغبرةُ الملتهبة؟ وهذا الصّوت الذي يناديني باسمي على الطّريق، هل هو صوتُه؟
2016