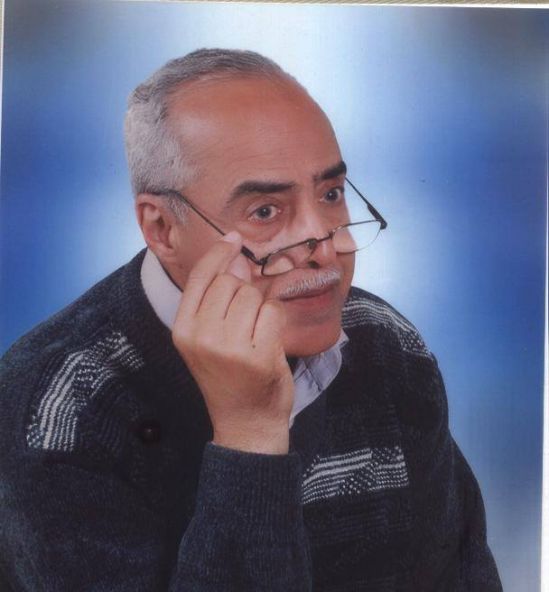أسامة كمال أبو زيد
تَفَزَّعَتْ حمامةٌ بيضاءْ
(كانت على تمثالِ نهضةِ مصرْ..
تَحْلُمُ في استِرخاءْ)
طارتْ, وحطَّتْ فوقَ قُبَّةِ الجامعةِ النُّحاسْ
لاهثةً, تلتقط الأَنفاسْ
وفجأةً: دندنتِ الساعة
……
باسمِ الزمنِ الذي لا يغربُ أبدًا …
حين عبرتُ بوابة جامعة القاهرة أول مرة، كنتُ فتىً غضّ الروح، يحمل قلبًا مبللًا بأحلام بريئة لم تعرف بعدُ ارتباك التفاصيل. كان الغروب ينسكب ذهبًا على الأشجار عند البوابة، والهواء العذب يلامس وجهي مثل نشيد جديد. شعرت أنني لا أعبر إلى حرم جامعي وحسب، بل إلى زمن آخر يفتح لي ذراعيه. توقفت مشدوهاً عند تمثال الفلاحة المصرية بجوار كلية الإعلام، تمد غصن الزيتون بيدها كأنها ترشدني إلى الطريق. عرفت أنها تقف هناك منذ مظاهرات 1935، يوم سقط الشهداء وهم يهتفون باسم الوطن. قرأت أسماءهم على الحجر كأنني أقرأ أسماء أصدقاء عابرين للممر نفسه: محمد عبد المجيد مرسي، علي طه عفيفي، عبد الحكم الجراحي. أحسست أن أرواحهم ما زالت تمشي معنا، تهمس في أذاننا بأن الحلم لا يموت.
كنت أبحث عن مقعد في مدرج، حتى وجدتني في مدينة ٧٨، أعرق مدرجات كلية الآداب، مدرج له رائحة الخشب العتيق، مقاعده تحمل أثر آلاف الأجساد التي جلست قبلي، جدرانه تحفظ ضحكاتهم، حماسهم، دموعهم، كان صدى الأساتذة ينساب من المنصة إلى سقفٍ عالٍ يشبه سماءً مصغرة، وفي داخلي كنت أسمع أصواتًا أخرى: طه حسين وهو يفتح العيون على النور، سلامة موسى وقاسم أمين يزرعان أسئلة الحرية، نصر أبو زيد يجادل بشجاعة لا تخاف، كأن المدرج كله مدينة من الذاكرة، مدينة تعج بأطياف الطلاب، وكل واحد منهم يمد لي يده ويقول: أكمل.
في المكتبة المركزية جلست بين الرفوف العالية، الممرات صامتة والكتب تفتح أبوابها مثل كواكب صغيرة، كنت أرفع رأسي أحيانًا فأرى القبة من النافذة، لامعة كأمّ تحرس أبناءها، كنت أكتب أوراقي الصغيرة وأحلم أن الكلمات يمكن أن تفتح أبوابًا نحو غد أجمل، كنت أضحك مع أصدقائي في الطرقات ونختلف ونتجادل عن الحرية والحب والوطن، وكلما ارتفعت أصواتنا شعرت أن الجامعة لا تضيق بنا، بل تحتضننا كأنها تعرف أن هذا الصخب هو طريقتها في تخليد الأجيال.
كنت أشعر أنني أسير فوق طبقات من التاريخ، أن خطواتي تعيد صدى هتافات 1946 حين خرج الطلاب ضد الاستعمار، أنفاس 1968 المثقلة بالهزيمة، شعارات 1972 المنادية بالديمقراطية، دماء 1977 التي امتزجت برغيف الخبز، كل ذلك يتردد في الهواء ويذوب في دقات ساعة الجامعة، حتى بدا لي أن القبة ليست نحاسًا فقط بل رئة ضخمة تتنفس أحلام مصر كلها.
وحين عدت بعد غياب سنوات، وقفت أمام القبة طويلًا، بدت كما هي، ثابتة، براقة تحت الشمس، كأنها تقول لي إن الزمن يمر لكن الحلم لا يغرب، تذكرت رعشة قلبي الأولى في مدرج ٧٨، أصوات أصدقائي، رائحة الكتب القديمة، خفقات الخطى المرتبكة في الممرات، وأدركت أن القبة ليست بناءً بل ذاكرة، ليست حجرًا بل قلبًا نابضًا، وأن كل دقة من دقاتها القديمة ما زالت تتردد في داخلي حتى الآن، تذكرني أنني حين دخلت حرمها دخلت زمنًا أبديًا لا يغرب أبدًا.