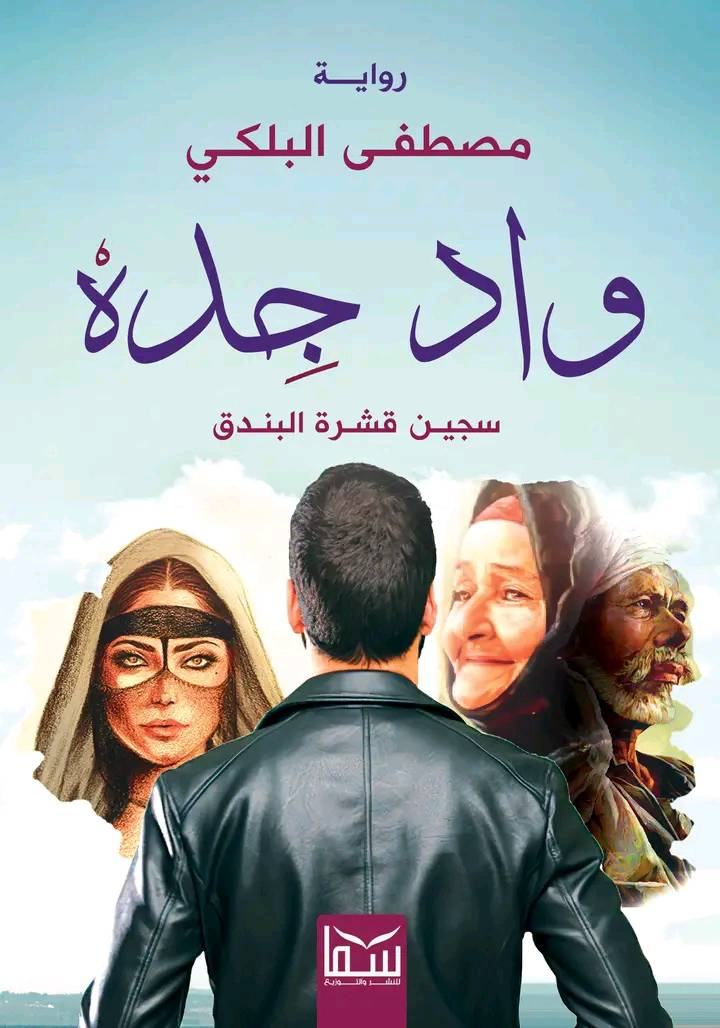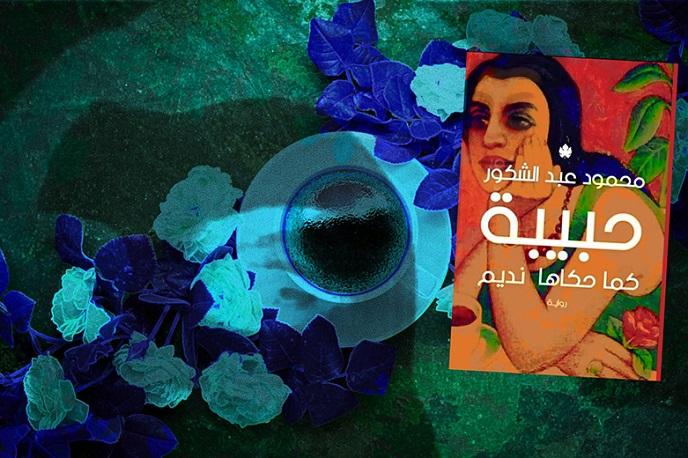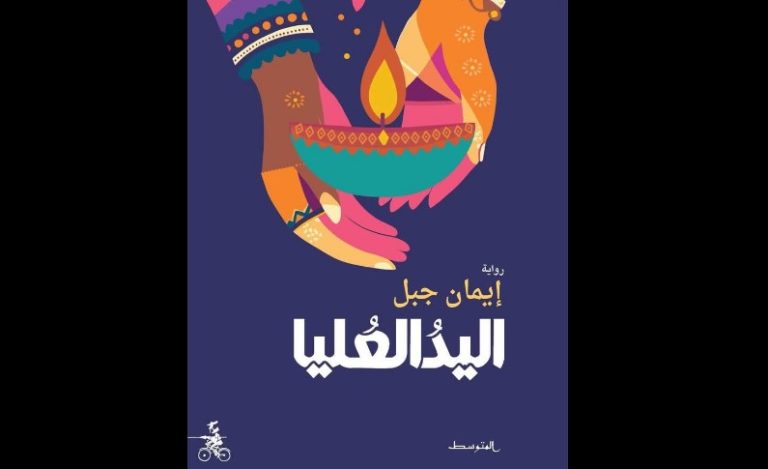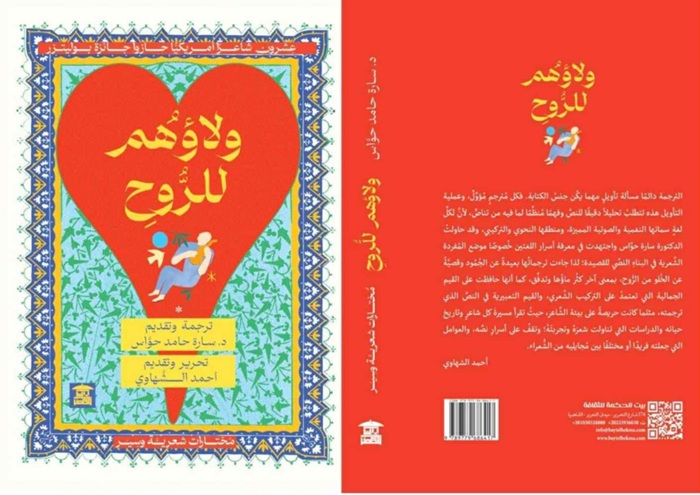ياسين رفاعية
ليس هناك أقسى على حامل من ان يكون رحمها هو قبر لجنينها. هذه المأساة عولجت أكثر من مرة في كل الآداب العربية والعالمية، لكن مي التلمساني تضيف عليها هواجس لا تشعر بها الا المرأة التي تريد أولاداً، وتريد أن تحمل إحساساً بأنوثتها وأمومتها أكثر من مرة، فالأولاد زينة الدنيا ولا شك.
“دنيا زاد” هو عنوان الرواية واسم الجنين المفقود طفلة لم تر الدنيا. وبالتأكيد ولادة الجنين ميتاً، لا يعني لهذا الجنين شيئاً، لكن يعني للأم عذابات تسعة أشهر من الانتظار وآلام المخاض وما بينهما من هواجس مخيفة ومن متاعب لا حصر لها.
هكذا من السطر الأول جاءت “دنيا زاد” الى الغرفة 401 للمرة الأولى والأخيرة: تودعني في اكفانها البيضاء الصغيرة. عدة لفات من الشاش النظيف. وثلاثة أربطة عند الرأس والقدمين وعند الخصر. وملاءة كبيرة تضاعف من حجم الجسد النحيل”.
هكذا خطف الحلم الذي استمر قوياً وحاضراً تسعة أشهر بلحظات، مما أشكل على الأم غير مصدقة أنه يمكن لهذا الواقع أن يصبح حلماً ثم يندثر بلحظات.
رواية ملزوزة بما لا يمكن تجاوز أي سطر منها حتى الرقم 86 صفحة، تكاد تشعر قارئها كما لو أنه يشهد المأساة منذ البداية، مما يدل على موهبة الكاتبة في استقطاب ما يحدث دقيقة بعد دقيقة من الابتعاد عن الحياة والاقتراب من الموت.
كلمة
الأم تروي، والأب يراقب ويروي على طريقته، تقول هي: كانت تحيا هناك على الرغم من كل شيء. بذلك الوجه الهادئ وذلك الرأس الذي امتنعت عنه الحياة (والذي سرعان ما تمحوه الذاكرة) كان منذ أيام قليلة فقط يندفع خارجاً من رحمي الى العالم الذي لم يكن تأهب لاستقباله. لم أقل سوى كلمة واحدة مقتضبة “كانت تشبهني”: ثلاث ممرضات يحطن بي وزوجي الذي لم يكن قد رأى وجهها من قبل ـ وكلمات رثاء بلا معنى، احداهن تربت على يدي، وربما أيضاً على جبيني، وندمت لانني لم أشعر بخروجهن، ولم انظر فيما بعد من النافذة، عاد زوجي الى الغرفة ثم تركني ورحل مع الجمع المزدحم خارج الأبواب. هذه المرة بكيت بصوت عال وقلت ـ كانت جميلة ـ لم استطع أن اسميها. كان اسمها خالياً من أي اشارة الى جسدها النحيل الراحل، والى رائحتها التي لم تزل تملأ فضاء الغرفة”.
وهكذا، كل شيء بالنسبة للطبيب والممرضات انتهى، وكل واحد منهم ذهب الى عمله، لكن الأم وحدها ظلت تحدق في كل شيء غير مصدقة أنها فقدت إبنتها التي كان من المفترض ان تسميها “دنيا زاد”.
يروي الزوج من جهته المشكلة الأكبر، شهادة المستشفى، شهادة الوفاة وعندما نظر الى الجنين نظرته الأخيرة يهمس: منحني الوجه الساكن طمأنينة لم أشعر بها طيلة اليومين الماضيين، في ضوء النيون الباهت، حملقت بضع ثوان أخرى قبل أن تسرع الممرضات بتغطية الوجه، حيث لن أراه مرة ثانية.
تبرز الكاتبة، في السياق، بل وفي تكرار ما عاشته تلك الساعات العصيبة مشكلة الموت التي لا نراها في الآخرين، بل ونحاول تجاهلها ولكنها عندما تمسنا شخصياً نشعر بقسوتها في فقد الأب أو الأم أو الابن أو الابنة. نراه عن قرب في تلك الوجوه الساكنة سكون الموت، نلمسه باليد، وندرك أن هذه الحياة التي تبدو لنا جميلة بحلوها ومرها، انما يقف خلفها هذا العملاق الرهيب الذي لا رحمة في قلبه، ويجتث الناس تباعاً دون أن يرف له جفن، في مواجهة الموت يفقد المرء حتى الايمان والدين والطقوس، لأنه يرفض هذا الموت الذي في النهاية حفرة على قد الجسد وتراب يهال علينا كما لو أننا لم نكن أبداً.
النسيان
لكن الأم هنا ترفض لابنتها “دنيا زاد” هذه النهاية، وترفض نسيانها، فهي اشترت لها قبل ولادتها ألعابها المتنوعة وملابسها الصغيرة وأرجوحتها وسريرها الصغير، وزينت غرفتها بكل ما يسعد الطفل ويحبه ويفتح عينيه عليه الى أول خطواته نحو الدنيا. فتبقى دنيا زاد، ليس في الذاكرة فحسب بل في البيت بكل تفاصيله، في الصحن الصغير والملعقة الصغيرة، في الدراجة الصغيرة والوسادة وكل ما يحيط بالبيت، صحيح أن للأم طفلها الأول، لكن حلمها ان تكون لها ابنة أيضاً اندثر في لحظة، لحظة الموت الذي لا يرحم أحداً، تلهو الأم المنكوبة بصور وأحاديث ومشاعر متنوعة كلها تصب في هذا الفقد الفاجع: “احتميت بفراشي من وجه أمي (أي الجدة) العابس.
واستغرقت في النوم دون أن أبدل ملابسي. وحين صحوت كانت آلام الجرح تلح علي. وأسئلة كثيرة متخبطة تومض في رأسي. ثم سرعان ما تنطفئ.
صحيح ان الموت أخذ دنيا زاد، لكنه لم يستطع أن يأخذها من ذاكرة الأم: مرت إذاً تسعة ايام، واليوم هو الخميس، لم يعد الاثنين يحمل حزنه الخاص. ولم يعد الخامس عشر من الشهر يخلف غصة في الحلق، لكني لا زلت أبكي”.
وفي الحقيقة: ليس من السهل أن تخرج من مأزق التفكير اليومي في الموت دون ان تفقد بضع ذرات من وجودك الملموس.. قد تتساقط خصلات شعرك في هدوء الأيام التالية. وقد تظل في الليل مفتوح العينين على الأرق. وقد تقضم اظافرك عن آخرها وأنت تقرأ جريدة الصباح. وربما أيضاً تفقد شهيتك للطعام وتفقد معها بضع كيلوغرامات زائدة. وتضع نظارة طبية للمرة الأولى في حياتك” الخ: وتذكر انك لا زلت تحيا (ص 50).
اذ أصبح هاجس الموت الذي لم تكن تفكر به من قبل أبداً، يقض مضجع الأم صباح مساء، فها هي دنيا زاد رحلت ولم تترك ولو ذكرى يوم واحد سوى ذكرى موتها. فعندما يسألها صديق للعائلة: هل التأم الجرح ـ فدنيا زاد خرجت بعملية جراحية قيصرية ـ وتخاطب نفسها: لم أعرف عن أيهما يسأل.. قلت نعم. وأكد الطبيب أيضاً أني استطيع انجاب اطفال آخرين. لا يموتون ربما! ألم يلتئم الجرح؟ ومع ذلك فإن “دنيا زاد” لا تغادر المكان انها: تنام الآن الى جواري هادئة وادعة، يبتسم ثغرها الوردي وتبدو في انفراج الشفتين سن واحدة صغيرة بيضاء. ابتسم لأنها بدأت مرحلة التسنين ـ هكذا تتخيل الأم كما لو كانت دنيا زاد تكبر ـ وأفرح لها لأنها لا تبخل علي من حين الى آخر بابتسامة.
… آخر
وتعود الأم لتحلم بجنين آخر من جديد: “يتكور بطني قليلاً لا بد أن طفلاً مني يرقد الآن في تجويف الرحم، ليس له فم بعد وليست له أطراف حقيقية. بعد قليل أباهي الجيران بملابسه الداخلية الناصعة حين أعرضها على الصفوف الأولى من الحبال. ولا أهرب من “أم هاني” الى الشرفة صباح كل اثنين، بل أقبع الى جواره في غرفته المشمسة دوما وأداعب أنفه الكبير ويديه الناعمتين” وتتسلل يد الأم الى بطنها حين يتسلل النوم الى ملامح وجهها فيبسطها. وتحلم بأيام مشمسة: هل يولد هذا الطفل أيضاً؟ أتكون الغرفة 401 (حيث ولدت دنيا زاد) أيكون الوقت عصراً؟ ص 61.
مع تقدم الزمن تصبح ذكرى دنيا زاد باهتة، بل يخيل للأم انها تنساها رويداً رويداً، ويطفر حنانها كله لابنها البكر شهاب الدين، الذي أصبح طالباً مجدّاً في المدرسة، وأصبح يروي لأمه اعجابه وحبه لرفيقة مدرسته سلمى “حب من النظرة الأولى ولا بد رآها في حلم ما أو تصور وجهها حلماً. شهاب الدين يحب سلمى دون ان يعرف” ص 64.
وتتلون حياة الأم بأحداث جديدة، تلد أولاداً أخر. ولكن دنيا زاد لا تغادر فتختم الكاتبة روايتها القصيرة (ست وثمانون صفحة من القطع الصغير): هذه خاتمة تليق بلحظة حداد متأخرة، اكتب “دنيا زاد” وأستعين على حروفها بالنسيان. تعلق وجهها المستدير وعينيها المسدلتين فوق رأسي. وتبدأ في الدوران في فلك معلوم، يمنحها الخسوف توهجاً بين الحين والحين. وأعود معها طفلة بلا ضفائر. تدور فترسم حدوداً لما قبلها وما بعدها وما عداها افلاك تتخبط فيها وجوه أخرى قبل ان تنتظم في دورانها المرسوم. لحظة حداد أخيرة، لكل هؤلاء الذين سقطوا في بئر التحول.. وماتوا”.
وكما قال الدكتور علي الراعي في رأيه بهذه الرواية: كل تلك العذوبة، كل هذا الشجن، كل هذا الشعر والقدر من التحكم في مادة الرواية، هذه المقومات تجعل من “دنيا زاد” علامة مضيئة في الرواية العربية، وفي أدب المرأة على وجه خاص. اذ لم تستطع هذه الأم الحنون ان تهرب من أمومتها مهما انجبت من أولاد، فإن يموت جنين على هذه الصورة المأساوية سيترك ندباً في قلب الأم من الصعب أن ينسى.
ولا بد من الاشارة أن هذه الرواية عندما ترجمت الى الفرنسية فازت بجائزة (آرت مار) في باريس، كما انها فازت بجائزة الدولة التشجيعية لأدب السيرة الذاتية في مصر.
لغة الكلام ولغة الأفكار في “واد جده.. سجين قشرة البندق” لـمصطفى البلكي
أمل رفعت جاءت قراءتي للنص...