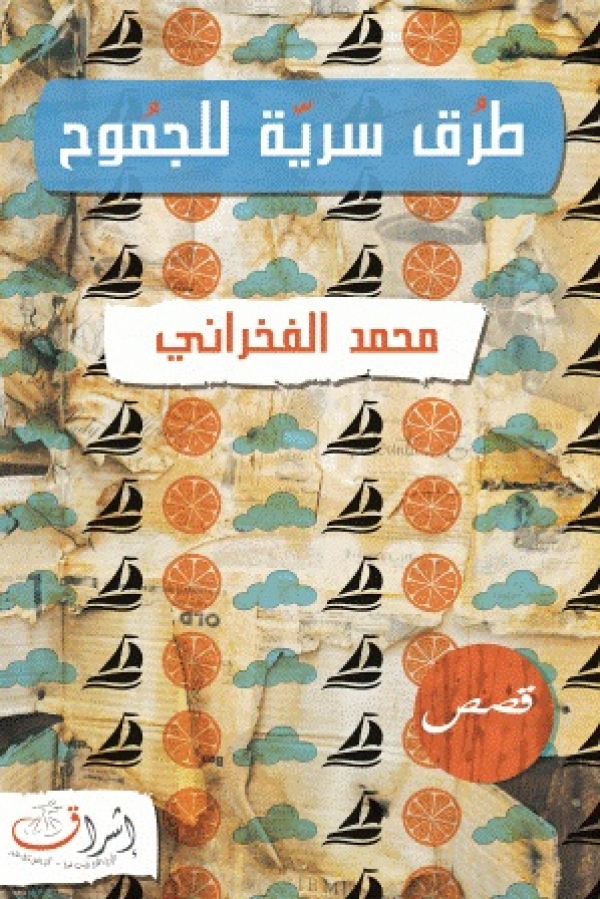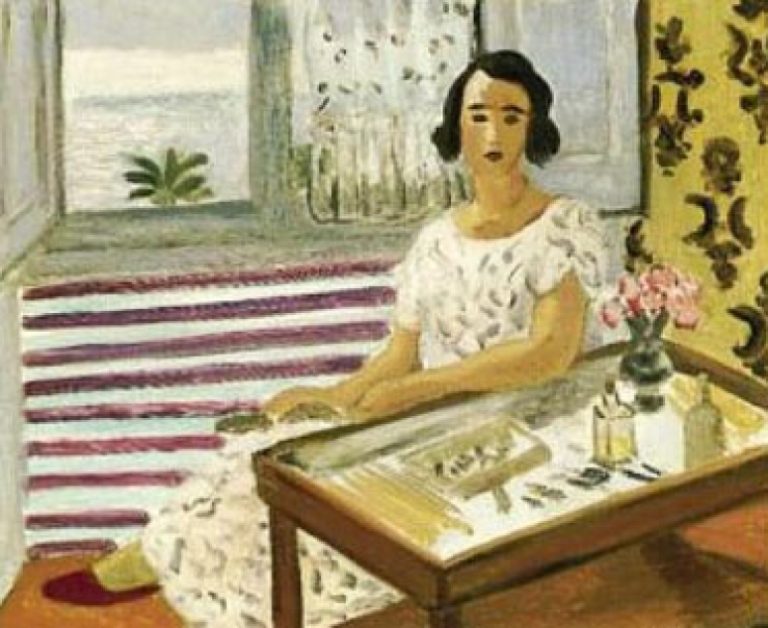د. مصطفى عطية
(1)
ليلة النصف من شهر شعبان، انطلقنا إلى ” المولد ” حول جامع الروبي، غصنا في الزحام، أمسكت جلباب أخي الذي تقدّمني، علينا أن نستمتع في هذه الليلة، فالماء المثلج مجانا، يوزعه السقّا وهو يردد : ” اشرب وصلّ على النبي، حلوة الصلاة على النبي “، أتجرع عدة أكواب تبرّد جوفي بعد لعب طويل في المراجيح الحديدية، وألعاب ” الزقازيق ” القلابة الخشبية، ثم أعدو إلى موزعي سندويشات الأرز واللحم، أنال واحدا، وأنسلّ وسط الزحام، ولا أنسى – كعادتي – شراء كيس كبير من الحمّص، سأطحن حبّاته مستمتعا بمذاقه.
ساحة جامع الروبي تمتلئ بأتباع الطرق الصوفية، تمايل وإنشاد وطعام، لافتات معلقة تعلن عن أسماء أصحاب الطرق : الشاذلية، الحامدية، الحسينية، القادرية الأحمدية، الهاشمية…، أمرّ بين خيامها، كلها من الريف، نسوة يرتدين “الملَس “، ورجال يتلفعن الملافع، وقد تهدلت أكمام جلابيبهم الواسعة مع اشتداد تمايلهم. سيمتد السهر الليلة، وستصل إلى بيوتنا أصواتُ المنشدين والتواشيح، ثم بكاء فصراخ، علّق أخي :
– رأيت بعضهم مع زجاجات العرَقي خلف المسجد.
علينا أن نعود إلى بيوتنا، قبل السهرة، التي ستنتهي حتما بسقوط كثيرين على الأرض صرعى الوجد كما يقولون، وعند الظهيرة سيظلون مستلقين في خيامهم، يتجاور النسوة و الرجال في نومهم.
(2)
هذه حارتنا، على ناصيتها بضعة خيام للصوفية، وإن نجا آخرها، حيث يقبع بيتنا. وصلنا البيت، الشباب مجتمعون أمامه، لاشك أنهم يتباحثون في زينة رمضان، ولابد أنهم سيرفعون التكلفة، لتزيد مساهمات البيوت فيها، ولن يهتموا باعتراضات الناس عن قلة حبال الزينة المعلّقة.
دوري كان دائما ينحصر في حمل الأوراق البيضاء المقصوصة وقد تلوّنت بـ ” البَفتة ” ؛ ودُهن طرفها بنشا لاصق مصنوع من عجين الدقيق والماء الساخن، ثم أعطيها لمن يلصقها على حبل الزينة، وعليّ أن أسند السلّم الخشبي، عند تثبيت الحبال بين جدران البيوت، وستستأثر بيوت هؤلاء الشباب بتعليق الفانوس الكبير والمسجد الصغير أمامها، تتلألأ في ليل رمضان، وتظل الظلمة أمام بيوتنا إلا أنوار البلدية الصفراء.
اجتمعنا، أنا وأخي وحمدي، وطارق وعصام وعماد، وقررنا للشباب:
- سنزيّن أمام بيوتنا نحن، ولن ندفع شيئا.
سخروا، وضحكوا وهم يشيرون إلى قِصِرنا الذي سيمنعنا من تعليق الحبال. رددنا بإصرار : ستحكي كل الحارة عن زينتنا.
*******
اجتهدنا مفكرين، أنا وأخي وحمدي، المبلغ قليل، اختلفنا في أشكال الزينة، حتى قطع أخي بالرأي :
- نشتري فانوسا ونعلّقه وسط الحارة، ونضيء مصباحه بتوصيلة من بيت حمدي.
تشبثت بحبال الزينة، فأصروا أن الفانوس يغني عنها، إلا أنني انطلقت إلى سطح بيتنا مع الولد ” محمد “، وأحضرت كتب المدرسة القديمة، ومقصا، وألوان البفتة، قصصتُها ولوّنتها وثبّتها في خيوط، واتجهت نحو شرفة بيتنا، حيث مددت يدي بين حديدها، ثم علّقت الحبال على نصف دائرة، ورحت أتأملها، وأحدّث الولد محمد عن جمالها، وأنني سأباهي بها كل عيال الحارة فقد صنعتها وحدي. ظللت باقي اليوم واقفا، أنظر لما فعلتُ، وسط ابتسامات من أبي وأمي وإخوتي..، لم أفهمها، مثلما لم أبادلهم إياها.
*******
لم نصدّق ما فعل الثلاثة ؛ طارق وعصام وعماد، لقد صنعوا حبال زينة طويلة جدا، واستطاعوا تثبيتها في أعلى نقطة في بيوتهم المتقابلة في الحارة، وعلّقوا جامعا صغيرا شديد الإضاءة وسط الزينة، جذبت نظر الجالس على المصاطب، والواقف في الشرفات، والماشي في الحارة، فيتمتمون متعجبين من ارتفاعها العالي. وحينما سألناهم عن كيفية رفعها بهذا العلو، نفخوا صدورهم قائلين :
- سر اللعبة، وستظل زينتنا إلى رمضان بعد القادم.
(3)
قبل أيام من انتهاء شهر شعبان، وانفضاض زحامه، ورحيل أهل الطرق إلى بلداتهم، بدأ باعة حلوى المولد والعرائس يفكّون خيامهم وأكشاكهم وصواوينهم، ومعهم كانت ” سنية ” أم عبد النبي ( بائعة الكشري )، في نفس موضعها التي تقف فيه عربتها، تحوّله إلى صيوان كبير، تبيع فيها حلوى المولد بمعاونة زوجها العابس، وابنها عبده، وتصمم أن تركن عربة الكشري الخاوية من حلل الأرز والمكرونة في أقصى الخيمة، ومع قدوم رمضان، تفرغ “صيوانها ” من بقايا الحلوى والعرائس المكسرة، بتوزيعها على عيال الحي، متجاهلة مطالب زوجها أن تبقيها كي يرجعها للمصنع ويقبض ثمنها.
تحضر عربة “كارو” محملة بطوب أحمر، فيقوم عمال ببناء فرن الكنافة البلدي دائري الشكل، وقد احتلّ نصف مساحة الصيوان، أما فرن القطايف، فقد انزوى في ركن صغير.
سيتم توزيع العمل بينهم، أبو العبد زوجها لعمل الكنافة، يقف عاري الصدر يقطّر العجين السائل على الأسطوانة النحاسية أعلى الفرن، ويتولى عبد النبي عمل القطايف، أما أم العبد فهي تصنع العجين في الليل، وفي الصباح تعدّ الزبادي المسكّر في السلطانيات.
وعليها أن تصمّ أذنيها عن شتائم زوجها وزوبعاته التي تشتد مع اشتداد الحر والصيام، وهو غير عابئ بكلام ابنه الذي يؤكد له أن لا صيام مع سبابه، ولا يملك أبو العبد إلا إلقاء ما تبقى من ” كوز ” العجين في وجه ابنه، الذي يتنحى مؤثرا السلامة.
(4)
شعر رأسي يتنازعه البياض، والعمر يتقدّم..، بعدما تناءت بي الأمكنة.
غدوت ليلة النصف من شعبان إلى الجامع الروبي، خيام متناثرة في ساحة المسجد، أسفلها وجوه مغضنة التجاعيد، تتشبث بالحضور سنويا، متجاهلة ذوي اللحى الذين يمرّون عليهم، ساخرين من بدع التمايل والصراخ، وارتفعت بعض التواشيح الدينية بصوت رجل أنهكه الهِرم.
هذه حارتنا، أتطلع إلى نافذة بيتنا، أتذكر ضاحكا : كيف أن الزينة التي صنعتها وعلقتها لم يلتفت إليها أحد في الشارع، وضحك الأولاد وهم يرفعون عيونهم وقد غطوها بكفوفهم من شمس يوليو الحارة، لعلهم يرون حبالي المدلاة على جدار الشرفة، وقد غطّتها حبال الغسيل، أما زينة الثلاثي طارق وعماد وعصام فقد ظلّت عاما كاملا، متحدية عصف الريح، وإن ذبلت ألوانها، وجفت أوراقها، بحكم الشمس والمطر، وقد علمت بعدئذ أن آباءهم ساعدوهم في تعليقها، حتى أغاظت الشباب، وجعلتهم ينزوون خجلا.
تلاشت صواوين الكنافة البلدي، واكتفى عبد النبي في محل الكشري المطل على ساحة الروبي بنصب فرن آلي لعمل الكنافة، رفيعة الشعر.
********
لففت الحي كله، علّني أجد فانوسا خشبيا، يتوسط الحارات، ينفح ظلامها أضواء ملونة، تتألق مع حبال الزينة، أو أحصل على حمص يشبعني، أوكنافة بلدي ثخينة الشعر، تملأ رائحة حشوها فناء بيتنا.