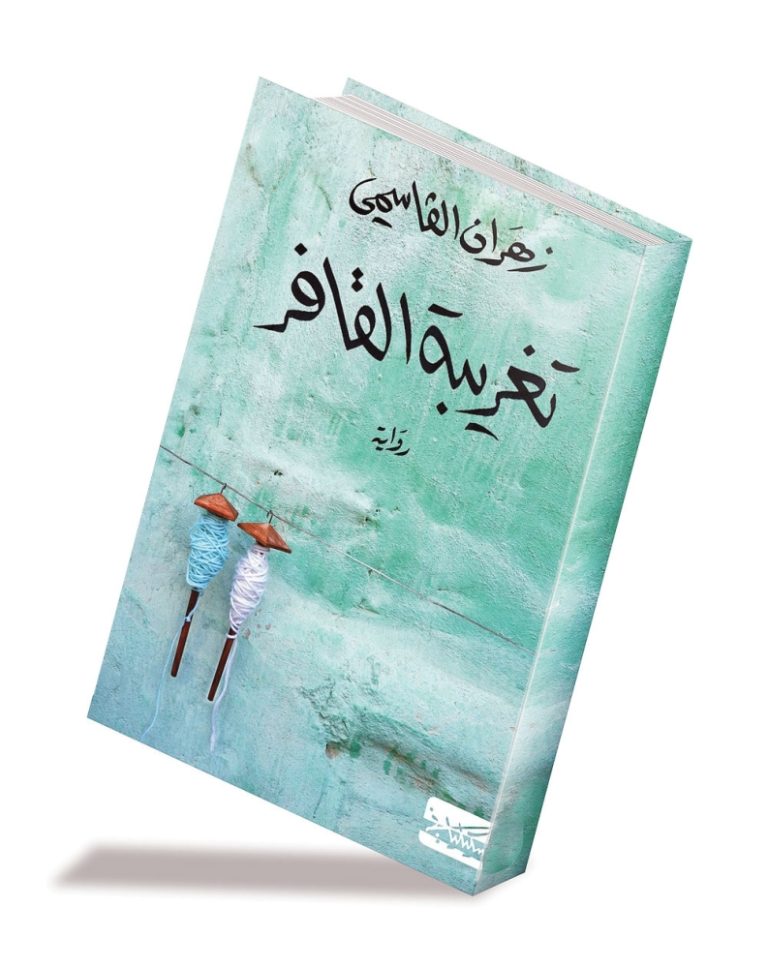د. مصطفى عطية جمعة
ربما يكون المفهوم المبسط لمصطلح ” تيار الوعي “، هو المفهوم الذي قدمته ” فرجينيا وولف ” في مؤلفها الشهير “القارئ العادي”، حيث لمسنا تحديدًا للمصطلح بشكل مبسط، صاغته مترجمة الكتاب بقولها: “إنه أسلوب التسلسل العفوي”، وحددته أكثر بـ ” أنه أسلوب الشيء بالشيء يُذكر “([1])وهو في ظاهره مبسط، ولكنه ينطوي على جوهر هذا الأسلوب الفني، الذي أضحى من سمات القصص بخاصة، والفن بشكل عام في القرن العشرين. فعندما يذكر أحد الأمور، فإن العقل سرعان ما يتداعى إليه – بشكل عفوي – ما يتصل بهذا الأمر، سواء مما يحبه الفرد أو ما يكرهه. وفي تلك اللحظة، فإن قرار الفرد أو سلوكه سيتحدد بناء على تلك الخلفية المتداعية. وقد يكون الأمر جديدًا عليه، وحينئذ تتوزعه أيضًا مجموعة من المشاعر التي تتباين بين الرغبة في المعرفة والخوف من الجديد.
وهذا لا شيء فيه على صعيد الواقع الإنساني المعتاد منذ فجر الخليقة، فما الجدل – إذن – إزاء ذلك المصطلح؟ مشروعية السؤال تأتت من المعرفة المبسطة السابقة، ولكن على مستوى الفن القصصي – بخاصة – كان الأمر جد مختلف. فالقص موضوعه منذ الأزل علاقة الإنسان مع أخيه، أو مع الطبيعة. وتلك العلاقة لم تكن مجرد سلوكيات، بل سبقتها دوافع ونوازع متعددة، ترسبت في داخل الإنسان، وحركت توجهاته. إلا أن القص كان يتوقف عند الوصف السلوكي الظاهري والتركيز على البعد الاجتماعي أو الظاهري في المسألة دون التعمق فيه. وبقي الإنسان – كنفس ونزوع – في عزلة عن السياق القصصي. فالقاص يعرض النتيجة دون ذكر العمق النفسي الذي يكمن وراءها. ولكن مع اقتراب أو انكفاء الإنسان على ذاته في عصر الثورة الصناعية، حيث كان القلق والخوف والإحساس بالتلاشي يسيطر عليه، أمام جبروت المدنية بمصانعها ومداخنها، بدأ يتأمل تلك النفس التي يحتويها جسده. ومن ثم كانت مكتشفات ” فرويد ” حول العقد الغريزية واللاوعي التي تحرّك الكثير من السلوكيات الظاهرة للفرد. ومحاولات “برجسون” لدراسة وشرح كل ما هو صادر عن الشعور. وثبت الأمر أكثر في دراسات ” ليفي برول ” وكشفه عن عقلية ما قبل المنطق عند الفطريين أو الإنسان البدائي ([2]). فكان ذلك فرجة لدراسة النفس وقراءة السلوك بطريقة مختلفة، حاولت أن تتوازى مع العلم المعاصر الذي انصب على الطبيعة يتحداها ويصارعها، ولم يستطع أن يكتشف إلا النذر القليل من نفس هذا الكائن الآدمي، الذي يريد مجابهة الكون. ومن هنا كانت محاولات ” جيمس جويس “، هذا الأديب القلق في حياته، المتمرد على كل ما يحيطه، والذي أدار السجال حول نزعاته وشبقاته، مثلما فجره بأعماله القصصية، فكانت أعماله نماذج مصغرة لواقعه المعاش، وبعضها كان تصويرًا لكل نزعاته المتقلبة. أي أنه راح يقرأ ذاته بطريقة تختلف عن القصاصين السابقين، وهذا هو سر تفرده، منذ روايته ” صورة للفنان كشاب ” 1916، ثم ” الفينيقيون يستيقظون ” 1939، وأخيرًا ” عوليس ” التي حوت قمة رؤاه الفنية وتمرده. لقد أراد أن يكتب رواية تصور الحياة المدركة وغير المدركة ([3]). والأولى تعني السلوك الظاهري الذي يحكمه الزمان والمكان والمادة، أما الثانية فهي الخلفيات والنوازع – الواعية وغير الواعية – التي تكمن وراء هذا. وبالتالي كان الأمر يُعَد فتحًا على مستوى القص، فهناك تجارب وحالات نفسية لا نستطيع التعبير عنها، وحتى اللغة ذاتها لا تملك مصطلحات نقلها، وهناك لحظات بين اليقظة والنوم، والوعي والجنون، كلها تحرّك السلوك ([4])وتلك هي الثورة التي فجرها ” جويس”، وأجاد بناء قواعدها في قصصه، فكان النحت وإيلاج كلمات جديدة من لغات عدة ([5])، وكان التعامل مع الأسطوري والشاذ والتراكمي. وفي الوقت الذي قد نخجل من طرحها وتسييلها على الورق، فكان لابد من مجابهة الأديب لذاته، كما يجابه الفيزيائي الكون، وإن كان البعض، توقف عند أطروحات ” جويس ” وتفجيره لللذات الجنسية بصراحة تصل لحد التنفير، وتتبع كل ما هو غير مألوف في العلاقات الجنسية، فكانت النظرة المضادة له تنبع من الجانب الخلقي، وهي تمتلك الكثير من المشروعية، فلا الجنس هو المحرّك الغريزي الأوحد – كما يرى فرويد -، ولا الحياة الإنسانية تتوقف عند الأعضاء الوسطى من الجسد، وليس التحرر الحقيقي، عندما يصبح إشباعها هو نهاية الأرب. فالقيم والمباديء والمثل لها أيضًا لذتها، فكما تجنح النفس للشهوة الحسية، تجنح أيضًا للفضيلة اللاحسية. وهذا هو سبب الاختلاف مع ” جويس “، بجانب الأسباب الفنية الأخرى، المتمثلة في كسر المألوف من الحكي القصصي واللغوي. وفي هذا يكون للفن والنقد كلمتهما التي لها الكثير من المشروعية أيضًا.
كما وجدنا – أيضًا – تقنيات القص التي مزجت المونتاج السينمائي ([6])، لا باعتباره من الحيل الإبداعية، بل باعتباره عملية نفسية ذاتية في المقام الأول، فكل منّا يخضع ما يدور من أمور حوله إلى رؤية نفسه، فيرى الأشخاص وفق زمانه ومكانه وبيئته وأيضًا أسطورته وفهمه لدينه ولخالقه. وحركات الارتداد “الفلاش باك ” تتم في الوعي قبل أن تنقلها الكاميرات السينمائية. فـ” جويس ” يتأمل ويستبطن اختلاجات جوانحه “من خلال عمليات عديدة: صريحة ومضمرة، ذهنية ودافعية، مزاجية وإدراكية، انعكاسية وتراكمية، متروية ومتسرعة، بطيئة ومتلاحقة..” ([7]) كما يوظف علوم وثقافات عصره في إبداعه. وكان البناء الفني الذي قدمه في أعماله، لا يقوم على حبكة واضحة، بقدر ما يقوم على الفهم المتعدد للقص في العمل الأدبي، الذي لا يلين من القراءة الأولى، بل يتأتى من القراءات المتتالية.
وتبعًا لذلك، أصبح المفهوم الجديد للفن لا يقوم على تقديم الأمل ووصف انتصار الخير ضد الشر وإن كان هذا يحدث، بل سعى الفن إلى تقديم المزيد والدقيق عن الحالة والواقع الإنساني في لحظات الحكي، تقديمًا عميقًا دون تزييف ([8])، ويترك الأمر بعد ذلك للقاريء يستنتج ما يريد من خلال تجربته هو كقاريء. فتحول القاريء إلى مبدع إيجابي غير مسترخ. وهذا بالطبع كان يحدث على درجات عديدة في الآداب والدراميات السابقة، ولكنه أضحى مع رؤية المبدع المعاصر، من الأمور التي تصاحب المبدع في لحظات إبداعه، كما هي تصاحب القاريء في تلقيه.
فالفهم لذات الإنسان، لم يقف عند الذات المبدعة فقط، ولا عند تشريح شخوص القص، بل تعداه إلى إشراك المتلقي في النشاط الإبداعي ـ على اعتبار أن الإبداع لا يُفسَّر من ركن واحد، ولامن رؤية مسبقة، بل هو جزء من الفعل الإنساني الذي لا يخضع لدافع نفسي واحد أيضًا.
وبذلك صارت وظيفة الفن كما يقول ” أرنست فيشر “: ” فتح الأبواب المغلقة، لا ولوج الأبواب المفتوحة “، أي البحث عن المستغلق في أعماقنا ومكنوناتنا، وهذا ما دفع ” ماركيز ” إلى أن يؤكد عليه بقوله:” يجب دفع القص إلى أقصى حد، ليتجاوز كل واقع ” ([9]) والواقع هنا – كما أرى – كل رؤية لا تتعمق الظاهر والسلوك، وتكتفي برصده فقط.
ولذا نرى أن مصطلح ” تيار الوعي ” ليس دقيقًا ؛ فهو يقصر التداعي على ما يعن للعقل في لحظة وقوع الحدث، فلا المتداعي من الوعي يكون بوعي أو بمنطق من صاحبه الفرد، بل إن لحظة التداعي هي حرة في تكوينها، تتخطى مشاعر الحب و الكره، وتتآلف مع اللاوعي في تكوين الدافع والسلوك، وهذا ما وجدناه ونجده في الإبداع، حيث تتقاذف العقل والنفس عشرات من الأمور العقلية واللاعقلية، ومن هنا يكون مصطلح ” تيار التداعي ” أدق وأشمل، فهو يشتمل حركة وتماوج النفس بين الوعي واللاوعي، والعقلي والسلوكي.
أما عن الزمان، في هذه التقنية، فإننا نلحظ أن هناك زمنين، زمن الحدث الواقع، و” زمن التداعي “، فالأول هو كائن ثابت خاضع للمقياس العقلي البشري، نستطيع تسجيله ورصده والتحكم فيه، أما الثاني ” زمن التداعي ” فهو يتخطى كل المقاييس المنطقية، ليحلّق في الزمن المطلق، لأن الحدث المتداعي هو البطل، وهو الذي يجمع في تداعيه أشتاتًا من الطفولة والشباب والشيخوخة، بل ويجمع الأمنيات المستقبلية لصاحبه، كل هذا يتم في لحظات قد تكون دقائق – وفقًا للمقياس البشري – أو ساعات، ولكنه تمتد بامتداد العمر، بل وتتخطى هذا العمر البشري، حين يتداعى على العقل والنفس ما توارثه من أساطير وعادات وقيم وخرافات، وفي هذا، يكون الزمن ممتد عبر الرصيد الإنساني بكل ما عرف وترسب في أعماق الفرد.
ونفس الأمر يكون مع المكان، فهناك المكان الواقعي، الذي يكون الحدث الظاهر يحدث فيه، وهناك ” مكان التداعي “، وهو يشكل الخلفية المادية المكانية للأحداث المتداعية في النفس عند استثارتها بالحدث الخارجي، وقد نراه – في النفس – واضحًا بتفاصيله وموجوداته، أو غير واضح حينما يكون المتداعي من الأساطير أو الكوابيس أو المشاعر المحبة أو الكارهة.
إذن، يكون ” تيار التداعي ” ليس مطلقًا في كل الأحوال، فهناك تيار زماني متداعٍ مقيد، وهناك آخر مطلق، فالمقيد يكون مقيدًا باللحظة الزمانية الواقعية التي استدعته، مثلما أن يرى الفرد حدثًا لثورة، فيذكّره بكل ما اختزنه من الأحداث الثورية التي عاشها في حقبات من حياته، سواء اتفق أم اختلف إزاءها فهذا هو المقيد. في حين عندما يخلد الفرد نفسه إلى ذاته، تكون هناك الكثير من الأمور المتداعية، دون رابط موضوعي أو زماني محدد، وكما يحدث في النوم والأحلام، تترك النفس على سجيتها فيكون التداعي هنا مطلقًا دون قيد.
وينصرف الأمر بالتالي على المكان، وهو مصاحب للزمان والحدث، لأنه يمثّل الإطار المادي الذي يحتويهما، وقد يكون مقيدًا أو واضح المعالم والقسمات ( كما في الحدث الثوري السابق، حين يذكر الفرد ما رآه بعينيه من مظاهرات ومسيرات في أماكن بعينها ) أو يكون المكان غير واضح المعالم، بل هلاميًا.
وتتبقى الأشياء والجمادات في الحدث الواقعي، والحدث المتداعي، حيث نرى أن ثمة ترابطات بين الشيء الواقعي وهو مجرد جزء، قد يستدعي جزءًا آخر يشابهه من أعماق النفس، وقد يستعي أيضًا كلاً يشتمل هذا الجزء.
وفي نفس الوقت، فإن التحاور العقلاني يكون واردًا أيضًا لحظة التداعي، أي أن العقل يكون حاضرًا بأشكال مختلفة، سواء بعقد المقارنة بين الواقعي والمستدعى، أو بالانتقاء من الأمور المستدعاة، للربط بينها وبين الحدث الواقعي، أو إقامة حوارًا بين الرؤية المترسبة في العقل، وبين الحدث الواقعي.
………………..
( [1] ) فرجينيا وولف. القاريء العادي. ت / د. عقيلة رمضان. ص 4. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1971.
( [2] ) انظر. د. محمد غنيمي هلال. النقد الأدبي الحديث. ص 489. نهضة مصر للطبع والنشر. د. ت.
( [3] ) انظر. إيفور إيفانس. مجمل تاريخ الأدب الإنجليزي. ت / د. زاخر غبريال. ص 177. سلسلة الألف كتاب الثاني. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1996.
( [4] ) انظر، د. محمد غنيمي هلال. مرجع سابق. ص 488.
( [5] ) انظر. د. طه محمود طه. موسوعة جيمس جويس. ص 242، 243. دار القلم. بيروت. 1975.
( [6] ) انظر. المرجع السابق. ص 246.
( [7] ) د. شاكر عبد الحميد. الأسس النفسية للإبداع الأدبي. ص 17. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1992.