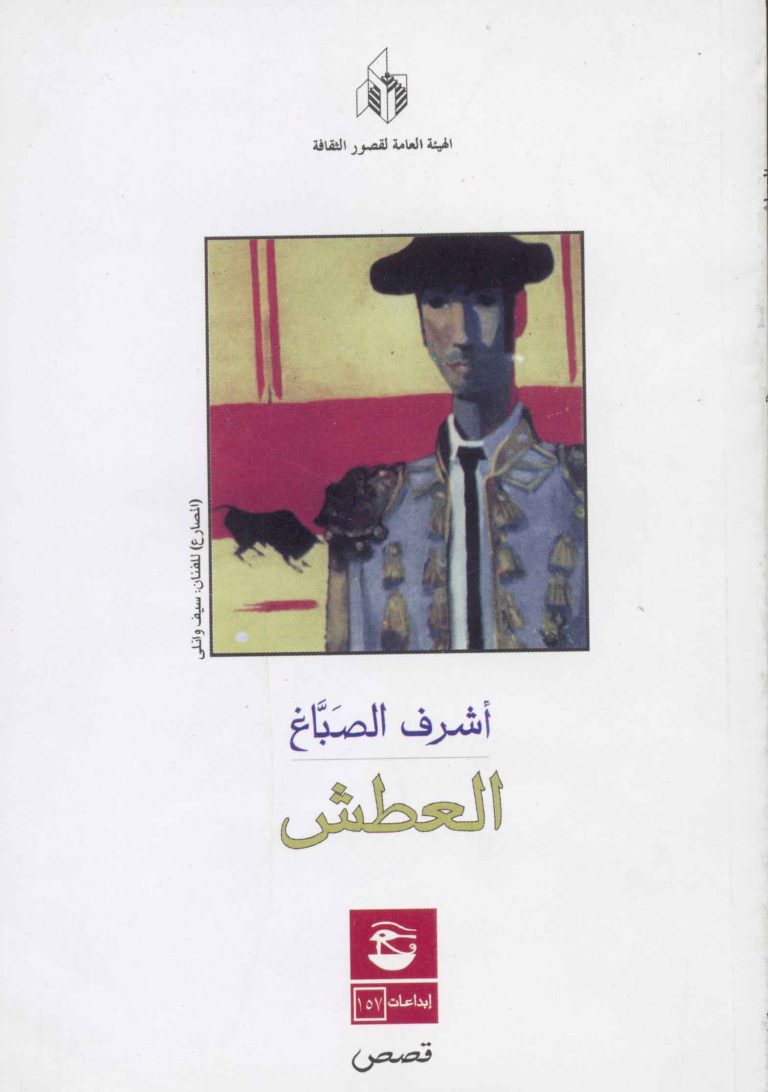مايكل ميلاد
جمع شتات نفسه، وعقد العزم أخيرًا أن يخبرها عند انتصاف الليل.
جلسا صامتين على طاولة العشاء؛ الطعام بارد، متبقٍ من الغذاء، ورائحة الغبار عالقة في الغرفة، رياح خريفية تعوي بالخارج، وينسرب رذاذ التراب من خصاص النافذة والباب. غرفة السفرة ساكنة، وكراسي الطاقم مغطاة بمشمع، تذكرة لهما أنهما استغرقا منذ عشر سنوات في زواج هامد، تغذّى على ذاته حتى النفاذ، سحبهما عن معارفهما جميعًا، حتى اعتادا منذ زمن على عدم استقبال ضيوف، وغابا عن الجميع فلم يعد يدعوهما أحد إلى عيد ميلاد أو احتفال، ولم يبقَ لهما للاستخدام سوى هذين الكرسيين المتقابلين، اللذين يجلسان عليهما على مبعدة، وهما ذوا حواف وزخارف متربة أيضًا، بعد أن كفّت زوجته عن طبخ طعام جديد، وعن تنظيف المنزل والاعتناء بالأثاث، كما كانت تفعل في الماضي.
ذلك الزواج الذي لم يُسفر عن أطفال جعله يفكر كل يوم أنه أخطأ حين أصرّ على خطبتها على عكس رغبة أبيه. تلاحقه الأفكار أن عدم حصوله على مباركة والديه هو السبب في جفاف رحم زوجته. أما هي فكانت في البداية كتلة حياة متوهجة، شعلة تجوب البيت، تضفي الدفء على أركانه، حتى ما إن يعود من عمله، يجد ما يعوّضه عن الشقاء الذي تعرف أنه يشعر به بلا جدوى، طالما أنه بلا ذرية.
لم يُفصح لها عن جزعه وسأمه، وحاولت غير مرة استمالته ومداعبته، ولكنه كان صامتًا مثل سرّ مستغلق. واتفقا أن لا يطرقا باب الأطباء، حتى لا تتطرق إليهما معرفة أيّهما هو سبب العقم. ولكنه في ذات الوقت لم يفاتحها في أمر الطلاق، وكأن عزوفه عن الانفصال، ومعاملتها بالحد الأدنى من المعاملة الحسنة، لهو الدليل الكافي أنه لا يزال يرغبها، وبرهان واضح أنه «ابن ناس» لن يترك زواجه لمجرد عدم وجود أطفال. غير أن عينيه كانتا تقولان غير ذلك، وصوت جسده الساكن، الذي لم يقربها منذ عام، كانت تسمعه بوضوح.
الصمت يقتلها. تتمنى أن يفتح فمه ويفصح عمّا به، أن يخبرها أنه سامحها إن كان رحمها عقيمًا، وأنه لا يشعر بالنقص في رجولته إن كان القصور منه، ولكن شيئًا من هذا لم يحدث. تمنت لو اقترح أن يقتنيا كلبًا، أو يتبنيا طفلًا، ولكنه ظل صامتًا مثل وادٍ سحيق، ففترت همتها، وآثرت الصمت أيضًا. وبالوقت حلّ على بيتهما الخرس والوجوم، وكسا أثاثهما التراب، وارتسمت على مجلسي كرسيهما المتقابلين، بخطوط التراب، آثار جلساتهما الحذرة الساكنة، فبدا انطباع مقعديتهما مثل فراشة ميتة، أو رسمة رورشاخ غير معلومة التفسير، لا يمكن التنبؤ بمعناها، تمامًا مثل مستقبلهما.
ثمّة اتهام ضمني تشعر به يوجّهه إليها، أنها هي من تسببت في فشل تلك الزيجة! وتأخذ عليه أنه لا يبذل أي جهد بالمرة. للمرة الأولى تنفتح عيناها، بعد زوال غلالة الحب، أنه منذ أن يدخل البيت لا يحرك ساكنًا. منذ أن تزوجا وهو يعتمد عليها كليةً لإحضار غياراته الداخلية، وتذكيره بمواعيد عمله، وشراء طلبات البقالة، وتصليح الأعطال. هو لا يفعل شيئًا سوى الجري وراء المال، وتحت طائلة هذا السعي يبرر لنفسه أنه في مكانة أكثر رفعة. لقد سئمت هذا كله، وكانت صدمة – متوقعة – أن بدأت هي أيضًا تشعر بحيز وجوده الخانق، وبضيق تلك الزيجة والبيت وأعبائهما الشخصية عليها. تعيد النظر في ذلك الحبيب الذي تقدم لها على جواد أبيض، ربما لم يكن سوى طفل يحتاج طوال النهار إلى مرضعة ومعلمة وطبيبة وسكرتيرة وكاماريرة، وفي الليل غانية.
لاحظ هو أنه في محادثاتهما القليلة الأخيرة الماضية، بدأت تلمّح من بعيد إلى طلب الانفصال، ولكن ببذل خارق للذات كانت تتعمد أن تشير لذلك من بعيد، حتى يكون له هو – إن أراد – رد الفعل النهائي، وبذلك تكون قد استطاعت أن تصبح أمينة عليه حتى النهاية ولا تكسر قلبه، حتى النفس الأخير.
وتلك الإشارات العديدة التي غذّته بها، ومنها عدم الاجتهاد في إعداد الطعام، والاعتناء بجمالها الشخصي وبالبيت، والسفر المتكرر لمسقط رأسها بلا داعٍ، تراكمت وتصاعدت لديه، وكأنها أسئلة تحتاج أن يجيب عليها باقتراح الترك، جواب في أغنية حزينة يحتاج إلى قرار. تقاعس هو عن الرد عليه لوقت طويل، حتى دخل كلاهما في حالة من السبات الروحي، هدنة مميتة، مرحلة من جفاء اللا سلم واللا حرب، قطعت كل طريق للعودة.
«سأفاتحها في الموضوع اليوم»؛ ظل يحفّز نفسه.
توقفا عن الاحتفال بالفالانتاين منذ وقت طويل، وكان هذا هو العرَض الأكثر خطورة، علامة الاحتضار الأكيدة، أن علاقتهما الآن تسير بقوة الدفع المنهكة، وأن ما يدفعهما للاستيقاظ هو سير الزمن القهري للأمام. وكانت مفارقة ذبحت كليهما أن يحل عيد زواجهما العاشر دون أن يفكر أحد منهما أن يقول للآخر، ولو ببلادة، كمجاملة خرقاء: «كل سنة وإنت طيب». كان هذا الإعلان المقصود المزدوج منهما هو المسمار الأخير في نعش زواجهما، شهادة الوفاة التي أعلن بها كل منهما للآخر أن علاقتهما الآن أصبحت جثة هامدة.
أنهيا العشاء، وصوت احتكاك أدوات المائدة وسط سكوتهما التام يصأصئ مثل سرب فئران تلتذ بتقويض جثمان. والحديث المهذب المحرج المفتعل، الذي يحاولان أن ينشآنه حتى لا يقتلهما الاعتراف بالحقيقة العارية، يضربهما في قلبيهما خلسة بعد أن يصمتا من جديد، بقسوة أكثر من الإهانات الصريحة. تعليقات مبتورة بلا معنى، أشبه بالتسول. كلمات متكسرة لا يناجي بها الواحد الآخر، على قدر ما يفضح خواء نفسه وسأم روحه.
تتمايز في أذنه دقات عقارب الساعة، يتابع ذراع الثواني بفرح خاطئ ينتظر خلاصه، بحزن مجرم سوف يتم فيه تنفيذ الحكم بالإعدام. لقد عقد العزم أخيرًا.
حين تدق الثانية عشرة، سوف أفتح فمي وأقول ما كان يجب أن أقوله منذ زمن. ربما كانت غلطة أننا تزوجنا من الأساس. ربما تستحق هي من هو أفضل مني، وبالتأكيد أستحق أنا الخروج من هذا الفخ. الثانية عشرة هي مفتاح باب السجن. حين ينتصف الليل سوف يصبح كلانا حرًا من جديد.
أغمض عينيه، واستدعى قوته، أخذ نفسًا عميقًا، وضم قبضتيه، وهيأ نفسه للكلام، وكان قد قرر أن يعالج الوضع المحرج مثلما يعالج مشرط الطبيب الورم. إنها بضع كلمات سوف يخرجها من فمه، قد تجرح الآن، ولكنها على المدى البعيد سوف تعدهما بمستقبل آخر، غامض ربما، ولكنه على امتداده قد يجلب لهما الشعور بالحياة والشفاء من جديد.
«النهاردة بداية التوقيت الشتوي، إنت عارف كده؟»
فتح عينيه متفاجئًا، ونظر إليها على الجهة الأخرى من الطاولة متعجبًا متسائلًا. بدا له الحديث، لأول مرة، حقيقيًا، ليس في معناه بل في نبرته. يتأكد له شعوره القديم الذي شعر به تجاهها فيما مضى، ولم يشعره مع كل الفتيات، أنها هي الوحيدة التي تتشعر به، وتستبق قوله. كانت لها تلك العادة؛ حين تستشعر ارتباكه، تثرثر في أي شيء لكي ترفع عنه التوتر والحرج. ما كان يعتبره هو طوال الوقت حديثًا فارغًا بلا معنى، شعر به في تلك اللحظة أنه في أمسّ الاحتياج إليه. آه! كم أتمنى أن تطلب هي الطلاق! وتوفّر عليّ كل هذا العناء.
استدعى كل تلك الأسئلة المفتوحة المشابهة التي كانت تسأله إياها، وكان يختال داخليًا بينما يجيب عليها، وهي تعرف أن مثل تلك الأسئلة تجعله يراها كشخصية ضحلة وعقلية مسطحة. وأدرك لوهلة أنها لم تكن تجهل إجاباتها، على قدر ما كانت يدًا ممدودة ترسلها له بحب، قبل أن يسقط غائرًا في ضيق نفسه وأفكاره الداخلية المقبضة. فكانت تتعمد أن تثرثر في أي شيء لكي تُسري عنه وحدته، التي تعرف من مرات عديدة خلت آثارها المدمرة والكئيبة عليه.
تفحّص جسدها، الذي لم يقربه منذ عام، وتذكر المرات التي عاتبها فيها بسخرية قاتلة على البدانة التي استسلمت لها أثناء سنين الزواج، رغم أن جسده الرياضي اكتسب كرشًا مقببًا. وتذكر أمه وبدانتها، وأدرك أنه كلما كبر، كلما شعر أنه يرتد صغيرًا، وازدادت سلطة ذكريات الطفولة عليه. واستعذب حضن زوجته وجسدها الدافئ، لأنه ذكّره بحضن أمه.
وأدرك أنه، حتى وإن كان قد توقف عن اشتهائها، فإنه كان ينزع دومًا إلى العودة للبيت الذي هي بؤرته، وأن ما نما بداخله من مشاعر انجذاب نحو جسدها كان قد تبدل وأخذ أشكالًا عديدة على مدى السنوات. وكانت ملامح الاشتياق الأخيرة التي شعر بها تجاهها في المرة الأخيرة قد طرأت عليه حين أصابتها الحمى وطرحتها الفراش. وتذكر كيف كان يسكن لها وهو يضع على جبهتها الكمادات، تكاد تدمع عيناه وهو يسمعها تهمس باسمه شاكرة وتهذي: «أين كنت سأكون لو لم تكن بجانبي الآن؟»
رغم نجاحه المهني، كانت هذه اللحظة إحدى المرات النادرة التي شعر فيها بأقصى درجات التحقق. يومها نهض إلى الشرفة، ونظر إلى الأفق البعيد، وزاره خاطر خاطف أن حياته ربما ليست بهذا السوء، وأن ما شعر به نحوها من اعتيادية وملل، قياسًا بجمود الزمن الذي يعبر فوقه بثبات وقسوة مخرطة ملوخية، لهو أعلى درجات الحياة تشويقًا وإثارة، مقارنة بالأيام الخالية التي كان سيقضيها بمفرده لو لم تملأ هي حياته.
«أنا هقوم أغيّر الساعة، لحسن تتأخر بكرة على شغلك، إحنا دلوقتي بقينا 11…»
وبينما كانت تعبث بمسامير ضبط ساعة الحائط، تأملها هائمًا كأنه يحدق في جوهرة. وحين تركت الصالة لتضبط ساعة غرفة النوم، شعر لأول مرة أن غيابها من أي مكان يعني انسحاب الهواء.
وتذكر الليالي الباردة التي قضاها في فراشه وحيدًا حين كانت تسافر إلى أسرتها في ظروف طارئة، وتذكر قسوة الفراش الخالي. وفكر في نفسه أن كل الزيجات تعاني من مشكلات، وأن الصيف قد خلا، والخريف قد حل، والشتاء آتٍ لا محالة. وتسائل: «من سيعوضني عن ملمس زوجتي الهش الدافئ اللدن الحنون؟»
……………………
*كاتب وقاص مصري