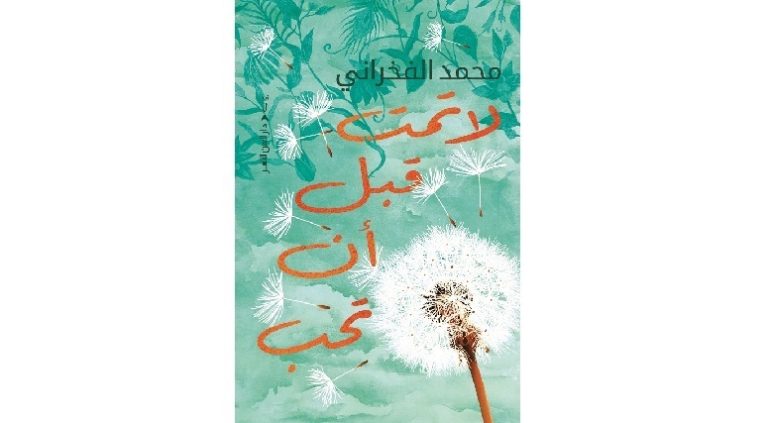محمود فهمي
إلى أمي
1
البيت
أعيش وحدي في هذا البيت القديم منذ سنوات تعبت من عدّها. الخشب تحت خطواتي يئن، أسمع تأوهاته بين خطوة وأخرى. الجدران امتصّت الأصوات واحتفظت بها في داخلها. في أحد الأركان درج خشبي لم أفتحه منذ زمن، ولم أعد أتذكّر ما بداخله. بالأمس فقط سمعت بكاءً خافتًا يصدر منه. اقتربت، ارتفعت دقّات قلبي، لم أجد عليه قفلًا ولا مفتاحًا، فقط مقبض صدئ. فتحته، ففاحت منه روائح اختلطت ببعضها فأنتجت عطرًا يمكن تسميته بعطر الحنين. وجدت به خليطًا من ورق أصفر تآكلت حوافه، مددت يدي إلى آخره فخرجت بها أشياء لا أتذكّر متى وضعتها؛ بطاقة بريدية من مدينة لم أزرها أبدًا، خصلة شعر مربوطة بشريط أزرق، مفتاح نحاسي صغير، قصاصة ورق اختفت بعض حروف العبارة الوحيدة المكتوبة عليها.
أخذت القصاصة، قربتها من وجهي، حاولت تكوين بعض كلماتها علّني أستطيع أن أفهم. شعرت برغبة في البكاء، لكنّني لم أبكِ. ولكن بعد لحظات عاد الصوت الخافت للبكاء ينبعث من جديد، اختلط بصوت موسيقى قادم من مصدر مجهول. أعدت الأشياء إلى مكانها داخله.
في الصباح وجدت الدرج مفتوحًا، والقصاصة لم تعد هناك.
2
تناولت إفطاري وأنا ما زلت أفكّر في العبارة الطويلة التي كانت على القصاصة المختفية. عدت للبحث عنها من جديد، أخرجت محتويات الدرج بالكامل، نثرتها على الأرض، لم أجد قصاصة الورق. أعدت الأشياء إلى مكانها، ومنذ اختفاء الورقة توقّف الدرج عن البكاء.
كان البيت صامتًا كعادته، لكن كان هناك اختلاف خفيف في الهواء، اختلاف لم أستطع تحديده. ذهبت إلى الجدار المواجه للنافذة المفتوحة على فضاء واسع، نظرت إلى الصور الثلاث التي لا أتذكّر متى التقطت. ثلاث صور ذات أطر قديمة، في كل واحدة وجوه مبتسمة، لكن اليوم في الصورة الوسطى، الوجه اختفى. كانت اليد الموضوعة على الكتف في مكانها، لكن الوجه الذي تلتفّ حوله لم يعد هناك.
جلست على الكرسي المقابل، أحدّق في تلك البقعة الفارغة من الورق، شعرت بشيء بداخلي يتلاشى. ليس الوجه فقط الذي لم أعد أتذكّره، بل الاسم الذي كان يقال عند النظر إليه.
حاولت أن أتذكّر: الصوت، الضحكة، نبرة السؤال حين يقول: “هل تتذكّر ذلك اليوم؟”، لكن كل ما تذكّرته هو الصمت.
قمت من مكاني مرّة أخرى، نظرت مرّة أخرى إلى بقيّة الصور، كل الوجوه كما كانت، ثابتة، توقّف الزمن فيها. عدت إلى الصورة الناقصة، شعرت أنّ من اختفى منها قد بدأ في الاختفاء منذ سنوات، لكن اليوم فقط قد اختفى تمامًا.
3
نافذة لا تفتح
في غرفة نومي نافذة قديمة، ذات إطار خشبي تآكل من الرطوبة. منذ سكنت هذا البيت لم أفتحها يومًا، لا أعرف حقًا ما الذي منعني، ولا أظنّني حاولت يومًا. النافذة تطلّ على حديقة أخذت في الاختفاء تدريجيًا، رحلت أشجارها الواحدة تلو الأخرى حتى صارت رقعة مقفرة من الأرض، رقعة تتقاطع فوقها آثار أقدام القطط والكلاب الضالة التي تأتي وتغيب من وقت لآخر.
كل صباح أقف أمام النافذة، أزيح ببطء الستارة الثقيلة، أنظر من خلفها، أرى صورتي منعكسة على الزجاج المغبّر، أرى خيالي يحدّق فيّ كأنّه يراقبني من الخارج، أو كأنّني محبوس في مرآة كساها الغبار.
بالأمس انفتحت النافذة وحدها، كنت مستلقيًا على السرير أحدّق في السقف، أرسم أشكالًا من التعرجات والتشققات البادية في السقف. الضلفتان تحرّكتا ببطء وكأنّهما تتنهدان. دخل هواء بارد ورائحة تراب مبتل، ثم انغلقت مرّة أخرى.
قمت مفزوعًا، اقتربت من النافذة، وضعت يدي على المقبض، دفعته ـ لم يتحرك. الصدأ الذي علاه جعل من الصعوبة فتحه. حاولت مرّة ومرّة ومرّة، ارتجّ الإطار في يدي لكنه بقي مغلقًا. حاولت بكل ما فيّ من رغبة في فتحه، لكن النافذة بقيت صامدة. مسحت العرق الذي بدأ يتساقط من جبهتي، لم أكن أشعر بالتعب بل بالهزيمة. تركتها وعدت للجلوس على حافة الفراش.
منذ تلك الليلة، صرت أقترب من النافذة، أزيح الستارة الثقيلة ببطء، أضع يدي على المقبض، أدفعه، لا يستدير أبدًا. يئست من فتحها مرّة أخرى، كأنّها فتحت مرّة واحدة لتذكرني أنّها هنا، ثم عادت لتلوذ بصمتها الأبدي.
تركتها مغلقة وجلست أكتب، كمن يحاول فتح نافذة على الورق بعدما عجز عن فتحها في الجدار.
4
الباب
باب البيت موارب دائمًا، لا ينغلق تمامًا. في البداية كنت أغلقه كل مساء، لكن شيئًا فشيئًا صار يفتح وحده، كأنّ البيت لم يعد يخاف من الغرباء، أو يشتاق إليهم. الباب الذي لا يطرقه أحد، ظلّ كما هو، غارقًا في صمته وانتظاره.
ذات مساء عدت من الخارج، أجد الباب مفتوحًا بالكامل. قلت ربما لم أحكم إغلاقه، لكنّني كنت متأكّدًا أنّني أغلقته. ظننت أن أحدًا ما بالداخل، لكن لم يكن هناك غير الصمت.
الصمت الذي تكدّس لسنوات داخل الجدران سال فوق السلالم كأنّه طوفان أغرق الشوارع. لم يعرف الناس في البداية من أين أتى. وضعوا حجارة يمرّون عليها حتى لا تتبلّل ثيابهم بالصمت. صاروا جميعًا صامتين. كنت أمرّ عليهم وهم جالسون أمام البيوت وفي المقاهي، يحدّق أحدهم إلى الآخر ولا يقول شيئًا. كنت أعرف أنّني من تسبّب في هذا الصمت الذي ضرب المدينة. كنت أتحاشى النظر إلى عيونهم حتى لا ينكشف أمري. مرّت عدّة أيّام، جفّت الشوارع وعادوا جميعًا إلى الكلام، وعدت أنا لأكدّس الصمت داخل الجدران، بينما الباب يرفض الإغلاق. حاولت كثيرًا أن أغلقه، دفعته، لكن كأنّ يدًا في الجانب الآخر تدفعه في الاتجاه المعاكس.
في المساء جلست إلى الكرسي القريب من المدخل أراقب الباب وهو يفتح ويغلق كأنّه يتنفس.
5
الممر الطويل
لم يكن في الشارع أحد حين عدت. المطر توقّف منذ ساعة، لكنّه ترك رائحته العالقة في الهواء. صعدت الدرج المضاء بإضاءة خافتة من لمبة صغيرة تسكب ضوءها الأصفر على الجدران الرطبة. أدرت المفتاح في الباب، ودخلت. وضعت المفاتيح فوق المنضدة، أفرغت جيوبي من بعض العملات المعدنية التي تساقط بعضها على الأرض واختفت تحت المقاعد. تجاهلتها ولم أبحث عنها، عملات معدنية تشبه الأيام التي تتساقط الواحد تلو الآخر وتختفي إلى غير رجعة. البيت على حاله، غارق في الصمت.
وقفت في الممر الطويل الذي يربط الغرف ببعضها، كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل بقليل. لا أعرف ما الذي دفعني لأناديها بصوت خافت، ثم أخذ صوتي يرتفع بالنداء مرّة بعد أخرى، وكأنّني أختبر إن كنت لا أزال أتذكّر النطق أم أنّني فقدت صوتي مثلما فقدته هي خلال سنواتها السبع الأخيرة إثر جلطة في المخ.
قبلها كان الكلام بيننا لا ينقطع، ويبدو أنّني فقدت الرغبة في الكلام يوم فقدت هي النطق. لم أعد أستمع إلى حكاياتها عن قريتها البعيدة حين تنهمر عليها الذكريات لحظة ظهور ذلك الشاعر الجنوبي على الشاشة. لم أعد أتحدّث إليها وقت مشاهدة مباراة لفريقنا المفضّل، والذي كانت أصواتنا تختلط وهتافاتنا ترتفع ونحن نشاهد مبارياته. فقط صرت أنطق ببعض كلمات، ترد هي عليها بإشارة من يدها، تشير إلى أنّها لا تستطيع الكلام، فأشعر بوخزة في قلبي وأعود إلى الصمت. لا أريد أن أتحدّث إليها فأشعر بعجزها الذي أراه دمعة معلّقة في عينها تأبى النزول.
ناديت: “أمّي”، لكن لم يجبني أحد. كل ما سمعته صدىً باهت يعود مرّة أخرى، ليس من نهاية الممر حيث غرفتها، بل من داخلي. سرت ببطء حتى نهاية الممر، فتحت كل الأبواب، لا أحد.
في المطبخ ما زال الكوب ذاته في مكانه، في غرفة نومها السرير مرتب، كأنّ جسدها غادره دون أن يخلّف فوضى.
عدت إلى الممر، جلست على الأرض، ناديت مرّة أخيرة.
أدركت أنّني لم أنادِها هذه الليلة فقط… بل كنت أناديها منذ رحلت.
6
المقعد
هناك مقعد معدني قابل للطيّ، له كسوة من الجلد الأحمر، موضوع قبالة مقعدي تمامًا في غرفة المعيشة. كان دومًا لها، تجلس عليه وتمدّ قدميها قليلًا، ثم تبدأ في الصلاة، وبعد أن تنتهي تضع كوب الشاي على الطاولة، وتبدأ الحديث، حديث لا ينتهي، ولا يبدأ من مكان واضح.
منذ غيابها، لم أغيّر وضع المقعد، ظلّ كما هو، مواجهًا لي. يبدو كأنّه ينتظرني أكثر مما أنتظرها. أجلس وحدي، أحيانًا أفتح التلفاز، أحيانًا أقرأ شيئًا لا أكمله، لكنّني دومًا، بين جملة وأخرى، أنظر إلى المقعد، أنتبه إلى أنني ما زلت أترك مساحة على الطاولة لكوبها.
أجهّز في بعض الليالي كوب الشاي الذي كانت تحبّه، وأضعه هناك، أمام المقعد المقابل، ثم أعود لمكاني. لا أحد يشربه، لكن البخار يتصاعد كأنّه يحاول الكلام.
في المساء، يطول النظر بيني وبين المقعد. أحيانًا أشعر بأنّه ينظر إليّ أيضًا. أحيانًا، أظن أنّ المقعد بدأ يحنّ إليها أكثر مني.
بعد رحيلها، لم أجرؤ على الجلوس عليه، كأن شيئًا غير مرئي يمنعني، كأنّ الكرسي لم يعد يفتح حضنه لأحد. بقي في نفس الزاوية، لكنّه أدار نفسه قليلًا، لم يعد يواجه الطاولة، لم يعد يواجه أحدًا.
ذات ليلة، شعرت بشيء يتحرّك في الغرفة، صوت احتكاك على الأرض. خرجت من غرفتي فرأيته، كان الكرسي قد التفّ بزاويته نحو الحائط. لم أنقله، تركته يحدّق في اللا شيء، كمن اختار أن ينسى. أعرف أنّه يشتاق.