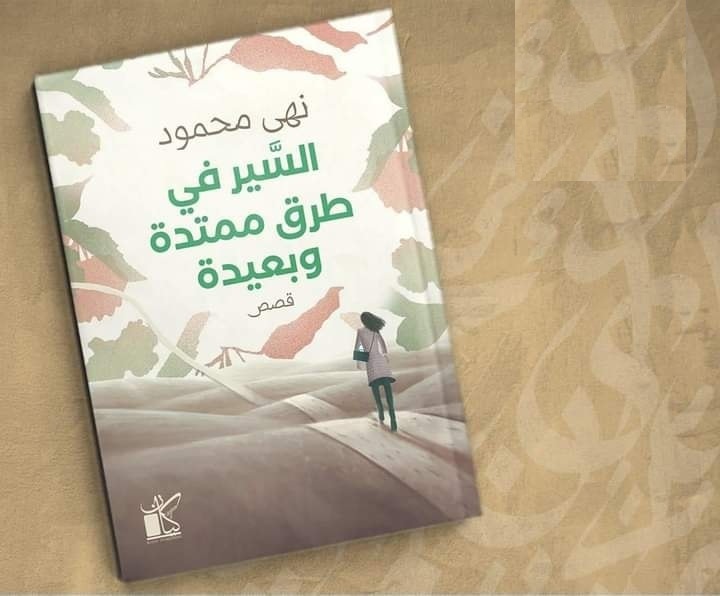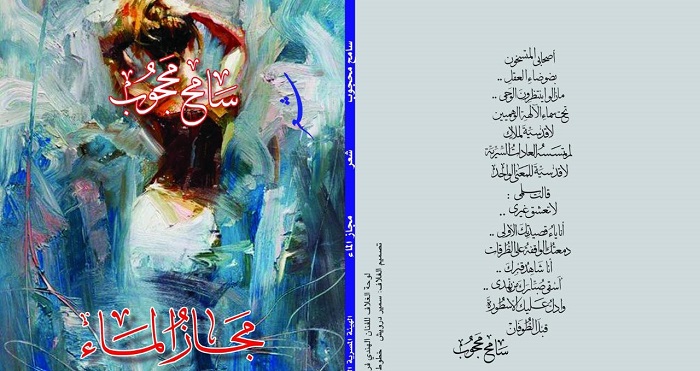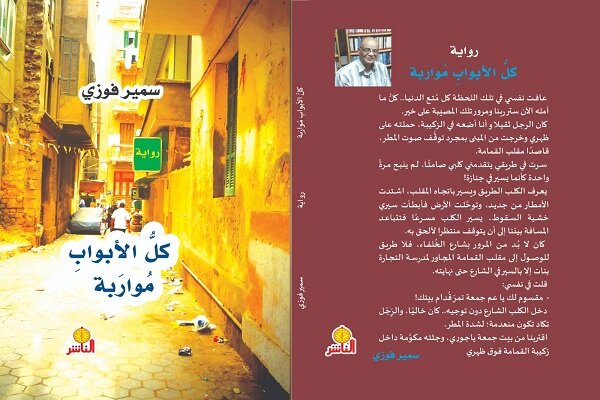أمل سالم
تظل الرواية مدينة بوجودها لاهتمام الإنسان بالإنسان، ومدينة أيضا لاختلاف العواطف والمشاعر الإنسانية تلقاء الآخرين. وتظل الرواية هي الفن الوحيد الذي ليس له شكل ثابت ومحدد، إنما يستمد شكله الخاص من طبيعته ومن تكوينه الخاص، إذ أن الرواية في واقع أمرها مرآة للخصوصية الإنسانية والفروق الفردية، ومن ثم مرآة للثقافية المجتمعية، ففي الوقت الذي تعبر فيه الكتابة الروائية العربية المعاصرة عن خصوصية الثقافة العربية- كإحدى الثقافات العالمية المؤثرة- فإنها أيضًا تعبر عن ثقافات فرعية محلية داخل الثقافة العربية.
-مورفولوجية الرواية:
وبالعودة إلى الرواية التي ننتوي مناقشتها اليوم وهي رواية: “صورة مريم”، للروائية مريم العجمي، وهي الرواية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة ابداعات قصصية، وهي الرواية تقع في ثلاث وثمانين صفحة، وفعليا في إحدى وسبعين صفحة.
وقبل الدخول إلى عالم الرواية سنتناول شكلها وبنيتها في عجالة سريعة؛ حيث تبدأ الرواية بالإهداء، وهو إلى روحيّ الأب والزوج، ثم المفتتح الذي نصه: “أرى في المرآةِ سيدةً تشبهني تمامًا، أكسرُ السطح؛ يتحطمُ قطعًا صغيرةً ومتوسطةً وكبيرة. أنظر ذاتَ المرأةِ بعدد القطع المتناثرة: تختلفُ النظرةُ، الحجم، البُعد، الزاوية، لديَّ مئات مِن النسخ لنفسِ الشخص.”، مما يعني أننا أمام مرايا، وأننا أمام من التشظي قد يواجهنا عند مطالعة أحداث الرواية.
وبعد ذلك نقول أن الرواية تتكون من سبعة مقاطع مرقمة من الرقم واحد إلى الرقم سبعة، المقطع السردي الأول جاء في ثماني صفحات، ويتكون أيضا من سبع جزئيات غير مرقمة وبينها فواصل، ثم أن المقطع الثاني وهو أطول مقاطع الرواية؛ إذ جاء في إحدى وعشرين صفحة ويحتوي على أحداث تدور في سبع ليال متتالية/ سبع جزئيات أيضا، ثم بعد ذلك من المقطع الثالث وحتى السابع كتل سردية واحدة بدون تجزئة ظاهرية أو ترقيم واضح، وجاءت على الترتيب في اثنتي عشرة صفحة للثالث، سبع صفحات للرابع، ثم سبع صفحات للخامس، ثم إحدى عشرة صفحة للسادس، وأخيرا خمس صفحات للسابع والأخير.
الملاحظة الأولى أن بنية العمل الروائي حافظت في شكله على الرقم سبعة ثلاث مرات متتالية، وحيث أن الرواية- كما سنري بعد قليل- لها علاقة بتناول الإبداع كمستوى من مستويات الخلق الكتابي، فهذا الرقم، أعني السبعة، أيضا له علاقة وطيدة بنظرية الخلق وفكرته سواء في الديانات السماوية أو حتى في الميثولوجيا عموما، فهو ذو دلالات مرتبطة بالخلق، ففي الحضارة الفارسية كان الرقم سبعة يرمز إلى الخصب والنماء، وعند العرب استخدم للدلالة على الزيادة العددية والكثرة، وحتى في النص القرآني، قال تعالى: “كمثل حبة أنبتت سبع سنابل”، وأيضا “إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً”، إراد هنا التكثير، والمبالغة فى كثرة الاستغفار؛ فقد جرت عادة العرب فى أساليبهم على استعمال هذا الرقم للتكثير لا للتحديد.
القصد أن ثمة تأثير ثقافي على بنية الرواية لا يمكن اغفاله عند قراءتها نقديا، حتى أن الخلق جاء في الأديان في ستة أيام واختلف اليوم السابع في بعضها، فإننا نجد أن الليالي في المقطع الثاني جاءت متتالية؛ الليلة الأولي، الليلة الثانية، ولكن عند الليلة السابعة جاء العنوان: “سابع ليلة”. مغايرا لما سبق.
واستخدام هذا الرقم-سبعة بالتحديد- جاء متسقا مع الرواية، فبغض النظر عن مردوده الديني، فإن تعبيره عن الكثرة جاء متسقا مع حالة الرواية، حيث تقف مريم بطلة الرواية بين مرآتي الدولاب لتجد صورا كثيرة لها، ولا عدد لها. وقد اختارت الروائية شخصية مريم كسارد، وعلى لسانها تقول في ص 10: “لكن ما جعلني أفتح عينيّ عن آخرهما هاتان المرآتان المتقابلتان في باطن الدرفتين بطولهما. وقفتُ أتأمل كم النسخ اللا نهائية منّي في صفين متقابلين، إنها أنا في الجهتين!” وكذلك تكرر في ص 13: “انتهى الأمر، صار الدولاب لي، امتلكتُ زوج المرايا المتقابلتين، الآن يمكنني مقابلة النسخَ اللا نهائية منيّ والتعرف على الحكايا من الماضي والحاضر والمستقبل،”.
وإذا قلت أن الرواية تعتمد التصميم المفكك؛ إذ أنها تجمع عددا من الحوادث إلى بعضه من غير علاقة منطقية أحيانا، وأحيانا أخرى بعلاقة ضعيفة، كما أنها لا تعتمد على سير الوقائع، بل تعتمد على شخصية البطل/مريم التي تمثل المركز الرئيسي والوحيد للرواية، والرواية تجمع عددا من العناصر المتفرقة في شخصيتها، وتكون تاريخًا لمخاطرات متنوعة تحدث لها في مجرى حياتها.
السرد والخداع الزمني:
في المقتبس الأخير من الرواية ندرك أن شخصية مريم في الرواية ستتجول في الزمن بأبعاده الثلاثة؛ الماضي والحاضر والمستقبل، وهو بالتحديد ما فعلته منذ المقطع الأول، فعلى حين أن الجزئية الأولى من هذا المقطع تتحدث عن سيدة متزوجة وحامل، فإننا في الجزئية الثانية مباشرة ننتقل عبر الاسترجاع وهو مخالفة سير السرد، وأعني العودة إلى الأحداث السابقة، وهنا تتولد الحكاية الثانوية، وهي حكاية الساردة/ مريم مع المرايا في بيت جدتها، وفي واقع الأمر أنه لا حكاية ثانوية في هذه الرواية؛ إذ أن الحكاية الثانوية سرعان ما تصبح الحكاية الأساسية. أما في الجزئية الرابعة من هذا المقطع فإن الساردة/مريم تستخدم أيضا الاسترجاع عبر الحكاية الثانوية ليتولد حكاية فرعية وهي حكاية الأب وهو يقوم بتركيب دولاب الجدة في حجرة مريم لكي تحصل على مرآتين متقابلتين، وهي الفكرة الأساسية التي تقوم عليها الرواية. هذا الاسترجاع الداخلي الذي يقوم عليه المقطع الأول من الرواية من خلال جزئياته السبعة هو ما يطلق عليه “جواني الحكي”؛ كونه يتناول أحداثا ماضية مرتبطة بالشخصية الأساسية في الرواية، وفاعلا ومؤثرا في سلوكها الحاضر، ومشكلا حدثا مؤثرا في الحدث الرئيسي. وفي الجزئية السابعة من المقطع الأول تخبرنا السارد/مريم أن الطبيبة حددت أسبوعا كأقصى موعد للوضع، ومن هذه النقطة سيتشكل المقطع الثاني من سرد عبر سبع ليال متتالية.
وهنا بالتحديد تربط الأحداث بين هذا الجنين الذي يتشكل في حملها ويستعد للخروج إلى الحياة وبين الكتابة والإبداع، ذلك الذي مهدت له الساردة حين تحدثت عن علاقتها بالكتب والأقلام والمكتبة الصغيرة في الجزئية السادسة من المقطع الأول وبين ذهابها للندوة الأسبوعية في قصر الثقافة بالمدينة المجاورة.
والحق أن ما من خط سردي يُتناول في هذه الرواية إلا وقد استعمل استعمالا دقيقا عبر التفرقة بين زمن السرد وزمن الحكاية، فعلاقتها بقصر الثقافة مثلا والتي طالعتنا بها في المقطع الأول ستعود لها ثانية في المقطع السادس لتحكي المرة الأولى لذهابها إلى هناك، عندما كانت صغيرة، فزمن الحكاية هنا سابق على زمن السرد. والبحر الذي رأته الساردة في الليلة الأولي من المقطع الثاني، ووصفت كيف لاقت صورة أخرى منها على الجانب الآخر منه ستعود له ثانية في المقطع السادس عبر تعريجة على رواية همنجواي ” العجوز والبحر” لتستخلص قيمة الرواية حين تقول: “أن لكل واحد منا سمكته الخاصة.”
أيضا الصديق صاحب النظرة النافذة الذي ظهر في الجزئية السابعة من المقطع الأول، الذي تعتمد عليه الساردة في تقييم كتابتها وابداعها، ستعود إليه مرة أخري في الليلة الرابعة من المقطع الثاني ليربط الكتابة بالألم، في الليلة السادسة أيضا تستدعيه في خيالها ليكرس لعلاقة الكتابة بالألم، وفي المقطع السادس ولكن هذه المرة عبر تقنية الاسترجاع الجزئي، إذ أنه يغطي جزءا محدودا من الماضي، ويعمل على تقديم معلومات محددة ضرورية لفهم الأحداث.
الأمر كذلك بالنسبة للسور الذي بدأت مريم في الوقوع من عليه ثم اعتلائه في اماكن أخرى من الرواية، إلي أن تقول في ص 37: “صرت أخشى من الاقتراب من السور الذي وقفت على حافته يوما.”
وماذا إذن؟
الرواية تلعب في الزمن الخطي بأبعاده الثلاثة (الماضي والحاضر والمستقبل) ولكن بشكل انتقائي فالأزمنة المستديرة التي اختارتها الساردة لعرض حكايا الطفل/ارضاع الأخت/ الصديق ذو النظرة النافذة/ حادثتها الشخصية مع السور…تقاطعت مشكلة ما يشبه الشبكة الزمنية. هذا الخداع الزمني في ترتيب الأحداث هو ما أعطي النص ديمقراطيته، أعني بالتحديد مشاركة المتلقي في استنتاج الأحداث وإعادة ترتيبها وإجراء عمليات الربط بينها واستكمال مقاطع الصورة؛ ففيما يبدو أن الروائية كانت تضع ذلك-أقصد مشاركة المتلقي- نصب عينيها أثناء الكتابة؛ فقد أشارت لها بالتحديد في استهجانها لمعاملة أحد المتواجدين على المنصة في الندوة الثقافية، قالت على لسان الساردة/مريم في ص 70:
“لم أفهم أبدًا كلام ذلك الرجل الأصلع الجالس إلى المنصة، هل طلب منّي أن أحفظُ ألفَ بيتٍ ثم أنساهم، أم كان يحكي عن فتى يحاول تعلُم الشعر وأمره أستاذه بذلك؟ ماذا عن القصة؟! كيف يعترض على أنني أخبرته كل شيءٍ بالقصة؟ ولِمَ أترك له مجالًا لإتمام الناقص؟”.
-الرواية وتعرية المحيط:
ما من روائي جاد إلا وله وقفة في كتابته، وقد تكون هذه الوقفة مع الوجود عامة، إلا أننا نجد هنا أن الكاتبة لها وقفتها مع المحيط من حولها، ولها رأي تبديه في تصرفات الشخصية المختارة لروايتها، وهذه التعرية- أقصد الكشف عن مساوئ هذه الشخصيات- أعلنتها الساردة/مريم فقالت في ص29: “لا أعرف متى بدأتُ أعريّ الناس من حولي، أتلذذ وأنا أتخيلهم بلا ملابس، كنت أختار كل ليلة قبل أن أنام أحدهم أعرّيه تمامًا”، وهذه التعرية التي هي في واقع الأمر انتقاد هذه الشخصيات المختارة تبدأ من وقفتها مع الزوج، واستهجانها لتصرفاته معها عندما تنتوي القراءة، تقول مريم ص14: ” استنكر الرجل الذي تزوجت هذا الكم (تقصد عدد الكتب)، كلما حاولتُ التقليب في كتابٍ أمامه؛ يطلب مني إعداد الطعام أو كوبٍ من الشاي أو اصطحبني إلى غرفة النوم. امتنعتُ عن مداعبة الكتبِ في حضوره،”
هي تعري أيضا ديكتاتورية الأب على المستوى الأسري، إلا أن تعرية الأب اختلفت عن مثلاتها مما سبق؛ فقد جاءت تعريته على المستوى الحسي وليس المعنوي كما سبق، تقول مريم في ص 29: “لم يسلم من خيالي سوى أبي؛ كنت أخافه حتى في الخيال، لكنني رأيته عاريًا في الحقيقة، بعد أن أغلق التليفزيون كعادته قبل أن ينتهي الفيلم، وأمرنا بالنوم”
لكنها تستبق ذلك في صفحة 20 فتقول: “عندما أفتقد حضن أبي كنتُ أفتحَ الورق وأكتبُ مشهدًا بالغ العذوبة لحضنه، حتى صار حضنه الورقي أجمل من الحقيقي”.
أيضا فضح فكرة العقاب سواء من قبل الأبوية الأسرية أو الأبوية التعليمية، حتى صار العقار مرتبطا شرطيا مع آداء الواجب ثم العمل، ثم تحوله إلى نزعة مرضية؛ فعندما عجزت عن الكتابة عاقبت نفسها بنفسها.
هي أيضا تعري الأبوية التعليمية المتمثلة في المناهج التعليمية المجحفة، وكذا في القائمين على التعليم من مدرسين ومدرسات الخ، وتعري أيضا الأبوية الثقافية المتمثلة في الرجل الأصلع الجالس على المنصة الذي يوجه الإبداع لمفومه الشخصي ويرفض غيره، السلطة بمختلف أشكالها-كونها أبوية- تعرضت لذلك الانتقاد، تقول الساردة/ مريم في ص 54: “ما الفائدة من حذف اسم الملك ووضع اسم الرئيس؟ في النهاية الشعب من يتحمل النتائج.”
وماذا إذن؟
نحن بصدد صفة أساسية يتسم بها أصحاب ما بعد الحداثة وهي تحديهم للسلطة، نحن هنا أمام تعرية للهراركية، أو ما يسمى تراتبية السلطة، التي هي ركن ركين في تنظيم المجتمعات الإنسانية، ولكنها تختلف هذه الأبوية من مجتمع لآخر فهي أبوية ضعيفة في الدول الأوربية مثلا وقاصرة على الهيراركية الاقتصادية متمثلة في الرأسمالية الاقتصادية، ولكنها عميقة وشديدة التأثير في مجتمعات أخري كالمجتمعات العربية.
الرواية وأدب ما بعد الحداثة:
يختلط الأمر لدينا، فهل نحن بصدد ولادة طفل، أم ابداع نص، تقول مريم في ص 35 : “أسمع صوت بكاء الصغير، هل اكتمل النص الذي أكتب في ليال سبع؟”، إلا أننا نجد أن صورة الطفل الذي ولد بعد الليالي السبع ستتحول بالقرب من نهاية الرواية إلى صورة متخيلة، وتتداخل هذه الصورة وارضاعه الحليب مع متخيل أخر هو صورة الأخت، كذلك الأمر بالنسبة لاختصاصية المسرح وللعرض المسرحي، فيمكن القول أن هناك اشتباك بين الواقع والمتخيل عبر الرواية.
لكن يمكن النظر من جهة أخري لهذه الأحداث التي تملأ الرواية؛ فالخيال الما ورائي هو من سيطر على النص، لدرجة أنها رأت الفتاة التي كان الولد ينظر لها من مكانها لكن لم تتبين ملامحها، فهذه الذاتية الإنعكاسية هي التي تفرض نفسها على النص من أوله، منذ لحظة تكوينه عبر الصور المتعددة في مرآتين متقابلتين. والسرد هنا ذاتي الانعكاس، والنص يمتلك وعيا ذاتيا يمكنه من تخطي الحاجز بين الواقع والخيال، ويتكون المتخيل الثانوي فوق المتخيل الأصلي.
هناك أيضا الراوي غير الموثوق، ففي صفحة 17 تقابل مريم صورة لها على الجانب الآخر من البحر، لها نفس اليد التي عوقبت عليها، وبها نفس الخط الأحمر من أثر العصا، ص22، هنا يتكون الراو المخاطب والراو الغائب، لذا فإن المتلقي يقع في دائرة الشك في مصداقية الراوي، وهذا ما يطلق عليه في ما بعد الحداثة بالراوي غير الموثوق.
وهناك التناص، وينظر أحيانا بريبة إلي هذا المصطلح، فهو في الثقافة العربية قد يرتبط أحيانا بتبرير السرقات الأدبية، لكنه عندما صيغ اريد به تبين العلاقات المتبادلة بين نص ونصوص أخرى دون تتبع التأثير والمصادر، بل يعني تفاعل الأنظمة الأسلوبية. هناك التناص مع قصة السيدة مريم العذراء، والتي يستطيع القارئ بمجهود قليل أن يستنج قدومه في الرواية قبل موعده، هذا ما أشرت إليه بمسمى ديمقراطية النص. وهناك التناص مع النص القرآني، كما جاء ص35، إذ قالت مريم: “أريد جذع نخلة أهزه يساقط عليّ رطبا”. حتى أن أسماء الكتاب التي وردت في الرواية؛ ماركيز، وتشيكوف، وهمنجواي، ومياس، ودستويفسكي، فهناك تماس مع العجوز والبحر، وخوان مياس مثلا صاحب ” هي تتخيل وهلاوس أخري” الكاتب الذي يلعب في المنطقة المحايدة بين الواقع والخيال، هي ذاتها المنطقة التي تدور فيها رواية مريم.
التناص والقص الماورائي والراوي غير الموثوق والانعكاسية الذاتية جميعها مصوغات رواية ما بعد الحداثة، إذن نحن بصدد رواية ما بعد حداثية بامتياز. وما يدل على أننا بصدد رواية قيمة أن تصميم هذه الرواية له قيمة ذاتية في نفسه، فهي لم تهتم بالأشياء عديمة القيمة والسطحية، إنما تحاول جاهدة أن تكسب الحياة قيمة أخلاقية، وكما أنه يشترط في الرواية أن تكونصادقة، فنحن بصدد كاتبة كتبت روايتها وشرفت بأن تهب لبطلة الرواية اسمها، وهذه هي سمات الروائي القدير.