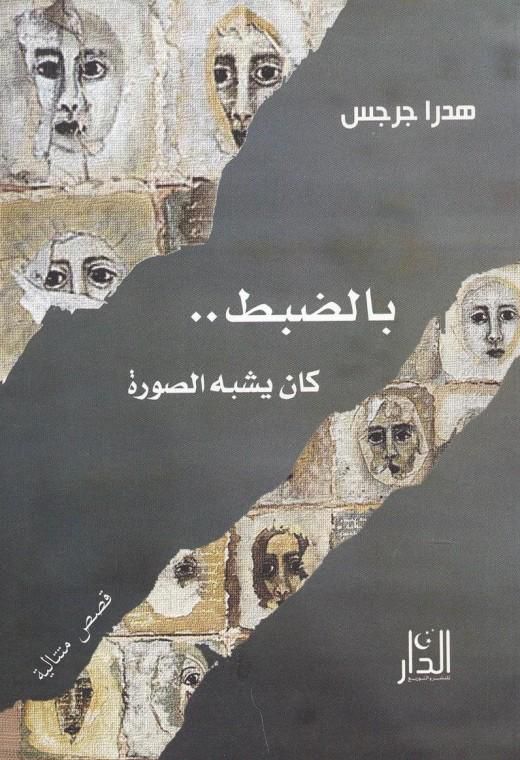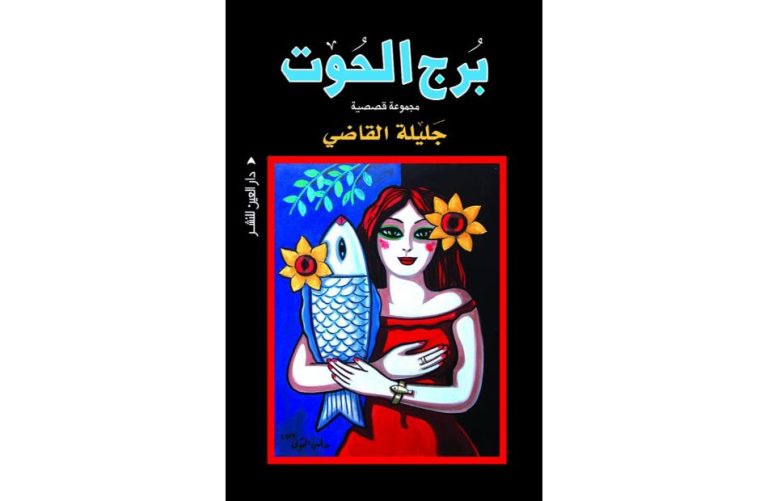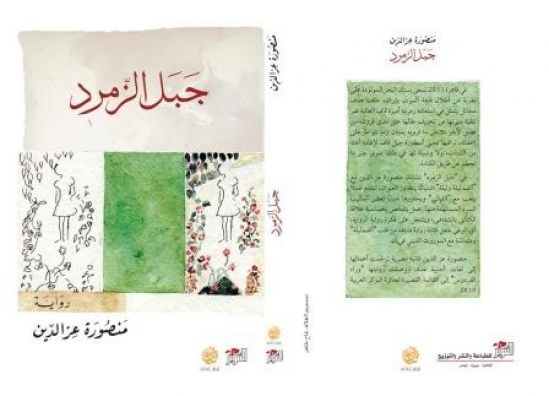محمد فرحات
قصص متتابعة، بذات الشخصيات، وبنفس الزمان المكان الروائي، وبخط درامي تتطور معه الشخوص، وتحتدم الأحداث في تصاعدها، لكشف ما اكتنف الأحداث من غموض؛ يماط عنها اللثام رويدا.
وماذا يكون ذلك غير الرواية، فلماذا أختار الكاتب “هدرا جرجس” في تحديده لجنس نصه “قصص متتابعة” ولم يكتب “رواية”، سبب ذلك في ظني كون النص قصيرا لا يتعدى التسعين صفحة، وهل مازال حجم النص من محددات جنسه ليصنف كرواية؟! زمن النصوص الطويلة قد مر زمنه بلا رجعة في ذلك العصر الرقمي، متلاحق الأحداث، لاهث الأنفاس. ولأن من السخف بمكان تحديد عدد صفحات النص بعدد معين ليصنف كرواية، ولأن الرواية فن أوروبي خالص، ولأن الكلاسيكين الأوروبيين من كتبة الرواية قد كتبوا في البداية نصوصا ضخمة، فرضت شكلها على مؤسسة النقد فتبنته؛ ولكن في البدء كان المبدع، فتبعه الناقد ومن ثم رسخ قواعد شكل الفن، فأصبحت قيدا، وسجنا على رؤية المبدع. أم تراها كانت مشروع رواية طويلة، وحال دون إكمالها حائل، ولكن حسنا فعل الروائي “هدرا جرجس” بروايته “بالضبط…يشبه الصورة” ومما يرجح قصدية الكاتب، تكثيفه تلك المعاني بلغة شعرية رصينة قوية.
تبدأ الحكاية بمشهد تنصيب”بخيت” “إستفانوس” أسقفا، مع فلاش باك لما عاناه حيال عنت ورفض والده سلوك طريق الرهينة.
“لابد أن يعرف الولد الناكر للنعمة أن هناك واجبا نحو هذه التجارة، وتلك الأطيان، فلمن سيصير هذا الثراء، أنه ربى وتعب لأجل أن يكون له وريث لا راهب-أم يريد الولد أن يقصم ظهره تماما.
همس بخيت بتحد:
-لكن أنا اخترت.
وهنا تلقى الضربة التي باغتته، انغرز سن العصا في عنقه”.
من تلك البدايات تتشظى الحكاية بتفاصيلها لتتناثر بشتى أنحاء النص لتكتمل الرؤية مع آخر سطر بالرواية.
لنكتشف بعد عدة سطور أن مشهد الافتتاح يسبق الآن الروائي بسنين طويلة مرت، فقد انتقل الأنبا استيفانوس، وتستعد الكنيسة للاحتفال بذكراه، فتوزع صورا للأنبا الراحل، فتقع صورة في يد الباشكاتب…إلا أن ملامح الأنبا الراهب الراحل تكاد تتطابق مع ملامح الباشكاتب فيصيح أحدهم…
“-يارب المجد…ملامحك تشبه القديس تماما…فوله وانقسمت نصفين.
هكذا هتف القسيس وهو يتطلع إلى وجه البشكاتب بدهشة وعلى شفتيه ابتسامة بلهاء، كثيرون لفتوا نظره للتشابه بينه وبين الأنبا إسنيفانوس، ولكنه كان يأخذ كلامهم على محمل الهزل، والآن فقط وبعد تجاوزه السبعين ببضعة أعوام انتبه إلى الشبه الكبير، حتى أنه لو وضع تحت وجهه لحية بيضاء طويلة صار الأنبا إستيفانوس نفسه، ومع تقدمه في العمر كان الشبه يزداد رسوخا”.
لنواجه البدايات الأولى فبخيت قبل أن يكون الأنبا استيفانوس كان شابا بأسرة مكونة من أم وأب ولقيطة تبنوها لتقوم بخدمتهم ولتتعلق بها الأم بعد موت ابنتها الطفلة”بخيته” بالطاعون.
يحاول الأب منع ابنه سلوك الرهبنة بإيقاعه بذات الفعل مع الخادمة المتبناه.
” ولكن متى بدأت غواية الحية؟
ذات يوم فتح أيوب(الأب الرافض لترهبن ابنه )في أذن الحلبية (هكذا كانوا يطلقون على الخادمة المتبناه لأن أهلها الحلب(الغجر) قد هجروها ورحلوا) سأزوجه لك…فأيوب يعتبر الحلبية هي الحل الأخير لمواجهة عناد الأرعن بخيت الذي يريد أن يترهبن ويتركه إلى حيث الدير الرابض فوق الجبل الشرقي(…)كانت تقول بصوت نادم:-
-عيب ياسيدي…حرام.
فيهمس أيوب:
-ماهو حرام…صدقي.
-ولكني حاولت.
-حاولي تاني.
-كيف…؟
-اسمعي…باكر سألهي الغندورة(الأم) في أمر خارج البيت…وأتركك معه وحدك.
-يامصيبتي…لا…لاياسيدي…ده كتير.
-والله يامريم…صدقي.
-ولكن حرام ياسيدي…حرام.
-قلت ماهو حرام…هيكون جوزك.(…) رأى الحلبية في قميص يشف عن عري كامل، فظن أنه يحلم، وفي لحظة خاطفة فكر أنه يحتاج دليلا على يقظته…قال:
-مريم؟
لم ترد، كانت واقفة عند الباب والدموع تنهمر من عينيها بلاتوقف، ومن مكانها ميزت ارتجافه(… ) حاولت الحلبية أن تقترب، ولكنه أوقفها بصرخة هستيرية هائلة، وراح يصفع وجهه ورأسه بكفيه فوق رأسه…
-اتركه يطلع الدير ياسيدي…ابنك قديس.”
لنكتشف في الفصل المعنون ب” ساحة واسعة للصلاة، مريم الحلبية” بكون الحلبية هي ذاتها أم الباشكاتب شبيه الأنبا استيفانوس. هكذا تتوازى حكايات إسماعيل الأعرج والعم منصور وحكيم الزبال وتتداخل التفاصيل لتنتهي كل نهاية حكاية بمفاجأة ولغز شبيه بلغز تشابه ملامح الباشكاتب مع استفانوس الراهب.
ينافس المكان بطولة الشخوص فلكل مكان حكاية فكيف تحولت أقدار الساحة بتتابع الأزمان والشخوص…
“قلب أيوب الساحة التي آلت بعد الجواهري إلى مخزن، وكانت ابنته بخيتة قد ماتت وقت شوطة الطاعون، فما الداعي لأن يعالج فيها الفقراء، والله نفسه لم يستجب له في شفاء بخيته، خزن فيها أجولة الغلال والعطارة، قبل أن يحولها بخيت ابنه الذي صار أسقفا إلى ملجأ، ويبني على أنقاض البيت الكبير بجانبها كنيسة. والكنيسة في تطور متلاحق، لا يمر العام إلا وكان فيها شئ جديد، العام الماضي استبدلوا الأجراس، ركبوا في المنارة أجراسا جديدة، تعمل بالكهرباء، ولا تحتاج الشد العنيف للحبال السميكة، إنما تعمل بالضغط على مفتاح واحد، لأعلى ولأسفل، فيبدأ المحرك الكهربائي الضخم في رجرجة الجرس حسب الوقت المقدر لكل معنى يحمله الرنين، المتقطع يعلن الحداد على ميت مات في المدينة، والمتواصل يعلن الاستعداد للقداس والأعياد…”
وكذلك حكاية الفندق العائم الغارق وكيف حولت الأقدار والمصائر المكان…
” هدأت الأمور، أخرجوا المركب الضخم من جوف النيل، ووضعوه على الضفة الشرقية جنب الجسر، بعد أن خلعت الشركة المالكة له محركات التشغيل، وبعض الحاجات الثمنية الأخرى، واعتبرت جسم المركب كتلة غير مفيدة من الصدأ، فظل رابضا كقصر مهجور، كانت الناس ترى الأشباح تحوم حوله، ورأى واحد منهم امرأة بيضاء كالثلج، وشعرها أصفر كالذهب، وعيناها حمراء كالدم ترطن بلغة غير مفهومة وتصرخ.
وسرعان ما نبتت الحشائش حول المركب بصورة مذهلة، حتى قاربت أن تغطيه تماما، وبدت الأرض كأنها أخرجته كما أخرجت تلك الحشائش بطريقة إلهية، حتى سمت الناس هذا المكان ب…”الهيش”…ذلك المكان المظلم المخيف الذي تحف به أرواح وذكريات الغرقى والعفاريت.
وبمرور الوقت هربت العفريتة الشقراء التي كانت تصرخ، واستسلمت باقي جحافل العفاريت لاستيلاء رواد جدد على المركب، ففرت هاربة…”
ليرتبط مصير الأبطال بالأماكن فهذا حكيم الزبال يسيطر على المركب المهجور. فيتحول من مصير لمصير…
” ومرة طار بالمجداف خلف تلميذين أمسكهما بين الحشائش، ينحني أحدهما ليمد مؤخرته العارية إلى الآخر(…) استطاع حكيم بجدارة فرض سطوته على السكان الجدد الذين استأجروا منه الكبائن المهجورة، لواطيون وهاربون ومدمنون وراغبون في ممارسة الغرام السري، وافتتح لهم سوقا صغيرا لبيع منتجات الغياب، لفافات وحقن ومسحوق أبيض له مفعول السحر(…) “عروسة النيل”…وهو الاسم الذي اختاره للمركب بالفعل فيما بعد، فعندما بشر الرئيس المؤمن بعصر الانفتاح، خرج الخفاش من عتمة المركب إلى النور فجأة، ظهر على السطح بضجة كبيرة صاخبة، وكان وقتها تاجرا مرموقا في مجاله،(…) تمسك حكيم بحلمه، تمسكه بلبسه القديم، اشترى أرض الهيش من المحافظة، وأطلال المركب من الشركة، ووضعوا له شمسية، وازالوا الصدأ، وغطوا الحيطان بخشب فاخر، وفرشوا السيراميك والسجاد، ووضعوا مناضد من الألمنيوم والزجاج، ووزعوا أصص الزرع والورد في كل مكان…”
ليستقر ظني في النهاية على كون النص كان بذرة لرواية أجيال طويلة، إلا أن مانعا ما حال دون ذلك لعله الضجر، لعله اليأس من مآلات النهايات، لعله الإصرار على التكثيف والاختصار قدر الممكن، في زمن ضاق ذرعا بالمطولات ونفد صبره.
هدرا جرجس من مواليد أسوان 1980، له من الأعمال الروائية المتميزة ك”صائد الملائكة” و”مواقيت التعري”، حاصل على جائزة دبي الثقافية، وجائزة ساويرس للأدب المصري.