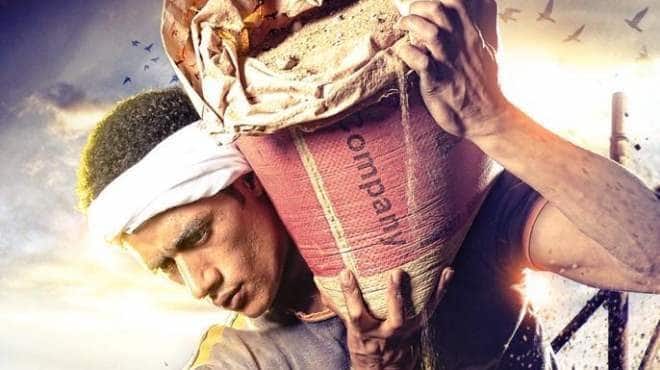أما الثاني فكان الرائع الراحل صلاح منصور “غول” التمثيل الذي أوقف دنيا السينما المصرية ولم يقعدها في “الزوجة الثانية”. وهذا النجم بالتحديد يستطيع أن يفعل أي شيء وأن يقوم بأي دور، حتى لو “قناوي”.

وسواء أكان توفيق هو الذي قام بتجسيد دور “قناوي” أو منصور، فإنه في اعتقادي لا شيء كان سيتغير للأحسن أو للأسوأ. ولكن شاهين صنع المعجزة.
صنعها لأنه “مخرج غاوي تمثيل” وليس ممثلا بالأساس. صنعها لأنه أكثر صناع الفيلم بل صناع السينما المصرية شبها بشخصية “قناوي”. دعك من قصته في محطة القطار وولهه بـ “هنومة”وعشقه لها، وكذا ثيابة الرثة وضحكته المتقطعة غير المكتملة، ونظراته الحادة، وحركته العصبية، وانظر إلى شاهين نفسه، ستجد نفس السلوكيات تقريبا.
صنعها لأنه حافظ على التوازن الإبداعي بين نفسه كممثل، وبين نفسه الأخرى كمخرج.

الغريب أنه في الوقت الذي كنت أتخيل فيه شخصية توفيق أو منصور في دور “قناوي”، اجتهدت أيضا في إيجاد شخصية ممثلة أخرى في دور “هنومة”، واستمر خيالي في التحليق، فوجدت هدى سلطان وماجدة وفاتن حمامة وشادية وسعاد حسني وغيرهن ممن عملن مع شاهين ومع غيره.
فـ”هنومة” ليست فقط الفتاة المثيرة التي يعشقها “قناوي” فتجاريه بمنطق نفعي بحت، مرة لأنه تستر عليها وقت أن كانت الشرطة تبحث عنها، وأخرى بإهدائه لها (عقدا ذهبيا)، كما أنها ليست فقط الفتاة التي ترى في “أبو سريع” والذي جسده فريد شوقي، فتى أحلامها، بل هي نفس البائعة التي نراها يوميا على المقاهي أو في الشوارع أو في البارات أو في محلات السوبر ماركت.

“هنومة” ليست هند رستم فقط، بل هي شخصية رسمها عبدالحي أديب (مؤلف الفيلم)، وأعتقد أن أي نجمة من نجمات هذا العصر كانت لتتقن الدور مثلها مثل هند رستم.
إذن البطل في “باب الحديد” ليس في تفرد شاهين (كممثل) وهند رستم، فأين البطل إذا؟
احترت في أمر عبدالحي أديب، فهو ولاشك سيناريست كبير قدم علامات كبرى مضيئة في تاريخ السينما المصرية، منها “صراع الأبطال” للمخرج توفيق صالح، و”أم العروسة” للمخرج عاطف سالم، و”امرأة في الطريق” للمخرج عز الدين ذو الفقار، اتفقنا أو اختلفنا مع بساطة تناول “سر طاقية الإخفاء” و”صغيرة على الحب” للراحل نيازي مصطفى، لكنهما يظلا علامات أيضا في تاريخ السينما، لكن أعماله الكثيرة ليست على هذا القدر، فهو من كتب أيضا “إنت اللي قتلت بابايا”، وهو من كتب “امرأة واحدة لا تكفي” و”استاكوزا” لإيناس الدغيدي في الثمانينيات والتسعينيات.

هو في باب الحديد وعلى مستوى لغة الحوار يأخذ الدرجة الكاملة برغم تأثير لغة شاهين المعروفة في حوار كل الشخصيات تقريبا، وكذا على مستوى السيناريو. قبل التترات، يبدأ الفيلم بعدد من الجمل يقولها “عم مدبولي” الذي قام بدوره العبقري حسن البارودي، عن “محطة مصر”، وعن هؤلاء الذين يلتقون فيها يوميا من شتى بقاع مصر (شرقها وغربها، صعيدها وبحريها)، بصفته بائع الجرائد الأشهر في المحطة، ثم يقطع الكلام العام إلى كلام خاص عن “قناوي” الذي يقول إنه وجده في يوم على أحد أرصفة المحطة، فقرر أن يساعده.
قبل التترات أيضا اكتشف “عم مدبولي” مرض “قناوي”، فأطلق عليه لفظ (محروم)، عندما وجد جدران غرفته الصغيرة البائسة مليئة بصور فتيات عاريات قصقصها “قناوي” من الجرائد التي يسرح بها.
هكذا بدأ الفيلم وبسرعة. اعتراف بحقيقة مرض البطل “قناوي”، وبوجود راوٍ يمسك الخطوط الدرامية من البداية إلى النهاية.
حقيقة المرض لم تتغير، بل تصاعدت بشكلها الطبيعي حتى نهاية الفيلم، عندما حاول “قناوي” قتل “هنومة” على قضبان القطار، في أكثر مشاهد السينما المصرية شهرة، إلا أن فكرة الراوي اختفت تماما، وتماهى “عم مدبولي” ضمن شخصيات وأحداث الفيلم.
بعد التترات، وفي مشاهد بسيطة، ينهي أديب الفيلم تقريبا. فـ”أبو سريع” يحاول مع العمال تكوين نقابة للعاملين بالمحطة بعد تزايد الحوادث والإصابات، كما يعلن أنه سوف يتزوج “هنومة” الجميلة. بينما نفهم أن “قناوي” ومن خلال تلصصه على “هنومة” في المشاهد الخمسة الأولى من الفيلم، أنه مغرم بها إلى حد الجنون والمرض.
عبقرية أديب ظهرت في الحقيقة في محاولته الدائمة من خلال أحداث الفيلم أن يحافظ على خيوط فيلمه الرئيسية والفرعية التي تكشفت منذ البداية. نجح في أحيان وأخفق في أحيان، لكن شاهين (كمخرج) كان سندا وعونا له بإيقاعه الصاعد والنازل وفقا لما يطلبه المشاهدون.
الفتاة التي تظهر في كل أحداث الفيلم تقريبا داخل المحطة، والتي أنهى شاهين الفيلم عليها، فكانت تنتظر حبيبها الآتي ضمن أفواج المسافرين، فمرة تلتقيه ومرة تمل من الانتظار، وأخيرة يفارقها، كانت تحت أنظار “قناوي”، ربما هو الوحيد الذي كان يشاهدها ويعرفها ويعرف حبيبها، ويفرح لفرحها، ويحزن لحزنها.
قصة هذه الفتاة ربما كانت قصة الحب التي يريدها “قناوي”، وربما كانت تحكي حدوتة الفيلم كلها بشكل موازٍ، من لقاء وانتظار ثم فراق وبكاء يصل إلى حد الصدمة، وربما تكون إحدى أفكار شاهين المتأثرة بالسينما العالمية في هذه الفترة.
الفيلم كله كان غريبا على ما كانت تقدمه السينما المصرية وقتها. لذا فشل في العرض الجماهيري. لكنه كان يمتلك كل مقومات النجاح من فريد شوقي إلى هند رستم، ليصبح لغزا كبيرا من ألغاز الجمهور المصري. ربما، وأقول ربما، لأن الفيلم في هذه الفترة كان لابد وأن يكون له بطلا، إلا أن الجمهور افتقد لفكرة البطولة في هذا الفيلم، لاسيما وأن فريد شوقي أو “أبو سريع” في الفيلم كان دروه أشبه بالدور الثانوي، وليس بطلا كما هو معروف عنه في أفلامه السابقة وخاصة التي كانت تقترب من “الأكشن”.
فالبطل في الفيلم هو “الفيلم” نفسه. لذلك لم يلق إقبالا من الجماهير الذين اعتادوا على نمط “البطولة” في نهاية الخمسينيات.