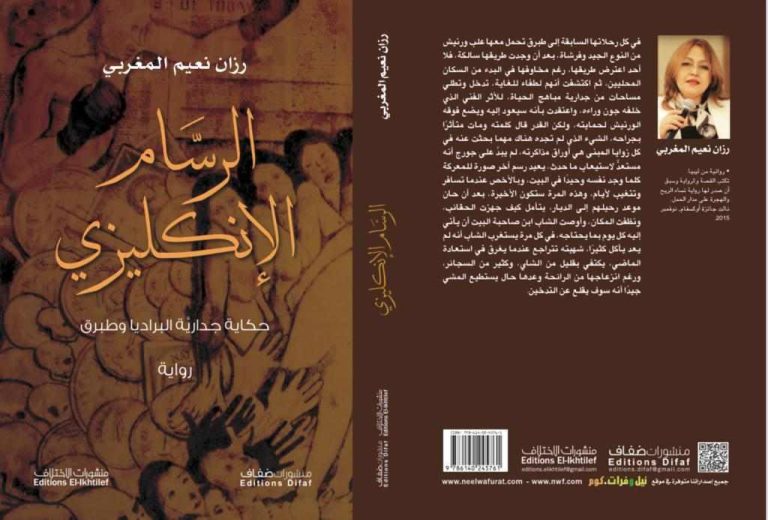ركبنا من موقف “عرب” حيث بقايا قضبان السكّة الحديد القديمة (التى مازالت تحتفظ بلمعة طفيفة) ضاقت بصخب الميدان وظلت تنزوى شيئاً فشيئاً حتى اختبأ معظمها أسفل الأقدام وكاوتش السيارات.
تحاشيت يد الصبى الذى يلّم الأجرة حين حاولت لمس ظهرى أثناء صعودنا للميكروباص. جلسنا فى كرسيين إضافيين داخل السيارة التى أُضيأت بلمبة برتقالية صغيره معلقة فى منتصفها. كان الميكروباص دافئاً من الداخل. الجميع صامتون ومعظم الركاب بجانب النوافذ أسندوا رؤوسهم للزجاج آملين فى بعض الراحة أوغارقين فى النوم.
راقبت وجهه. توقفت عند لمعة عينيه المربكة التى كادت تضىء السيارة. كانت بحدّة لمعان الأجزاء المتبقية من القضبان حين انعكست عليها إضاءة أعمدة النور الصفراء، وغسلتها الأمطار التى سقطت برفق ونحن فى الندوة. عينيه كانتا مشتتتين طوال الندوه وحركته منزعجه ساعتها قلت هذا الفتى محتاج لحضن جامد.
معظم الوقت اخمن بشكل صحيح ماذا يحتاج، من أول لحظة رأيته فيها فى قاعة الاستماع فى المكتبة الموسيقية. شكل جسده ونظرة عينيه ومشيَته. هذا الفتى لا يحتاج لسماع صوت بشرى، وإنما لأصوات آلات فقط. لكنى لم اعرف تحديدا ماذا يريد منّى بالضبط، فالأمور كانت مثل أرجوحة المركب لكن بلا فرامل، تبطئ أحيانا، وتسرع أحيانا، وأحيانا تنقلب من فرط سرعتها.
ألقى الصبى نظرة على السيارة ثم أشار بإصبعيه “2” للسائق الذى يقف بعيدا باحثاً عن ركاب، بينما واصل الصبى النظر لى من وراء الزجاج.
نشيج خافت لفت نظر جميع الركاب، نهنهة صادرة عن سيدة بدينة ترتدى جلباباً قطنياً واسعاً أسود مزركش بورود حمراء لها أوراق خضراء صغيرة وطرحة سوداء، وترقد فى حِجرها العميق طفلة صغيرة تنظر لأمّها فَزعة لا تفهم سببا لبكائها.
اكتملت السيارة وانطلقت بسرعة متوسطة وصوت خافت للمحرك على غير العادة. اندمج الصبى فى لّم الأجرة، بينما – تسّرب صوت “صالح عبد الحى” مستفسرا: لِمَ يُبهج البنفسج بينما هو من المفترض أنه زهر حزين؟ ، ودعوت ألا يغير السائق المحطه حينما يفشل فى الاجابه عن هذا السؤال الحيوى.
استرحت لأن الرجل الجالس بجوارى نام مستندا على الزجاج فاغرا فاهه بدون أى “شخير”، وبقايا دهان حائط أبيض وأخضر قد تناثر على ملابسه الباليه وقدميه بارزتى العروق .
كان صمتا مثاليا اتفق عليه الركاب، حتى السيدة التى كانت تبكى فى الخلف توقفت عن البكاء إلا من “شَنّة” تُصدرها من حين لأخر.
رأيتنى داخل بلُّورة، فالسيارة كانت مُلمّعة حديثاً وكانت أنوار الشارع تظهر من خلف الزجاج كعلامة “إكس”، واستطعت رؤية كل الكنبة التى أمامى فى زجاج : وجه نائم، ووجه يأمل فى النوم دون أن يجد ما يسند رأسه عليه، ووجه سارح، ثم من اليمين -وللخلف قليلا- وجهه.
ظللت أراقبه حتى ضُبطت متلبّسة. أدار لى وجهه فابتسمتُ وابتسمَتْ عيناه “من باب الواجب”. أمسكت أصابع يديه واقتربت منه فشعرت بعينين وراءنا تتلصصان. نظرت بنصف عين للوراء فتراجعتا، لكن نظرى اصطدم بعينى السيدة المحمرَّتين. كانت تنظر إلى وكأنها تريد إطلاعى على مصيبتها، فرددت عليها بنظرة آسفة، وتشبثتُ بيده.
عاد صوت السيدة يتردد متحشرجا مكتوما كبرطمان أحكم غلقه ولن يفتح ثانيه ، تقول لابنتها: “هنرجع إسكندرية يا حبيبتى. هنرجع لأهلنا”. بكت البنت كفأر مذعور، وبدأت الرؤوس تتحرك تطفلاً أو عطفاً، وخُفت أن يلتفت السائق ويُطفئ الراديو فنغرق جميعا فى الكآبة، لكنه لم يفعل. لعله كان معتاداً على “أحوال” الركاب. وترددت عبارات: “لا حول الله يا رب”، “ربنا معاكى يا ست”.
استطردت السيدة بحرقة: “هنعمل العملية هناك وسط أهلنا”.
صمت معظم الركاب بعد اكتشاف السر ، بينما نظر لى هو بانزعاج أسعدنى ، أخيرا تفاعل كأنه أفاق فجأة، وفجأة أيضاً انطلق صوت السيدة عالياً “على جنب هنا يا أسطى”. نزل لتعبر السيدة وابنتها وقد تسمّرت ملامحه وضاقت عيناه بنظرة تحفز، خرجت السيدة من الباب بصعوبة ولحقتها الطفلة قفزاً، بينما توقف هو لثوان أمام الباب ناظراً للسماء قبل أن يأمر الصبى: اطلع انت..!