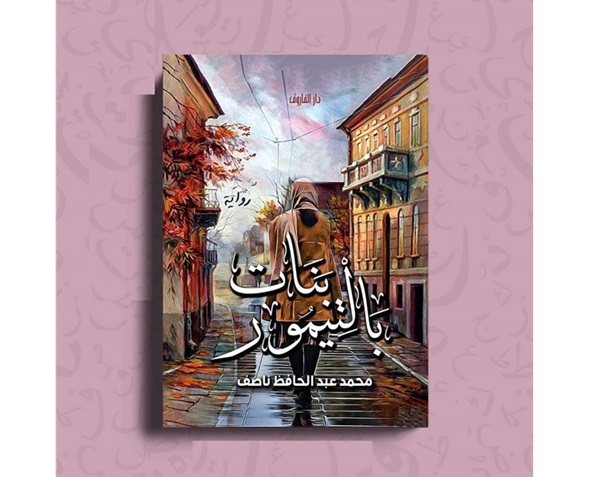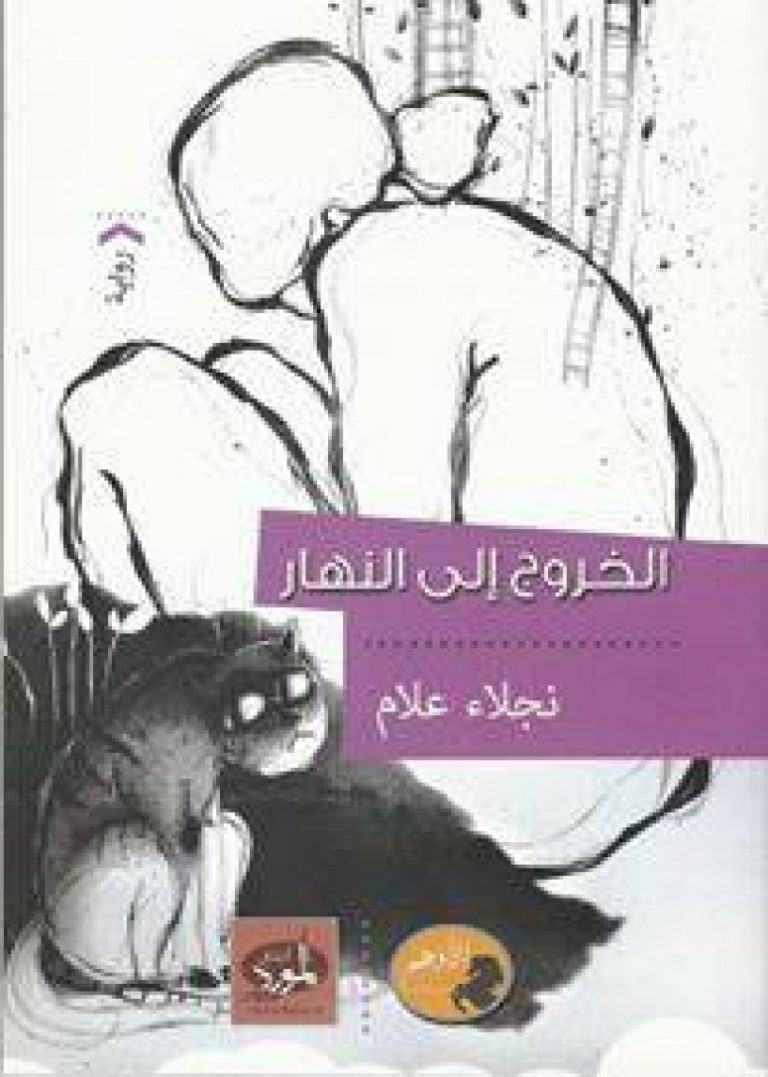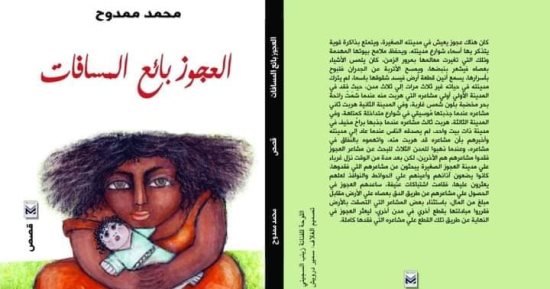د. هبة محمد عبد الفتاح
كثيرًا ما تستحوذ تلك الأعمال الروائية التي تتعامد في فكرتها مع محور ذلك الصراع الكائن بين الشرق و الغرب علي مجموعة من المشاعر المختلطة والمواقف المتباينة، تلك التي تستحث لدي القارئ التفكير في أمرها والبحث في شأنها من أجل تحديد وجهته وإلى أي الفريقين أو الحزبين ينتمي؟
إلي الفريق الأول الذي يفضل الهروب، مرتميًا في أحضان الغرب، مستسلمًا لعوامل الجذب، ساعيًا وراء مزاعم الثروة وأحلام الحرية والتحقق والمجد، أم إلي الفريق الثاني الذي يصارع نفسه من أجل البقاء في الأرض، والتشبث بجذور الهوية ومنابت الفروع والأصل.
بين هذا الفريق وذاك تأتي رواية “بنات بالتيمور” لمحمد عبد الحافظ ناصف لتخوض في تفاصيل ذلك الاختيار.. تضع المتلقي أمام ذلك المحك القائم بين الشرق في نموذجه مصر، والغرب في نموذجه أمريكا، تفتح أمامه الباب الذي لم يغلق وتعيد عليه نفس نفسه..
العيش هنا أم الهروب إلى هناك؟ الحياة هنا أم الجنة الزائفة هناك؟
يتم تقسيم الرواية بحرفية متقنة إلي خطين سرديين، يرمز كل خط لأحد الفريقين، تمثل شخصية “فاروق” الفريق الأول، فهو الرجل المصري الأصل الأمريكي الجنسية الذي سافر إلي أمريكا منذ أكثر من ربع قرن هربًا من عبء واحد في مصر، ليجد نفسه محملاً بعدة أعباء في أمريكا آخذا معه بناته الثلاث وابنه إلي تلك الهوة السحيقة الحائرة، فصار الابن المراهق محاطًا بالقيود في مجتمع حر مفتوح يستطلبه ويريده، وصارت البنات كالحوريات اللاتي ينتظرن من يأتي إلي جنتهن ويطرق بابهن بعد أن تحولت علاقاتهن العاطفية من جانب الأب الحائر القلق إلى مشاريع زواجٍ موضوعة ومقدمة للعرض والطلب.
بينما يرمز الخط السردي الثاني للفريق الآخر ويمثله الشاب المصري “حسن” ابن التربة المصرية/ مدينة المحلة الذي يكافح والده ليجعله من الناجحين، فيقرر أن يسافر في طلب العلم ليعود لوطنه كما أوصاه والده، فيقول متذكرًا كلام أبيه وهو في أمريكا: “عد رجلًا كما ذهبت” فيقول: “سأعود كما تحب يا أبي”.
يتناغم المشهد السردي بتطعيمات وتنويعات تتسم بالمصداقية والتوازن الشديد في وصف الواقع الأمريكي في طقوسه وممارساته، وكذلك الغوص في الواقع المصري في كل تقاليده وأصوله استطاع من خلالها محمد عبد الحافظ ناصف أن يبرز مقدرته العالية علي الوصف والتعبير والإبحار في جنبات هذين العالمين بتؤدة شديدة وتأنٍ ملحوظ نقل لنا الصورة بأمانة واقعية وحرص مقصود.
فكما رأينا جامعة بالتيمور بأنشطتها ومبانيها وتعاملات الطلبة والمعلمين داخلها من عنصرية متطرفة، إلى ليبرالية متفتحة وشمولية تسعي لأن تقبل الجميع. رأينا أيضًا مصر بشوارعها وحواريها الضيقة، دخلنا إلى دواوينها الحكومية وعشنا مع الأهل في الريف ليلة الدخلة وترقبنا قماشة الشرف.. تنسمنا روائح الريف وأعجبنا بالدكش الذي يرفض الصدقة رغم حاجته ويقبل الزكاة لأنها حقه.. سمعنا أغاني عبد الحليم ودخلنا سينما النصر وتعاطفنا مع دعوات عم صاوي الطيبة.
ومثلما صعدنا مع حسن تمثال الحرية في رحلته الشاقة من القاعدة إلى الشعلة، سافرنا معه أيضًا من المحلة إلى القاهرة وركبنا معه الطائرة في سرد مشهدي ينقل تفاصيل كل ذلك لحظة بلحظة وتفصيلة بأخرى.
ولا يغيب عن رسم ذلك المشهد الدرامي تلك اللغة التي عملت على تضفير ذلك بانسيابية ويسر، يعلوها أحيانًا ذلك الطابع الديني ما جعل المفردات تبدو وكأنها تنطلق حقيقة من أفواه المصريين الطيبين المتوكلين علي الله والمتحاملين على أنفسهم رغم الصعاب، حيث نلمح “ربنا معاك.. سيبها لله… ونعم بالله… نعمل ما علينا والباقي علي الله”.
وعلي الرغم من أن محمد ناصف كان حريصًا على جعل المشهدين في مصر وأمريكا متعادلين، ونقل الصورة والسير مع الخطين الدراميين بحرص وأمانة واضعًا أمام المتلقي كل ما لهما وما عليهما، بما يجعل المتلقي لا يكره الواقع الأمريكي كله ولكن يدين بعضه، ولا يعجب أيضًا بالواقع المصري كله ولكنه ينتقد الكثير منه ويحزن له. فإنه مع ذلك وضع علامات في السرد تشي بالمكنون داخله وتكشف عن لا وعيه المحرك له.
فهو المصري الصميم الذي خاض نفس الأحداث وعاش ذات التجربة، تربي في المحلة مثل حسن وسافر في بعثة تابعة لوزارة التربية والتعليم مثله، فليس غريبًا أن يجعل من تلك الشخصية المحورية “حسن” رمزًا له ولكل مصري ألحت عليه مصريته ووفاؤه برسالته وحبه لوطنه ولأهله فأراد أن يعود إليه على الرغم من كل مغريات في أمريكا من زواج.. ثروة.. جنسية وما إلى ذلك.
إن الهوية معقودة في السرد كامنة في مرجعيته الثقافية، تأبي علي الكاتب إلا أن ينتصر لها ولمصريته، فيضع لبطله من السمات ما يجعله النموذج المثالي، يرسم له من الملامح ما يؤهله للتحدي والمقاومة والرفض؛ فهو يرفض الخمور في أمريكا.. يصوم رمضان.. يصلي الفروض.. ويمتنع عن تناول اللحوم لأنها لم تذبح طبقًا للشريعة.. ينازع حبه لإحدى البنات/ الحوريات، مؤثرًا الهروب من جنة بالتيمور على البقاء فيها كسجنٍ أسير لا أمل بعد ذلك في الخروج منه.