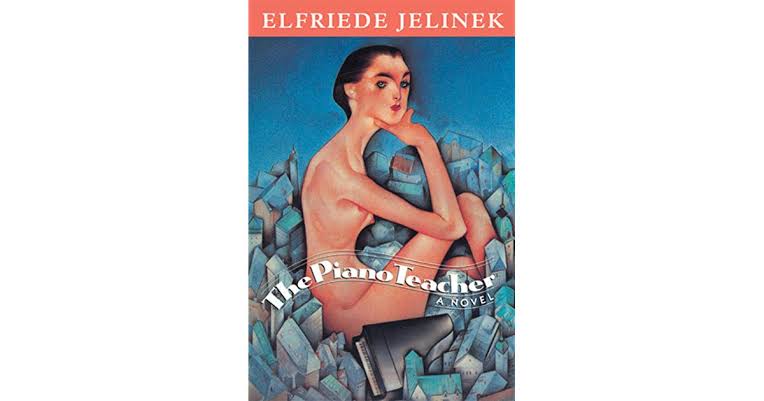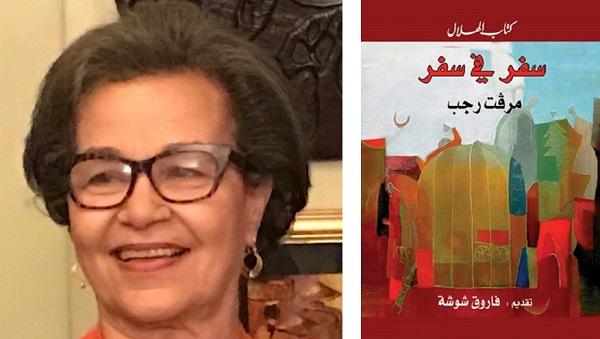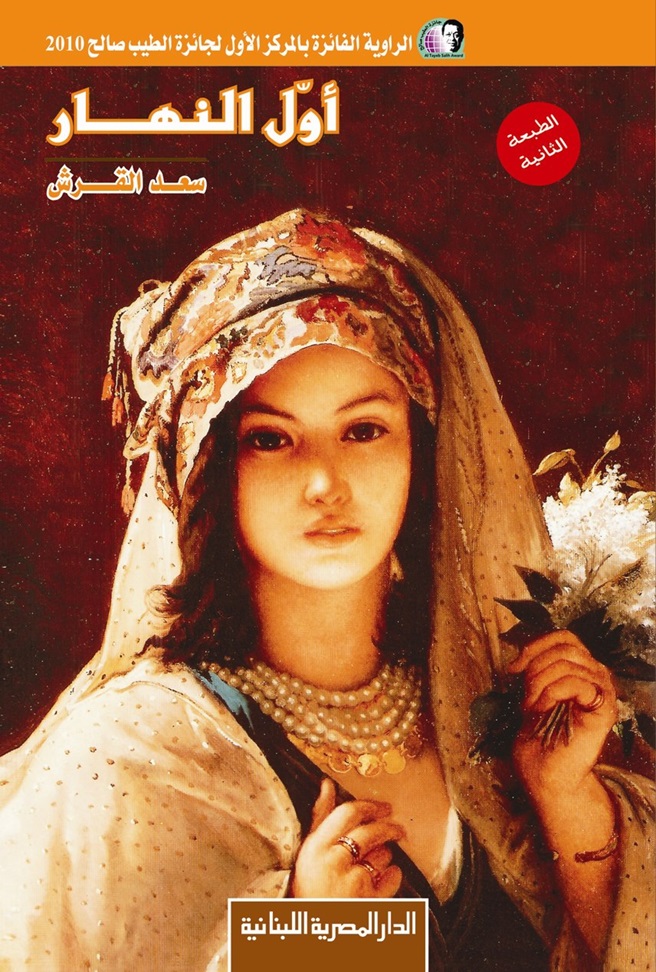أمل سالم
في ديوانه “صاحب مقام”، الصادر عن منشورات بتانة، عام 2024م، يضعنا مسعود شومان أمام عالم صوفي خالص ومتكامل بدءًا من العنوان ذاته الذي ينهل من معجم الروحانيات، حيث تُحيل لفظة “المقام” إلى تراث صوفي شديد الخصوصية، وإلى فضاء رمزي تتجاذبه المعاني الروحية والدلالات الثقافية. ويتجلى هذا المنحى في عناوين نصوص الديوان العشرة، التي تستدعي أسماء أولياء الله؛ مثل: الشاذلي، شيخ العرب، سيدي إسماعيل…، على نحو يجعل النصوص في ديمومة مشدودة بتقاليد الذاكرتين الشعبية والدينية معًا، ومتجاوزة التجربة الفردية إلى أفق جماعي متوارث. ويستطيع القارئ أن يتوقع من العنوان صدى تجليات النفري – صاحب المواقف والمخاطبات – قبل أن ينفذ إلى عمق النصوص وعوالمها، بما يرسخ الطابع الحواري والوجداني الذي يشدّ النصوص إلى بعديها الصوفي والرمزي معًا. لكن خصوصية هذه النصوص لا تقف عند استدعاء الأسماء والرموز، بل تمتد إلى بنيتها الداخلية؛ إذ نجدها تتحرك في منطقة التماس بين الشعر والسرد، بين العامية والفصحى، وبين الذاتي والجمعي في آن. هذا التداخل لا يُنتج نصًا هجينًا فحسب، بل يفتح أفقًا جديدًا لكتابة شعرية تسعى إلى تجاوز التصنيفات التقليدية. من هنا يتشكل ما يمكن أن نطلق عليه “الجماعية النصية”، أي النصوص التي تنبني على تعدد الأصوات وتنوع المرجعيات، فتغدو قريبة من مفهوم الحوارية كما بلورها النقد الحديث.
هذا البناء يجعل القارئ أمام طقس احتفالي يحاكي الموالد والإنشاد الصوفي على نحو دقيق؛ حيث تتجاور الأصوات، وتتداخل الإيقاعات، وتتشابك الحكايات في ما يشبه السرد الشعائري. ولعل في ذلك ما يعيد إنتاج التجربة الصوفية الشعبية داخل النص المكتوب، بحيث يصبح القارئ مشاركًا لا مجرد متلقٍ، وكأنه في قلب المولد أو الحضرة، يسمع ويردد ويشارك في صناعة الإيقاع الجمعي.
إن قراءة ديوان “صاحب مقام” – الذي تبدأ فيه الذات الشاعرة باستطلاع مقامها بين مقامات الأولياء – تضعنا أمام ضرورة الوعي بالمقام في ذاته، وبأصحابه في مقاماتهم المختلفة. فالنصوص، بحمولتها الرمزية والإيقاعية، تكشف حاجتها الملحة إلى إضاءة الأنساق المضمرة بين الصوت الفردي وصوت الجماعة. وهنا تتبدى قيمة المقام ليس كفضاء روحي وحسب، بل كبنية ثقافية تعيد ترتيب العلاقة بين المجتمع والذاكرة، وبين السلطة والهامش، وبين التجربة الفردية والجماعية.
كما أن هذه النصوص، بطبيعتها، تقبل أن تُقرأ في ضوء تعدد طرائق التعبير وتنوع الأصوات، وفق العلاقات الداخلية التي تنسجها، مع مراعاة آليات التفاعل بين الملفوظ وسياقه في كل نص على حدة، وفي التشكيل الجمعي للنصوص معًا. ولأنها صيغت على نحوٍ يجعلها تنفتح على السماع الشفاهي الذي يتيح إعادة إنتاجها في كل قراءة أو إنشاد، فإنها تدفع المتلقي إلى المشاركة الفعلية في بناء معناها. ومن ثم، فإن النص لا يُستهلك مرة واحدة، بل يولد من جديد مع كل قراءة أو أداء.
بهذا المعنى، تصبح نصوص “صاحب مقام” تجربة وجودية قبل أن تكون تجربة جمالية؛ إذ تستمد قوتها من كونها سجلًا للهوية والذاكرة الجمعية، ومرآة لوجدان شعبي ظل عبر العصور يبحث عن ملاذه في المقامات والأضرحة والطقوس، أكثر مما يبحث عنه في النصوص المكتوبة وحدها.
– المقام في بنية الذاكرة الشعبية
يشغل المقام في المخيلة الشعبية والصوفية مكانة تتجاوز حدود الجغرافيا إلى فضاء رمزي رحب، فتاريخيًا، ارتبط مفهوم المقام بذكرى الأولياء والمتصوفة الكبار الذين مثّلوا في الوجدان الشعبي رموزًا للكرامة الروحية والحماية، وملاذًا للمقهورين والباحثين عن العزاء. ومن هنا جاءت مقولة إن “المقام حياة”، لأنه يمنح زائريه شعورًا بالطمأنينة والانتماء. ولذلك انتشرت المقامات في مصر والمشرق والمغرب على السواء، وصارت جزءًا لا يتجزأ من المشهد الثقافي والطقوسي، بما يحمله من أبعاد روحية وجمالية تسهم في إعادة إنتاج الهوية الشعبية عبر الأجيال.
– المقام كامتداد للقداسة في المخيلة الجمعية المصرية
حين نتأمل انتشار المقامات والأضرحة في مصر، ندرك أن هذه الظاهرة ليست حكرًا على الإسلام أو التصوف، بل تمثل امتدادًا لميول راسخة – في الثقافة المصرية القديمة – إلى تقديس الشخصيات الروحية، وبناء أماكن للزيارة والاتصال بالعالم الآخر. فالمصري القديم قدّس آلهة متعددة مثل: إيزيس وأوزوريس وحورس وحتحور وآمون…، وشيد لها المعابد، وفي الوقت نفسه احتفى بالأبطال والملوك الذين اكتسبوا قداسة بعد موتهم. ويعدّ أوزوريس المثال الأبرز على هذا التحول، إذ أصبح رمزًا للبعث والحياة بعد الموت، ومركزًا لطقوس دينية وشعبية ظلت ممتدة قرونًا. كما أن كل مقاطعة مصرية في فترات من التاريخ كان لها معبودها الخاص، ورمزها الذي يجسد شخصيتها الثقافية والدينية.
هذا التعدد في الرموز والمقدسات يجد صداه في العصور اللاحقة، حيث تحول من تعدد الآلهة إلى تعدد المقامات والأولياء داخل إطار التوحيد الإسلامي. وبذلك استمر حضور “المقدس” في المخيلة المصرية، لكنه تبدل في رموزه وصوره، ليصبح المقام هو الشكل الشعبي لاستمرار العلاقة مع القداسة، ولتظل مصر أرضًا تعيد إنتاج طقوسها الروحية عبر العصور.
هذه الرغبة في تجسيد القداسة في مكان، سواء كان معبدًا أو مقامًا، بقيت راسخة في المخيلة الجمعية المصرية، وانتقلت بدورها إلى الديانة المسيحية عندما دخلت مصر واستوطنت فيها؛ فكان الآباء الكهنة، وبعد موتهم، يُحاطون بالتقديس ويُحتفظ بأجزاء من رفاتهم، ويتقرب الناس إلى قبورهم وأضرحتهم. ومع دخول الإسلام وانتشار التصوف، حلت المساجد محل المعابد كأماكن للقداسة، وتحوّل تقديس الآلهة القديمة إلى تبجيل الأولياء والعارفين، ليصبح “المقام” هو الشكل الإسلامي الشعبي لاستمرار القداسة نفسها.
والتعدد الذي ميّز الديانة المصرية القديمة، من حيث الآلهة والرموز والطقوس، وجد صداه في مصر الإسلامية في تعدد المقامات وتنوع الأولياء. وبدلًا من إله الحكمة وآلهة الخصب ومعبود الشمس، ظهر الشاذلي بوصفه “قطب الزمان” و”شيخ العارفين”، كما أسماه أتباعه، ليغدو في المخيلة الشعبية رمزًا للعصمة والنجاة من الفتن، وملاذًا للباحث عن السكينة.
ويعكس ديوان “صاحب مقام” هذه الرؤية؛ يقول في نص “الشاذلي”، ص 19:
“صاحب مقام ع الجبل بإيدي أنا اللي بانيه
وتحته نايمة عِمتي واخدة خضار لَبَنيه
ساكن في ريحي الندى والضلة حاضنه بنيه”.
في هذا المقطع يتقارب الشاعر مع الولي تقاربًا يوازيه تقارب عناصر الطبيعة ذاتها معه؛ فالندى والظل يحتضنان مقامه، وكأن الطبيعة تعلن خضوعها لقداسته، وهو ما يبرز امتداد الحس الجمعي المصري في التعامل مع “المكان المقدس” بوصفه مركزًا يلتقي عنده الروحي والإنساني والطبيعي.
ويجيء السيد البدوي، شيخ العرب والملثم وأبو الفتيان…، رمزًا للكرامة والبطولة، فلا سيد له إلا هو. إذ تصوره الذات الشاعرة سيدًا على ذاته، مكتفيًا بروحه، يقول في نص بعنوان “شيخ العرب”، ص 25:
“سيد على روحه وشايل مهجته في عصاه
بيجن له رمل الطريق ولا عمره مره عصاه
بيِعب م النور اللي متْلَتِم ودموع الندم فعصاه”.
ويستدعيه النص بوصفه حاميًا وملاذًا، حيث يقف شامخًا كالحصن في وجه المظالم، ويعكس حضوره صورة البطل الذي لا يتزحزح، فيقول:
“أربع سنين ماشي وشايل كفنه
ولكل رجل عنين
بس اللي عارف يبقى عارف فين”
غير أن صورة البدوي لا تقتصر على ملامح القوة والبطولة، بل تمتد إلى رقة الصوفي ودموعه، فيغدو قلبه رماحًا، ودمعه فرسانًا، بما يجسد المزج بين الصلابة الروحية والحنوّ الإنساني، فيقول:
“قلبه حصان رماح والدمع فرسانه
تحت السما يكتب ويقرا”.
وبذلك يجمع السيد البدوي بين صفتين متناقضتين ظاهريًا ومتآلفتين جوهريًا: صفة البطل المحارب وصورة العارف الصوفي. وهو ما يعكس طبيعة المخيلة الشعبية التي تجعل من مقامه فضاء للبطولة والحماية والبركة في آن.
أما عن أبو العباس المرسي فقد قدمته النص محتفيًا به كرمز للعلم والتصوف العميق، غير أنه يحضر في النص باسمه الشعبي القريب من الوجدان: “المرسي أبو العباس”، وليس باسمه الحقيقي “أبو العباس المرسي”، يقول الشاعر في نص “المرسي أبو العباس”، ص71:
“الحزن ويا الغرام طول عمرهم أليفين
والحق ويّا الحقيقة بيبدأوا بألفين
تايه وروحي مش عارفه طريقها لفين
أنا كنت زيك وتوبي واكله المطر والبرد”.
هنا تتجلى صورة الولي بوصفه إنسانًا خبر الألم والتيه قبل أن يهتدي إلى مقام الطمأنينة.
ويظهر أبو العباس في النص كهادٍ ومرشد، للناس عامة وللمريدين خاصة، ومهتدٍ أحيانًا، والذات الشاعرة في مقام المريد، والقمر في مقام الأنس، إذ يأخذ بيده من الظلمات إلى النور في تناص غير مباشر “تناص الدلالة” مع الآية القرآنية: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور)، فيقول:
“ياله يا عبدالله لم الوجع م الموج
وخلي قلبك يدلك ع الطريق وامشي
كانت ضلام بس القمر ونَّاس
ياخد بإيد المرسى أبو العباس”.
ويتجلى الولي أيضًا في صفة الرحيم على الضعفاء – الأيتام – حيث يقترن حضوره بالعطاء والحنو، في مشهد شعري يمزج بين القداسة والإنسانية:
“وجنينة الآيتام صحيت وباست إيده
قرا لها ورد المحبه والليل طرح قمرين”
بهذا يصبح المرسي أبو العباس في الديوان نموذجًا للولي العالم، المرشد، الرحيم، الذي يجمع بين صرامة الطريق الصوفي وحنان الأبوة الروحية، فيلتف حوله الناس كما يلتف المريدون حول شيخهم.
وتجيء السيدة نفيسة رمزًا للولاية والعلم، فقد سماها الشاعر “نفيسة العلوم”، فقال في (ص 81):
“يا نفيسة العلم والدارين
سكنتي والقلوب ماسكين
في كتابك اللي اصفّر
على إيدك ونام مسكين”.
وهي في النص صاحبة معرفة ربانية، اشتهرت بالعلم والفقه والتفسير. ويُلمّح الشاعر إلى مفهوم القداسة والاختيار الإلهي في مقامها، إذ يقول:
“جالها النبى فى المنام واتفضت الحسبه
ابني هنا التُربه
بيتك يكون أرض مصر وأرضها زعفران”.
وهذا يشير إلى أن مقامها في مصر اختيار رباني، جعل الأرض التي تحتضنها مقدسة كأنها زعفران. كما تمثل السيدة نفيسة أمانًا ومأوى للغريب؛ فهي رمز للملاذ الذي لا يُخذل من يلجأ إليه، في إشارة إليها وإلى أرض مصر في آن:
“جالي الجواب م الحبيب
وصلت إشارة المكان
هنا الغريب مضمون
ترابها أصل الكون”.
وتغدو في المخيلة الشعبية محبوبة المصريين وملجأ الأيتام، إذ تُخرجها الذات الشاعرة من القبر لتضعها في مكانتها الشعبية الحقيقية، في قلوب المصريين ووجدانهم، لتبقى مصدرًا للنور الروحي:
“مع السلامة يا زينة ويا بُهرج ويا ألوان
مع السلامة يا ليل بلا عنوان
والطاهره تسكن فى روحنا تنور الأبدان”.
ويُبرر النص عشق المصريين لها من خلال نسبها الشريف، إذ هي حفيدة الحسن بن علي، الأمر الذي يرفع منزلتها الروحية ويمنحها موقعها المميز بين الأولياء:
“يا مؤتمن حاسب عليها
جدها سيدنا الحسن
قمره نحيله وسنها بيقول خمستاشر
من هنا عطر الحسين
وعريسها من ريحته”.
بهذا تتجلى السيدة نفيسة في الديوان جامعةً بين القداسة والنسب الشريف، وبين العلم والبركة، لتصبح رمزًا للولاية والعلم، وملاذًا روحيًا يعبّر عن عمق المخيلة الشعبية المصرية في حب الأولياء.
أما الحسين، فهو سيد شهداء أهل الجنة، وقد جاء في الديوان رمزًا للشهادة والفداء والتضحية، إذ غدا دمه خالدًا للعدل والحق، يقول الشاعر في نص “سيد الشهدا”، (ص 37):
“شاهد ياليل على الجراح
والسما شاهدة
على السيوف اللي من دم الحسين بتقطّر”.
فالحسين هنا إمام الحق في مواجهة الظلم، وصوته رمز دائم لا يخبو مهما حاول الاستبداد إسكاته:
“في يوم عاشورا الدم بيزهّر
ما تحسبوش الحق يوم هايموت”.
وهو في النص مثال واضح للخلود في الذاكرة الجمعية، إذ يبقى حيًا في وجدان الأمة، رمزًا للشجاعة والاطمئنان، وللمقاومة ضد السلطة الجائرة. إن صوته يتجاوز اللحظة التاريخية ليصبح نسقًا مقاومًا متجددًا، وبطلًا حاضرًا في النصوص وفي الذاكرة، يقول:
“يا سيد الشهدا يا ساكن مصر
أنا من هنا لكن بلادي بعيده
بلحس في جرحي الغربة عن خلاني
صوتك ناداني
وجيت أزورك واشتكي لروحي
جوعي وفقري وقهرتي وعدمي”.
بهذا تتجلى صورة الحسين في الديوان بوصفه رمزًا كونيًا للعدل والمقاومة، وصوتًا خالدًا يستمد منه الناس عزاءهم وطاقتهم الروحية، مما يجعل “سيد الشهداء” مقامًا أبديًا للحرية والكرامة في الوجدان الجمعي.
– المقام دلالة وتحولات
إن استدعاء المقام في الشعر المعاصر – كما فعل مسعود شومان في ديوانه “صاحب مقام”– لا يقتصر على حضور صورة الولي أو المزار، بل يستدعي رصيدًا هائلًا من الدلالات الثقافية والتاريخية، ويفتحه على أفق حواري جديد يربط بين النص الشعري والموروث الروحي.
– المقام كجسد شعري
النصوص في ديوان “صاحب مقام” لا تكتفي باستدعاء صورة المقام، بل تعيد بناءه على مستوى الشكل الفني ذاته. فالقصيدة تُصاغ كأنها مقام جديد، لها عتبة أشبه بالباب الذي يُفضي إلى الداخل، وفضاء داخلي يتسع لتعدد الأصوات وتداخل الإيقاعات، ثم ختام يشبه طقس الزيارة أو التبرك. وهكذا يتحول النص إلى مقام يُزار لا بالأقدام بل بالقراءة والإنشاد.
وتتجلى هذه الطقوسية في البنية الشعرية، إذ غالبًا ما تبدأ النصوص بالنداء أو الاستدعاء، في صيغة أقرب إلى المناجاة أو الدعاء، كما في افتتاحية نص “فاطمة النبوية”، (ص 64):
“يا بنت سيدنا الحسين يا فاطمة يا نبويه
أنا جاي أزورك والدموع على كمي”.
حيث يُفتح النص بباب الزيارة، ويُدخل القارئ في أجواء الحضرة. ثم تنبسط النصوص في فضاء داخلي يحتشد بالأصوات والرموز والتناصات الشعبية والدينية، بما يشبه صخب الموالد أو حلقات الذكر، لتُعيد إنتاج الأجواء الطقسية. وأخيرًا، يُختم النص بالبركة أو الدعاء أو إشارة إلى مقام الولي، وهكذا في معظم النصوص، كما في ختام نص “السيدة نفيسة” (ص 88):
“والطاهره تسكن في روحنا تنوّر الأبدان
وودعوها الحبايب وما اشتروش الأحزان
وقالولها بالعين اللي نامت في حمى الرحمن”.
بهذا المعنى، يغدو النص الشعري مقامًا رمزيًا وروحيًا في آن، تُمارَس فيه القراءة بوصفها زيارة، والإنصات بوصفه تبركًا، مما يعيد إلى الشعر وظيفته الطقسية التي تتجاوز حدود الجماليات اللغوية إلى المشاركة الوجدانية والجماعية.
وإذا وضعنا هذا البناء الطقوسي في سياق الشعر العربي الحديث، سنجد أن مسعود شومان يقترب – بطريقته الخاصة – من مشاريع شعرية حاولت إعادة الشعر إلى فضائه الأول كطقس جماعي. فصلاح عبد الصبور مثلًا في “مأساة الحلاج” جعل القصيدة أشبه بالحضرة الصوفية حيث تتجاور الأصوات وتتقاطع مع النصوص التراثية، فيما عمد أدونيس في “كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل” إلى بناء نصوص طقسية تستند إلى التكرار والاستدعاء بوصفهما بنية روحية. لكن شومان يضيف خصوصية مصرية واضحة؛ إذ ينقل الموالد والمقامات الشعبية إلى فضاء الشعر، ليعيد إلى النص حيويته الشعبية وارتباطه الوثيق بالذاكرة الجمعية.
– المقام فضاء وجداني
في ديوان “صاحب مقام”، يُقدَّم المقام فضاءً روحيًا رحبًا يتسع للتطهر والاعتراف وإعادة إنتاج العلاقة بين الفرد والجماعة. ففي نص “فاطمة النبوية” يقول الشاعر (ص 64):
“يا بنت سيدنا الحسين يا فاطمه يا نبويه
أنا جاى أزورك والدموع على كمي
واملي عين بطلعتك يا بهيه
وآخد حفان النور واوديه لامي
عاجزه ومحرومه ونورك يبقى عكازها”.
هذا النص يكشف أن الزيارة للمقام ليست مجرد أداء طقسي، بل فعل وجداني يتأسس على الدموع والاعتراف بالعجز، حيث تتحول البركة إلى عكاز رمزي يحمل الضعفاء ويمنحهم القدرة على مواجهة الحياة. وهنا يصبح المقام فضاءً ديناميًا يجاوز حدوده المكانية، ليصير أفقًا روحيًا وجماعيًا يستمد منه الأفراد قوتهم، ويجد فيه المهمشون عزاءهم.
بهذا المعنى، يتشكل المقام في شعر مسعود شومان كفضاء متحرك. إنه ليس مكانًا جامدًا، بل فضاء رمزي تتجدد فيه الذاكرة الجمعية عبر الزيارة، ويتجدد فيه الشعر نفسه كطقس إنساني وروحي.
– المقام المقاوم
إن استدعاء المقام في نصوص ديوان “صاحب مقام” يكشف عن شكل من أشكال المقاومة الصامتة للهيمنة الثقافية، إذ يضع المهمشين والبسطاء في مركز السردية، بعد أن كانوا على هامشها. فالمقام – في المخيلة الجمعية – هو مكان الهامش، حيث يتجمع الفقراء والمحرومون طلبًا للبركة، لكنه في نص “صاحب مقام” يتحول إلى مركز رمزي يعيد توزيع المعنى، ويمنح هؤلاء مكانًا في قلب النصوص.
يقول الشاعر في نص “عبد الرحيم القناوي”، (ص56):
“وسيدى عبد الرحيم تحت السما هايم
بيقول يا نور فينك؟
إحنا حبايبك صب كاس العافيه
إحنا مريدينك وعارفينك”.
في هذا المقطع يتجلى عبد الرحيم القناوي بوصفه صوتًا حيًا يخاطب المريدين، لا في مقام الواعظ أو الفقيه، بل في صورة المحب القريب، الذي يمنحهم “العافية” بوصفها عطية روحية تبعث الطمأنينة. وهنا يعيد النص صياغة صورة الولي كملاذ شعبي يقاوم القهر واليأس عبر الحب والرحمة.
من هذا المنطلق، يمكن القول إن مسعود شومان أعاد تشكيل مفهوم المقام في ديوانه، محوّلاً إياه من مكان ثابت مرتبط بالتاريخ الديني، إلى ذاكرة شعبية متحركة، وإلى فضاء شعري ينفتح على الحوار بين الفرد والجماعة، وبين الرمزي واليومي، وبين المقاومة الروحية والواقع المادي.
وبذلك فإن ديوان “صاحب مقام” لا يمكن قراءته بوصفه مجرد مجموعة شعرية، بل هو مشروع شعري وثقافي، يعيد الاعتبار للهامش، ويُعلي من صوت الجماعة، ويحوّل الذاكرة الشعبية إلى نص شعري مفتوح على الحوار والمقاومة. إنه نص يُعيد للأولياء حضورهم، وللشعر وظيفته الطقسية، وللمتلقي دوره الفاعل في إعادة إنتاج المعنى.