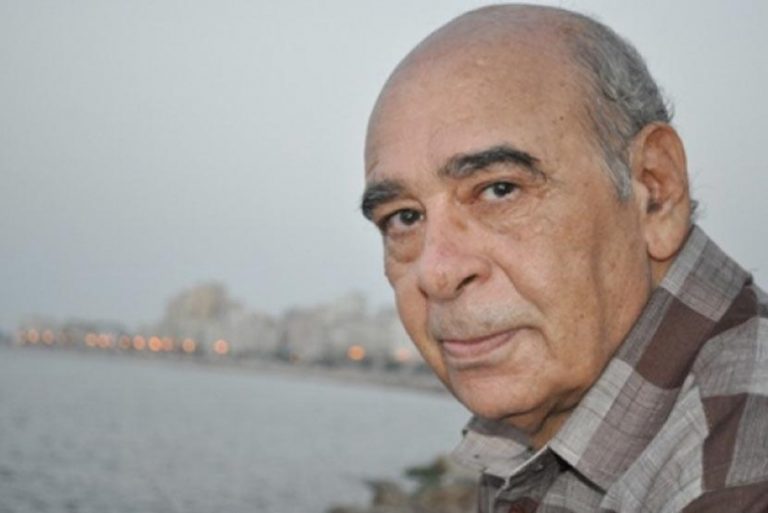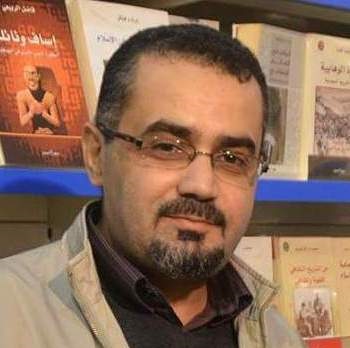-هو محمد راتب النابلسي- كانت الحلقة التي صادفها تتناول اسما من أسماء الله الحسنى “الخلاق”. تناول الرجل هذه الصفة الإلهية في علاقتها ببعض الظواهر الكونية التي تشير إلى عظمة الخالق تعالى من خلال المعطيات العلمية الدقيقة التي ذكرها. تأثر حسن كثيرا عندما سمع بعض المعلومات المتعلقة ب”المشيمة” ودور جهاز فيها يسمى “الحاجز العاقل”، وهو المسؤول عن نقل كل ما يحتاج إليه الجنين من دم الأم إلى دمه، وهو المسؤول عن صد كل ما يضر في دم الأم كي لا يتسرب إلى دم الجنين. وسمي هذا الحاجز بالعاقل لأن هذه المهمة لو أنيطت بأمهر أطباء الأجنة لمات الجنين.
فجأة تذكر حسن أمرا قطع عليه ما كان فيه من تركيز: لا يوجد خبز في البيت! جمع جسده المتهالك ونهض. كان عليه أن يذهب إلى الحي المجاور ليشتري خبزه المفضل قبل حلول الظلام، فالأحياء المجاورة هي فضاءات ينتفي فيها الأمان مع قدوم الليل: أزقة ضيقة بتصميم عشوائي يجعلك تدخل بعضها فلا تجد له مخرجا. أغلب المباني حمراء بلون الآجر، تبدو عارية كأنها مسخ كشف عن جسده القبيح، فتجلى في صورة تبعث على القرف.. ينتشر في الزوايا والعتبات المظلمة، شباب بمختلف الأعمار، منهمكون في أشغال يدوية متداولة بشكل كبير في هذه الأحياء: من برم للحشيش إلى ملء كيس بلاستيك بسائل الدوليو، إلى إفراغ أنواع من الكولا على خرقة يشمونها.. إنها حفلة الليل، تحضرها مخلوقات ليلية تبدأ بالظهور مع حلول الظلام.
لذلك كان على حسن أن يخترق هذه الممرات قبل الغروب. الطريق مزدحم بحركة دائبة لوجوه ما زالت آثار البداوة متمسكة بأغلبها، بلباس يختلف من شخص لآخر، ويتوحد في سمة بارزة هي انعدام التناسق وغياب الإحساس بالذوق. جحافل من البشر أغلبهم نساء، متفاوتات الأعمار والأبدان والألوان.. دفعتهن الحاجة وقلة الحيلة إلى هذه المدينة، فوفدن عليها دون سابق إنذار، ودون استئذان! تماما كما يحصل عندما تأتيك مجموعات من الضيوف دون إخطار، فتقف مندهشا لا تحرك ساكنا: لا المكان يسعهم ولا الأكل يكفيهم، ولا من يقوم على خدمتهم.. ذلك شأن هذه المدينة، أنشأت بها منطقتين صناعيتين، ونشطت بها الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزاد موقعها القريب من أوروبا من تنامي هذه الأنشطة، وتبعا لقانون السببية والحتمية، فقد عرفت المدينة توافد اليد العاملة من كل حدب وصوب، وبأعداد كبيرة ما فتأت تتزايد بتزايد المشاريع واتساع رقعتها.
في مقابل هذا الواقع الجديد الذي عرفته المدينة، بتحولها إلى مدينة بمواصفات المدن الكبرى -ديموغرافيا على الأقل- وهو واقع متوقع بحكم كل ما عاشته هذه المدينة من خطوات تمشي بها في هذا الاتجاه. تبدو وكأنها تنمو كما ينمو العليق البري، لا يمكن توقع وجهته ولا نهايته.
بمرور الأيام، أصبح حسن معتادا على هذا الفضاء، لم يعد يثيره شيء، واصل سيره بخطى متسارعة حتى لا يتأخر، التفت بخفة ليجتاز الطريق إلى الجهة المقابلة، فإذا به يتسمر في مكانه. كانت تمر من هناك امرأة! والشارع يزدحم بعشرات النساء في مختلف الأعمار والأشكال والأحجام..، لكن حسن لم ير سواها، وكأنها تمشي وحدها في شارع مهجور. تتبعها بنظره دون أن يحرك رجليه، وأين هما رجلاه، لم يعد يحس بهما. كان مأخوذا وكأنه يرى ملكة من ملكات الزمن الغابر وهي تمشي بين الناس في كامل زينتها. واصلت مسيرها ولم تكترث لما أصابه.. ابتعدت قليلا، فتحرك في إثرها بخطوات بطيئة تجعله على مسافة تسمح له بتأمل موكبها المحفوف بالجلال والهيبة.. قوامها هو أول ما أبهر حسن. لم تكن فارهة الطول، ولكن فوق المتوسطة بقليل، تمشي بهدوء وثقة كبيرين، مع قليل من الدلال الأنثوي غير المفضوح، يراه ولا يراه، يتفاعل مع حضوره العذب إلى درجة الألم، دون أن يحدد مصدره، وزاد في بهاء موكبها، رجوع الكتفين قليلا إلى الوراء، مما أضفى على مشيتها مزيدا من الاعتداد والكبرياء، مفسحا في الوقت نفسه المجال لصدر ثائر متمرد، يعلن عن نفسه في تحد واضح. وجسدها المكتنز قليلا في غير بدانة، تلوح تفاصيله الرائعة وراء جلبابها البني الفاتح الذي لم يفلح في قمع هذا السيل العارم من الأنوثة الصارخة.. تمنى حسن، ذو الوجه الوسيم، والقامة المعتدلة، والهندام المتناسق على رغم بساطته؛ هذا الشاب المتذوق للجمال حيث كان: في بسمة الطفل ورشاقة الفرس وانبلاج الفجر وعطر النساء.. تمنى لو اقتُطعت هذه اللحظة من الزمن، فلا تنقضي أبدا. كان تحت تخدير ما، مأخوذا، منساقا، مسلوب الإرادة، معطل التفكير، يتبعها دون هدف، ودون حساب للتبعات.. انحدرت يمينا في زقاق شبه خال من الناس، فانحدر خلفها، تقدمت بضع خطوات، ثم وقفت تسلم على امرأتين خرجتا للتو من منزل مجاور، كانت إحداهما حامل يتقدمها بطنها، والأخرى تكبرها سنا، يجمعهما تشابه واضح. هذا الوقوف الاضطراري من جانب المرأة، أفسح المجال لحسن كي يلتقط أنفاسه ويفكر فيما يتعرض له من استيلاب، ومن اعتقال تعسفي!!
تابع سيره حتى وصل أمامهن، فرفع عينيه كي يرى ما فاته من سحرها وفتنتها، وهل تراه يقنع بنظرة عابرة؟
أراد حسن أن يطيل عمر النظرة، قرر أن يكلمها، لا لم يقرر، كيف له أن يقرر، وهو منذ رآها مسلوب الإرادة يمشي وراءها كحمل في إثر أمه، وكأن يدا تدفعه من الخلف وما عليه إلا أن يستجيب. لا يدري ماهية هذه القوة التي أصبح تحت وطأتها معطل الإرادة والتفكير، وكأنه قطعة خيزران تتقاذفها الأمواج. أيكون مصدرها هذا الجمال النادر الذي يتلألأ أمام ناظريه كما تتلألأ صفحة البحر مع أولى خيوط شمس الصباح؟ أم لعله ذلك العطش المتجذر في الرجل الذي يسكن أعماقه، والذي لا ترويه امرأة مهما بلغت من مراتب الجمال؟ أم أن القوتين قد أكملت إحداحما الأخرى، اجتمعتا عليه فانسحق تحتهما؟
قال حسن، وهو يلملم شجاعته:
-عذرا على المقاطعة!
قال العبارة، وهو يتجه بنظره إلى المرأة الأكبر سنا، حتى لا يثير الشك حول دافعه الأصلي وراء سؤاله.
-لا عليك يا بني! ماذا هناك؟
-أردت فقط أن أسأل إن كان هناك طبيب في الجوار، فأنا حديث العهد بالحي، لم يمض على انتقالي إلى هنا إلا أياما معدودات.
تكلم هذه المرة وعيناه تتفحصان وجهها. كانت تضع غطاء بنفس لون الجلباب، يحجب شعرها، مع لثام غطى أرنبة الأنف والخدين فما تحت. ولم يبد من الوجه إلا العينين ومحيطهما. وكان محظوظا لذلك، إذ لو ظهرت كل النفائس التي حال اللثام وغطاء الرأس دونها، لصُعق حسن. يكفيه ما حل به عند التقاء عينيه بعينيها، فلم يعد يرى سواهما من حوله، ضاع فيهما، أسقط المرأتان اللتان بجانبها من حسابه، وساد صمت قصير قطعته المرأة الحبلى بقولها:
-سوف تصعد في هذا الاتجاه-وأشارت إلى الشارع جهة اليمين- مسافة مائتي متر تقريبا، وستجد صيدلية تقابلها عيادة طبيب.
لكن حسن لم يسمع جوابها، ولم يكن يريد سماعه من هذه المرأة. تمنى لو أن ذات العينين الباسمتين تجيب. لقد ملأ عينيه من قوامها ومشيتها، ثم بعد ذلك وقف في مواجهتها، وأبحر في عينيها. ومع ذلك لم يشبع، يريد المزيد. النار بداخله تقول هل من مزيد!؟ أراد أن يسمع صوتها، لكنها لم تنبس، اكتفت بالنظر إليه، نظرتها تشي بجرأة ودلال استمدتهما من وجود المرأتين إلى جانبها، وتنطوي على سخرية عابثة تقول من خلالها: “أنت لا تبحث عن شيء .. أمرك مكشوف..”. هذا ما جال بخاطره، وهو يدمدم في حياء:
-شكرا لكن !
قال هذه العبارة مع انحناءة خفيفة ووجه باسم، وزع ابتسامته عليهن بطريقة سريعة، ولما كانت هي أطول من المرأتين، فقد رفع بصره إليها بنظرة متأنية لها معنى لا تخطئه النساء، ثم مضى لا يلوي على شيء. ما أن ابتعد حسن ببضعة أمتار حتى وجد نفسه في مواجهة سعيد، جاره الذي يسكن الطابق السفلي من منزله:
-السلام عليك يا رجل ! أين أنت؟ لم نعد نراك!
أجاب حسن باقتضاب، وهو لا زال تحت التخدير:
-ها أنت ترى! العمل والنوم. هذا كل شيء.
-أنا أيضا لا أجد الوقت حتى لأداء فاتورة الماء والكهرباء..
انطلق جاره سعيد يثرثر عن الفاتورة وثمنها الذي ما فتئ يزداد شهرا بعد شهر، إلى أن اضطر حسن إلى مقاطعته:
-اللهم اهدنا واهدهم!!
وضرب على كتفه بكفين متتاليين، وهو يقول:
-معذرة! أنا في عجلة من أمري. أراك لاحقا.
هكذا تخلص من سعيد، والتفت في حينه مطلقا عينيه ناحية مجمع النساء الذي خلفه وراءه فلم يجد لهن أثرا. قفل راجعا من حيث أتى عله يدرك فاتنته، مسح بعينيه المكان، دقق النظر في الزقاق الذي تركها عند ناصيته، دون جدوى!
“يا إلهي! كيف تختفي هكذا كأنها حلم لذيذ، مهما بلغ من قوة الحضور والتحقق، يصير مع لحظة الصحو الأولى مجرد صورة ذهنية أحاول جاهدا جمع شتاتها المتبعثر!!
ولما استيأس من ظهورها ثانية، تابع طريقه وهو يفكر:
“يا الله! كم هذا صعب وقاس، الناس معادن، ومعدني أنا لا قبل له بكل هذا الجمال.. نفسي جموحة، وأنا لا أقوى على كبحها. أنا ابن أبي: كان عليه ألا يقترب من فاكهة واحدة داخل جنات من الفاكهة عرضها كعرض السماء والأرض، ولم ينج بنفسه من نفسه التواقة إلى كل ما تراه.. أنى لي أن أتفوق عليه؟ أنا الذي لا أملك لا تفاحة ولا رمانة!!
قطع عليه تفكيره صوت جهوري دوى في الأرجاء معلنا آذان المغرب: الله أكبر، الله أكبر..
اتجه نحو المسجد وهو يقول:
“عليك بالماء يا حسن! وحده الماء يطفئ النار..”