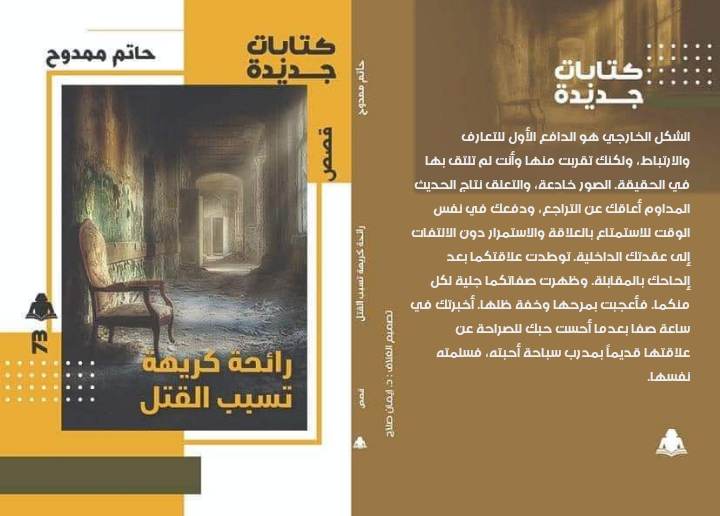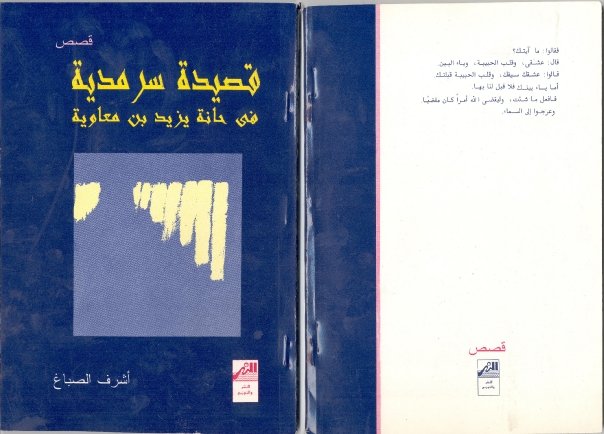بولص آدم
بعد أن شاهدتُ فيلم «النار الماجنة» للمخرج الفرنسي لوي مال في المعهد الفرنسي القريب من دجلة، من جهة شارع أبي نؤاس، كنتُ طالبًا في أكاديمية الفنون الجميلة، في صيفٍ حار من أوائل الثمانينيات. وكان الحرّ خانقًا، لزجًا، كأن الهواء نفسه متعب، وكأن الحرب في مكان ما تنزف بلا توقف.
خرجتُ من العرض مثقلاً بذلك الثقل الذي تتركه الأفلام الجيدة في الرأس؛ ثقل يشبه انفتاحًا مؤلمًا لا يُغلق بسهولة. شعرت بحاجة إلى الشرب، رغبةً في إبطاء دوران الأفكار أكثر من البحث عن السكر.
عبرتُ الشارع شاردًا. كان دجلة قريبًا، ماؤه يلمع ببرود غريب، كأنه غير معنيّ بما يجري على ضفتيه. نظرتُ إليه كما يُنظر إلى شاهد صامت، ثم اتجهتُ إلى بار اسمه الحمراء، يتوسط بارين آخرين: البيضاء والصفراء. كانت بغداد، يومها، مدينة أسماء أكثر منها مدينة ألوان.
دخلتُ ببطء. تحت إبطي رواية «السيد الرئيس» لميغيل أنخل أستورياس، ملفوفة بجريدة القادسية. كان الغلاف أقرب إلى تمويه منه إلى حماية. توقفتُ عند مدخل حديقة البار الواسعة وعددتُ ما في جيبي بعناية تشبه طقسًا صغيرًا للبقاء:
ما يكفي لساندويش فلافل، وأجرة باص مصلحة الركاب رقم (٢) من ساحة النصر إلى باب المعظم،
وقليل أخير، علّقتُ عليه تلك الأمسية كلها.
الفيلم ما يزال يدور في رأسي، لكن صوره بدأت تختلط بصور أخرى: طرق مغلقة، أصوات بعيدة، جنود بلا وجوه. كنت بحاجة إلى ربعية عرق، رغبةً في رؤية الواقع بحدّة أقل.
كانت الحديقة مكتظة وصاخبة، ضجيجها أشبه بمحاولة جماعية لنسيان أمر غير متفق عليه. دخلتُ. مرّ النادل، فقلت مازحًا، كما في كل مرة:
— أين الزيتون؟
ضحك وقال:
— لم نعد نبيع زيتون بعشيقة… نصنع منه عرقًا.
ضحكنا ضحكة سريعة. أشار بيده إلى الداخل وقال:
— ابحث عن مكان، الدنيا مقلوبة اليوم.
بعد جولة طويلة، وجدتُ مقعدًا بالكاد يتّسع لي. جلستُ، وشعرت بالعطش كحاجة جسدية ونفسية معًا. وضعتُ رواية السيد الرئيس على الطاولة، كما لو أنني أضع شيئًا شخصيًا في مكان عام.
جاء ميخائيل، أخذ طلبي، وغاب.
إلى جواري جلس عدد من الرجال بملابس رسمية. من جلستهم، ومن الصمت بين جملة وأخرى، بدا واضحًا أنهم من رجال الأمن. وحين انحنيتُ لأحكّ قدمي التي لسعتها حشرة، رأيتُ المسدس مثبتًا في حزام أحدهم. لم يتقدّم الخوف فورًا، بل حلّ وعي ثقيل: المكان لم يعد محايدًا.
سمعتُه يهمس، وكأنَّه يقرأ من نفس الرواية التي أضعها على الطاولة:
«سيدي الرئيس! سيدي الرئيس! السماء والأرض مَلِيئتان بأمجادك!»
عاد الفيلم في رأسي يتحوّل من حكاية رجل غريب في باريس إلى حكاية رجل لا يعرف أين يضع جسده في بلده.
عاد ميخائيل، وضع أمامي العرق وطاسة من الحمص، وقال مبتسمًا:
— اليوم الحساب مقدّم.
ضحكتُ، وكان الضحك أقرب إلى آخر ردّ فعل طبيعي متبقٍ لي.
على الطاولة المجاورة، بدأ الرجال يضحكون، يتحدثون عن الشيوعيين، عن الخونة، عن البحر الذي لا نملكه. الكلمات بدت خفيفة في نطقها، ثقيلة في معناها.
قال أحدهم:
— لو كان لنا بحر، لرَمينا فيه الجميع.
وعندما سُئل عن الذين في الاتحاد السوفيتي، نهض فجأة. أخرج المسدس. أطلق النار في الهواء.
في تلك اللحظة، انصبّ التفكير على الجسد: كيف ينخفض، كيف يلتصق بالأرض، كيف يصغر. انقلبت الطاولات والكراسي. ساد صمت مشروخ بالطلقات.
رأيتُ كتابي قرب قدميه، مقلوبًا. مددتُ يدي نحوه.
ركله بقدمه وسأل:
— هذا كتاب شيوعي؟
قلتُ:
— لا… رواية.
نظر إليّ لحظة، ثم قال بصوت متثاقل:
— حسنًا… من أجل المثقفين. لم نعد نعدم.
عاد كل شيء إلى شكله الخارجي: الكراسي، الطاولات، الضحك. لكن شيئًا ما لم يعد.
خرجتُ من البار. لم ألتفت.
كان دجلة يمضي ببطئه المعتاد. على الأرض، قرب الطاولة، كان كتاب أستورياس مقلوبًا. المسدس ما يزال في الحزام.