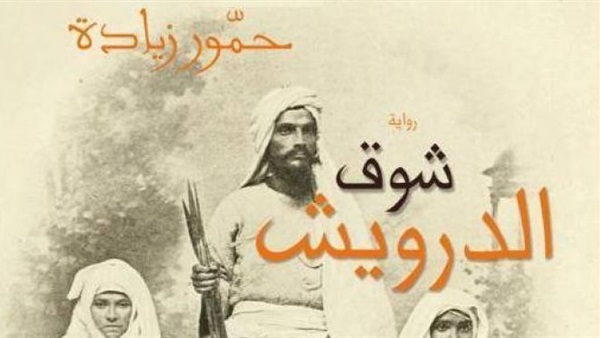قبل شهور، وفي ولاية آيوا الأميريكية، وضمن برنامج الكتابة العالمي الذي يقام سنوياً هناك برعاية جامعة الولاية، لكتّاب من كل بلاد العالم، ولمدة عشر أسابيع، حضرتُ بين الجمهور مائدة مستدير يتحدث فيها عددٌ من الأدباء الأمريكيين وغير الأمريكيين، موضوعها هو العلاقة ما بين الاتجاه الأساسي في الأدب والأنواع الفرعية؛ أي بين ما نطلق “الأدب” بألف لام التعريف، أو المضاف المستغني عن المضاف إليه، وعلاقته بتلك الأنواع الفرعية الشائعة خصوصاً في العالم الغربي التي لا تستقيم بلا مضاف إليه، مثل أدب الرعب أو الأدب العاطفي أو أدب الخيال العلمي، والقائمة تطول لأن لها خطوط إنتاج هناك تعمل بدوام أربع وعشرين ساعة، عليها أن تزوّد أرفف المكتبات العديدة أولاً بأول بمؤونة جديدة من تلك الأنواع الفرعية التي ترضي ذوقاً خاصاً لدى شريحة محددة من الجمهور “العريض” للكتاب هناك.
منذ سنوات والعلاقة ملتبسة بين هذين الصنفين، الأدب بألف ولام التعريف هو الشقيق الأكبر، ذو السلطات والتاريخ والعروش والأمجاد، أمّا أشقاؤه الأصغر سناً فهم المشردون على الأرصفة دون أمجاد تذكر: أدب الناشئة، الأدب النسائي، أدب الأقليات، والقائمة تطول الآن حتى في بلاد العالم الثالث، وليس أدل على ذلك أكثر من التجربة الفريدة التي نجح فيها كلٌ من نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق، حيث قدما وجبة مختلفة تماماً للشباب وصغار السن عمّا كان متاحاً قبلهما، هما وعشرات الكتّاب استطاعوا خلق تيار مصري صميم من الأدب الخفيف الموجه للشباب، يمكنه أن يذكي فيهم الرغبة في المعرفة ويبذر في نفوسهم بعض القيم الأولية كالانتماء والشجاعة وما إلى ذلك، حتى ولو كان الهيكل الأساسي لتلك الأعمال معتمد على قوالب جاهزة وناجحة في الغرب لسنوات طويلة.
أظن أن تجربة أحمد مراد الروائية تجد جذورها في سلسلة روايات مصرية للجيب، وفي تجربة أحمد خالد توفيق كمجدّد أكثر شجاعة، بل إنه أقدم مؤخراً على كتابة الرواية، بألف لام التعريف، مقتحماً السوق الذي كان مقصوراً على “نخبة” ضيقة من الأسماء، سواءً من أبناء جيل الستينات أو من لحق بهم من روائي التسعينات والألفية الثالثة، تلك الفئة الأخيرة التي اتسعت في السنوات الأخيرة لتشمل كتّاباً مهمين، كان من بينهم من تربّوا على أعمال روايات الجيب المصرية، ويعتبرون خالد توفيق مثلاً أعلى لهم في الكتابة، وهُنا ربما مفارقة أخرى لا يتسع لها المجال.
لو بنينا على ذلك كله لاكتشفنا ببساطة أن رواية مثل الفيل الأزرق تعرف جمهورها الذي تتوجّه إليه مقدماً، تحدس مكوناته النفسية وميوله العامة، وتقدم له العناصر الغذائية التي يُفضلها في طبخة معروفة المقادير والتوابل، دون أية مفاجآت في طريقة الطبخ والتقديم. ولكي لا يُساء فهم هذه الفكرة، لا نقصد بالمفاجآت هنا ما يتعلق بالدراما، فالرواية تحتشد بالمفاجآت والمنعطفات غير المتوقعة، لكنا نقصد بها مفاجآت أخرى سعيدة وغير متقنة الصنع، بل عفوية تماماً، تلك التي تذهل الكاتب عن نفسه بينما يمضي مستكشفاً عالم كتابه وشخصياته وحواديته الصغيرة، الانحرافة المفاجئة التي تجعل من تكرار فعل الكتابه ذاته مغامرة حقيقية لا تستند إلى قوالب سابقة إلا بالنية، ومن بعيد لبعيد.
هذه الانحرافة، وهذه المغامرة السردية، نادراً ما تجد لها متسعاً في الأنواع الفرعية، إذ يتوجب على الكاتب أن يلبي لقارئه رغباته، وأن يرضي توقعاته، وإلّا يستشعر الزبون الخيانة، وكأنه لم يتلق الخدمة التي كان ينتظرها، أين التشويق؟ أين الكاتشب؟ هذه ليست رواية رعب؟ هذه ليست سلطة كول سلو؟ وهكذا يختلط المنتج الثقافي بالسلعة في دوّامة مدوّخة جديرة بأزهى عصور الاستهلاك.
لكن ماذا عن التخوم الفاصلة والواصلة ما بين مملكة الأدب المطمئنة، بكهنوتها وعلاماتها ومعالمها، وتلك الممالك الصغيرة المجاورة لها: أدب الطفل، الكوميكس، الأدب الديني؟ هل من غير المسموح لشخص في رداء أكاديمي كهنوتي، بقامة شامخة، مثل الروائي الإيطالي أومبرتو إيكو، بجلالة قدره، أن ينط من فوق السور ليختلس زهرة سامة من حديقة مظلمة تجاور قصره؟ الحق أنه فعلها في روايته الأولى، وهي التي خلقت صيته الأدبي وحققت أفضل المبيعات معاً، اسم الوردة، حينما اعتمد لها حبكة بوليسية أساسية، وهي نبش أحد المحققين الأذكياء في سلسلة من جرائم القتل الغامضة، هيكل عظمي مضمون للنجاح، ووصفة مجربة مئات المرات، لكن ماذا صنع منها أومبرتو إيكو؟ ذلك هو السؤال، وأظن أنه سؤال الفن في كل زمن ومكان، كيف نعيد قول ما قاله الأسلاف، ولكن بألسنتنا نحن ونبرات أصوتنا الخاصة، كيف نعيد اكتشاف روميو وجولييت مثلاً على كوكب المريخ بعد ألفي سنة من الآن؟ وهكذا…، مع كل تكرار، يعيد النموذج الأصلي إنتاج ذاته، ليتخفى ويتجمل ويكتشف المزيد.
الأمثلة تتجاوز أومبرتو إيكو إلى باتريك سوزكيند صاحب العطر، وبول أوستر كاتب ثلاثية نيو يورك، وحتى في السينما عند تارانتينو، المخرج الأمريكي الأشد عنفواناً وجرأة على اقتحام الأنواع المهمشة والعثور على ضالته الجمالية هنالك.
الاتجاه المقابل من الطريق أيضاً مفتوح لمن يريد على مصراعيه، وهو أن نسرق الورود السحرية من مملكة الشقيق الأكبر، الأدب الجليل في أروقته الرخامية، لنحقن رحيقها في أنواعنا الفرعية، وإن ظلّ النوع الفرعي مخلصاً لزبائنه لكي لا يفقد مكانه في السوق. هل كان هذا هو طموح أحمد خالد توفيق في روايته يوتوبيا؟ وهل هذا هو نفسه طموح أحمد مراد في الفيل الأزرق؟ ربما.
أحمد مراد روائي مسلّح بترسانة من الأدوات التقنية المعروفة والتي لا غنى عنها في الأنواع الفرعية كأدب التشويق والإثارة والرعب، فهو يعرف ما معنى إحكام الحبكة من البداية للنهاية، يعرف كيف تكون روايته لغزاً ينكشف أمام قارئه تدريجياً مع كل فصل وصفحة، بل وفقرة جديدة، أو بحد تعبير بطله “ألغاز لا محل لها من الإعراب ومستنقع مظلم أكره الخوض فيه، أحتاج سيجارةً محشوّة”، ويتردد مجاز اللغز أو “البازل” بالأحرى داخل العمل نفسه غير مرّة: “حاولتُ استكمال قطع اللغز المتناثرة”.
ثم إنه يعرف كيف يختار بطله أو لعلّه البطل الضد في النصف الأول من العمل والذي يصير بطلاً حقيقياً مع نهايته، المهزوم المأزوم الخارج من محن جسيمة، ولكنه يملك مع هذا نقاط قوة ومهارات خاصة تعينه على اجتياز رحلته وحل اللغز. فهو هنا طبيب نفسي انقطع عن عمله في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لخمس سنوات، بعد حادثة سيارة توفيت فيها زوجته وطفلته، لأنه كان يقود مخموراً ومضغوطاً على المستوى النفسي، وفي اليوم ذاته الذي يعود فيه يحي لعمله في العباسية يجد في انتظاره مفاجأة من العيار الثقيل، يجد في انتظاره صديق قديم متهم في جريمة قتل زوجته والتمثيل بجثتها، هذا الصديق القديم نفسه كان طبيباً نفسياً أيضاً وشقيق الفتاة الوحيدة التي أحبها بطلنا المهزوم، وبصرف النظر عن سرد التفاصيل التي لا بدّ أن كل قارئ للرواية يعرفها جيداً، فهذه التوليفة ليست بعيدة بالمرة عن حجر الأساس الدرامي للعشرات من الأفلام الناجحة، إن لم تكن المئات، رحلة البطل في حل اللغز تطهره وتغيّره وتقلب حياته رأساً على عقب أيضاً، وفي الأثناء تتوالى العقبات التي يتوجّب عليه اجتيازها بكل تأكيد.
ورغم إحكام حبكة الفيل الأزرق فإن عدد المصادفات التي يبنى عليها السرد مدهش بحق، ولا ضرر في المصادفة بحد ذاتها كعنصر درامي له ضرورته في بعض الأحيان، غير أنه يتحول إلى نقطة ضعف عند الاعتماد عليه أكثر من اللازم وفي مفاصل الدراما الأساسية، فعلى سبيل المثال حين يعود يحي مضطراً لعمله في العباسية يدخل صاحبه القديم إلى المستشفى للكشف على قواه العقلية في اليوم ذاته تقريباً، ومن قبلها كان هذا الصاحب قد أرسل له رسالة غامضة برموز ملغزة، ثقةً منه أنه الوحيد الذي سيتمكن من حلّها، رغم عدم معرفته أي شيء عن يحي طوال سنوات، هذا غيض من فيض سلسلة المصادفات التي عرف الروائي الشاب الماهر كيفية دسها على طول خط حبكته دون أن تكون عقبة في طريق قارئه المستاهل الباحث عن متعته السهلة ولو على حساب المنطق الدرامي للعمل نفسه، إلى درجة أن بطله يحي يندهش أمام واحدة من تلك المصادفات العديدة، عندما يكتشف أن شريف، المريض والمتهم والصاحب القديم، قد اختار نفس مجال دراسته أو موضوع أطروحته لنيل الدرجة العلمية، فيقول: “صُدفة واحد في المليون أن يختار شريف نفس المجال الذي درسته ليبحث فيه”، غير أن الفيل الأزرق لا تفتقر إلى هذا النوع من المصادفات العجائبية بالمرة.
غير أن أحمد مراد في الفيل الأزرق لم يستسلم لأن تكون روايته مجرد كتابة مشهدية سينمائية، وليته سلّم بهذا، فأصر على أن يرصع سطوره بالعشرات من الحلي والزخارف البلاغية المبالغ فيها، أو ال over بلغة الرواية نفسها، تظهر تلك المحسنات البديعية فجأة في أي موضع من مواضع المشهد المسرود، وتختفي فجأة، قد تعتمد على الطبيعة أو على أحدث منتجات الحضارة البشرية من ماكينات وأجهزة معقدة، وقد تكون كالقرصة في عبارة سريعة أو تمتد لفقرة كاملة، كالتالي:
“حاولتُ التزام الصّمت الذي أجيده، بيتي القديم الذي جاهدت منذ سنين في ترميم أحجاره كي لا ينهار، حتى إنني نكسته ودسست بين ضلوعه القوائم الخشبية وطردت سكّانه، ما عدا أنا، وها أنا أسمع صوت الطقطقات، وأرى التراب يتسرب من السقف فوق رأسي، ثم حدث الانفجار.”
وسواءً راقت هذه التشبيه الممتد والمتشعب لقارئ الرواية أم لا، فالشاهد هنا أنه لا توجد استراتيجية جمالية محددة في اللجوء للبلاغة، وهي ما يحذر منه كاتب المشهد على طريقة السيناريو حذره من السُم، ولنا في إبراهيم أصلان رحمه الله أسوةٌ حسنة. وعلى العموم فإن المزج بين كتابة المشهد والبلاغة بحمولتها القديمة أرض وعرة ليس من السهل المشي فيها بلا مزالق، أهونها تشتيت انتباه القارئ عن المشهد الأساسي والزج به إلى بهلوانيات جمالية غير مأمونة العواقب.
كل هذا فيما يخص التقنية والحيل السردية، وهي المنطقة التي يبرع فيها كاتبنا الشاب بالتحديد، فلا سبيل في الحقيقة للحديث هنا عن رؤية للعالم من أي نوع، أو موقف واضح من أزمات مجتمعية مثلاً، فقد تأتي عبارة مثل “حدث كل شيء يوم الانفلات الأمني”، دون أي توضيح أو تحديد لذلك الانفلات وظروفه أو سياقه، وكأن الرواية بشخصياتها وأحداثها فرع مقطوع من شجرة، منبتة الصلّة بكل ما يحيط بها تماماً، وهو ما قد يكون محتملاً مع عمل يطرح أفكاراً كونية أو رؤى روحية تستطيع تجاوز لحظتها الزمنية وجغرافيتها، لكن أي هم كوني قد نخرج به من الفيل الأزرق؟ هذا سؤال موجّه للقرّاء ممن أحبوا الرواية واحتفوا بها.
ثم نأتي إلى نقطة تقنية أخرى ذات أهمية شديدة وهي آلية الحوار، فرغم البراعة الظاهرة في أغلب حوارات الرواية، وكيف تعكس الشخصيات وتطوّر الأحداث، فإن تلك الحوارات أحياناً قد تمتد لصفحات دون أي داعٍ، لتلف وتدور وتتلكأ في الموضع ذاته، من غير تطوير للحدث أو الكشف عن بواطن الشخصيات، وكونها مكتوبة بالعامية المصرية، وهو أمر يحمد لها، جعلها في بعض المواضع أقرب إلى عمل درامي خام فج، بحاجة إلى مقص التشذيب والتهذيب ليحف منها حفّاً سخياً.
ربما تكون الرواية جريئة، والشباب يحب الجرأة، كما أن الجرأة حلوة بلا كلام، لكن حتى في المناطق الكثيرة التي انجذبت فيها الأحداث نحو الجنس، نجدنا أمام عمل مؤدب مهذب، يحتفي بالجنس بلاغياً مثل العم محفوظ دون أن يسمي الأشياء بأسمائها بالمرة أو حتى ينقل صورة مشهدية واضحة على عكس عقيدة وأداء بقية مناطق الرواية، فيهرب إلى المجاز حيناً، فيقول: “العشق كما ينبغي أن يكون… وكل أمر متاح حتى أبعد الحدود… قبل أن نعود ثانية لحياتنا”، أو يلجأ إلى اللغة الإنجليزية ببساطة، فيذكرنا بالمئات من شباب العالم العربي الذين يعيشون بلسان غير لسانهم ويجدون فيه تعبيراً عن أشد الكلمات بذاءة وهم متباهون راضون، أمّا لو سمعوا الكلمة نفسها بالعربية الدارجة لاقشعرت جلودهم اشمئزازاً ودهشة.
قد تكون رواية الفيل الأزرق رواية ممتعة، ولكن ما المتعة؟ وهل يُمكن أن تقال أو يتم التعبير عنها أساساً؟ لا أظن. هل علينا أن نطابق ما بينا العمل المسلي والعمل الممتع؟ أتذكر الآن على سبيل المثال بعض روايات جوزيه ساراماجو ذات الإيقاع الهادئ البطئ الرتيب، والتي تكاد تنفّر القارئ غير المعتاد على موسيقيتها الخاصة، وأسأل نفسي كيف أستمتع أنا بها؟ وهل يحق لنا أن نقصر أسباب المتعة على عناصر التشويق والإثارة والحبكة المحكمة وتطهر البطل في النهاية وكان الله بالسر عليم؟ ثم هل يحق لنا أن نظلم الشباب – من يصنعون التغيير الحقيقي ومن يجذبون مراكب المجتمع إلى الإبحار في الغامض والمجهول – حين نزعم أن هذا هو اختيارهم وهكذا فلا بأس؟ ألا يذكرنا هذا من بعيد بالمقولة المبتذلة “الجمهور عاوز كده”؟ وماذا عن آليات الإعلام والترويج والبروباجاندا التي يمكنها أن تقنع ملايين البشر في العالم بتناول السموم اليومية وكأنّ فيها سر الشباب الأبدي؟
لا أصل إلى حد القول إن هذه رواية مسمومة، وأحترم بشدة المجهود الذي يقف وراءها، من حيث البحث وجمع المادة وضبط الحبكة والإيقاع السريع، إلى آخره، وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أتخيّل أن تكون الفيل الأزرق معبرة عن كتابة وقراءة جيل كامل، فيه من التنوع والثراء ما فيه. أمّا عن تلك المائدة المستديرة التي نسيتها تقريباً فلم نصل فيها إلى شيء، كما هي العادة، ولعلّنا سوف نواصل البحث في تلك العلاقة، ما بين نهر الأدب الرئيسي وفروعه العديدة المبهجة والممتعة المنبثقة منه التي تتكاثر وتمتد إلى ما لا نهاية، دون أن ينقص ذلك من قيمة المنبع مقدار قطرة.