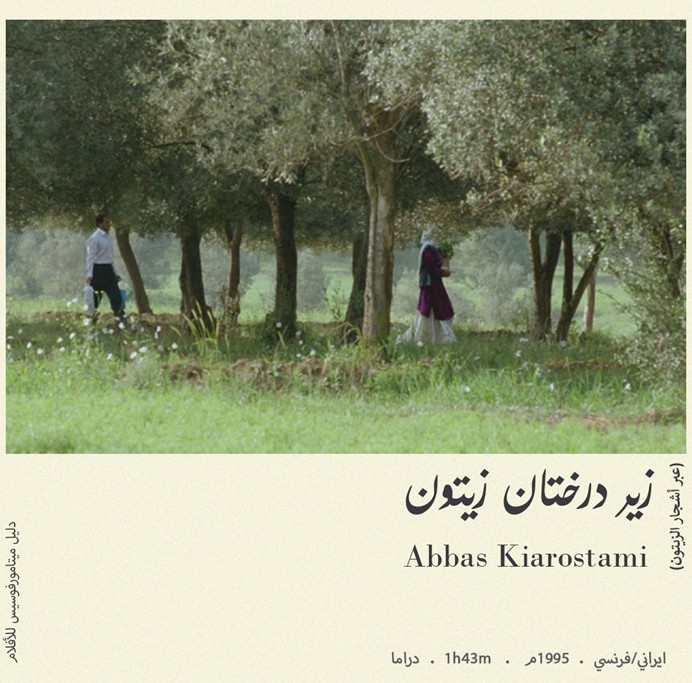يبدأ فيلم “شارك” بلقطات سريعة مكوكية خاطفة لصور من محافظات مصر المختلفة متداخلة مع لقطات لكتاب مكتوب عليه “الدستور” قد لا يلاحظها المشاهد ولكنها تبقى في وعيه فتطغي عليه. وينتهي الفيلم بلقطات قريبة من لقطات البداية متداخلة مع لقطات لأناس من فئات عمرية واجتماعية مختلفة ومسجد وكنيسة ورجال أشداء يمثلون الحضارة يقفون أمام أحد الأعمدة الضخمة لمعبد فرعوني ليتلو ذلك لقطة لنساء يجلسن على امتداد الصورة بالترماي بينما امرأة منتقبة بعمق الصورة تقف وحيدة منبوذة وكأنها تريد أن تجعل الترماي يرجع إلى الخلف.
أستطيع أن أقول أن هاتين اللقطتين قادرتان على تلخيص الفيلم بأكمله.
هذا ما تعمدته وقصدته المخرجة عبر استخدامها للمونتاج السريع والأغاني التي تعبر عن الشخصيات التي تظهر على الشاشة ربما أكثر من تعبيرها عن المحافظات التي ينتمي إليها مطربيها العظام. ولقد استفادت المخرجة كثيرا من خبرتها السابقة في إخراج الفيديو كليبات مثل إخراجها لأغاني لمحمد فؤاد وفؤاد عجاج وغادة رجب.
فساندرا التي تتوجه كل أفلامها التشويقية إلى الطبقة الوسطى البرجوازية مستخدمة ممثلين لهم رصيد كبير لدى هذه الطبقة مثل أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز لا تهتم بالطبقة الدنيا أو البسطاء مثلما يدعي الفيلم ومثلما أدعى مذيعو التوك شو، بل أنها تسخر منهم في أحيان كثيرة عبر المونتاج أو عبر وضعيتهم وحجمهم بالكادر. إن ما يهمها هو فقط الدعاية “لنعم” للدستور وليس الدعاية للتصويت بالدستور وهو ما يتنافى مع الغرض الأساسي المفترض من الفيلم ومن اسم الفيلم.
فكرة الفيلم (12 دقيقة) هي أن فريق العمل يلف معظم محافظات مصر ليستطلع آراء الناس حول الدستور ويحثهم على المشاركة في عملية التصويت عليه. فيقابل الفريق أشخاصا “بشكل عشوائي” لتسألهم المخرجة “هتقول نعم ولا لأ؟” بالاستفتاء على الدستور.
فكرة بسيطة ومهمة وبالتأكيد نحتاجها في مثل هذه الفترة لحث المواطنين على المشاركة في العملية الديمقراطية إلا أن الفيلم ملئ بمثل هذه اللقطات الموجهة التي توضح أن من سيقولون “نعم” هم من يعملون بجد من أجل بناء الوطن وأن من يقولون “لا” هم من يريدون تخريب البلاد.
يوضح الفيلم هذا عن طريق الصورة قبل توضيحه عن طريق الشخصيات التي يتم استطلاع آراءهم. ومن ناحية أخرى يوضح أن من يقولون “نعم” هم الأشخاص الحداثيين بينما من يقولون “لا” هم المتخلفون الرجعيون.
يتضح ذلك في لقطات متتابعة قد صكها المونتير بحرفية شديدة وأشرف عليها مخرج الفيلم. فنجد لقطة لشخص بفالوكة متهالكة ببحيرة قارون المتسخة وشخص يقول voice over “أنا مع مرسي” لتتبعها لقطة أخرى نجد فيها طفلا يجلس على موتوسيكل حديث حيث يستعمل المصور عدسة تضخم الفتي والموتوسيكل اللذان يحتلان مقدمة الكادر، فيقول الفتى “أنا بحب السيسي” وهو يمتطي الموتوسيكل كفارس أو كالسيسي نفسه مثلما يراه محبوه ومثلما رأي نفسه في منامه الشهير.
الرمز واضح. هذا الرجل الذي يقبع في الفالوكة القديمة المتهالكة سيقول “لا” لأنه متخلف حضاريا وفكريا وهذا الفتي الشاب رمز المستقبل الواعد سيقول “نعم” لأنه حداثي ومتقدم. وهو نفس الرمز الذي نجده حينما يقول رجل آخر جالس مع ابنه “نعم” بينما ابنه يفتح موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” على حاسوبه المحمول لتتلوه لقطة لرجل يلبس نظارة طبية وهو يقول “البلد مش محتاجة تتأخر في وضع الدستور.”
تؤكد هذه الرؤية لقطات عدة متداخلة حيث يقول رجل خمسيني وهو يمسك بجريدة عابرا طريق كورنيش اسكندرية الواسع والذي تسير فيه السيارات بسرعة “طبعا نعم عشان أصلح البلد.” وهو ما يجعل المشاهد يستنتج أن من سيقولون “لا” هم من يريدون خراب البلد بل بالفعل يقول أحدهم “اللي هيقول لأ ده عايز خراب البلد.” ثم يأتي رجل ملتحي يبدو أنه يريد أن يقول لا ولكن الخوف من الكاميرا يجعله يقول “لما نقرا الأول يبقى نعرف نعم ولا اه.” نعم ليس خطأ مطبعيا. هو بالفعل قال “نعم ولا اه.” لقد رهب من الكاميرا، فالكاميرا ستسجل أقواله وبالتالي فالأمن بقادر على الوصول إليه إذا ما قال “لا” فيصبح مصيره مثل مصير المئات الذين اعتقلهم الأمن بالفترة الماضية وهم يوزعون على المارة أوراقا توضح رأيهم بمشروع الدستور الجديد.
ولكن السؤال الذي يؤرقني ولم يؤرق صناع الفيلم للحظة واحدة. لماذا تجعل الحكومة الشعب يختار بين “نعم” و “لا” حينما يكون الخيار الأول إصلاح وعمار للبلاد بينما الخيار الثاني هو خراب ودمار؟!!
حسنا. لنعود بالزمان إلى عام 1934 أي ثمانون عاما بالتمام والكمال. سنجد أن المخرجة الألمانية ليني ريفشنتال قد أخرجت فيلما هو أحد أهم الأفلام بتاريخ السينما وهو فيلم “انتصار الإرادة” وهو فيلم دعائي لهتلر (من نفس نوع فيلم “شارك”) يسجل مؤتمر الحزب النازي الألماني الذي أقيم بمدينة نورمبرج بألمانيا.
في “انتصار الإرادة” يتجلى حب وثقة الشعب الألماني بهتلر كقائد وبطل عسكري ومحيي للمجد والكرامة الألمانية حيث يمتلئ الفيلم بلقطات لجماهير عريضة تقدر بالملايين تقف بصفوف طويلة لتري الفوهلر الألماني وهو يمر بسيارته المكشوفة حتى يقف ليخطب بجماهير لا تستطيع كاميرا ريفشنتال أن تحصرهم. ثم يبدأ قواد جيشه ووزراءه والشخصيات البارزة بالحزب يخطبون فيتملقون إياه معتبرينه ألمانيا نفسها، فيعبر أكثر من واحد منهم بالنص “أنت القائد الأعلى وأنت القاض الأعلى” و”أنت ألمانيا.. وألمانيا أنت.” ألا يذكرنا هذا بما يحدث كثيرا بوقتنا الحاضر من تملق لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، فلا فرق بين فنانو ومثقفو السلطان وفقهاء السلطان مثلما يقول المفكر الكبير حسن حنفي.
ريفشنتال لم تخلق أو تختلق هذه المشاهد التي توضح مدى حب الناس للمستشار بل لقد سجلت أكثر من ذلك ولكن زمن عرض الفيلم لا يسمح لوضع كل ما سجلته فاكتفت بمقطفات هي أقل القليل مما قد يعبر عن حب الشعب الألماني لهتلر. ولكن دعونا نمضي بالتاريخ قليلا لما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 وسقوط ألمانيا وانتحار هتلر. لقد اكتشف الجميع أن الأمر لم يكن حبا بقدر ما كان خوفا. إن المواطن الألماني في عهد هتلر كان يخاف من أهل بيته فقد يفتنا عليه فيؤدي ذلك إلى اعتقاله وربما اعدامه وهو ما كان يحدث كثيرا. كان الحب والخوف مخلوطان فلا يمكن تمييزهما عن بعضهما بعضا. فالمستشار شخص ديكتاتوري، شخص مُولهم، لا ينطق عن الهوى، ولا يخطئ، ولا يمكن أن يوجد رأي آخر سوى رأيه، وإذا ما وجد رأي آخر فهو رأي خاطئ يريد أن يخرب الوطن ويحيد به عن الطريق القويم ولذا وجب نسفه (الرأي وصاحب الرأي.) بل ستحرق كتب وأعمال من لا يستطيع النظام أن يحاكمهم أو يقتلهم لأنهم ماتوا منذ أعوام أو منذ قرون. لا شيء يبقى سوى حزب الفوهلر. بل لا يمكن أن يبقى شيء سوى الفوهلر.
وبعد ثمانين عاما وبينما كنت أشاهد فيلم “شارك” عرفت أن ساندرا نشأت تقع بنفس الغلطة التي وقعت بها ريفشنتال وظلت تندم عليها طوال حياتها. فلقد طارد فيلم “انتصار الإرادة” ريفشنتال طوال حياتها فلم تستطع أن تخرج أو تمثل فيلما لما يقرب من الستين عاما.
وقعت مخرجتنا المصرية المتميزة بنفس الخطأ الشنيع فتجاهلت دور الفن والغرض من الفيلم وانساقت “لتطبيل” “وتلميع” صورة السلطان وأغراضه.
خاص الكتابة