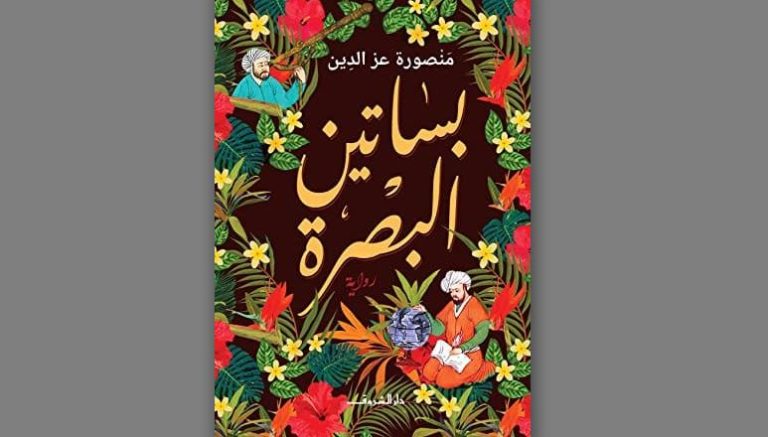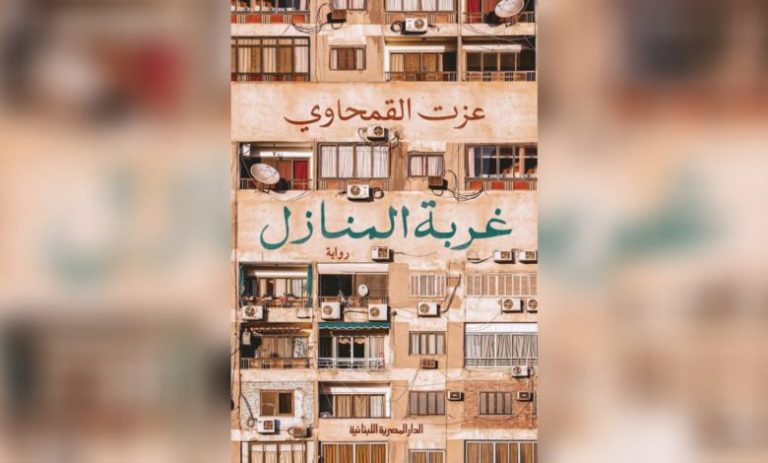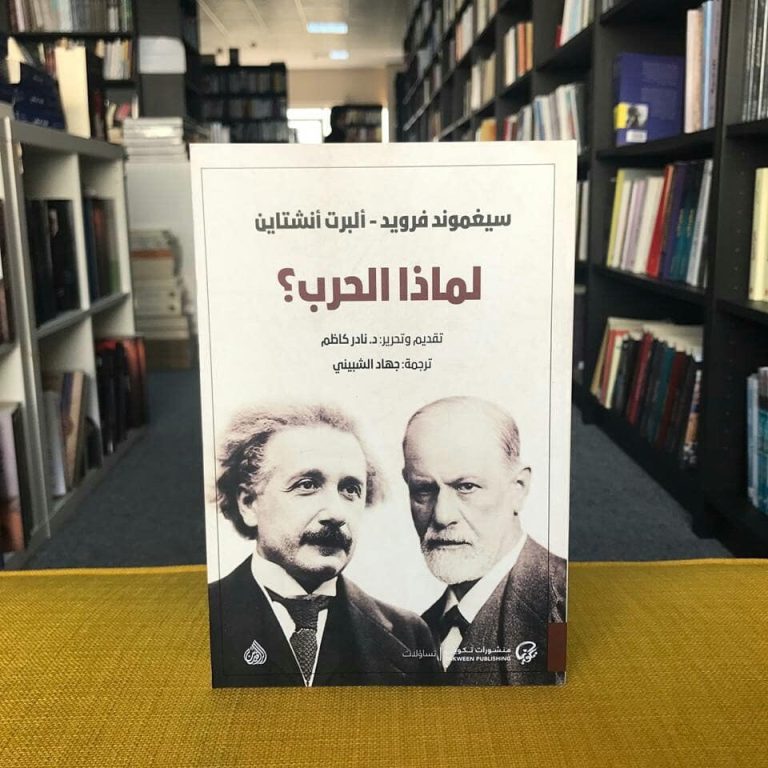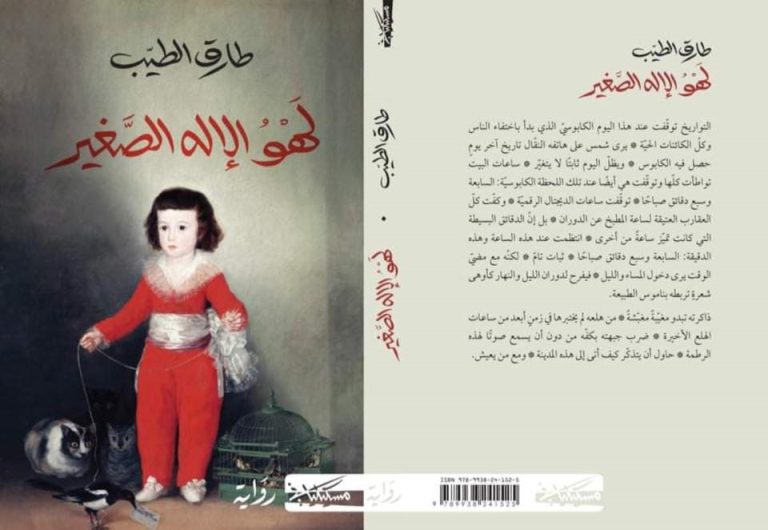سيرة حياة “رضوى عاشور” ومسيرتها الأدبية والفكرية مطروحة أمامنا مبكرًا كما كتبتها في آخر رواية “سـراج (نسخة روايات الهلال)” التي تعبر فيها عن وعيها بالكتابة وكيف انساقت إليها، تلك “الشهادة” التي ذكرت فيها أنها بدأت الكتابة لتتحدى الموت! ليس الموت المادي (نهاية المطاف) وإنما أيضًا “الموت بأقنعته المتعددة في البيت والشارع والمدرسة، أعني الوأد واغتيال الإمكانية” ـ كما تقول ـ
ذلك الموت، والخوف منه ومن سيطرته الذي جعلها تتذكر أثناء قصف بغداد مشاهد القصف الإسرائيلي لسيناء 56 ولبنان 82 لتقرأ فكتب فيما بعد “ثلاثية غرناطة” التي تقول عنها : لم أنتبه أن بداخلي رواية ولكن سؤال النهايات كان حاضرا وملحا يمليه العجز والخوف ووعي تاريخ مهدد. وفي تقديري أن كتابة غرناطة بأجزائها الثلاثة: غرناطة ومريمة والرحيل كانت ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الذي تلجأ إليه المخلوقات بشكل غريزي حين يداهمها الخطر. الكتابة هنا بدأت احتياجا نفسيا صرفا، لا التزاما بدور ولا طموحا لإنجاز مشروع ثقافي يعتمد على إعادة إنتاج مرحلة من مراحل التاريخ العربي في شكل روائي.
(كما تذكر في “صيادو الذاكرة”)
هكذا ترى “رضوى عاشور” الكتابة والأدب، وهكذا تحب دومًا أن تعبر عنه مؤكدة على أهمية “توثيق” الذاكرة كتأكيد لقانون “النضال الشعبي من أجل التحرر” الذي يجعل من الذاكرة شرط من شروط هذا الفعل التحرري
(لكل المقهورين أجنحة ..مقال)
من جهة أخرى تأتي علاقة ارتباطها وزواجها بـ”مريد البرغوثي” ذلك الشاعر الفلسطيني الذي كتب (رأيت رام الله) التي يحكي فيها 30 عامًا من الاغتراب والقهر والعزلة ويجسد القضية الفلسطينية بوضوح، حتى ليقول عنهما ابنهما الشاعر الجميل “تميم البرغوثي“:
أمي وأبويا التقوا والحر للحرة …
شاعر من الضفة برغوثي وإسمه مريد
قالولها ده أجنبي، ما يجوزش بالمرة …
قالت لهم ياالعبيد اللي ملوكها عبيد
من إمتى كانت رام الله من بلاد برة؟؟؟
يا ناس يا أهل البلد شارياه وشاريني … من يعترض ع المحبة لما ربّي يريد
كان الجواب ان واحد سافر اسرائيل .. وانا أبويا قالوله يللا ع الترحيل
دلوقت جه دوري لاجل بلادي تنفيني … وتشيِّب أمي في عشرينها وعشريني
يا أهل مصر قولولي بس كام مرة .. ها تعاقِبوها على حُبَّ الفلسطيني
تميم الفلسطيني يكتب لنا بالعامية المصرية (قالوا لي بتحب مصر) تلك التي يتغنى بها جيل الشباب من محبيه بالكامل، وهم يعلمون كم يكن المصريون من حب لفلسطين ولنضال أهلها وشعبها، وكيف أن الأنظمة مهما تعاقبت والمعاهدات والاتفاقيات مهما تحكمت لن تمنع ذلك السيل الجارف من المشاعر من الانهمار ليعبر عن وحدة صف شعبي عربي تجاه ما يحيط به من أزمات!
تلك العلاقة الجميلة من المحبة كانت محاصرة طوال الوقت بالموت ومهددة بالفناء ..
كان لزامًا على من يتحدى الموت بالكتابة أن يتحدث عن هؤلاء الذين يواجهون الموت في كل لحظة بأمل جديد وبحرص على مواجهة الحياة والابتسام في وجه القدر …
كنَّا جميعًا ننتظر ونترقب كيف ومتى ستكتب “رضوى عاشور” عن فلسطينها وفلسطيننا، عن الجرح العربي والألم العربي الكبير، عن الهم الأول .. وكم كان ردها مناسبًا !
هكذا خرجت إلينا “الطنطورية” أخيرًا .. تلك الرواية التي تبعث الدفء فيك مهما كانت البرودة من حولك قارصة، وتحثك على الأمل في أعتى لحظـات الإحباط والتشاؤم واليأس!
هي صفحة جديدة من صفحات الألم الوطني الجميل في “فلسطين” ترسمها بعذوبة ورشاقة “رضوى عاشور” كما عودتنا دائمًا في رصدها لوقائع الحياة بهذه الحميمية وهذا الشجن!
تصحبنا هذه المرة إلى فلسطين ـ أخيرًا كما يقولون ـ لنعيش مع رقية الطنطورية أيامها الحلوة والمرة في فلسطين وبين مخيمات اللاجئين حتى السفر إلى الخليج لتستقر في مصر عند شط الأسكندرية ثم تعود أخيرًا إلى جنوب لبنان محمَّلة بأمل التحرر!
تنقل لنا تفاصيل “الأيام” الفلسطينية المفعمة بالحياة والأمل، العارفة بأن الحياة بعد كل موت، حاملة معها روادًا يكمنون بين السطور كـ (درويش في لاعب النرد، حينما تحدث عن المصادفة التي أنقذته من الموت كل مرة) أو “غسـان كنفاني” و”ناجي العلي” الذين يبرزون بأسمائهم وأعمالهم التي تخط في الوجدان الفلسطيني والعربي من بعده بل والعالمي خطوطًا عريضة لأيام هي الأبقى والأخلد والأجمل على ظهر هذه الأرض ..
الرواية تمتلئ بالصدق الممزوج بالموت وأحداث المجازر والشهداء ورائحة الدم في كل وقت! مع الفرح “المختلس” بين فينة وأخرى، مع الآمال العريضة التي تبنيها تلك الأسرة في كل مكان ترتحل إليه!
إنها ملحمة الشجن الفلسطيني بوجهها الأسمى وشكلها الأجمل، كما تصنع كل مرة قصائد درويش ونبراته الواثقة الحزينة! رحلة الشتات الفلسطيني عبر بوابات العالم العربي، ..
كيف يمكن لرواية تحكي تاريخ الوجع والمأساة بكل هذا الصدق أن تكون جميلة وممتعة؟!
تبرع “رضوى عاشور” في ذلك من خلال لغتها السردية المتميزة، ومن خلال ما أسميه بـ”شاعرية المواقف والأحداث”، إذ هي تجعلك تعيش داخل بيت “رقية” منذ الصفحات الأولى بين سرد الاسترجاع الزمني وحكي ما يحدث في الحاضر، متوقفة عند عدد من المواقف البسيطة الدالة، التي تجعلك تبتسم أو ربما تضحك من ردود الأفعال والتعليقات الجانبية في هذا الموقف أو ذاك، تطلعك على “نفسيات” شخصياتها وأبطالها من خلال تلك المواقف الشاعرية الدالة، فلا تتملك نفسـك إلا أن تكون واحدًا من هذه العائلة!
وهكذا تنجو الرواية من فخ السرد “التاريخي” المباشر أو الساذج، لتتحول إلى سيرة حياة لـ”رقية الطنطورية” وعائلتها عبر أجيالِ ثلاثة وعبر الوطن العربي بامتداده من النيل إلى الخليج .. تلك السيرة التي لا تكتفي قطعًا بالمرور على الأحداث السياسية والتاريخية الكبرى، منذ حرب 48 ومشاركة العرب للفلسطينيين فيها، بل والمسلمين جميعًا حتى يعدد والد “رقية” جنسيات الشهداء أمامهم ويخص بالذكر الهندي والباكستاني الذي جاء ليستشهد في أرض فلسطين، ومذبحة “الطنطورة” تلك القرية من جنوب “حيفا” التي اختارتها “رضوى عاشور” خصيصا لتذكرنا جميعًا بأن فلسطين ليست أرض التقسيم، بل إن فلسطين العربية من النهر إلى البحر أرض عربية التي خرجت على أثرها رقية وعائلتها ليصبحوا من اللاجئين ..
ثم تتوقف كذلك لرصد “نكسة 67” على الجانب الآخر، الجانب الفلسطيني والعربي الذي كان قد عقد الآمال العريضة على “جمال عبد الناصر” فخذله! ولهذا، ولأن الراوية هنا هي “رقية الطنطورية” وليست “رضوى المصرية” فإنها تقفز عن انتصار (73) لا تذكره أبدًا، حتى تصل إلى مذابح “صبرا وشاتيلا”عام 82، ومقتل ناجي العلي 87، لتسرد حكاية هذا البطل الفلسطيني الذي تتخذ منه رمزًا للقضية وللأمل!
غير أن الأمر لا يتوقف عند حدود الرصد التوثيقي للأحداث والهزائم والانكسارات، فهناك إلى جانب كل هذا حياة تضج بالأمل والمشاحنات العائلية والأفراح والحفلات، هناك تلك المواقف “الشاعرية” بين الأبطال التي توضح خفايا مشاعرهم وطبيعة علاقاتهم ببعضهم، علاقات الحب بين الإخوة ودفء العائلة، ذلك “الحنان” الذي تسبغه “رقية” الأم ثم الجدة على أبنائها، بما فيهم بنتها “مريم” التي جائتها “كأنما من السماء” لتعيش بين هذه الأسرة كواحدة منهم ! وهناك بعد كل هذا تجاوز الآلام كلها والإعداد بكل إصرار وعزم وأمل لمشروع طموح يقضي بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في حق الإسرائليين ..
إذا كانت “رقية” بكل ما تمثله وتبثه في أبنائها من أمل وقوة وإصرار، فإنه هناك زوجها ذلك الطبيب الهادئ الغامض الذي يستشهد في ظروف غامضة، وهناك ابنها “حسن” الذي يحرض أمه على كتابه “مشاهدتها” و”سيرتها الذاتية” وهي تروي تلك الرواية بينما هو يعد العدة للعودة لفلسطين أرضه وأرض آبائه، وهناك أيضًا “عبد الرحمن” المحامي الساعي لاستراداد حقه وحق أهله “بالقانون“!
تلك “حكاية” ملحمية ستظل تروى على مر الأجيال ليتعلم منها الجميع، بذلك الأسلوب الفني الرفيع أحداثًا كثيرة مرو عليها الكبار مرور الكرام، وتوقفت عندها رضوى عاشور لتوثق تفاصيلها بأسلوبها البارع، ذلك التوثيق الذي لم يلق إعجابنا نحن فحسب ـ ممن يسمعون ويشاهدون القضية من خلال شاشات التلفزة وأخبار المعاهدات والحروب ـ ولكن من لاقى إعجاب من عاش القضية وعرفها عن قرب …
أثناء إعدادي لهذه الورقة لفت انتباهي موضوعًا كتبه المدون الفلسطيني “محمود عمر” (واسم مدونته سيرة لاجئ)، محتفيًا بالرواية وصاحبتها ممتنًا لها هذا التوثيق الروائي الفريد اسمحوا لي أن أقتبس بعضًا مما قاله:
“يعجبني، لا بل ويأسرني الكتاب الذي أتيقّن من أن كاتبه قد اقتنع بدوري كقارئ، فراح يعطي تفاصيل التفاصيل حقّها، يفتح المجلدات والمراجع والموسوعات، يسمع شهادة هذا، ويقرأ تجربة ذلك، قبل أن يبدأ بالكتابة. رضوى لا تعطيك تأكيدًا على أهميّتك أنت فحسب، بل تؤكّد على أهميّة المادة المقروءة كذلك، يستحيل أن تقرأ لها منشكحًا، تقرأ وأنت منشد، متجهِّز في أيّ لحظة للغناء، معمّر بيت النار
إن المادّة المقدمة من تعابير شعبيّة، وألفاظ فلسطينيّة عاميّة، وأغانٍ وأهازيج، ومشاهد أفراح وطلبة فتيّات للزواج، لكفيلة بإدخال كائنٍ من كان، إلى داخل البيت الفلسطيني، وليعلم هذا العالم بمن فيه، ليعلم كيف يعيش الذين يموتون على الفضائيّات، ماذا يفعلون حين ياخذ الصحفيّون اجازة نهاية العام، في داخل خيمتهم، وراء متراسهم، في مركز أبحاثهم، وسفنهم الرّاحلة الى تونس، على فراش الزوجيّة، في المنفى، كيف ولماذا يكون الفلسطيني؟ كيف يتزوّج، وكيف يصير عاملاً في الخليج، وكيف يسبّ الدين في نصف الشارع، ويصلّي في رمضانَ التروايح …“.
الجميل في “شهادة” محمود وكلامه عن الرواية أنها تعبير من “فلسطيني” تعرَّف على مرارة الأحداث وعاشها، ليس مشاهدًا خارجيًا، فهي شهادة منه بأن ما كتبته وتكتبه “رضوى” هو أصدق تعبير وأقوى تعبير عنما حدث ويحدث في “فلسطين” هي شـهادة لهذا الشعب وهذا الجيل بالكامل، شهادة مكتوبة بلغة روائية سردية عميقة، وبطريقة أدبية لم تلجأ إلى “التريرية” أو “السطحية” والمباشرة أبدًا، لأنها “فنانة” تعرف كيف ترسم شخصياتها ومشاعر أبطالها وتجعلنا نعيش معهم لحظة بلحظة …
وفي النهاية لا تنحاز “رضوى عاشور” لاتفاقيات السلام، بل تتقمص شخصية “رقية لأقصى حد، لتلتقط وبذكاء نادر لحظة انتصارٍ استثنائية ونادرة في مسيرة الوجع العربي الفلسطيني الممتدة لأكثر من 60 عامًا .. لتعود “رقية الطنطورية” إلى جنوب لبنان بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من هناك ذليلاً كسيرًا خائبًا وسط صيحات الفرح والانتصار تعود “رقية” أخيرًا إلى أرض تشبه كثيرًا أرضها وأناس مقاومون صامدون يشبهون أهلها ترصد تلك اللحظة وتجعلك تعيش مع بطلتها، التي تفاجئ أن ما يفصلها عن ابنها “سلك شائك”، ولكنها هناك تجد الأمل وتبحث من جديد مع رمز الأمل الفلسطيني الذي تعرفت عليه رقية مبكرًا مع “ناجي العلي” …
لا يمكنني إجمال الحديث عن رواية بمثل هذه التفاصيل وهذه الروعة! فالحق أن كتابتنا تظل عاجزة لا لأننا عاجزون عن وصف ما تتركه فينا تلك التفاصيل من أثر وشجن، بل لإن الإلمام بها كلها أيضًا مستحيل!
في “الطنطورية” وثائق وشهادات مسجلة بأسماء أصحابها، وفي “الطنطورية” حقائق صادمة لأرقام الشهداء وطرق التنكيل بهم في المجازر والمذابح، وفيها فضح لما تقوم به السلطات العربية المتآمرة من قتل وإفساد لجهود باحثين وعلماء فلسطينيين في (مركز الأبحاث الفلسطيني) ومكتبته التي استولى عليه اليهود وضاعت وثائقه الهامة كما ضاعت دماء الشهداء والعلماء بين مصر والجزائر!
وفيها مع كل هذا وذاك الأمل .. في أن يعود الحق لأصحابه .. كاملاً!!