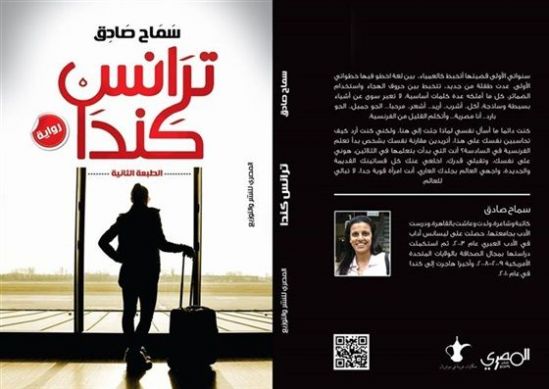ممدوح رزق
مات أستاذ مادة العروض والقوافي بكلية الآداب، قسم اللغة العربية، في اليوم التالي للقائي به، والذي اقتصر على تقديمي الشكر لعائلته الكريمة التي أنجبت إنسانًا معرّصًا مثله، وتوعّده لي بالفصل من الكلية قبل أن يطردني من مكتبه.. حينما علمت بالخبر كان أول ما خطر في ذهني أنه لو عاد مؤقتًا إلى الحياة كشبح ليرشد عن قاتله فسوف يوجّه الاتهام لي حتمًا، ليس نتيجة الاعتداء اللفظي في حد ذاته، بل لأن الشتائم التي أهنته بها كانت مختلة الوزن والقافية، وهو ما مثّل الجانب القاتل في الاعتداء.
لم تستطع أمي وهي جالسة في الصالة بيننا أن تتمالك نفسها حينما سمعت صرخة أخي الشاب الثلاثيني المشلول، الراقد داخل ظلام حجرته المغلقة، والتي لم يغادرها منذ سنوات عدة، بعد أن أفقده المرض خطيبته وأصدقائه ووظيفته وشقته التي لم يدخلها أبدًا، وحتى قدرته على إشعال السجائر بنفسه .. ضحكت أمي لأن صرخته كانت مضحكة بالفعل .. كانت تشبه تلك الصرخات الميلودرامية، التي غالبًا ما توصف بالافتعال الطفولي أو المبالغة الساذجة، بالرغم من أننا كنا متأكدين تمامًا من أن آلام أخي أكثر فظاعة مما تجسّده هذه الصرخة .. مسحة من الذنب كانت تحاول أن تطفئ الضحكات في عيني وملامح أمي بسبب ما اعتبرته بديهيًا رد فعل غير لائق، انفلت رغمًا عنها، إلا أن مشاركتنا العفوية أنا وأبي وأختي في الضحك جعلت تلك المسحة تتبدد على الفور .. لحظتها فكرت في أن أمي ربما ستطلب من أخي أن يعيد إطلاق تلك الصرخة أثناء تنظيفها اليومي لجسمه الهامد من البول والخراء كوقاية محتملة لها من البكاء والتقيؤ.
طلب مني طبيب الأمراض النفسية والعصبية الذي ذهبت إليه للعلاج من نوبات الهلع أن أحاول تجنّب الإفراط في التفكير، والبُعد عن مصادر القلق والاستفزاز والتوتر، والحصول على قدر كاف من النوم .. لم أجد طريقة لاسترداد نقودي سوى الاستمناء في حمام عيادته قبل خروجي منها، معدلًا في خيالي من تفاصيل الصورة العائلية فوق مكتبه، والتي ظللت أتأملها طوال حديثه لي.
فوق طاولة الطعام أطلب من أبي أن يناولني رغيفًا من الكيس الذي بجواره فيأمرني بالتوقف عن تقليد اللهجة الريفية لنجاح الموجي في مسلسل “سفر الأحلام” .. تخبره أختي بأنني لا أذاكر فيشتمها، ويأمرها ألا تتدخل ثم ينهر أمي لعدم متابعتها لأموري الدراسية .. تنظر أمي بلومٍ لأختي التي تلمح أخي الأكبر يرمقها بسخرية .. توجّه إليه كلمات جارحة فيشخر لها، ويمسك بأحد الأطباق ويضربه في الحائط ليتناثر حطامه المختلط بالطعام فوق الأرض .. ينهض أبي بعينين محتقنتين، وملامح توشك أن يفجّرها الغضب ليسب أخي بصوته الغليظ الجهوري فتحاول أمي تهدئته وهي تنعت أخي بوصف مهين .. يشتمها أخي بأمها ثم يسرع إلى المطبخ ويعود بجركن الجاز والولاعة فتتلاحق صرخات شقيقتي، وتسرع أمي لتفتح باب الشقة طلبًا للنجدة فيتدافع الجيران إلى الداخل بينما أتسلل إلى البلكونة، وأغلقها من الخارج ثم أتطلع نحو الغيوم، وأتمتم مرتعشًا بأول ما يخطر في ذهني من كلمات لا تنتمي إلى الضجيج المستعر ورائي، مقلدًا اللهجة الريفية لنجاح الموجي في “سفر الأحلام”.
نمر أمام مكتبة “تنمية” فتطلب ميادة أن ندخلها، وأن أشتري لها كتابًا من اختياري .. ألتقط لها كتاب “الضفادع الملتهبة” للكاتب الفرنسي هنري لي روكس، ترجمة: ندا القلوط .. تسألني ميادة عن موضوعه؛ فأخبرها بأن الكاتب يتعرّض للحساسية المفرطة لدى أعضاء الجماعات والقبائل الأدبية في المدن المركزية التي تهيمن عليها المأسسة الثقافية، والنتائج غير المحكومة، الفائضة بالتأثيرات ـ اللامؤسسية ـ التي لا تتوقف عن كشف ما لم يكن يبدو متضمنًا لها، والصور المتشابكة، دائمة التوالد، للإقصاء والتعتيم التي تمارسها هذه التأثيرات على هوامش وأطراف تلك المدن .. يسمي الكاتب هؤلاء بـ “الضفادع الملتهبة” نظرًا لعجزهم المزمن عن تحمّل أي تذكير باستفادتهم المنطقية من المركز؛ حيث ينتفضون، كما تفعل الضفادع تمامًا، بمجرد أن يلامس هذا التذكير جلودهم الملتهبة، ويسارعون باستخدام سياقات لغوية قديمة ومبتذلة، تمنعهم شدة الالتهاب من استيعاب أنها مكشوفة على نحو فاضح للآخرين .. ترتكز هذه السياقات على جذب الوجع خارج موضوعه بواسطة استدعاء مفردات سهلة ومقصودة كـ “المظلومية” مثلًا لإلصاق دلالتها النمطية البائسة والمضحكة في نفس الوقت بكل من يطرح تناولًا أو إشارة للمكاسب التي لم يكن لهؤلاء الضفادع أن يحصلوا عليها لو بذلوا المجهود ذاته في مكان آخر .. يوضح الكاتب كيف يحاولون ـ بنطاعة متأصلة ـ أن يفرضوا هوية مزيفة على ذلك الذي يقف خارج الجماعة أو القبيلة، أو بالتعبير الدارج “الشلة الأدبية” بأشكالها المتعددة، منتهكًا تلك السلطة التي تمنح أفرادها يقينًا متوهمًا بالتفوق القيمي .. تحاول الضفادع الملتهبة بتلقائية مسعورة، بالغة التعاسة أن تنسب إلى من يقوم بذلك قصدًا قسريًا لا يمثله، ومعنى ملفقًا لخطابه .. يحلل الكاتب الفروق التأسيسية بين المدينة المركزية وهوامشها، كيف تنشأ علاقات القوة بين المؤسسة وأطرافها، ومسارات تطورها، كيف تتشعب وتتداخل وتتكاثر خارج أطرها التقليدية، كما يوضح أيضًا كيف تكمن السلطة المركزية في اللغة التي تُستعمل لإنكارها؛ حيث تتكفل الضفادع الملتهبة بإقرارها عن طريق الاستخدام المتواصل لتلك السياقات اللغوية الساذجة، التي ينبغي بحسب تأويلها المعتاد أن تكون “مُرهبة” لذلك الذي يقوم بتقويض هذه السلطة .. يسعى كل ضفدع أن يحوّل الأمر إلى معركة فردية، على كل من هو خارج “الشلة” أن يدافع عن نفسه خلالها أمام الاتهامات المختلقة، مما يتيح لذلك الضفدع أن يضلل ما يعدها “بطحة” فيؤكدها، ويعترف ضمنًا برغبته في حماية ما يستثمره، وتوطيد دعائمه المختلفة .. ما يحاول الدفاع عنه أيضًا هو موقفه ضد النظام السياسي الذي تخضع له المدينة المركزية، ذلك لأن الضفدع الملتهب لا يريد لاستفادته المؤسسية أن تلوث فكرته عن نفسه، وكذلك انطباع الآخرين عنه كمعارض، أو كمناوئ لهذا النظام، يحظى في الوقت نفسه بامتيازات “رسمية”، تقتصر على المكان الذي يتحرك داخل حدوده .. يحدد الكاتب أصل المشكلة، أو “جوهر الالتهاب” في عدم قدرة هذه الضفادع على التفرقة بين نقد النسق الثقافي، ونقد التابعين له؛ حيث لا تعني مجابهة النسق بالنسبة لهم سوى إدانتهم، باعتبارهم يمثلون مع مختلف ظواهره كيانًا واحدًا، وهذا يرجع ـ مثلما ذكر هنري لي روكس من قبل ـ إلى “وهم التفوق” الذي يزرعه المركز في أرواحهم، وهو بالطبع ما لا يجب خسارته.
أعود بعد تجاوز الأربعين إلى مدرستي الابتدائية .. تتعاقب المعلمات أمام السبورة ليشرحن الدروس للتلاميذ الجالسين في مواجهتها، ويرتدون المرايل التي في الغالب تكون باهتة أو متسخة أو مقطّعة .. فوق الدكة الأخيرة من الصف الأوسط للفصل أضاجع زميلاتي الجميلات اللاتي مازلن أطفالا واحدة تلو الأخرى .. تقرأ معلمة اللغة العربية ذات الوجه الأسمر المتجهم بصوت مرتفع من كتاب القراءة، بينما التلاميذ بالبلاهة الناعسة التي تغطي ذبول ملامحهم يرددون ورائها بما فيهم البنت التي أضاجعها: (أمي أمي .. عمر عند الزرع .. انظري يا أمل .. هذا زرعي .. زرعي طلع) .. تمسك المعلمة فجأة بالعصا ثم تتوجه بخطوات سريعة نحو أحد التلاميذ وتنهال على جسده ضربًا لأنه كان ينظر إلى خارج النافذة، ولا يردد ما تقوله .. تتوقف المعلمة عن القراءة، وتسألني بضيق ونفاذ صبر أن أكف مؤقتًا عما أفعله كي أنتبه لها .. ألتفت ناحيتها مستمرًا في دفع قضيبي داخل الفتاة العارية المستلقية فوق الدكة رافعة ساقيها المستندتين على كتفيّ وأقول لها: لقد انتظرت أكثر من ثلاثين سنة حتى أتمكن من القيام بهذا .. هل تتوقعين مني أن أتوقف الآن؟
ترد غاضبة: حسنًا .. حاول على الأقل أن تكون عادلًا، وألا تميّز بعض التلميذات عن بقيتهن…
أضحك شاخرًا: هل تريدين أنا أضاجع الدميمات، والشاحبات، والكالحات، والبدينات، وذوات المخاط السائب دائمًا، والروائح النتنة، والأنفاس الكريهة، والشعر المتلبّد، واللعاب المتدفق من أطراف أفواههن، والشفاه الجافة، المتشققة والمتلاصقة، التي تصدر صوتًا مقززًا، ممزقًا للأعصاب حين تنفصل عن بعضها، والعيون الفائضة بالعماص، واللواتي يضعن أصابعهن ذات الأظافر الطويلة التي تختزن القذارة السوداء في أنوفهن طوال الوقت؟! .. بعد كل هذه السنوات، مازلت حقيرة يا أبلة.
أسمع ضحكة متأوهة من بين شفتي الفتاة الجميلة الراقدة فوق الدكة فاتحة فخذيها، وجسمها الصغير يرتعش منسجمًا مع إيقاعاتي المتبدلة .. تزعق المعلمة بملامحها النحيفة المحتقنة: كنت أظنك ولدًا مؤدبًا.
أزيد من سرعة وقوة اندفاعاتي داخل البنت التي بدأت تعض سبابتها بموازاة فكيها، وملامحها الرقيقة الصامتة متقلصة بالتوجع واللذة .. أقول للمعلمة: بل كنتِ تظنينني مثلما يعتقد الجميع؛ أحمقًا، وخجولًا، وفاشلًا اجتماعيًا، خصوصًا مع الفتيات والنساء .. كان معكم حق، وللعلم فمازلت كما أنا.
أشعر باقتراب الأورجازم .. أخرج قضيبي من بين فخذي البنت وقبل تدفق نشوتي مثلما أحب فوق ثدييها العاريين؛ تندفع المعلمة نحوي بأقصى سرعة لتجلس على ركبتيها أسفل قضيبي فاتحة فمها عن آخره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المتوالية القصصية “البصق في البئر” ـ قيد الكتابة.