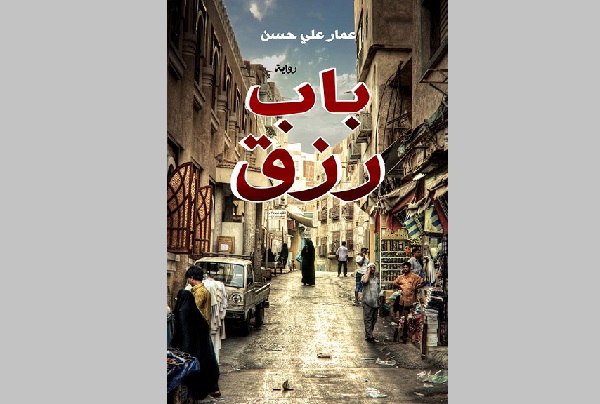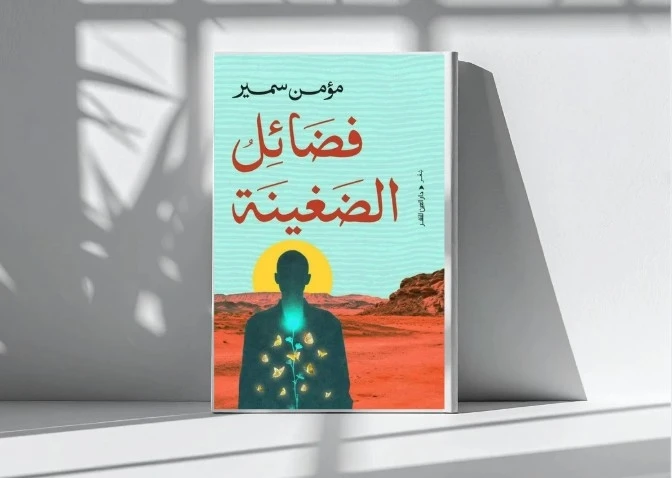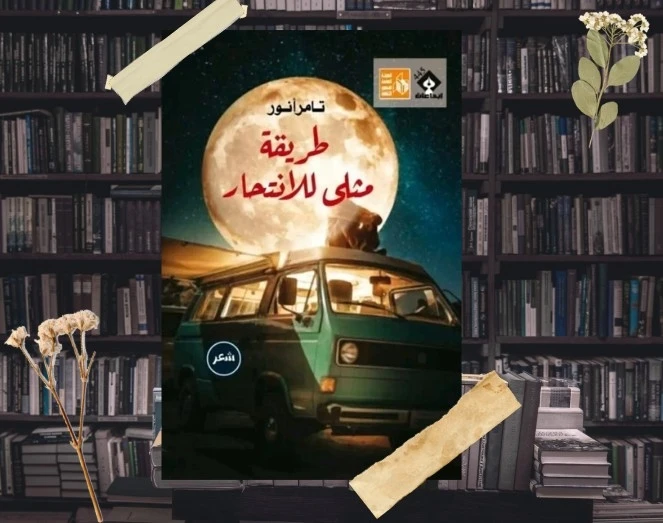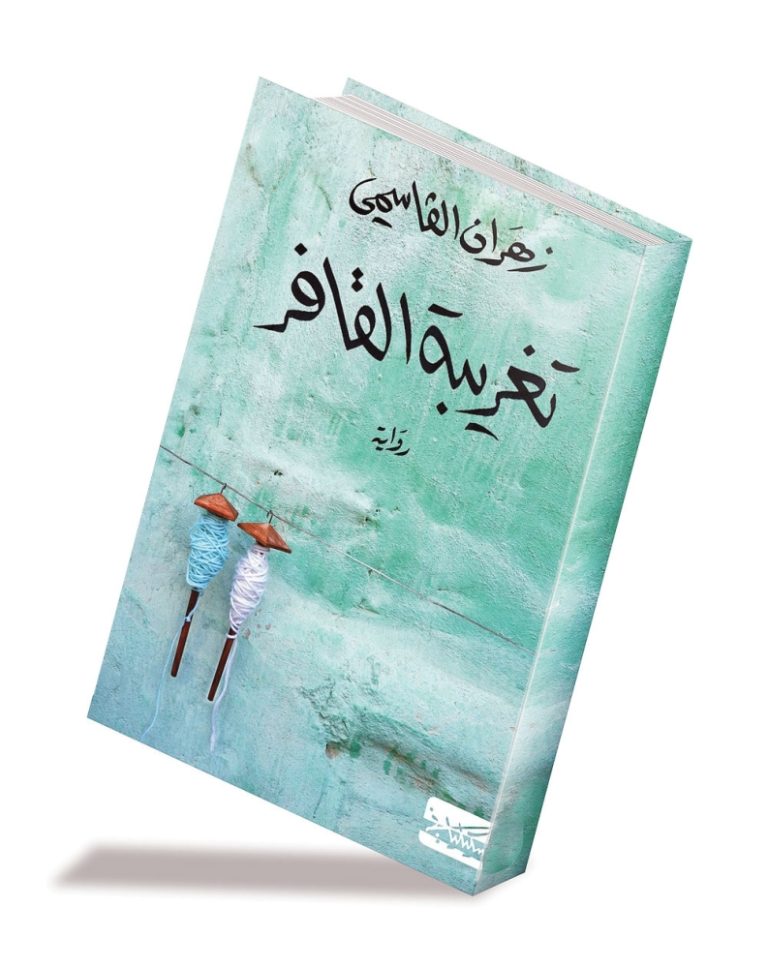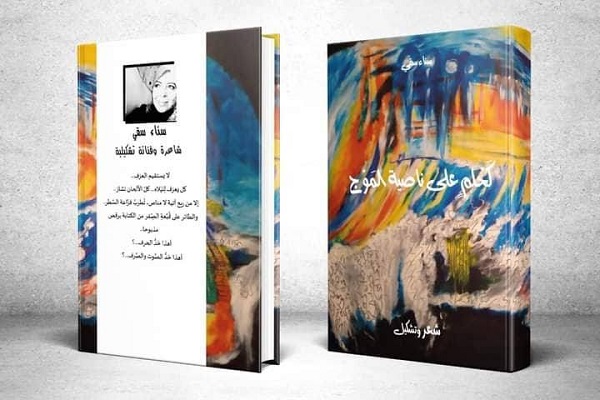بولص آدم
نشأت العلاقة بين الأدب والفوتوغرافيا ضمن مناخ ثقافي شديد الحساسية تجاه فكرة التمثيل. فالصورة الفوتوغرافية، منذ لحظاتها الأولى في القرن التاسع عشر، أعادت صياغة مفهوم الرؤية، وأدخلت عنصرًا جديدًا في فهم الواقع، عنصرًا يقوم على الالتقاط الفوري، وعلى تثبيت الزمن داخل إطار مادي. في المقابل، كان الأدب قد راكم عبر تاريخه الطويل أشكالًا متعددة لتمثيل العالم، قائمة على اللغة، والخيال، والتأويل، وعلى قدرة الكلمة على تجاوز المرئي نحو ما يتعذر الإمساك به مباشرة. هذا التفاوت في طبيعة الوسيطين جعل اللقاء بينهما مترددًا في البداية، محاطًا بالتحفظ والأسئلة الجمالية.
في تلك المرحلة، بدت الفوتوغرافيا أقرب إلى أداة توثيق منها إلى حقل تعبيري مفتوح، بينما كان الشعر ينظر إلى نفسه بوصفه فنًّا يشتغل على ما يتجاوز الظاهر. غير أن هذا التصور لم يظل ثابتًا، إذ سرعان ما بدأت التحولات الاجتماعية والتقنية في إعادة رسم حدود الفنون، وفرضت على الأدب أن يعيد التفكير في علاقته بالصورة، وبفعل الرؤية نفسه. فمع انتشار الصورة في الحياة اليومية، ومع تحوّلها إلى جزء من الوعي الجمعي، لم يعد ممكنًا تجاهل تأثيرها في طريقة إدراك العالم، وفي بنية الحسّ الحديث.
في سياق الحداثة، بدأ الشعر يتخفف من أنماطه التعبيرية الثقيلة، واتجه نحو تكثيف اللحظة، والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة، وإلى المشهد العابر. هذا التحول لم يكن معزولًا عن منطق الفوتوغرافيا، حيث تقوم الصورة على اقتناص لحظة واحدة، مشحونة بالدلالة، ومفتوحة على ما يحيط بها من صمت وظلال. القصيدة الحديثة، في هذا المعنى، أخذت تقترب من بنية اللقطة، حيث تتراجع الحكاية المتسلسلة لصالح مشهد مكثف، يتشكل عبر اللغة كما تتشكل الصورة عبر الضوء.
ومع هذا الاقتراب، لم تعد الصورة عنصرًا خارجيًا يُشار إليه داخل النص، وإنما أصبحت جزءًا من طريقة الكتابة نفسها. الجملة الشعرية صارت أقصر، أكثر تركيزًا، وأكثر ميلًا إلى الإيحاء. البياض داخل الصفحة بدأ يؤدي دورًا دلاليًا، كما يؤديه الفراغ داخل الصورة. ما لا يُقال في القصيدة أصبح جزءًا من معناها، كما أن ما لا يظهر في الصورة يشكّل جزءًا من تأثيرها.
ضمن هذا التطور، انتقل الاهتمام من الصورة المفردة إلى فكرة الألبوم بوصفه بنية للذاكرة. فالألبوم لا يقدّم العالم في صورة واحدة مكتملة، وإنما في سلسلة من اللقطات المتجاورة، تفصل بينها مسافات زمنية ونفسية. الصور فيه لا تُقرأ وفق تسلسل صارم، بل وفق علاقات خفية، تقوم على التشابه، أو الفقد، أو الحنين. هذا المنطق وجد صداه في نصوص شعرية كثيرة، حيث باتت الذاكرة تُستعاد عبر شذرات، ومقاطع منفصلة، تتجاور داخل النص كما تتجاور الصور داخل الألبوم.
الألبوم، في هذا السياق، يتحول إلى نموذج للكتابة الشعرية ذاتها. القصيدة لم تعد تسعى إلى استعادة الماضي بوصفه كيانًا متماسكًا، وإنما تقترب منه عبر آثار متفرقة، تحتفظ بشيء وتفقد أشياء أخرى. الصورة داخل الألبوم تحمل وجهًا ثابتًا، بينما الزمن الذي يحيط بها يظل متحركًا، وهذا التوتر بين الثبات والتحول يشكل مادة خصبة للتأمل الشعري.
يتكثف هذا البعد حين يدخل الألبوم في علاقة مع المنفى. فالصورة، في تجربة الاقتلاع، لا تكتفي بتسجيل ملامح أشخاص أو أماكن، وإنما تتحول إلى مساحة بديلة للانتماء. الألبوم العائلي، المحمول عبر الحدود، يحمل داخله زمنًا خارج الزمن الراهن، زمنًا لا يجد مكانه في الواقع الجديد. في الشعر العربي الحديث، يظهر هذا الاشتغال بوضوح، حيث تتكرر صورة الألبوم بوصفه أرشيفًا هشًا للذاكرة، يحفظ بقايا حياة سابقة، ويقاوم تآكلها عبر التذكر.
في هذه النصوص، تتعامل القصيدة مع الصورة بوصفها أثرًا ناقصًا. العدسة تلتقط ما يظهر أمامها، بينما التجربة الإنسانية تتجاوز حدود الإطار. هذا الفارق يولد توترًا دائمًا داخل النص، حيث تحاول اللغة أن تقترب من الصورة، دون أن تذوب فيها. القصيدة تكتب حول الصورة، وتفكك صمتها، وتطرح الأسئلة التي لم تطرحها الكاميرا.
كما يظهر في هذا السياق اشتغال واضح على الجسد. الجسد في الصورة يبدو متوقفًا عند لحظة معينة، محاصرًا بالإطار، بينما الجسد في الذاكرة يتغير، يشيخ، يختفي. هذا التناقض ينعكس شعريًا في لغة تراقب الزمن وهو يمر عبر الجسد، وتتعامل مع الصورة بوصفها شاهدًا صامتًا على هذا المرور. القصيدة، هنا، تتحول إلى مساحة حوار بين الجسد المرئي والجسد المتخيل، بين ما بقي وما مضى.
على المستوى الأسلوبي، أدّى هذا التداخل إلى بروز كتابة تعتمد على التقطيع، وعلى الانتقال بين مشاهد قصيرة، دون وصل تقليدي. النص يتحرك كما يتحرك النظر داخل الألبوم، من صورة إلى أخرى، ومن تفصيل إلى تفصيل. هذا الأسلوب يمنح القصيدة إيقاعًا بصريًا، حيث تتشكل الدلالة عبر التجاور أكثر مما تتشكل عبر الشرح.
كما أن هذا الاشتغال أفرز وعيًا متزايدًا بحدود التوثيق. الصورة تثبّت لحظة، غير أنها تعجز عن احتواء التجربة بكاملها. الشعر، في تعامله مع الصورة، لا يسعى إلى استكمالها، وإنما يشتغل على ما يتسرب منها. الكلمات تحاول أن تلامس الفراغات، وأن تصغي إلى ما لم يُلتقط، وأن تمنح الغياب شكله اللغوي.
مع تطور هذه الرؤية، أصبحت الصورة عنصرًا بنيويًا في التفكير الشعري، لا مجرد موضوع عرضي. القصيدة تُكتب كما لو كانت صفحة من ألبوم، أو تعليقًا متأخرًا على لقطة قديمة، أو محاولة لإعادة ترتيب الذاكرة عبر ما تبقى منها. هذا ما يمنح كثيرًا من النصوص العربية المعاصرة طابعًا تأمليًا، يتقاطع فيه الحنين مع الشك، والرغبة في التذكر مع وعي الفقد.
في هذا التلاقي بين الكلمة والصورة، تتشكل منطقة جمالية مشتركة، حيث لا تُلغى خصوصية أي من الوسيطين، وإنما يُعاد تعريفهما عبر الحوار. الصورة تقدّم أثرًا بصريًا، والقصيدة تمنحه زمنًا لغويًا. الألبوم يحفظ، والنص يعيد القراءة. ومن هذا الاشتباك، تنشأ كتابة قادرة على مساءلة الذاكرة، والهوية، والزمن، دون ادعاء اكتمال أو يقين.
هكذا، يمكن النظر إلى حضور الصور الفوتوغرافية وألبوماتها في الأدب والشعر بوصفه تحولًا عميقًا في طريقة التفكير بالكتابة نفسها. لم تعد القصيدة تسعى إلى الإمساك بالحقيقة، وإنما إلى ملامسة آثارها. لم يعد الهدف تثبيت اللحظة، وإنما الإصغاء إلى هشاشتها. وفي هذا الأفق، يواصل الشعر دوره بوصفه فنًّا للانتباه، يقترب من الصورة، ويحاورها، ويتركها مفتوحة على ما لا يمكن قوله دفعة واحدة.