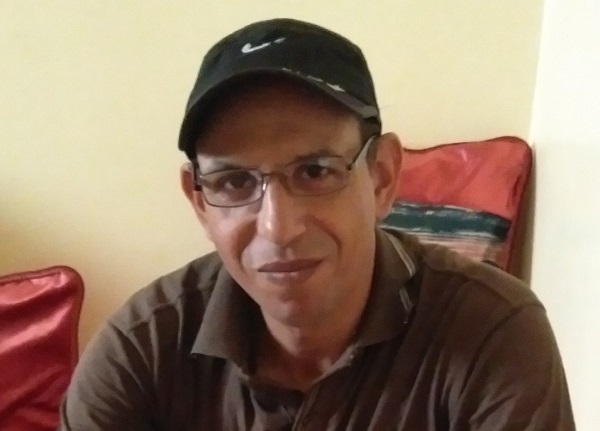عبد الرحمن أقريش
المكان: آسفي
الزمن: 1988.
يقال إننا لا نختار أسماءنا.
اسمي (هبة)، وهو كما ترون اسم تقليدي، لم أحب هذا الاسم أبدا، ولكنني في النهاية تقبلته، تقبلته دون أن أتصالح معه، وحدث كثيرا في ظروف وسياقات معينة أن تنكرت له واستبدلته بأسماء أخرى من وحي اللحظة، أسماء أفترض أنها عصرية، مشرقة، وأكثر جمالا…
ولدت في زمن مختلف، زمن يبدو بعيدا الآن، بعيدا جدا، آنذاك نأتي إلى العالم، يأتي بنا، ويقرر آباؤنا كل شيء، أسماءنا، ملابسنا، مدارسنا، تربيتنا، أصدقاءنا، أزواجنا، أسماء أبناءنا، وأحيانا أسماء حفدتنا…
وأخيرا عندما ينجح أحدنا في التحرر من هذه التبعية، يكون الوقت قد فات، يكون بعض الآباء أمواتا أو شيوخا عجزة يستحقون الرحمة والشفقة وليس التمرد…
ومع ذلك، فهذا الأمر ليس مهما الآن، فللحكايات دوما وجهها الآخر.
أنا واحدة من (بنات النادي)، جيل المتمردات الأول، أنا الحب الأول في حياة (المامون)، في الحقيقة ليس الأمر كذلك، أعرف، أعترف الآن، ولكن يحلو لي أن أتخيل ذلك، والمهم أنني جعلت البنات، بنات النادي يصدقن ذلك، والأهم من ذلك كله أنه أمر كان يشعل نيران الغيرة والحسد في نفوسهن، وينبغي أن أعترف أيضا أن ذلك كان يشعرني بسعادة عارمة.
أتذكر، كان يوم أربعاء، أتذكره وكأنه حدث بالأمس.
قررت بنات النادي الذهاب إلى السينما، (بنات النادي) هو الاسم الذي تستعمله البنات، ويستعمله الجميع في المدينة للإشارة إلى الفتيات المنخرطات في (النادي النسوي)، تقع سينما (الريف) في حي (الزاوية)، غير بعيد عن النادي، بضع دقائق مشيا على الأقدام، والسينما في ذلك الزمن البعيد لم تكن تعني أفلاما وفرجة فقط، بل كانت عنوانا للحرية والسعادة، فعندما نحب الحياة نذهب للسينما، كان ذلك شعار المرحلة، لا أذكر أين قرأت ذلك، ربما في مجلة شبابية، أو ملصق سينمائي، آنذاك كانت السينما فرصة أسبوعية للشباب والمراهقين للتحرر والانفلات من القيود إلى حين، قيود الأسرة، قيود المدرسة، قيود الشارع، وقيود النادي النسوي بالنسبة للإناث، السينما كانت بالخصوص فرصة للذهاب إلى مواعيد غرامية، والاستمتاع بأجيج مراهقة بدأت بوادرها مبكرا تلوح في الأفق، مراهقة محاصرة، شقية، عصية، عنيفة وجارفة.
لسبب ما كانت (بنات النادي) أكثر تحررا من (بنات الليسي) وكنت أنا أكثر جرأة من الجميع، كنت مراهقة تحركني أحلام الطفولة وأوهامها، وعندما يتعلق الأمر بالمشاعر والعواطف ونداء الهرمونات كنت أفقد زمام أمري وأستسلم لسعادة عارمة، في سن مبكرة انتبهت أنني أريد أن أكون سعيدة، وانتبهت أن ذلك لم يكن ممكنا بدون حب، بدون عواطف، بدون جرأة وجرعة قوية من قلة الأدب…
ينظر(المامون) للملصق، أقف بجانبه على بعد خطوة أو خطوتين، أنظر إليه وأنتظر، أحاول أن أقرأ التعبير الذي يرتسم على وجهه، ينتبه، أبتسم، يرد هو بابتسامة أخرى مشجعة، أذهب توا إلى الشباك، أقتني تذكرتين، أعود بسرعة، أسحبه من ذراعه وندلف إلى الداخل.
هل أحببت (المامون)؟ نعم.
هل كان يحبني؟ لا أدري.
– الحياة أوسع من أنثى واحدة…
تلك عبارته المفضلة عندما يتعلق الأمر بالنساء والعشيقات…
في البداية كنت أكلمه بتحفظ، تحفظ مصطنع طبعا، أنتقي كلماتي بحرص شديد، فقد أردت أن أبدو قوية، وكنت أخشى بالخصوص أن يعتقد أنني فتاة سهلة، ثم حدث ما كان طبيعيا أن يحدث، ما كان ينبغي أن يحدث، فمشاعر الغيرة والرغبة في التملك والخوف من الهجر والفقدان هي دوما أمور مؤلمة، يتحول معها الحب إلى جحيم لا يطاق، ومع مرور الأيام اقتربت منه أكثر، اصبحنا صديقين، أكثر قليلا من صديقين، وانتبهت أنه لم يكن قابلا للتملك، ومن جهتي، ينبغي أن أعترف أن هذا الاكتشاف كان أمرا مريحا، فالشخص الذي لا ننجح في تملكه، عادة لا نخشى من فقدانه، أو هو فقدان بألم أقل، ولكن ذلك الاكتشاف كان مريحا لسبب آخر، (المامون) شخص كريم النفس ومستعد دوما للصداقة، وفي كل مرة أقع في ورطة، أحمل تعبي، ألجأ إليه، يسمعني، ويدعني أبكي على كتفيه.
أتذكر، لن أنسى أبدا، كان أيضا يوم أربعاء.
انطفأت الأضواء منذ لحظات وراح الفيلم يحكي قصته، ثم حدث ما لم يكن منتظرا، حضرت مديرة النادي رفقة الموظف المسير للسينما، المديرة سيدة ذات شخصية قوية وصارمة، يبدو الرجال أمامها لا شيء، مجرد دمى، كراكيز، عيدان قصب جوفاء تنفخ فيها الريح، جاءت إلى السينما لتعيد الأمور إلى نصابها، فبنات النادي لا يحق لهن الهروب من حصة (الطرز الفاسي) والذهاب إلى السينما.
تستعرض المديرة الصفوف صفا صفا، يسلط الموظف مصباحه اليدوي على الوجوه من بعيد، وفي كل مرة تغادر البنات تباعا.
يلتفت (المامون) إلى الرجل بجانبه.
– عفاك، أعرني جلبابك، سأرده لك بعض لحظات…
لبست الجلباب فبدوت مثل فلاح دكالي، يستعرض المصباح الصفوف والوجوه بحثا عن بنات النادي المتمردات، يمر دون أن يتوقف عندي، غادرت المديرة وهي تدفع أمامها آخر ضحية وسط الصفير والهتاف والكثير من السخرية…
– وسيري تعلمي الطبخ والطرز الفاسي واستعدي للزواج !!