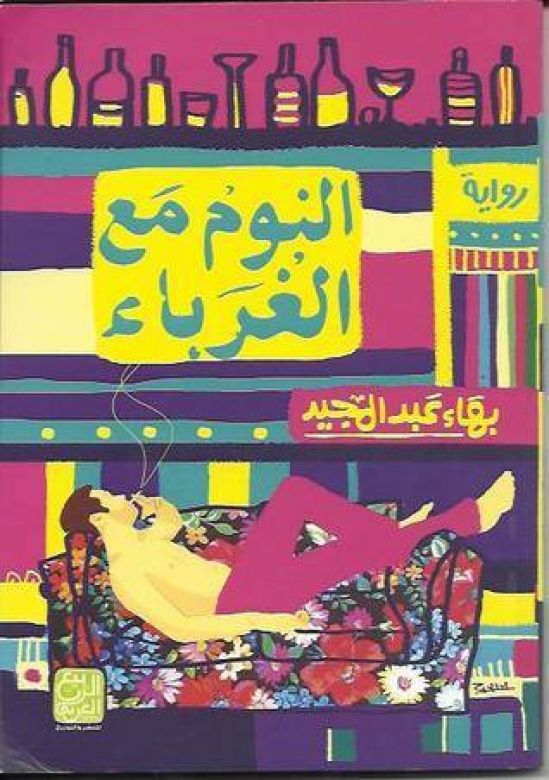بسنت الوكيل
بزوغ الفجر بالنسبة لها إشارة لاستكمال الحياة، أو بالأحرى أمر إجباري لتكمل حياتها. أصعب شيء عليها أنها ما زالت تتنفس، ما الفائدة من بقائها إلى الآن؟ ربما هناك مغزى! هكذا تختم حديثها الليلي المتكرر حتى طلوع الشمس، فتتحول الإشارة للون الأخضر، ويصبح فرضًا عليها أن تتحرك بمركبتها الثقيلة.
تحب أذان الفجر وصوت المؤذن، وصوت جارتها وبناتها، تجد فيهم أنسًا ومودة، أحيانًا تهمس للعصافير أن يخفضوا صوتهم لتجيد سماع همهمة الأطفال. تنهي صلاتها، تسبّح على أصابعها، تدعو لمن فارقوها، تمسك صورهم وتطمئن على واحدٍ واحد: عائلتها، والديها، وأخوتها الذين افترقوا أثر أشياء كثيرة. تنسى كيف فقدتهم، لكن تتذكر جيدًا أن مع كل رحلة لجوء يقع منهم واحد، سواء في حفر الموت حيث اللاعودة، أو ربما شق طريق نجاة بعيد لا تعرفه. لكن أكثر صورة تحدق فيها وتحدثها هي صورة زوجها، وتضع وراءها نتائج تحاليل حملها التي توضح أنها كانت حاملًا في توأم، فقدتهما مع والدهما، وللأسف نجت هي. وعندما أخبرتها الدكتورة بذلك، ظلت تكذبها وتقسم أنهم ما زالوا في رحمها. للآن تشعر بحركتهم حتى دون إرادتها تضطر أن تتمهل في حركاتها.
تحضر إفطارها سريعًا، ودون إرادتها تصنع لزوجها معها، وأحيانًا ترد على ندائه المعدوم. تأخذ فطارها وتجر خيباتها، وتجلس بجانب شباك المنور، تسمع همسات جارتها التي تجهز بناتها نجيا وفداء للذهاب للمدرسة. تعرف صوت كل واحدة منهما وروتينها المتكرر: نجيا هي التي تستيقظ أولًا وترفض الفطار، وفداء تتضجر لأن رابطة شعرها ليست بجودة رابطة نجيا. تبقى معهما تستمتع بصوتهما الطفولي البريء، وهمهمات أمهم وصبرها الطويل، مسلسل إذاعي حي لا تمل سماعه، حتى تسمع أزيز الباب فتعرف أنهم نزلوا، وأحيانًا تسمع قبلة والدتهم لهم وتشعر بالعناق الدافئ الذي بدأوا به الصباح.
تخرج للفراندا، تطمئن أن كل أطفال الحارة وصلوا للمدرسة. هنا عليها أن تتأهب سريعًا، تلبس خمارها الطويل والشال المفضل. تعرف أن دقة ساعة مهمتها. تجر الدراجة بعربة البضاعة الصغيرة أربعة أمتار حتى تصل لباب المدرسة الخلفي، تجلس في الشارع أمام الباب مباشرة، خلفها السيارات تمر وموقف لا يكف سائقيه عن النداء. مصدر رزقها فتحة صغيرة من الباب تدخل فيها كفها وتتسع لكفي طفلين، ربما ترى منها أرجل المعلمين ونصف وجوه الأطفال.
هي تجلس على مقعدها البلاستيكي مع بضاعتها، تنتظر الأطفال يمدون أيديهم الصغيرة ويطلبون ما يروق لهم. معها خبز صغير دافئ تتغلب به على طول الليل وتخبزه لأجلهم فقط، ومعها من الحلوى أطعمها وأرخصها التي تكفي مصروف أبناء النازحين. عندما يبدأ الطابور تعرف جيدًا الأطفال الذين يهربون منه ويتسللون لشراء الحلوى. تبقى طوال الفترة المدرسية من السابعة حتى الظهيرة لأجلهم. الأطفال يعرفون لمسة يدها الحنونة والخشنة في نفس الوقت، يظنها بعضهم عجوزًا، لولا صوتها الحنون وهي ترد على طلباتهم. هي أيضًا تعرف لمسة يد كل منهم، تعرف تلك اليد التي تمد فارغة من المال فلا تردها خائبة. تحفظ يد نجيا وفداء اللتين أوصتهما والدتهما ألا يشتريا منها سوى الخبز لأن باقي الحلوى تراقبها الشمس. سمعت هذا التحذير الدافئ صباحًا مع تجهيزاتهما للمدرسة، وتعرف أن أمهم لا تكذب أو تفتري عليها. بالفعل الشمس عمودية عليها وعلى بضاعتها طيلة فترة المدرسة، تحاول اجتنابها بشتى الطرق لكن دون جدوى. تقول لنفسها إن ضربة الشمس عليها هي التي تسمح لها بالنوم، حتى إنها لا تنام أيام الإجازة.
الطابور هذا اليوم كان طويلًا، يفر الأطفال من ملله أحيانًا ويشترون منها. عرفت من مطلعه أنه احتفال بشيء ما.. احتفال بأمل مسلوب وأرض منكوبة، لم يتضح لها ماهية هذا اليوم. تجلس كعادتها تحت أشعة الشمس تنتظر أيديهم الصغيرة، تجد أن هذا الباب الذي يفصلها عنهم كأشياء كثيرة: قاسية، حدود، وفراق، وخوف… حاولت أن تسمع فقرات الطابور بإصغاء: من أول المسرحية التي عبرت عن مأساة حدثت بالفعل، شمت من صوت ممثليها الصغار غبار الظلم الذي تعرضت له من طفولتها حتى الآن.
سمعت صوت بعض الأساتذة يلقون في الميكروفون على الطلاب حديثًا من قبيل الأرض والقضية، ويكررون بعزم. عرفت أنه الحديث الذي لا يجب أن يُمَل من تكراره، وأملت أن يكون هو البذرة التي يسقيها الزمن ويكبروا ويغيروا هم شيئًا. مرت هذه الفقرة وتلتها فقرة غنائية عرفت من مطلعها أنها غناء نجيا وفداء، فقد سمعتهم أمس يتدربون عليها مع والدتهم، والآن بصوتٍ أرق من النسيم وأجمل من صوت الفراشات -لو أن للفراشات صوت-. صوتهم من مكبر الصوت شعرت كأنه هارب من السماء. ظلوا يغنون: “يا عالم أرضي محروقة.. أرضي حرية مسروقة.. أعطونا الطفولة.. أعطونا الطفولة.. أعطونا الطفولة..”
هم يغنون وهي طفولتها تمر أمام عينيها، تزداد قسوة أشعة الشمس وأشعة الفقد والألم أقسى. شريط حياتها يمر أمامها: من أول بيتها المقصوف، لحد زواجها في أعماق الحرب، وزوجها الذي فقدته وهم ينزحون، وكل المحاولات الفاشلة للبحث عن أمان. الدموع تنهمر من عينيها، كلما طالت الأغنية. الصغيرتان بأعلى ما فيهما من همة وصوت يستغيثان بأغنية: “يا عالم أرضيييي…” لكن العالم رد عليهما بقصفٍ جديد.
شعرت أن الأرض ترج من تحتها، وأن نهاية العالم الآن. باب المدرسة صامد، وهي خلفه تحاول أن تتسلق لتطمئن على أطفالها كما تعتبرهم، تود أن تحضنهم كلهم بذراع واحد. “كيف حالكم؟” هكذا تصرخ. لعنت هذا الباب وكل الحدود الفاصلة. تحاول التسلق لكن فجأة مسكت بطنها ثورة من الألم والغضب تقام فيها. تقسم أنها تلد، رغم أنها متأكدة أنها فقدت جنينها منذ عامين، لكنها تشعر أنها ستلد. ومن الألم سقطت أرضًا.
“لا تدخلي في الغياب
سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسيل
سنطردهم عن حجارة هذا الطريق الطويل
سنطردهم من هواء الجليل”
عندما استردت وعيها وجدت نفسها على سرير في شبه مستشفى، لا تعرف كم مر من الأيام ولماذا عمر جديد للمرة المئة. أهي الأرض التي لن تموت؟ سألت عن طفليها التي تتعمد أنها ولدتهما، لكن لم تجد ردًا. صرخت وسألت مجددًا، ألحت في السؤال، وعندما فقدت الأمل قالت إنها يجب أن تذهب لباب المدرسة لتؤدي عملها وتطعم الأطفال. أجابتها الممرضة بلهجة حادة يائسة: “وين بتروحي؟ المدرسة مقصوفة ويد الأطفال مبتورة!”.