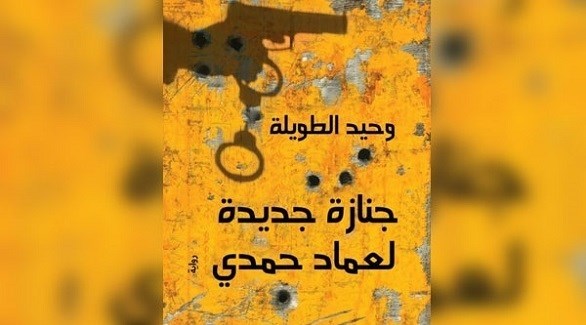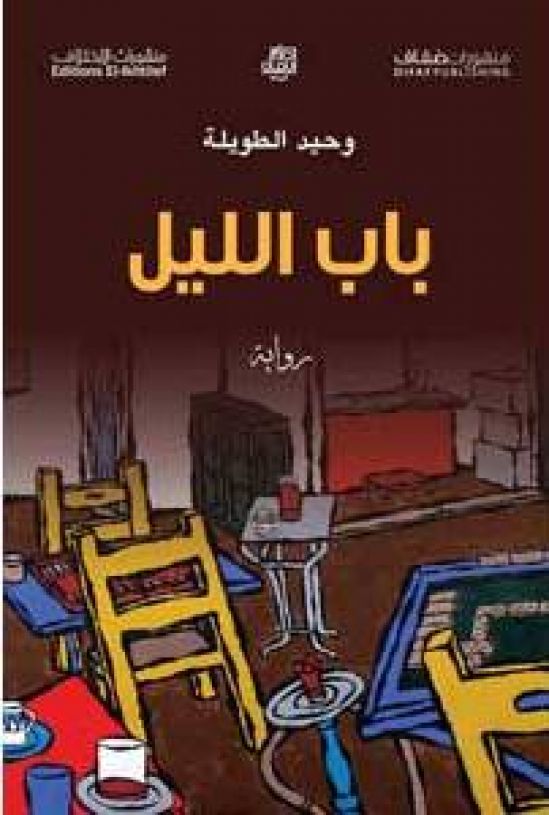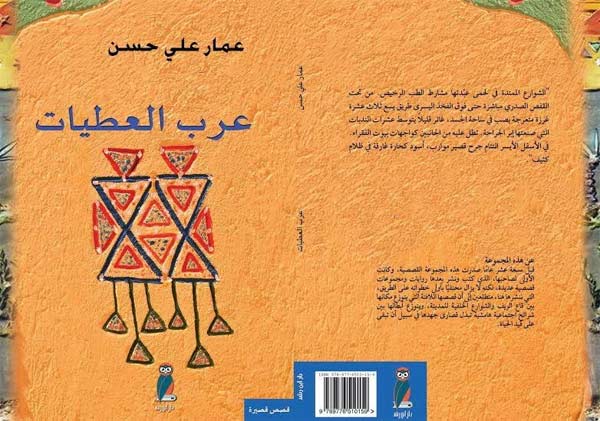تنفتح الرواية على حدث استقبال أهل مدينة تطوان الفقيه أحمد بن عجيبة في حال غير الحال الذي عهدوه عليه. حال من لبس المرقعة، ووطن النفس على السير في طريق القوم، وهفا إلى معانقة المجهول، وتحرق إلى تجاوز عوائد الحس، وانسلخ من الشواغل والعلائق وتطلع إلى معانقة أنوار الحقائق، وفرغ القلب من الأغيار وملأه بالمعارف والأسرار، كما يقول. وهذه الحال أثارت في وجهه متاعب كثيرة وكابد من أجل الاستمرار فيها أشد المكابدة، وقاسى من الانغماس في جلالها وجمالها كل ضروب المقاساة.
يقول السارد/ابن عجيبة مصورا هذه الحادثة:
“.. في ذلك اليوم كنت أتوقع حدوث كثير من الأشياء. حدث ما توقعت وحدث ما لم أتوقعه. كأن تطوان أصابها مس مني وكأن الناس حينما رأوني على تلك الحال إنما رأوا جحافل الصبنيول تنقض على مدينتهم. شُده من شُده وفر مني من فر، وظهرت على محيا كثير منهم قسمات حزينة ونظرات كسيرة، وحوقل بعضهم ليتأكدوا مما رأت أعينهم وابتعد آخرون، هلعا وجزعا، حينما تأكد لهم أني من كان على ذلك الحال، كان..كنت أنا..نعم أنا.. الفقيه أحمد بن عجيبة..”(ص.5)
ومن هنا تنطلق الحكاية وتبدأ الرواية، وعبر هذه الافتتاحية الروائية يضعنا الكاتب في بؤرة الصراع، ويرصد بداية إحساس الصوفي ابن عجيبة بغربته في الزمان والمكان. وهي الغربة ذاتها التي يستشعرها الصوفي المعاصر في مجتمعاتنا العربية/ “الإسلامية” البعيدة عن التدين والتصوف معا. وعبر تتبع سيرة الشيخ ابن عجيبة يتشكل أفق التخييل الروائي الذي يستثمر سيرة الشيخ ويوظف عناصر فعلية من سيرته كما دونها في فهرسته من أجل بناء العوالم الروائية، ومن ثم الإلماح إلى اغتراب الصوفي في زمانه ومكانه.
ومما لا شك فيه أن أول مياسم تشكيل المتخيل انطلاقا من الاتكاء على “السيرة” المعلومة لابن عجيبة وقوف السارد عند علاقة الشيخ الصوفي بشيوخه وتلامذته وأهل مدينته -التي استقر فيها: “تطوان” في مرحلة من مراحل حياته- وبسكان قريته “اعجيبيش”، وعلاقته بأمه وجدته، وهي علاقة أولاها ابن عجيبة أهمية فيما دونه بقلمه في الفهرسة، وانطلق منها السارد ليشكل جوانب من حياة ابن عجيبة في أفقها الروائي.
وتحفل الرواية بجوانب كثيرة من حياة أحمد بن عجيبة أشار إليها في سيرته غير أن الروائي شكل منها عالما روائيا جديدا، لا شك أن له نسب في كتاب “الفهرسة” وفي الكتب التي أرخت للفقيه الصوفي، ولكنه يذهب في مضارب التخيل وبناء المتخيل الروائي أشواطا بعيدة هي التي تحتاج إلى الوقوف عندها في هذا العمل الإبداعي الجاد.
يروي السارد/بطل الرواية عن علاقته الملتبسة بمدينة تطوان وأهلها في مشهد دال من مشاهد الرواية:
“.. أما تطوان فقد أحببت المقام فيها منذ اليوم الأول، وما حببني فيها إلا معاشرة علمائها ومخالطتهم والتتلمذ عليهم والإكثار من مجالستهم والمذاكرة معهم. في أول الأمر لم أستسغ أحياءها الضيقة وأزقتها الملتوية المسقوفة والمكتظة بالناس باعة ومتسوقين، ولم أكن أطيق التصاق البنايات والدور والدكاكين بعضها ببعض، وكيف لمثلي أن يستسيغ ذلك ويطيقه وقد عشت في قريتي اعجيبيش حيث لا تجد العين ما يحبس آفاق رؤيتها وما يحد من تمليها بجمال الحقول وتموجاتها وسموق الجبال وهاماتها وحيث المساكن والبيوت تحتفظ بالمسافة الكافية بين بعضها مما يجعل من الصمت نعمة كبيرة في البادية، وليس الأمر كذلك في تطوان، فشيوع الضوضاء في كل وقت وكل حين سمة لأحيائها وأزقتها. وقد زاد في قنوط منها في الأيام الأولى فران الحومة التي سكنت بها إذ كان ينادي ببيع سلعته قائلا:
ها الحلوى د تطوان.. تطوان أسيادي ضامنها سعيد والطاغي يموت فيها بالحديد.
فكان قوله يخيفني وينفرني منه ومن كعكه.
لكني لا أخفي أني لم ألبث أن آنستها وتعلقت بأحيائها وحوماتها وأدركت بعض أسرار جمالها وعبق جنباتها، فكنت في بعض أوقات فراغي أستلذ بعبور أحيائها والتجوال في حدائقها وبساتينها وزيارة بعض مساجدها وأضرحتها، فكنت في أحيان كثيرة أمشي مسافت طويلة خارج المدينة..”(ص.39-40)
وهكذا إذا كان المشهد الأول الذي تعاملنا معه –سابقا- يعكس حالة الصراع وبداية التوتر في حياة ابن عجيبة، بعدما لبس المرقعة، وارتضى السير في طريق القوم؛ فإن المشهد الذي نقف عنده الآن يعود بنا إلى ماضي الشيخ وبداية إقامته في تطوان لطلب العلم والمعرفة. وهو مشهد يعكس نوعا من الألفة نسجها الشيخ مع المكان، لكنها ألفة ليست تامة لم يكتمل فيها الشعور بالرضا والقبول، بحيث تثوي طي هذا الاعتراف شوائب نفور، وملامح حنين إلى القرية الأصل، وإلى البادية وطبيعتها. وهكذا نجد المتخيل يغوص في نفسية الشخصية الروائية ليكشف حالاتها الوجدانية والنفسية المختلفة في سياق لا يقف عند حدود استعادة ما دونه الصوفي ابن عجيبة في فهرسه، وما حكاه عن نفسه، وإنما يفسح المجال لتفاصيل جديدة وعناصر متخيلة تضفي على النص حيوية وحركية مشهودتين. وبهذه الكيفية تتشكل أبعاد جديدة للشخصية يؤثثها السرد الروائي عبر لعبة الكتابة الروائية وما تتيحه من إمكانات للتخييل، وبهذه الشاكلة يتمكن الروائي من وضع مسافة بينة بين “السيري” والتخييلي في بناء عوالمه السردية.
وإذا كنا قد وقفنا عند مشهدين دالين على جوانب من تفاعل الشخصية المحورية في الرواية مع المكان والناس إيجابا وسلبا مما شخص بعض معاناة الصوفي في زمنه وفي مكان نسج به نوعا من الألفة، فإننا سنقف عند جوانب أخرى من “سيرة” الشيخ وهي تتشكل روائيا وتنبني في أفق متخيل يذهب بعيدا عن حدود ما سطره ابن عجيبة. يركز السارد على معاناة الصوفي من عنت السلطة وبطشها في صور دالة، لها جذر في كتاب “الفهرسة”، لكنها تشي بمنطق السلطة في كل زمان ومكان، وهو منطق واحد تغيب فيه مياسم الإنسانية والقيم الرفيعة:
“..كان ابني الأوسط عبد الباقي راجعا يوما من المورد الأسفل للمدشر [مدشر الزميج] يحمل سطلين من الماء فالتقى به ابن شيخ القبيلة مع اثنين من حراسه فسلم عليه ابني لكن الرجل لم يرد السلام ونظر إلى عبد الباقي شزرا: – ابن من أنت يا هذا؟
وكان اللئيم يعرفه خير المعرفة: – أنا عبد الباقي بن الفقيه بن عجيبة.
-آه الفقييييييه.. الفقيه المرقع..
فضحك هو وحراسه فانزعج عبد الباقي ورفع سطليه قاصدا الانصراف لكن اللعين غرس عكازه في سطل الماء فتعثر عبد الباقي وكاد يسقط فضحكوا عليه ثانية. ثم توالت صنوف الإذاية بعد ذلك، ليس ضدي فقط بل ضد فقراء آخرين، فكثيرا ما تلقى أحدنا حجرا في ظهره أو مر من أمام رأسه ونحن جلوس في حلقة الذكلا وسط الزاوية يرميه أحد هؤلاء المتهيجين الحمقى. بعد ذلك سرعان ما سعى بنا أهل المدشر إلى عامل طنجة، ولم يكن الظالم ليفوت الفرصة ليزري بنا فأرسل أعوانه فأخرجونا من دارنا، فغضب بعض الأهالي لما حل بنا من ظلم وسلمونا موضعا آخر فبنينا فيه دارا جديدة، فاشتكى أولئك ثانية فأرسل ذلك العامل ثانية أعوانه، فهدموا البيت وحرقوه ولم يكتفوا بذلك بل حرقوا الكتاب الذي كنا نتذاكر فيه القرآن صغارا وكبارا، ونهب رعاعهم كل الفراش الذي كان فيه واقتلعوا ما غرسنا من أشجار البرتقال والبرقوق والإجاص، ودهسوا بأرجلهم كل ما زرعناه من خضر.. فلم يرحموا غرسا ولا جمادا..”(ص. 146-147)
يسرد الراوي سيرة معاناته ومعاناة بعض أبنائه وفقراء زاويته في بيئة أخرى انتقل إليها، هي قرية الزميج بنواحي طنجة، حسب أنها ستكون مكانا مناسبا لخلوته وانصرافه إلى العبادة والمعرفة وإرشاد الناس إلى طريق القوم، فإذا به يصطدم مرة أخرى مع بعض الجهلة من سكان القرية ومع أعوان السلطة وممثليها سواء في القرية (الشيخ وابنه وحرسه) أو في مدينة طنجة (عاملها الظالم). ولعل الرواية التي ركزت على تصوير “سيرة المعاناة” كانت ترمز –عبر الإمعان في تجلية صبر الصوفي وتحمله- إلى شدة مقاساة المتصوفة الصادقين في سبيل تقربهم من الله وميلهم إلى نشر قيم المحبة والإخلاص بين الناس على الرغم من جهلهم وجبروتهم. وهذا النمط من التصوير الروائي لا يقف عند حدود زمن ابن عجيبة بما يعج به من خلل ومن اضطراب في سلوك الناس واختلال في سلم القيم، وإنما يومئ إلى آفة كل الأزمنة التي لا تسلم من وجود أناس أخلصوا لمعتقدهم فقاسوا كل مر ونالوا كل أذى فما وهنوا وما استكانوا في أداء واجبهم.
ولعل الروائي أبدع في تفصيل ما ألمح إليه ابن عجيبة في “فهرسته” وما دونته كتب السير والتاريخ عنه وعن فترته الزمنية. وقد كان عبد الواحد العلمي موفقا في اختيار ابن عجيبة وزمنه لمساءلة زمننا الحاضر ووضع اليد على أوجه عدة من اختلال القيم وانحسار الأخلاق وتجبر الجهلة وتذرعهم بالسلطة والمال لمحاربة الآخرين لا لشيء سوى اختلافهم عنهم في المعتقد أو السلوك. وهذا النص الروائي الأول لصاحبه يشي بإمكانات سردية هامة لا شك ستتفتق عن أعمال أخرى قريبا. وأحدس أن الروائي عبد الواحد العلمي سيتحفنا برواية عن جده عبد السلام بن مشيش نزيل جبل العلم. وإنا منتظرون.
خاص الكتابة