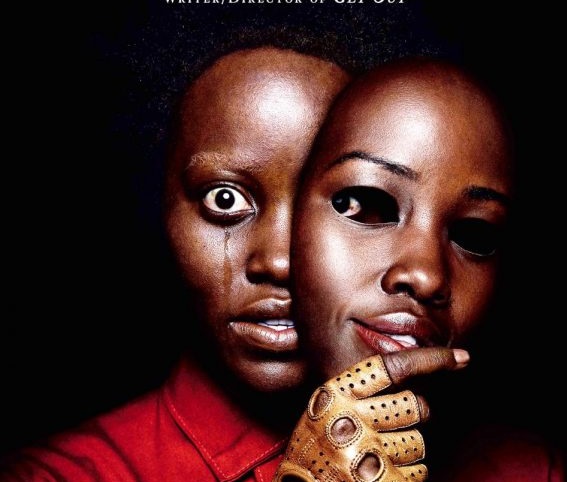الأتباع، أو المريدون، أو طلبة العلم، أقسى ما يواجه العالم في حياته العلمية. إن خوف العالم على تلميذه أشد بملايين المرات من خشية التلميذ من أستاذه، كما أن تعلم الأستاذ من تلميذه قد يكون أكثر من تعلم التلميذ من أستاذه، إذ إن التلميذ يملك – ما زال – براءة السؤال وجرأة الطرح وبكارة الروح. وإذا كان الأستاذ بالنسبة لتلميذه ملجأ، فإنما التلميذ بالنسبة لأستاذه همّ بالليل ومشقة بالنهار. ما أصعب أن يعلم الإنسان وما أمتع أن يتعلم، من هنا كانت خطورة أن تكون أستاذا، تملك عقول تلامذة وباحثين، تشعر تجاههم بمشقة المهمة فيما تشعر تجاه وطنك ودينك بخطورة المسئولية.
لا يدرك أقطاب الفريقين المعنيين بحديثنا معنى ما نقول أبدا، إذ يصرون في الغالب على تكوين جيش من الأتباع ليسوا أكثر من جنود في كتيبة، فكثرة الأتباع سمة جامعة بين الفريقين؛ حيث إن كليهما يحظى بشعبية كبيرة بين مجموعة من «المريدين»، وهو ما يملأ خطابهم الفارغ – إلا من المعلومات أحيانا – بكثير من الثقة التي لا يمكن أن يجد المتابع مبررا لها، إلا إذا رأيت المريدين وهم يقبّلون الأيدي ويسألون بانكسار ليس في عالم العلم ما يبرره، اللهم إلا إذا كنت تأخذ علمك عن نبي معصوم موحى إليه، لا مجرد باحث – أو هكذا يجب أن يكون – يلهث عمره كله وراء فكرة يبتغي معونة الله في أن تكون سديدة.
والفريقان وإن تميزا بكثرة الأتباع، فإن طبيعة هؤلاء المريدين عند كليهما مختلفة، ففي حين يتسم أتباع الفريق المديني بالرقة والوداعة وقلة المحفوظ من النصوص المقدسة قرآنا وحديثا، فإن أتباع الفريق الثاني يملكون همة تمكنهم من تحصيل مجموعة من العلوم القديمة كالنحو والصرف أحيانا والعروض أحيانا أخرى، بالإضافة إلى حفظ كتاب الله في الغالب وبعض كتب الحديث وبعض المتون الشهيرة.
ويختلف مريدو الفريقين من حيث طبيعة التعليم الذي تلقاه كل فريق، فعلى حين ينتسب معظم مريدي الفريق (المديني) إلى مدارس وجامعات خاصة ويجيدون أكثر من لغة – وإن ضعفت صلتهم في الغالب باللغة العربية، لغتهم الأم – ويمتهنون مهنا كثيرة ومتنوعة بعيدة عن العلم الديني، فإن الكثرة الغالبة من مريدي الفريق الثاني تلقوا تعليمهم في المدارس الحكومية، وأكثرهم لا يجيد أكثر من اللغة العربية؛ حيث إن أكثرهم من شرائح اجتماعية رقيقة الحال، بل إنه ليس من المستغرب أبدا أن تجد فيهم من ليس حاصلا على مؤهل جامعي، حتى إن بعض الدعاة الكبار منهم لا يدخل أولاده في صفوف التعليم النظامي – البنات منهم خاصة – ويكتفي بتحفيظهن القرآن الكريم ورياض الصالحين أو ما شابهه من كتب الحديث.
وعلى الرغم من هذا الاختلاف الواضح بين مريدي الفريقين من ناحية الشكل أو المضمون، فإنهما يتسمان معا بسمة مشتركة تجمع بينهما، وهي الكسل العقلي الواضح عند كليهما؛ فنادرا ما تجد عند واحد من هؤلاء الأتباع موقفا نقديا من فكرة ما أو قراءة خارج الإطار العام للفريق الذي يتعاطف معه. بالإضافة إلى أن السلوك البشري عند هؤلاء الأتباع منقسم إلى دائرتين اثنتين فقط هما الحلال والحرام، فأي سلوك ليس إلا حلالا أو حراما واختفت الدوائر الأخرى الكثيرة بين دائرتي الحلال والحرام. كما أن الدين في نظر هؤلاء الأتباع أخذ منحى شكليا جدا. لا فرق في هذا بين الفريقين.
لم تكن هذه السمة لتشغل تفكيرنا لولا خطورتها على البيئة العلمية من ناحية العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية سواء بسواء؛ حيث إن أقطاب الفريقين يكتسبون ثقة مبالغا فيها نتيجة وجود مثل هؤلاء الأتباع، وهذه الثقة التي يكتسبونها تنعكس على ما يقولونه من جمل مفعمة بالغرور، على الرغم من كونها تفتقر إلى التوثيق العلمي، وهو أول دروس البحث العلمي وأولى بدهياته.
ينبغي قبل أن نسترسل أن نتوقف عند ملاحظتين:
الأولى: أن دعاة المدن تتحقق عندهم هذه الخاصية (الافتقار للتوثيق) بشكل جلي وواضح لا يحتاج لبيان، أما دعاة الريف (وجه بحري) فإنهم يوثقون – بل ويوثقون جدا – النصوص المقدسة كالآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ وهي نصوص موثقة ومخرجة أصلا، لا تحتاج لتوثيقهم الذي يملئون به الحياة ضجيجا، أما افتقارهم الحقيقي فإنما في توثيق أفكارهم، من ناحية تاريخ وجود هذه الأفكار، ومن أول باحث قال بها، ومن تابعه من الباحثين ومن اختلف معه. كما أنهم – ولفرط ثقة هي عمياء – لا يعودون في مقولاتهم إلى أحد خارج منظومتهم التي تسير على نفس طريقهم وتنتهج منهجهم ذاته.
الملاحظة الثانية: يخرج من هذه السمة قليل من دعاة الأقاليم، بل وقليل جدا ممن وجدنا لهم جهدا يستحق النظر في متابعة الجهد العلمي والفكري لمن سبقهم، ليس في حدود النصوص المقدسة فحسب، ولكن في الجهود العلمية البشرية في العصر الحديث، ومن هؤلاء وليس مثله كثير الدكتور سيد بن حسين العفاني (وللمصادفة فهو ليس من القاهرة ولا من ضواحيها ولا من وجه بحري، ولكنه من صعيد مصر، تحديدا من قرية عفان من محافظة بني سويف). ولا يعني هذا أننا نتفق مع مقولاته، أبدا، فاختلافنا معه شديد، ولكنه – على أقل تقدير – قرأ، وطرح وجهة نظر يمكن أن ينطلق منها من خالفه الرأي.
وبالعودة إلى نقطتنا الأصلية هنا وهي خطر التلميذ على الأستاذ، فإنما تكمن في ملئه بهيبة كاذبة تخلو من الاعتراض والاختلاف، وهو الاعتراض والاختلاف الذي لا يقوم به التلميذ خاطئا، ويرفضه الأستاذ ضعيفا، ولذا فليس أمام كل تلميذ إلا المجاهرة – في أدب طبعا – بكل اختلاف يعن له، إذ الأستاذ ليس مستودع العلم ولكنه سبيل الوصول إليه، فلا يجب على التلميذ أن يصل بأستاذه إلى درجة الألوهية أو النبوة المعصومة فهو بشر، والأستاذ الذي لا يحتمل الاختلاف يضر بالعلم وبالدين وبالوطن وبالأجيال القادمة.