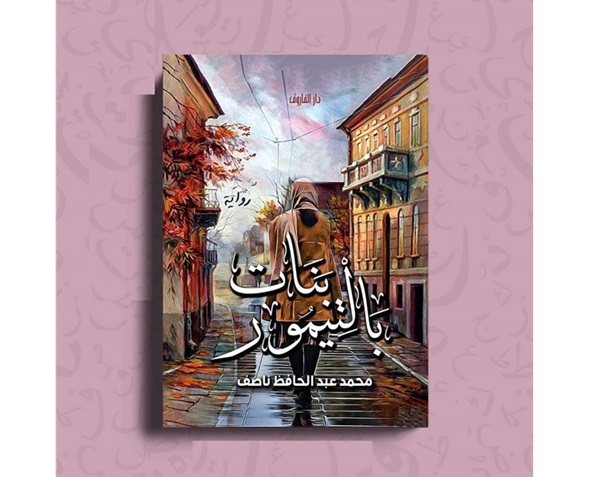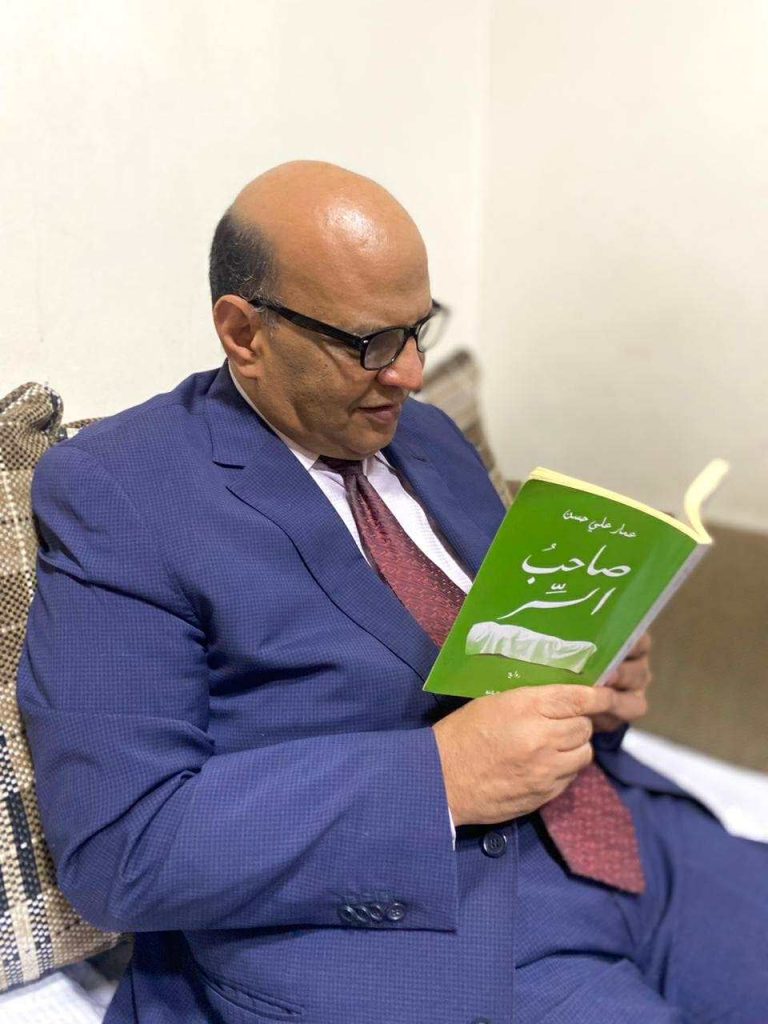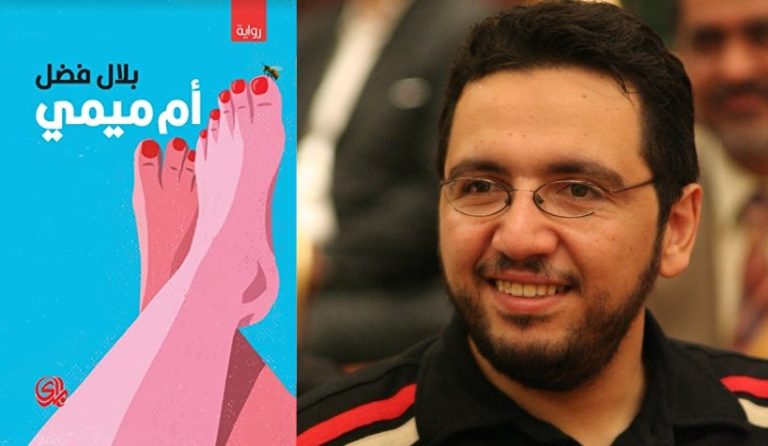د. حمزة قناوي
يبدو كم الموضوعات التي تطرحها الكاتبة المبدعة رشا عبادة في مجموعتها «ما روته خايبة الرجا» لافتاً؛ فهذه المجموعة القصصية تحتوي على أربعٍ وسبعين قصة وأقصوصة تتوزع عبر ثلاثة مستويات من الحكي، لكل قصة منها موضوعها الخاص، وزاوية الرؤية، وأسلوبها المميز، وإن كان السمت الأساسي لكتابات رشا عبادة هو السخرية، فإننا في هذه المجموعة القصصية نواجه نوعاً خاصاً من السخرية، وإذا كانت أحد تعريفات السخرية أنها: «نوع من التأليف الأدبي أو الخطاب الثقافي، الذي يقوم على أساس انتقاد الرذائل والحماقات والنقائص الإنسانية، الفردية منها والجمعية، كما لو كانت عملية الرصد أو المراقبة لها تجري هنا من خلال وسائل وأساليب خاصة.»([1])، فإننا في حالة هذه المجموعة القصصية نشاهد نوعاً من السخرية السوداوية المتشائمة إلى أقصى مدى في رؤيتها، بحيث لا يبدو أن هناك مفراً من هذا الواقع الكئيب الذي تعيد رصده على نحو يعيد إدراك تلك الموضوعات التي أصبحنا ننظر لها في أرض الواقع باعتبارها أموراً طبيعية واعتيادية، لنعيد النظر إليها وقد أدركنا أن بداخلها مأساتها الخاصة، وهو الأمر الذي يذكّرُنا بنظرية التغريب عند الشكلانيين الروس، فوفقاً لشكلوفسكي لكي نجعل من شيءٍ ما واقعةً فنية، يجب إخراجه من متوالية وقائع الحياة، ومن الضروري إعادة إدخاله في صيغ وروابط جديدة تخالف تلك الصيغ والروابط المألوفة في الحياة، والتي جعلتنا نألف تلك النقاط التي يرغب المؤلف في أن ننظر لما فيها من غرابة، ومن معاناة أو مأساة([2])، والطريف في الأمر استخدام عامل السخرية نفسه كأحد عناصر نزع الألفة عن الظواهر والقضايا التي تتناولها (عبادة)، ليزداد التغريب غرابة وحدة، وتصبح رسالة المؤلفة ناجحة في الوصول لمبتغاها، وسأحلل الكيفيات التي تعمل عبرها السخرية لخدمة الموضوعات المتناولة.
لكنني أرغب مبدئياً في الإشارة إلى أن المؤلفة كانت تنوي تسمية هذه المجموعة بــ «ما روته مقصوفة الرقبة»، بدلاً من عنوانها الحالي، وهو العنوان الذي يتناسب مع الجرأة اللافتة التي تتناول بها الراوية الأحداث، والتي تتعامل بها مع وعينا بشكلٍ مفرط في الجرأة. و«مقصوفة الرقبة» بغضِّ النظر عن صحة تاريخها الشعبي ونسبته، فإنها كلمة توحي شعبياً بتلك الفتاة التي لا يهمها شيء، والجريئة في اقتحام كل شيء، وأيضاً التي تدخل نفسها في العديد من المشكلات، التي يتمنى معها أهلها لو لم تكن هذه الفتاة موجودة، ويتمنون لو أن رقبتها قد قُصِفت وانتهى عمرُها حتى تنتهي هذه المشكلات، ولكن عدلت المؤلفة عن هذه العنونة إلى عنونة أخرى أكثر سوداويةً وقتامة، ألا وهي «ما روته خائبة الرجا»، وخيبة الرجاء هي أقصى ما يمكن أن يصل له أي إنسان من فقدان الأمل في أي شيء قد يحدث مستقبلاً يُدخل عليه البهجة أو السرور، ومن ثم فالعدول عن العنوان المسبق إلى العنوان الحالي تأكيد للسوداوية المفرطة التي رغبت المؤلفة في أن تسِم مجموعتها القصصية، لكن كيف تجتمع السخرية والسوداوية؟ إن ما يميز السخرية عادةً أن بها نوعاً من الأمل، مهما بلغ الألم من درجةٍ عالية، يظل هدف السخرية الدفع للتغيير إلى الأفضل؛ فإن لم يكن هناك أمل في التغيير فلا معنى لفعل الكتابة في حد ذاته.
تأتي المجموعة القصصية موزعةً عبر ثلاثة مستويات، الأول حمل اسم: «ماضٍ بسيط»، والثاني: «بلا تورط في خدش حياء»، والثالث: «ماذا لو رفع الهواء الفستان؟»، ورغم وجود بعض الملامح التي تجمع كل مستوى مع الآخر في قصصه المختلفة، فإن «ماضٍ بسيط» تشير على نحو كبير بما له علاقة بأحداث ماضية أثرت على الرؤية الحالية لدى أبطال قصتها، والقصص المنضوية تحت «بلا تورط في خدش حياء» وهي القصص الأكثر عدداً في المجموعة حيث تضم نحو إحدى وثلاثين قصة مقارنة بخمس عشرة قصةً لــ «ماضٍ بسيط»، وثماني وعشرين لـــ «ماذا لو رفع الهواء الفستان؟»، إلا أن موضوعات القسمين الثاني والثالث يمكن أن يتداخلا معاً، فمنطقة عملهما واحدة تقريباً، من حيث تناولهما نوعاً من القصص ذات العلاقة بتابوهات المجتمع، وبما يعد الخروج عليه خروجاً مجرّماً في العرف العام، وفي الثقافة الشعبية.
وفي كل مستوى من المستويات الثلاثة هناك قصة تحمل اسم المستوى الذي تنضوي تحته المجموعة القصصية، وكأننا بهذا التقسيم أمام ثلاثة مستويات من الحكي، كل مستوى منهما له خصوصيته ودائرته التي تدور فيها القصص حول القصة الأساس، فمثلاً في قصة «ماضٍ بسيط» تُطرح فكرة الرجل الشرقي الذي يقبل على نفسه أن يفعل بخطيبته ما يشاء مما تطوله يده بها، ولكنه إذا وضع في إطار عكسي، تدور برأسه الدوائر، فإذا ما خطب فتاة كانت مخطوبة سابقاً، راح يتساءل عما حدث معها من قبل، وكيف تقبل رجولته هذا الموقف، وبعدما كان يُعِدُ سابقاً قدرته على التمكن من خطف قبلة أو حضن أو ما شابه من خطيبته، فحولةً، إذ به يصبح باباً للصراع النفسي اللامتناهي، وقد يدمر هذه العلاقة. تصف لنا الكاتبة ذلك:
«قبل حفل الزفاف بثلاثة أشهر، خطف القبلة الأولى وتوسل لأخذ الثانية فأهدته الثالثة على طبق محبة، في الزيارة الأخيرة سألها إن كان خطيبها السابق قد لمسها أم لا؟ وانتظر رداً التزمت معه الصمت، حتى جاءت أمه لتخبرهم أن كل شيء قسمة ونصيب.» ص9
هذا الفعل الصادم من موقف ذلك العريس الذي فرح في بداية القصة بأنه وجد «بنتاً هائلة وحلوة ومتعلمة ودمها خفيف» لكنه كان متخوفاً منذ البداية عما قد يكون حدث مع خطيبها السابق، هو نوع من أنواع تأسيس لعلاقة من نوع خاص بين المؤلفة/ الراوية والقارئ، إذ عبر العناصر الإنشائية، وعبر التقديم والتأخير في الأحداث، وعبر النهاية الصادمة التي تأتي كانقلاب على الافتتاحية التي بدأت منها، تؤسس لعملية من الإدراك المغاير، التي تقوم على التواصل مع المتلقي لكي يعيد التفكير من جديد في التصرفات والموضوعات التي تتناولها المؤلفة هنا([3]).
إذن نحن أمام نوع من القصص يتخذ السخرية وسيلةً لمخاطبة الوعي مباشرة، ومع السوداوية المفرطة يصبح الأمر كمن تمسك في يدها مطرقة تخبط بها على منضدة العقل لينتبه للأفعال التي يقوم بها بعضنا بلا وعي. ترى لو كانت أخبرته بخلاف ذلك، وأصرت على أنه لم يحدث بينها وبين خطيبها الأول شيء.. هل كان ذلك سيغير من موقفه؟ هل هذه هي الإجابة التي كان ينتظرها؟ وكيف نفهم صمتها؟ هل هو رغبة في عدم الكذب؟ أم استغراب للسؤال، أم تناقض بين الفعل بالقبلة التي منحتها له، وتقبله إجابة الرفض؟ هل كل الرجال سيفعلون معها ذلك مستقبلاً؟ هل الخطوبة بهذا الشكل تعني إساراً أبدياً تحاط به الفتاة التي سبقت خطبتها، فلا يتم لها بناء من بعد؟ وهل قبول رجال آخرين بإتمام مثل هذه الزيجة على فتاة كانت مخطوبة سابقاً، هو قبولٌ بما لا يمكن قبوله في التقاليد والأعراف الشرقية؟ أسئلة كثيرةٌ تقف في خلفية المشهد تثير انتباهنا وتضعنا أمامها دون أن يكون لدينا إجابة محددة عنها، أو ربما لدى كل فرد إجابة مختلفة عن الآخرين.
في المستوى الثاني تأتي قصة: «بلا تورط في خدش الحياء»، وفي قصص هذا المستوى بصورةٍ عامة نحن دائماً مع بطلة القصة التي هي أم، والتي تعاني مع صغيرها، دون حضور لأب يشاركها هذه المعاناة، لتواجه مصيرها بمفردها مع كل كبيرة وصغيرة مع هذا الطفل أو هذه البنت، وكذلك فإن سمات الطفل هنا مغايرة للمعتاد، فلديه من الجرأة أو من التفسير للمواقف من حوله، ما يختلف كثيراً عن الوضع التقليدي لما كان عليه أطفال الأمس، فهناك وعيٌ متضمنٌ لدى تصرفات الأطفال مغاير تماماً عن الأجيال السابقة، حتى أننا في القصة التي تحمل اسم هذا المستوى نجد نوعاً من الاعتزاز الغريب بالذات، اعتزاز يصلُ لمرحلة: «… يتعامل مع فضلاته معاملة “ذواتي”، يعتبرها جزءاً من تكوينه لا يصح تداوله بين العامة والدهماء، ولا إهداره داخل الخرابات وتحت الكباري، محاولاتي البدائية لإقناعه أنه كائن ذكوري يمكنه عمل بيبي في الشارع، دون تورط في خدش حياء المارة، تتحول لفضيحة يصرخ فيها برفض متواصل، لدرجة من السهل تشك معها “إني خطفاه”.» ص 48
نستحضر هنا مقولة (لوسيان جولدمان) من أن كل واقعة اجتماعية هي واقعة وعي([4])، والكاتبة هنا تطرح موضوعاً على بساطته إلا أنه به من الفحوى الكثير بوصفه موضوعاً اجتماعياً متعدد الجوانب، وعلينا أن ننتبه لجميع هذه الجوانب مجتمعة، فمن ناحية هناك كلمة «كائن ذكوري»، والتي تتسع هنا من إسقاطات الظلم للمرأة إلى إسقاطات القبح وعدم إدراك الجمال، والتعدي الكامل على الآخرين سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً، فعبر ذلك الفعل الذي يعتبره الذكور حقاً مستحقاً لهم، فإنهم في الحقيقة يقومون بنوع من الاستباحة الجماعية للحياء العام، فضلاً عن الإشارة الضمنية لعدم إدراك خصوصية قضاء الحاجة التي هي في النهاية جزء من الشخص، ومن ثم فإن طريقة قضاء الحاجة هي نوع من التعبير عن الشخصية، وكأم استطاعت بشكل أو بآخر أن تجعل ابنها ينجو من هذه الذكورية السيئة، فإنه يأتي مختلفاً عن باقي الذكور، هو لا يستطيع القيام بهذا الفعل، وغير قادر عليه، ومع ضغط المثانة تلجأ لحل آخر هو فكرة «البرطمان» الذي يتم فيه تجميع هذه الفضلات لحين التخلص منها.
لكن على نحو صادم تختار المؤلفة مكاناً وزماناً ومجموعةً من الشخصيات المحيطين بها في «ميكروباص» لكي تحاول وسط هذا الجمع أن يقوم الطفل بقضاء حاجته في البرطمان المخصص له، لتختلف وجهات النظر لهذا الفعل، هل هو فعل يحفظ الحياء، بالنظر إلى طريقة التخلص من الفضلات بدون التسبب في بقائها مزعجة لأحد، أم هو في الحقيقة تسبب في خدش حياء أكثر لمجموعة من الناس الذين ساقتهم الظروف لمعاينة هذا الحدث في «الميكروباص»؟ بيد أنه حتى لو افترضنا أنه خدش حياء لهذه المجموعة الصغيرة فإن به نوعاً من الاختزال عن القيام بذلك في فضاء كبير قد يكون فيه مجموعة أكبر من الناس، نحن هنا أمام نوع خاص من الوقائع والزمان والمكان والمشكلة التي تجعل القارئ يعيد النظر في تلك العملية البسيطة التراتبية اليومية لكي يراها بمنظور آخر، منظور من يشمئز منها وينبه لكونها خدشاً للحياء العام، وكعادة كل القصص التي تأتي النهاية فارقة وصادمة، يقوم سائق الميكروباص بالتوقف على جنب، غير عابئ بكل هذا، لكي يقوم بأداء هذا الطقس الذكوري، ولا يجرؤ أيٌ من ركاب الميكروباص -الذين كانوا يتشاجرون مع بطلة القصة- أن يتحدثوا، ليأتي التعليق الوحيد على ما يفعله من الطفل الصغير، عندما يقول له: «نشن كويس يا عمو عشان متبلش الهدوم!.» ص49
هذه المفارقة بين براءة الطفل، وتصديه للفعل الذي صمت عنه جميع الركاب، في حين لم يكن للركاب أن يرحموا براءة الطفل، ورأوا ما يفعله نوعاً من الخدش الاجتماعي للحياء الذي لا يمكن السكوت عليه، يعكس مقدار التناقض المذهل في مجتمعنا، ومقدار الكيل بمكيالين، خاصةً إذا كان أحد أطراف الصراع عنصراً قوياً يخاف منه البعض ومن ردة فعله، مقارنةً بما إذا كان عنصراً ضعيفاً، أو ما إذا كان أحد أطراف الصراع ذكراً وليس امرأةً لا يرحم أحد معاناتها مع طفلها.
أما المستوى الثالث، والذي تحمل القصة المحورية فيه عنوان: «ماذا لو رفع الهواء الفستان؟» والذي تعيد فيه مناقشة قضية الاحتشام في الملبس عند السيدات، ترى لو نسير في الشارع وشاهدنا سيدة ترتدي تنورة طويلة، لكن فجأة رفع الهواء هذه التنورة وكشف عما تحتها من ساقيها الجميلتين، فهل سنلوم الهواء؟ أم نلوم السيدة لعدم ارتدائِها شيئاً أسفل التنورة؟ من هذا السؤال البسيط تحبك (رشا عبادة) قصة فلسفية تتمعن في السؤال وإمكانيات إجاباته، وتتخيل لو تحول الأمر إلى مباراة كرة قدم يتم التعليق عليها: «… أو قالت عابرة بالصدفة “البنطلون سترة” أو نهرتها عجوز من شرفتها متسائلة: “أبوكي مشفكيش وإنتي نازلة م البيت يا صايعة؟» ص71.
بهذه الكيفية تتناول القضية التي تعكس مقدار القيود المفروضة على المرأة في المجتمع الذكوري الذي يحاكمها على كل كبيرة وصغيرة، حتى ليعد مجرد هواء عابر يقوم برفع فستانها إلى أعلى أمراً خطيراً يجب أن تستعد له، ولو حتى بما تكره أن ترتديه أسفل جيبتها، فهي ليست كالرجل الذي يمكنه أن يرتدي ما يشاء، بل مطلوب منها أن تضع مزيداً من الملابس الواقية حتى لا ينكشف منها شيء، وتنظر هنا لتلك الملابس ليس باعتبارها سترة، وإنما على أنها تقييد لها ولحريتها، وفي النهاية فإن المجرم الحقيقي هو الهواء لا هي، ولكن المشكلة أن كلاً من الهواء و”الأهواء” لا يمكن محاكمتهما ولا حبسهما، لكي تبقى المرأة – من وجهة نظر رشا عبادة – هي المُحاكَمَة نيابة عنهما، وهي التي يتم حبسها وسجنها وفقاً لهذه الأهواء.
تجمع المؤلفة في قصصها بين العامية والفصحى، وتتلاعب بالزمن والحوار، ولا تقيم افتراضاً مسبقاً حول الحجم الذي يجب أن تبلغه القصة، فهناك قصص لا تتعدى بضعة أسطر، وأخرى تمتد عبر عدة صفحات، والموضوعات متنوعة جداً، ما بين الشخصي، وما بين الاجتماعي، في قصتها «مخلوقات اللاشيء العجيب» تتناول النظام العالمي الذي نعيش فيه، والذي حوّلنا لأسرى منتجات وطريقة أفكار وأسلوب معيشة غريب وعجيب، وفي قصتها «كتاكيتو بني» تتحدث عن ذكر تغلب عليه ملامح أنثوية تعرضه للتحرش، وتدعوه للإبلاغ عن هذا التحرش. ويصعب تتبُّع الموضوعات المطروحة بأكملها بعض الشيء ، لكن ما يبدو كاشفاً عن نفسه بشدة هو الجرأة وعدم الوقوف أمام أي تابوهات باعتبارها حائلاً عن التساؤل، ففي قصتها «هل يحب الله العفاريت» تطرح السؤال: لماذا يعطي الله العفاريت كل هذه القدرة علينا؟ مروراً بقصة «بارك الله فيك» والتي تتحدث فيها عن معاناتها مع طفلها لكي توصل له معنى أن الله هو من خلقنا، حتى قصة «الطريق إلى الجحيم» التي تعرض فيها شخصية ذلك الشيخ «الكفتة» الذي لا يعرف شيئاً، وصوته مريع، ويقوم برفع الآذان، تلتقي فيها الجرأة مع السخرية والسوداوية، والصورة القاتمة للرجل الذي تكاد تكون هذه القصص انتقاداً مباشراً له، دون وجود لنموذج واحد جيد من الرجال، مع إظهار المرأة المغلوبة على أمرها والمحاصرة بالقيم الرجعية لمجتمع غارق في التخلف والانتصار للذكورية، وتعظيم معاناتها وعذاباتها اليومية، كل ذلك يخلق جواً آسراً لا يمكن كبح جماح تشويقه، رغم أن كل قصةٍ منفصلة عن الأخرى، إلا أن الإطار العام لها يجعل المتلقي مستغرقاً في الأحداث ليعرف ما الذي حدث لــ(مي) وللصور المتنوعة لــ (مي) في عذاباتها المختلفة، ورحلتها اليومية المغايرة المريعة التي تتعذب فيها بشكلٍ يوميّ.
……………………………………….
[1] – شاكر عبد الحميد: الفكاهة والضحك، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد 289، يناير 2003، ص 53.
[2] – تودوروف وآخرون: نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة: إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1982، ص 137.
[3] – روبرت سي هولب: نظرية الاستقبال، ترجمة: رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار، اللاذقية، 2004، ص 46.
[4] – لوسيان جولدمان: الوعي القائم والوعي الممكن، ضمن كتاب: البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، ترجمة: محمد سبيلا، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1984، ص 36.