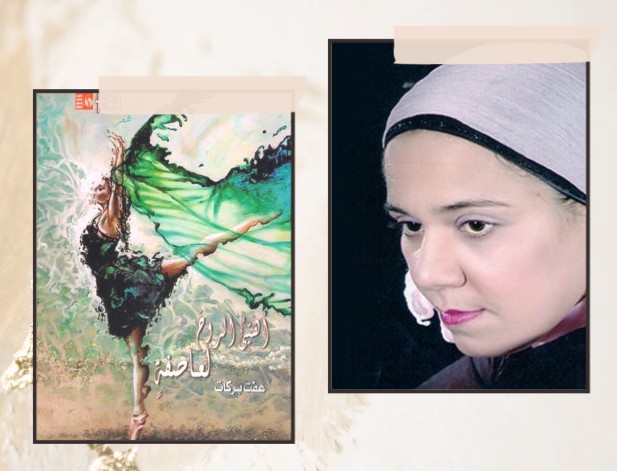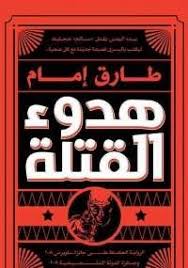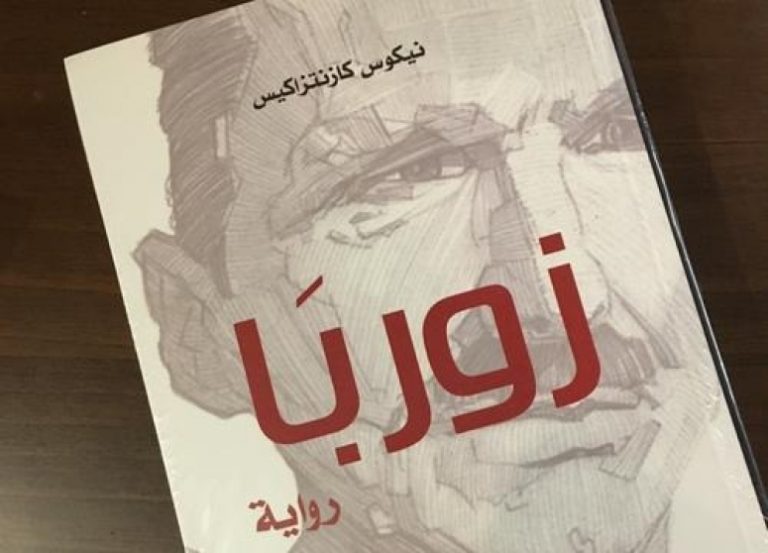محمود عبد الدايم
«لم يسقط في الفخ التقليدي»، الانطباع الأول الذي رافقني فور اطلاعي – للمرة الأولى – على رواية الكاتب والقاص محمد البُرمي، لا لشيء سوى أني دائما أجد الصحفي عندما يتجه إلى الأدب فإنه يصبغ كتابته بـ «اللون الصحفي»، فيقدم لنا كتابة سريعة، مختصرة، وجامدة في بعض الأحيان، غير أن «البٌرمي»الذي بلا شك منحته الصحافة الكثير، ومن ضمن الكثير هذا «العناوين المدهشة»، لم يجعل لغته الصحفية تطغى على إبداعه، ليقدم لنا روايته الأولى «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقي»، الصادرة عن دار الشروق.
«أنا أكتب.. لأنني لم أسامح أبي».. جملة صادمة اختارها «البٌرمي»لافتتاحيه روايته، ليجعلنا نتذكر واحدة من أفضل الافتتاحيات الروائية، تلك التي كتبها الكاتب الفرنسي ألبير كامو في رائعته «الغريب»، عندما قال: «اليوم ماتت أمي. أو ربما ماتت أمس، لست أدري»، العبثية التي وضعنا أمامها «كامو»، كانت حاضرة في افتتاحية «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقي»، بل الغوص في فصول الرواية فصلًا تلو الآخرى، تكشف وجه عبثي كبير، ليس لأبطال الرواية، بل للزاوية التي قدمها «البٌرمي» للحياة.
بالطبع.. كانت الصحافة حاضرة في مجريات الرواية، غير أنها لم تكن «عمود الخيمة»، فصاحب «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقي»، كان كريمًا جدًا مع أبطاله، أظنه لحظة الكتابة كان يجلس أمامهم، يحاورهم، يمنحهم «طبطبة» على الكتب حينًا، ونظرة لوم في حين آخر، يعاتبهم عندما يخطئون، ولا يطير فرحًا بهم في لحظات انتصارهم، وهي قليلة بالمناسبة، وهنا تكمن روعة «البطل العادي» الذي يقدمه «البرمي»، فأبطاله أناس عاديون مثلنا، يتحركون، يخطئون، يلعنون، ويضحكون، لم يحاكمهم في أي سطر من الرواية، فـ «المحاكمة» كانت للزمن، للأيام وليس للأبطال الذين يكشف لنا «البٌرمي» قلة حيلتهم في أحيان، ورغبتهم في الهرب في أحيان آخرى.
«الوصية».. نقطة الانطلاق التي اختارها «البٌرمي» لروايته، كاشفًا للقارئ جزء من سيرة بطله، وهو الذي لن يحمل اسمًا حتى السطر الأخير من الرواية، ومقدمًا لنا زاوية واقعية بعض الشيء عن الذي سترافقنا سيرته طوال الأحداث، وهنا من الواجب الإشارة إلى أنه أجاد في اختيار «عناوين فصوله» والتي تعطي القارئ موجزًا عما ستحمله الصفحات التالية.
اختار «البٌرمي» في البداية تقنية «الفلاش باك»، متأرجحًا بين ماضي مضطرب وحاضر أكثر اضطرابًا، بين محادثة هاتفية حول «شيرين» المختفية، والتي تكشف لنا جانبًا من «نزوات» البطل غير المحسوبة، فالزوج يطلبه يسأله عن زوجته، وهو يتذكر اللقاءات التي جمعتها سويًا، ليؤكد لنا أنه واحد من الأبطال التي تهوى «التورط في الأزمات»، غير أنه ومع الاعتياد على هذا التورط، يقول: «الحقيقة أن هذا ما اعتدته في السنوات الأخيرة. كان عقلي يعمل كآلة، أو كرقعة شطرنج، أحسب معه احتمالية تحرك كل قطعة على الرقعة في محاولة تلافي الضربات من هنا أو هنا، لم يعد في جسد موضع لخيانة، لا رغبة لي في وقوع جديد، بات العالم عدوي».
الصراحة التي منحها صاحب «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقى»، والتي تنقلب في بعض الفصول إلى «وقاحة»، كانت أشبه بـ «مغامرة محسوبة العواقب»، فبحرفية واضحة ينقذ «البٌرمي» بطله من أن يكون «مكروهًا»، بل جعله في مواضع عدة انعكاسًا لنا، يخطئ، يحب، يكره، يتحدث كثيرًا ليس طلبًا للمغفرة بقدر ما هو «رغبة في الاعتراف»، وهو ما أبدعه «البٌرمي»باختياره اللحظة الذهبية لظهور «السائقة الليلية»، الفتاة التي تمتلك هي الآخرى حكاية خاصة بها، تروي جزء منها بحزن، والبقية _ وكعادة أبطال «البرمي»، تتعامل معه بـ «كثير من العبث والسخرية».
ما بين «شيرين» و«رباب» وبطل «الأناشيد للآلهة والنياشين للحمقى»، كثير من الأحداث التي برع «البٌرمي» في أن يصنع منها ما يمكنني وصفه بـ «سباق القراءة»، فعلى امتداد الرواية ستجد نفسك متورطًا في «سباق الحياة» الذي صنعه الكاتب بحرفية واضحة.