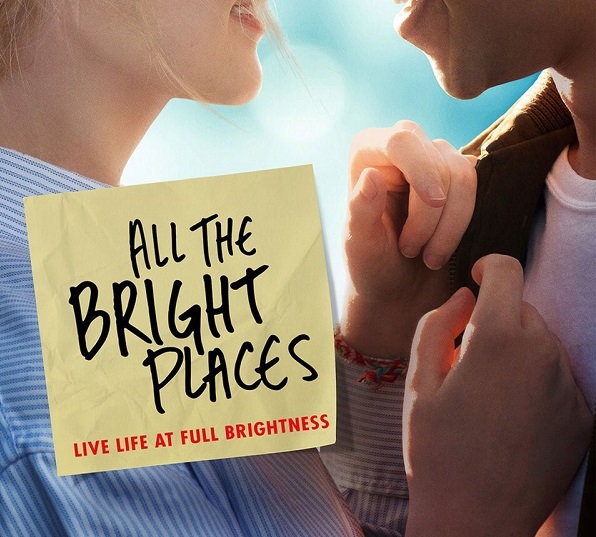عادل محمود
قراءة نقدية في “عائلة زيزي” (1963) و”عائلة ميكي” (2010)
– في تاريخ السينما المصرية، نادرا ما نجد فيلمين يضعان الأسرة في قلب الدراما، ويقدمانها كـ”مسرح” تتحرك فيه القوى الاجتماعية والثقافية كما في فيلمين يفصل بينهما ما يقارب نصف قرن : “عائلة زيزي” (1963) للمخرج فطين عبد الوهاب، و “عائلة ميكي” (2010) للمخرج أكرم فريد.
الأول يصور الأسرة كخلية حية تحتفظ ببراءتها وسط الأحلام والأزمات، أما الثاني فيرصد تفككها التام، حيث تتحول القيم إلى ديكور مزيف، والروابط إلى كذبة جماعية. بين الفيلمين، لا تتغير الأسماء بقدر ما تتغير الوظائف النفسية والاجتماعية للأسرة. فما الذي حدث للمجتمع المصري، وما الذي تقوله السينما عنه بوضوح لا يتوفر في الخطابات الرسمية؟
– في “عائلة زيزي” ، تتجسد ملامح الطبقة المتوسطة المستقرة: منزل واسع، أحلام بسيطة قابلة للتحقق، وروح متفائلة تسكن العلاقات الأسرية. سبعاوي يعمل على اختراع آلة للنسيج، سامي يخوض تجربة حب جارته، وسناء تحلم بالتمثيل، أما زيزي الطفلة فترصد العالم حولها بعين مندهشة. هنا الحلم له طعم المعرفة، والاجتهاد، والانتماء.
أما في “عائلة ميكي”، فنجد طبقة متوسطة هشة، تعيش على المظاهر، وتخاف من السقوط إلى قاع الفقر أكثر مما تأمل في الصعود. الأبناء لا يحلمون، بل يحتالون: ضابط شرطة مرتش، طالب يزيف درجاته، وابنة تعيش مأزقا نفسيا وجسديا. والطفل الأصغر، ميكي، لا يرى سوى عالم التنقيب عن الآثار، لا لعلم أو متعة، بل كوسيلة سريعة للثراء. لقد تغير معنى “النجاح”: من اختراع يصرخ صاحبه “قماش!”، إلى شهادة مزورة تشتريها رشوة.
– في “عائلة زيزي”، تحضر الأم بوصفها العمود الفقري للأسرة، صوت الحكمة والإتزان، حتى حين تمارس العتاب واللوم. إنها الحاضنة التي تجمع الشمل وتخفف من صخب الأحلام المتضاربة.
أما في “عائلة ميكي”، فتحضر الأم كمرآة مشروخة للأخلاق المنهارة: تتواطأ مع أبنائها في الكذب، بل تشارك في خداع لجنة تحكيم لاختيار الأسرة المثالية، في مفارقة قاسية تكشف انهيار معيار “المثالية” ذاته.
– الفيلم الأول يقدم نقدا رشيقا لصناعة السينما المصرية، من خلال مشهد ساخر يجمع بين كاتب سيناريو ومخرج يعيدان تدوير القصص المهترئة، دون وعي بالتكرار أو الحاجة للتجديد. لكن رغم السخرية، يظل هناك تقدير للفن كقيمة إنسانية.
أما الفيلم الثاني، فيغوص داخل مؤسسات المجتمع ذاتها: الشرطة، التعليم، الإعلام، الأسرة، ويكشف هشاشتها من الداخل. الفساد لم يعد حدثا معزولا، بل هو بنية شاملة، تطال كل فرد، وتعيد إنتاج نفسها عبر التنشئة الأسرية نفسها.
– في “عائلة زيزي”، الطفلة الصغيرة ترصد، تتعلم، وتمنح الفيلم نكهة من الطهر. أما في “عائلة ميكي”، فالطفل نفسه يتصدر المشهد بوصفه زعيما صغيرا لعصابة تنقيب عن الآثار، كأن الطفولة لم تعد بريئة، بل باتت مرآة للمجتمع المنهار.
– ليست السينما هنا مجرد مساحة للتسلية، بل سجل دقيق – وربما موجع – لما حدث للمجتمع المصري. في زمن “عائلة زيزي” ، كانت الجيرة امتدادا للعائلة، والبيت وطنا صغيرا. في زمن “عائلة ميكي” ، صار الجار مصدر فضيحة، والبيت ملعبا للأنانية والخداع.
– لقد تغيرت أحلام الطبقة المتوسطة من الطموح الشريف إلى الاحتيال المقنن، وتحول النجاح من إنجاز ذاتي إلى شهادة مزورة. وبين الحلم والأقنعة، بين البراءة والخداع، تقف السينما شاهدة، ومُدانة أحيانًا.
– “عائلة زيزي” ينتهي بزواج الأبناء ونجاح الاختراع – نهاية تؤمن بإمكانية التغيير والتقدم، ولو بالتدريج. أما “عائلة ميكي”، فتنتهي بانتصار أسرة فاسدة، رشت لجنتها وابتسمت أمام الكاميرا – نهاية لا تحتمل أي تفسير سوى أننا صرنا نكافئ القبح.
وبينهما، لا تزال السينما تكتب شهادة المجتمع، لا لتدين، بل لتوقظ من نام طويلا أمام الشاشة.