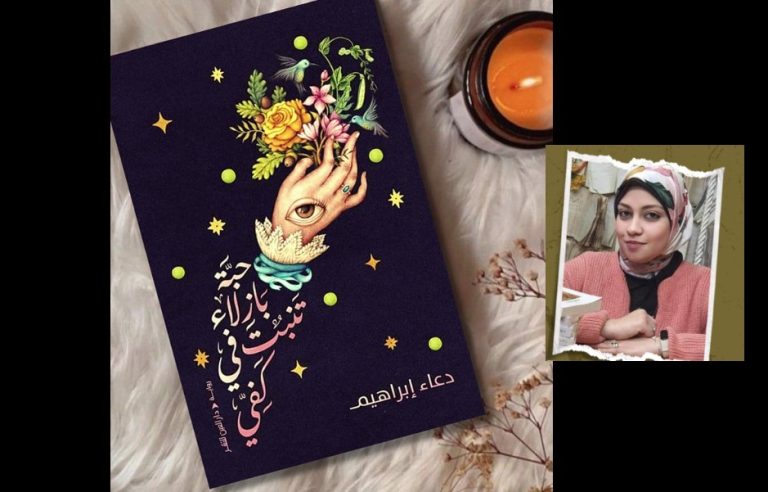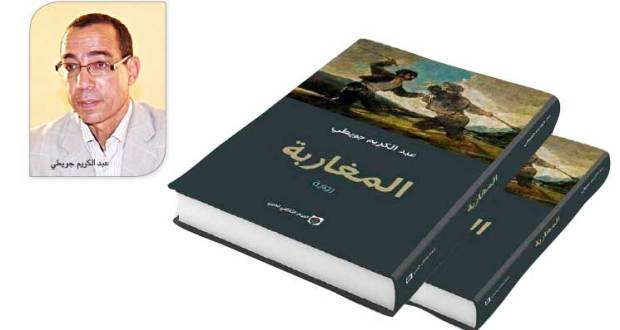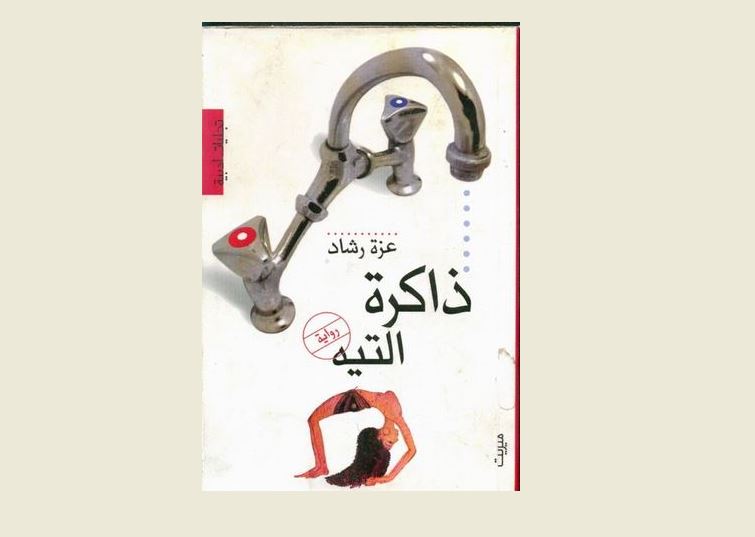سامح قاسم
“اسمعيني يا أثينا، اسمعيني.
أنا لا أملك من الحكمة ما يجعل شوارعك حمراء،
ولا أملك عمرًا كافيًا لزيارة مقابرك..”
يبدو ديوان اسمعيني يا أثينا اسمعيني لياسر الزيات وكأنه نص وُلد من رحم تجربة مكتملة الاحتراق، تجربة لا تبحث عن تفسير، ولا تطلب تبريرًا، وتتحرك منذ لحظتها الأولى في فضاء مثقل بالأسئلة والدم والحنين. القارئ لا يدخل هذا الديوان خطوة خطوة، وإنما يُلقى فيه كما يُلقى الجسد في بحر لا يُعرف عمقه. فالنص لا يُمهّد ولا يُهادن، إنه يفرض إيقاعه منذ السطر الأول، إيقاع قائم على الاعتراف العاري، وعلى مواجهة مباشرة مع فكرة الخراب بوصفها مصيرًا شخصيًا وجماعيًا في آن.
أثينا في هذا الديوان ليست مدينة بالمعنى التاريخي أو الجغرافي، لكنها كيان رمزي شديد الكثافة. تتحول إلى رأسٍ مثقوبة، إلى جسد عجوز صامت، إلى امرأة مطهوة في إناء الزمن. المدينة هنا تحمل صفات الأنثى وصفات الوطن وصفات التاريخ، وتغدو مرآة لكل مدينة خُذلت، ولكل حضارة استُهلكت ثم أُهملت. في مقطع يقول الشاعر: “خانوك، مثلي، يا مدينتي العزيزة، ودفنوك تحت أقدام المقاتلين والتجار..” يتضح هذا التماهي الكامل بين الذات والمدينة، حيث يغدو الخذلان تجربة واحدة تتكرر بأقنعة مختلفة.
الذات الشعرية تتحرك داخل النص بوصفها ذاتًا مكسورة، محاربًا منسيًا، أعمى يرى أكثر مما ينبغي. العمى في هذا السياق لا يدل على فقدان البصر، وإنما على فائض الرؤية، على معرفة فاجعة تأتي بعد فوات الأوان. المعرفة هنا عبء، وكل اقتراب من الحقيقة يضاعف العزلة. لذلك تتخذ القصيدة شكل اعتراف طويل، اعتراف لا يسعى إلى الغفران، ولا ينتظر خلاصًا، وإنما يكتفي بأن يضع الجرح في موضعه الصحيح.
الجسد عنصر مركزي في هذا الديوان، جسد يتعرض للانتهاك، للافتراس، للاختفاء. الجسد لا يعمل بوصفه مساحة للمتعة أو الطمأنينة، بل بوصفه ساحة للصراع بين الرغبة والفناء. المرأة تظهر في صورة مركبة، تجمع بين الإغواء والأسطورة والعنف. هي كائن متعدد الأذرع، متعدد الوجوه، تحمل في داخلها الحياة والموت معًا. يقول الشاعر: “كانت ضفائرها ثعابين، وأذرعها التسع حبال سفن غارقة” الصورة هنا تفتح بابًا واسعًا على عالم رمزي شديد القسوة، حيث يتحول الجمال إلى فخ، وتتحول العلاقة الحميمة إلى مواجهة مع المصير.
الحب في هذا الديوان تجربة حدية، تجربة تقود إلى أقصى درجات الانكشاف. الحب لا يُقدَّم كملاذ، ولا كقوة شفاء، وإنما كطريق إلى العتمة، عتمة الروح. الحب كهف مظلم، كما يقول الشاعر، تحرسه الخفافيش، وكل من يدخله يخرج منه محمّلًا بالخسارة. ومع ذلك، تظل الذات مدفوعة نحوه، كأن الحب قدر لا يمكن تفاديه، أو كأن الإنسان محكوم بأن يختبر نهايته بيده. في هذا المعنى، يصبح الحب شكلًا من أشكال المعرفة، والمعرفة ثمنها الفقد.
الزمن في “اسمعيني يا أثينا اسمعيني” ليس خلفية محايدة للأحداث، إنه كائن حاضر، ملموس، قابل للتشخيص. الزمن جثة على الشاطئ، كرة سوداء متعفنة، عبء يُحمل على الظهر ثم ينزلق إلى العينين. الزمن هنا قوة مريضة، تولد وتموت في اللحظة نفسها. حين يقول الشاعر: “أنا البحر الذي سيبتلعني، وأنا مصيري”. هنا تتجلى رؤية عميقة ترى الإنسان صانع نهايته، وشريكًا كاملًا في المأساة التي يعيشها.
البحر يحتل موقعًا محوريًا في بنية النص. البحر مساحة للتردد، منطقة بين الحياة والموت، بين القرار والتأجيل. السفن تصعد وتهبط، الجنود ينامون ويصحو الخوف في صدورهم، والمغني يكرر نشيده في مواجهة الموج. البحر هنا لا يَعِد بالنجاة، ولا يمنح يقينًا، لكنه يكرس حالة التعليق الوجودي، تلك الحالة التي لا تنتمي إلى بر ثابت ولا إلى غرق مكتمل.
لغة ياسر الزيات لغة متدفقة، مشبعة بالتكرار والإنشاد، قريبة من مذاق الملاحم القديمة، مع احتفاظها بحساسية شعرية معاصرة. الجملة طويلة، متلاحقة، كأنها ترفض التوقف خوفًا من الصمت. الصور تتراكم فوق بعضها، وتضغط على القارئ حتى يشعر بثقل التجربة. هذه اللغة لا تسعى إلى الزخرفة، ولا إلى الإبهار السريع، اللغة هنا تهدف إلى خلق أثر طويل المدى، أثر يبقى في الوجدان كما تبقى الرائحة الثقيلة بعد احتراق كبير.
في عمق هذا النص، تتشكل رؤية أخلاقية واضحة، من دون خطاب مباشر أو وعظ فج. الخراب يبدأ من الداخل، من القلوب التي تلوّثت بالكراهية، من العيون التي اعتادت مشهد الدم. يقول الشاعر: “الخراب داخلكم، وليس في المرايا”. هذه الجملة تختصر موقف الديوان كله: لا خلاص جماعي من دون مواجهة فردية مع القبح الكامن في النفس.
القصيدة في هذا الديوان لا تنتهي، لكنها تظل مفتوحة على العتمة. النهاية ليست حسمًا، وإنما استمرار في السؤال. الذات تظل معلقة بين شاطئين، بين زمنين، بين حب وموت. هذا التعليق الوجودي هو جوهر التجربة الشعرية هنا، وهو ما يمنح النص ثقله وقيمته. “اسمعيني يا أثينا اسمعيني” ليس ديوان عزاء، ولا بيانًا احتجاجيًا، وإنما شهادة شعرية على زمن فقد بوصلته، وعلى إنسان أدرك الحقيقة متأخرًا، فاختار أن يكتبها بدمه.
بهذا المعنى، يقدّم ياسر الزيات عملًا شعريًا شديد الخصوصية، عملًا يرفض الطمأنينة السهلة، ويضع القارئ أمام مرآة قاسية. نص يذكّرنا بأن الحب قد يقود إلى الفناء، وبأن المدن تموت حين تُخون ماضيها، وبأن المعرفة حين تأتي بلا رحمة تتحول إلى جرح مفتوح لا يندمل.