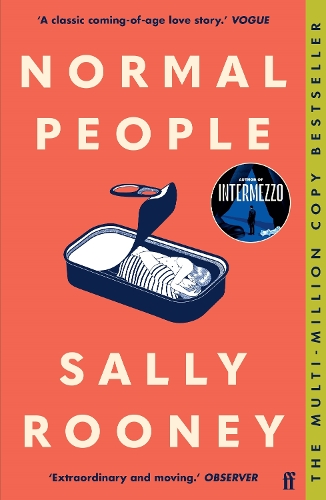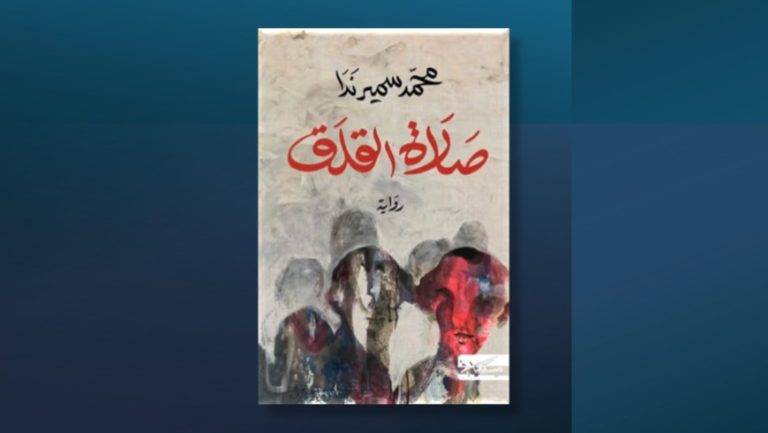الشخصية هنا آخذة في تقويض نفسها، بلا حاجة لعنصر خارجي ينهض لدحرها.إنه اشتغال أقرب للشعري فيما يخص البنية الشمولية للنص، فلا حكاية خطية تتنقل مفاصلها تعاقبياً من نقطة لتاليتها في الزمن. بالتالي فالرواية تنهض رأسياً بأكثر مما تتوسع أفقياً عبر حبكة تقليدية. “النهوض” بالعالم عوضاً عن “تمديده” هو ما يبدو شاغل هذا النص، وبحيث تجري خلخلة الزمن بعنف، مؤسسةً لقطيعة تامة بين الزمن الكرونولوجي التعاقبي والزمن النصي الذي لا يعترف سوى بقانونه الخاص. لذا، فنحن أمام رواية “استباق” بالقوة نفسها التي نجد نفسنا بها أمام رواية “استرجاع”، أو “استرجاعات” إن شئنا الدقة حيث لا تتوقف الرواية عند نقطة سالفة بعينها بل تتنقل بين “أنماط” من الماضي تستدعي معها لحظات ذات دلالة، من 641م في الفسطاط، لـ 1610م في غرناطة، ومن قاهرة يونيو 1967 لقاهرة أكتوبر 1973، وصولاً لسنوات التسعينيات والألفية. بالقوة نفسها ثمة استباق يصل للعام 2052.
مَن إلياس؟ ربما “جميع الشخصيات التي يؤديها.. ولا أحد”، بتعبير ستانسلاف ستانسلافسكي عن “الممثل”. لكن إلياس بدوره ممثل، لأدوار ثانوية، مثلما هو قاتل، وكاتب قصص قصيرة مجهض، ونبي مغترب في عصره، وجثة متحركة بساق مبتورة، وفي الأخير، خالد، حسب تصوره الخاص عن نفسه.
لن تألو الرواية جهداً في التفتيش بين “هوياته”، هويات تتراوح حتى أنها يستحيل أن تجتمع في ذات مفردة إلا بقدر لا يُصدق من التسامح.. يناقض بعضها بعضاً وينقضه، فلا يتبقى منها سوى الاسم. الوجود يسبق الماهية، لكن التشكيك هنا يجري على المستويين، أي وجود يمكن التحدث عنه وأي ماهية؟
(2)
يبدأ ابن كثير الرواية وينهيها، كسارد.
إنه يتحول هنا إلى راوٍ لحكاية إطارية وليس فحسب اسماً مُتضَمناً في “تصدير”.
“أربعة أنبياء أحياء، اثنان في الأرض: إلياس والخضر، واثنان في السماء: إدريس وعيسى”. هذا هو مفتتح الرواية وليس تصديرها، كونه يُعرّف مباشرةً بـ”ماهية” بطلها ويبسط سماته الجوهرية أمام قارئها: نبي حي عائش على الأرض، والحياة هنا تتضمن كونه حياً وسيظل.
يلتقط إلياس نفسه طرف التعريف من راوي المدخل السردي الإطاري، ليبدأ على الفور تعريفه الخاص لنفسه، واضعاً نفسه “كسارد حي”، محل “السارد الميت”: “أنا إلياس. اسمي إلياس. أو هكذا سمّوني بإلياس. أو هكذا يدّعون أنهم سمُّوني بإلياس. أو هكذا يظنون ـأن اسمي إلياس. إلياس هو الاسم وأنا أردد الاسم بيني وبين نفسي”.
سيختفي السارد الأول (المتحدث بالضمير الثالث)، وقد أرسى التعريف الأول لسارد يتحدث بالضمير الأول، وتركه يقبض على ناصية سرده. لكن السارد الإطاري نفسه، “ابن كثير”، سيظهر مجدداً ليغلق الحكاية (أو مجمل الحكايات) مثلما بدأها، بمشهد أخير يلتئم مع الأول ويؤكد عمدية الحكاية الإطارية. المشهد الأخير تحصَّل عليه السارد عبر أحد عشر راوياً: “كنا مع رسول الله في سفر، فنزلنا منزلاً، فإذا رجل في الوادي يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفورة المُتاب لها، قال: فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع، فقال لي من أنت؟ فقلت: أنس بن مالك خادم رسول الله، قال: فأين هو؟ قلت هو ذا يسمع كلامك، قال: فأته فأقرئه مني السلام، وقل له أخوك إلياس يقرئك السلام. قال: فأتيت النبي فأخبرته، فجاء حتى لقيه وعانقه وسلم، ثم قعدا يتحادثان فقال له: يا رسول الله إني ما آكل في السنة إلا يوماً، وهذا يوم فطري فآكل أنا وأنت. قال: فنزلت عليهما مائدة من السماء، عليها خبز وحوت وكرفس، فأكلا وأطعماني وصلينا العصر، ثم ودعه ورأيت مرّه في السحاب نحو السماء”.
كأننا أمام حكاية إلياس التي تبدأ بتوصيفه وتنتهي بانتقاله العجائبي للسماء.
بين القوسين الكبيرين، القادمين من سارد عاش ومات في القرن الثامن الهجري، تتحقق محكية عابرة للزمن والمكان، بالضمير الأول، حيث “إلياس” نفسه هو السارد.
النبي في التصدير والنبي في الخاتمة، وفي الاثنتين هناك الراوي الذي أقام الحقيقة من الفعل الشفاهي، لكن بينهما، هناك الكتابة، وهناك الراوي المتكئ على الكتابة في تقديمه لنفسه، بما يتجاوز فكرة النبي نفسها، مكرساً لخلوده، وكأنه ارتقى الدرجات اللازمة التي على النبي أن يقطعها ليصبح إلهاً. ليس “إلياس” بناقل لرسالة، لكنه خالقها، لذا فرسالته هي “إلياسيته”، وأتباعه، جميعهم “إلياس”. لا يرغب إلياس _كالأنبياء_ في محاكاة، إنه يطمح في تطابق رعيته معه. لذلك، لا يملك إلياس في هذا النص أتباعاً، بل أشباه. إنه تعميق لتصور، يغدو فيه الفرد وعالمه الشيء نفسه.
الهوية المغلقة تتحول في النص إلى هوية مفتوحة، تتسع للعالم وتستوعبه وفق اقترابه من “إلياس” العابر للأمكنة والأزمنة، ويغدو العالم، العالم كله، “أرشيفاً” يحيا السارد بين أوراقه.
(3)
المكان في إلياس إذن هو “العالم”. لكن، ما العالم؟ إنه الأرشيف اللانهائي الذي يحيا إلياس بين قصاصاته. العالم إذن هو “التدوين” ولا شئ آخر. كل ما لم يدون، لا يعول عليه، ليس لأنه لا يصدقه، لكن، لأنه ببساطة، لم يقع. نص إلياس الذي بين يدينا هوكتابة على كتابة، كتابة تتأمل كتابة سابقة (ولاحقة)، كأن العالم. نص إلياس نفسه الذي بين يدينا هو مكتوب يجادل مكتوباً، لينتج في النهاية “ميتا رواية”.
يجافي “الأرشيف” فكرة “الاستخلاص”، لصالح التراكم الكمي والدقة “التسجيلية”. الأرشيف هو “الكلية” التي تفتقر للدلالة كونها تعمد إلى التجميع عوضاً عن “الانتقاء”. هذه هي الرواية الأولى، (هي في الحقيقة ما ينهض كصورة للواقع التراكمي) اللانهائية، مكتوبة أيضاً بواسطة إلياس أو موجهة إليه. أما الرواية الثانية فهي رواية “الانتقاء”، رواية التخليص والتلخيص، التي تمثل نص إلياس “الدال”، وبالتالي صوته المهيمن.
منذ اللحظة الأولى، نحن أمام “صوت” بأكثر مما نحن أمام “شخصية”. لا يكف إلياس عن تعريف نفسه، ولا يكف عن نقض التعريف. هذه “مونودراما” روائية، أو هكذا تبدت لي: ممثل وحيد على خشبة مسرح يسرد مونولوجه الطويل الذي يتجاوز المائتي صفحة في قطع “كِتابه”.
صوت إلياس هو نصه، صوته المرتبك، الذي تترجمه عبارات قصيرة مبتورة، تجافي الفواصل، وتنتصر للنقطة التي يتكسر على شاطئها كل سطر. يوحي إلياس لقارئه بأنه يكتب شهادة نهائية تلخص مزق حياته، المكتوبة بالفعل في قصاصات متباعدة يضمها أرشيف ضخم. يكتب كتابة “لاحقة” على أنقاض “كتابة سالفة”.
يبرر ذلك هذه الرغبة المحمومة في تقريب اللغة المكتوبة من تقنية خاصة في “التلفظ” تخص صاحبها. التلفظ وقد صار موضوعاً للتدوين، إنها التقنية التي تقرب العالم الروائي من أحد أشد أسئلته إلحاحاً: العالم كسلسلة من النقل الشفاهي، وهو يطمح في تحوله إلى كتاب نهائي لا يقبل “التحريف”.
يعرف إلياس نفسه من اللحظة الأولى، كأن متلقيه يجلسون قبالته. إنه وعي أولي بفكرة “العرض”. “العرض” يتسق ومهن “تخون الواقع” سواء بالاتكاء على وهمه الممثل في الفن (إلياس كاتب القصص القصيرة/ إلياس ممثل الأدوار الثانوية)، أو تخونه أخلاقياً، بالقتل (إلياس القاتل).
متى تصبح الشخصية الروائية بطلاً لعرض؟ عندما تدرك أنها بصدد نصها لا واقعها. نعم، واقع إلياس هو نصه، هو صوته العميق وقد تحول لكتابة، وهو وعيه الخاص باللغة وقد حلت محل العالم عوضاً عن أن تعمل كمحض جسر بين الدوال ومداليلها الاتفاقية في الوعي الجمعي.
يتبنى إلياس بنية خاصة للعبارة، بنية تكرارية تتكاثر فيها الدلالات بقدر ما يشح محصول المفردات. إنه تصور للزمن أيضاً، لا وجود فيه لفاصلة. وحيث لا جملة مكتملة إلا بإكمال تاليتها لقدر من الدلالات المرجأة. النقطة التي تجعل من كل عبارة نهاية، في مواجهة الفاصلة التي تعد بالاستمرارية. إنه وعي يلائم المتكلم الذي “قد” تنتهي حياته قبل أن يكمل عبارته، حتى مع يقينه بخلوده. حسب ذلك التصور، تنتفي الفروق بين الماضي والمستقبل. وتبعاً لذلك، يسرد إلياس ببساطة ما وقع في مستقبل بعيد، كمن يتذكره.
(4)
نحن أمام سارد يتجاوز، حتى، فكرة أنه “البطل”، حيث أنه هنا يغدو “الحكاية” نفسها.
النص بأكمله سيتحقق إذن كمونولوج داخلي طويل: إنها تقنية تطمح، إذا ما استعرنا مفهوم روبرت همفري، “لتقديم المحتوى النفسي للشخصية والعمليات النفسية لديها في اللحظة التي توجد فيها هذه العمليات في المستويات المختلفة للوعي قبل أن تتشكل للتعبير عنها بالكلام على نحو مقصود”. قصدية الكلام هنا تتقاطع مع ملاحقة الوعي في آنيته، فينتج خطاب إلياس على النحو الذي يبسطه النص: كتابة تجتهد لكي تكون على الدوام صورة من الحاضر. بهذه الطريقة فقط يمكن أن يكتسب الزمن سيولته النصية كما تحققت روائياً. من هنا أيضاً يمكن ملاحظة هيمنة الفعل المضارع على الخطاب، سواء كان ذاهباً إلى الماضي أو مستبقاً نحو المستقبل.
إنه، بتعبير جيرار جينت “خطاب فوري يضع القارئ داخل ذهن الشخصية ليشهد حدوث عملية تفكيرها”. القارئ داخل ذهن الشخصية: إنه طموح آخر توفر هذه الرواية إمكانات تحققه، بحيث يغدو الفعل الإنتاجي مقسماً بالعدل على السارد والمتلقي معاً.
ليست لغة السارد هنا إذن محض ولع شكلاني بتغريب اللغة السياقية المتعارفة، لكنه محاولة دائبة لمحاكاة عملية التفكير تجعل اللغة أقرب ما تكون للوعي. نحن فعلياً نكاد نكون “شهوداً” على عملية التفكير نفسها، وكأننا أمام نص قائم فعلياً في المضارع.
ربما لذلك يكاد النص يكون “عرضاً” لوعي الصوت المركزي المتحدث بضمير المتكلم. لا وسيط هنا بين السارد وخطابه، وهكذا يصير الخطاب، في حالة إلياس، هو نفسه السارد.
تبقى المغامرة في “إلياس”، فادحة بقوة التخييل الذي يقودها باتجاه عالم مشيد على غير مثال، تنتفي فيه المسافة بين الإله والنبي والفرد، بقدر ما تذوب بين الأزمنة التي ظنناها غير قابلة للتجاور.