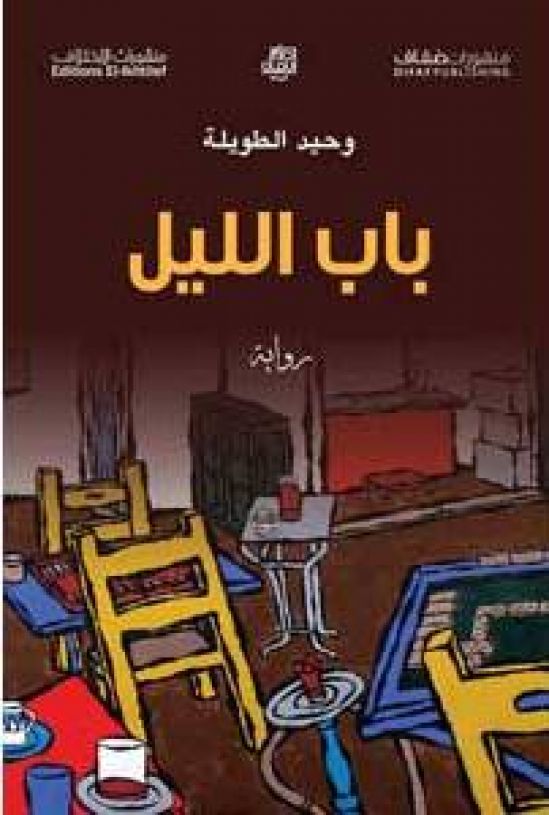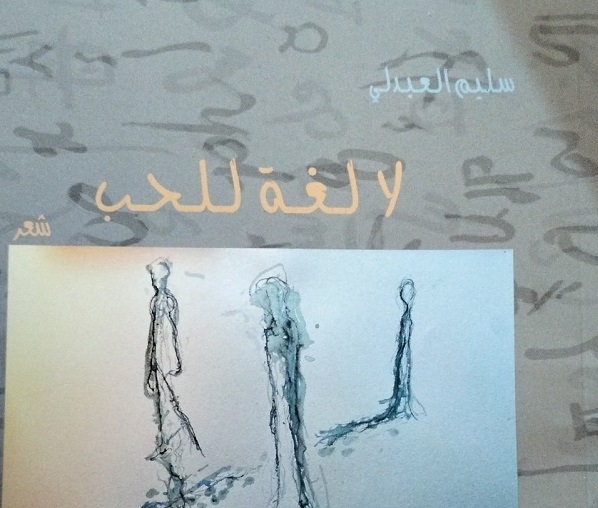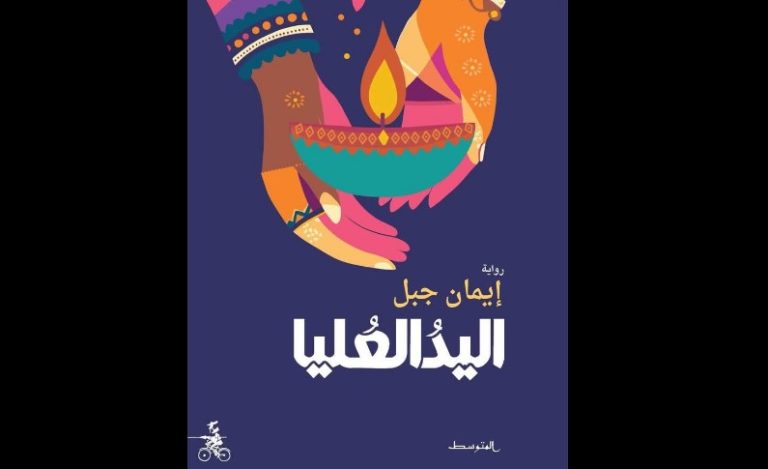تسير الرواية على خطين متوازيين، يساند أحدهما الآخر في إطار الشخصية الرئيسية للرواية، والتي حُشد لها عدد وافر من الشخصيات الواقعية حيناً والغرائبية حيناً لخدمتها أثناء عملية ذلك البحث المستحيل.
وقد تشابه الخطان في بدايتهما إذ لعبت الصدفة دورها في صناعة البداية، كما تشابه الخطان في نهايتهما إذ أفضيا إلى الوهم والفراغ، لتكتشف أنّ الغاية في النهاية من وجودهما ليس اجتيازهما من أجل الوصول إلى هدف ما، وإنما يكمن الهدف الذي تسعى إليه الرواية عبر هذين الخطين في عملية الاجتياز ذاتها، والمطلوب منها فقط هو الكشف عما يتضمنانه، فالرحلة أشبه إلى حد بعيد باكتشاف الجينات أو الكروموسومات المتموضعة على حبليْ الـ«DNA» إنها رحلة إلى عالمي « اليقظة والحلم» أو الواقع والخيال، أو شرم الشيخ والكهف الداخلي للإنسان، والذي أسماه المؤلف كهف الفراشات، لأنّه يسعى بالدرجة الأولى إلى سبر أغوار بعض أشكال الحبّ المشوه أصلاً، ليخرج بنتيجة هي استحالة إمكانية وجود حب أبدي « فالواهمون لا مكان لهم في كهف العشاق».
الهرب من القاهرة
على الصعيد الواقعي، يخرج البطل من القاهرة طلباً للاستجمام، هرباً من القاهرة بما فيها من ازدحام وعمل متواصل وإرهاق، يأخذ إجازة ويمضي إلى شرم الشيخ، علّه ينسى وجه هند التي لا يعنيها من العلاقة سوى الزواج والإنجاب، أو لعله ينسى أو يجد نورا الضعيفة أمام شهوتها حداً لا يطاق، والتي لم تستطع فهم ما يريد، فالجنس بالنسبة له هو آخر المطاف، أو آخر ما يفكر فيه، فهو يريد حباً يذكّره بالحضن الأول في حياته، حباً كالذي طرد منه.
في شرم الشيخ، يلتقي ببتول بعد عدة مصادفات، ونظرات خاصة سابقة ليكتشفا في النهاية أنهما يحملان عقدتي أوديب واليكترا، وليضعا الرواية أمام صورتين مشوهتين من صور الحب، وبفضل عقدته الأوديبية نراه يفشل في التواصل معها، ونكتشف أنّها عاشت قبله علاقتين مشوهتين أخريين، إحداهما مع شبيه والدها، والثانية مع نقيضه تماماً، لتنتهي علاقتهما، وينتهي البطل في أحضان جانيت «سوزان» العاهرة التي تبيع جسدها لتصرف على أمها وأختها، وذلك في علاقة عابرة تفضي إلى فراغ.
أما على الصعيد الغرائبي أو على صعيد الأحلام أو اللاوعي، فهو دائم البحث في كهف الفراشات عن نورا، الحبّ الوحيد. يلح عليه رغم أنّها خانته وتزوجت.
في الكهف يستعرض بعض أشكال الحبّ المشوه أيضاً، فسيدة الجبل تحبّ لتنتقم ممن أهان موضع أنوثتها، والصلت يهيم داخل الكهف بحثاً عن محبوبة، بعد أن قمعت علاقتهما العادات والأعراف، وما الفراشات الهائمة في هذا الكهف كله إلا أناس هاموا حباً، ولخطأ ما في العلاقة أو في البيئة التي تحتوي هذه العلاقة، تحولوا إلى فراشات، أو هم في طريقهم إلى التحول، ولا نجد أحداً ممن في الكهف يصل إلى ضالته مطلقاً، وكل منهم يعيش تهويمه في فراغ الكهف تائهاً ضائعاً منتظراً. وبعد مروره على عدد من النساء ممن حاولن إيهامه بأنهن من يبحث عنها، نجده في نهاية المطاف على حافة جرف تماماً كما يعيش في واقعه على حافة جرف، فإن تقدم سقط، وإن تراجع استمر في ضياعه. لتنتهي الرواية عند هذه الحافة تاركة المتلقي يعيش الحالة ذاتها في هذه النقطة العدمية.
البنية الحكائية للرواية
الراوي في الرواية هو ذاته البطل فيها، ولهذا جاءت الرواية من وجهة نظر الشخصية الرئيسة، ولذلك هيمن حضور البطل على مفاصل الرواية بالمجمل، وعلى امتداد صفحاتها الـ 132، وهذا الحضور الطاغي للبطل جعل من باقي الشخصيات في المجمل تابعة له وخادمة لرغباته، ما أدى بالضرورة إلى تتابع الأحداث زمنياً بشكل يخلو من أيّ تنامٍ للحدث، فجاءت الرواية أشبه بوحدات قصصية منفصلة تؤكد كل قصة فيها ما ترمي إليه القصة السابقة من أنّ لا مكان للواهمين في كهف العشاق، وكأنّ العشق وهم والحب وهم، وما الأمر إلا شهوات ورغبات، وإذا كانت الفكرة بشكلها هذا قابلة للنقاش، فيفترض بداية أن توضع لها المقدمات الصحيحة والمنطقية لا أن تعتمد الرواية أساساً على بطل أوديبي، ولأنّ الفكرة أساساً كما ساقتها الرواية، لا تحتمل الإطالة، واستجلاب البراهين عبر إيراد قصص الآخرين « الصلت الرجل الفراشة سيدة الجبل الدميمة وحتى أحلام» فقد عمد الراوي إلى الاستفاضة بذكر التفاصيل الصغيرة، ولن أنعتها باليومية لأن المفترض بالتفاصيل اليومية أن تقدم حالة جوهرية تفضي إلى تعزيز الرؤية الفكرية، إلا أن ما أوردته الرواية من تفاصيل لا تتعدى وصف أحداث بسيطة كدخول الغرفة، ومن ثم الاستحمام، ومن ثم الخروج من الغرفة، فقد أثقلت هذه التفاصيل الرواية على قصرها، بدلاً من أن تعزز المقصد، وتغني الحدث الأساسي، وما زاد في تأثيرها السلبي على الرواية هيمنتها المباشرة على ما جاء في الرواية من حوار فبدا في كثير من جوانبه مثقلاً بما لا يهمّ المتلقي.
وبدلاً من التأكيد على هذه التفاصيل الصغيرة، كان بإمكان الرواية أن تستفيض قليلاً بما تضمنته من أجواء أسطورية واتكاءات ميثولوجية من شأنها أن تنهض بالمروي على مستويات أخرى، وتصنع سطوحاً سردية متباينة وآسرة في آن.
يبقى أن نقول إن إبراهيم فرغلي استطاع في روايته البكر أن يجمع عدداً معقولاً من حالات الحب المشوه والفاشل محللاً كما ذكرنا بعض أسباب هذا الفشل، أو كاشفاً عن هذه التشوهات تاركاً للقارئ أن يستنتج أن الحب إما أنه غير موجود أو أنه على غير هذه الشاكلة، وإذا أردنا الدقة أكثر فيمكننا أن نستنتج أن أي علاقة حب غير حقيقية مصيرها عتمة الكهف، كهف الضياع، لأن الحب الحقيقي لا يستطيع العيش في العتمة فهو يتغذى على النور أبداً. ولا أجد هذا الاستنتاج متناقضاً مع مقولة « الواهمون لا مكان لهم في كهف العشاق» التي وردت في الرواية ذلك أنها صدرت أساساً عن واهم، والواهمون لا يدركون حقيقة وهمهم، وما الكهف في واقع الأمر إلا ذلك البرزخ الأبدي لحالات الوهم المعاش على أنه حب، إنه قبر العلاقات العاطفية غير المتوازنة