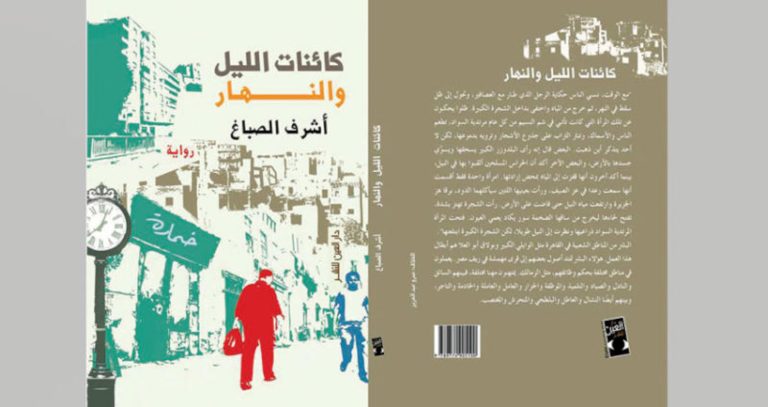غصون حجاج
يُرهقها الشعور بحرارتها الداخلية، ترتفع أكثر فأكثر، لا يمكنها الالتفات حتى إلى شيء سواه، كالعادة القاهرة متخمة بالناس الليلة وكل ليلة، وأيضًا ذلك المقهى مفتوح الذراعين على شوارع وسط البلد الرئيسية، ولكنه تحدث فصمت الضجيج وتقولب داخلها محدثًا الصراع المعتاد، هل تترك قلبها ليحضنه الآن؟ أم تنتظر قليلًا؟ كم من الوقت عليها انتظاره؟ كانت أمها تخبرها أن في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة، مهلًا يا ابنتي العزيزة إن لم تحصلي عليه اليوم، ستحصلين عليه غدًا، كانت الأم تخص الحب بالذكر، ولكنها لا تحب أن يتملك الحب من فيها، لذلك فهي لا تنطق الكلمة أبدًا.
خرج صوت الأم من رأسها، فإن الأمر يزداد تعقيدًا هنا، لقد بدأ يتكلم بحماسة أكثر، استخدم يداه الاثنتين في شرح إحدى المعضلات التي يتحمس إليها جدًا، “ألن تتحمس من أجلي ولو لمرة واحدة فقط؟” كالعادة كانت تنظر إلى يديه بحسرة ما.
انتبه أخيرًا إلى تركيزها الشارد، فأزاح معضلته جانبًا بقوله “ها، قهوة ولا شاي المرادي؟”
ابتسمت أنيسة أخيرًا، وأزاحت هي أيضًا أمها وأفكارها جانبًا، أحبت كونه لم ينسَ هذه المرة بأنها لا تحبذ الكافيين، كان يسخر من كل شيء حتى من نفسه، ففي كل مرة كان يأتي إلى المقهى طالبًا “اتنين قهوة” بينما تأتي هي متأخرة كالعادة، فتفوقها تلك التفاصيل اللعينة، وتهمس في أذنها “هو لا يحبك أبدًا، هو ينساكِ وينسى رغباتك المفضلة دائمًا” فتجلس باهتة أمام اعتذاراته السخية.
انتهت الأمسية في سيارته بعدما ثرثر كثيرًا أمام عمارة أنيسة، فهي كأي فتاة مغتربة تكره مدينة الطالبات وقيودها ففضلت أن تسكن في شقة صغيرة بجانب الجامعة بحي الدقي، حيث تقع العمارة بالشارع الموازي لبيته، لذلك كان دائمًا سهل الوصول إليها، مهما قررت البعد، وإنقاذ روحها الحية من الموت المحقق، ودعته وانتظرت حتى غاب عن بصرها، ولكن لم يغب عن خيالها كالعادة، كانت يداه تنكز خيالها بقوة، لطالما كانت تتخيل أصابعه الطويلة الجميلة وهي تمسكها برفق، فتتمايل معه على أنغام قلبها السعيدة، ثم اصطدمت بكلمات أمها وهي تصعد السلم، أنيسة الفتاة المحترمة لا تتخيل رجل غريب عنها بهذه الطريقة، لا تتخيله أبدًا، فما بالك وهو لم يفكر فيها ولو مرة واحدة في حياته؟ لا تدخلي الجحيم بكامل إرادتك يا أنيسة، تراجعي قبل فوات الآوان.
صوت أمها كاد ينخر رأسها، أرهقها تمامًا، بل لم يتركها إلا وهي باكية على السرير مثل كل يوم.
ردت أنيسة بوهن على صوت أمها، إرادتي؟ الحب لا ترافقه الإرادة يا أمي، فقط يرتبط به الوهن وقلة الحيلة، بالأخص إذا لم يخلق لنا منذ البداية، وأنتِ .. نعم أنتِ تدركين ذلك جيدًا، وتعرفين إحساسي حق المعرفة، فإذا الحب تتخلله الإرادة لكنت الآن أرغمت نفسك على حب أبي!
(الآن أواجهك بشرِ ما أفعله، أنا أتخيله يا أمي، أتخيله في جميع أرجاء هذا البيت الموحش، أنتهز فرصة وجودي وحدي لأكون معه للحظات، لا بل لساعات، أتكلم، أضحك، بل أنتظره ينام حتى أقبل رأسه المتكئة على كتفي زورًا وبهتانًا، أنتظره عائدًا من العمل متعبًا، ولكنه لم ولن يدق جرس الباب أبدًا. بعيدًا عن كل هذه الخيالات المؤسفة، أنا فقط لا أفعل شيئًا حقيقيًا يا أمي سوى الانتظار.)
غلب النوم أنيسة، غلبها الإرهاق الشديد وحظها السئ، غاصت في حلمها المتكرر، كل يوم ذات الحلم الذي يبدأ بزمجرة القطار المتوجه إلى القاهرة رأسًا دون الوقوف في أية محطات فرعية، يقولون أن القاهرة كبيرة ولكنها ضيقة جدًا وخانقة في نفس الوقت، أنيسة لم تهتم سابقًا أن تنزل مع والديها إلى القاهرة، كانت تحب بيتها الريفي الأنيق في قنا وسياج شجر المانجو المحيط بشرفة غرفتها، هي أيضًا لا تحب زمجرة القطارات، ولكن كلية “الاقتصاد والعلوم السياسية” أجبرتها على قطع التذاكر لتسمع الزمجرة بشكل متواصل، اقترح والدها أن تحول أوراقها إلى أي كلية أخرى قريبة – لم تمانع أنيسة- لكن والدتها أصرت على أن تكمل البنت دراستها في جامعة القاهرة مثلها كمثل أخيها، صوت أمها العالي، زمجرة القطار، اعتراض والدها، وتردد أخيها لأن القاهرة لا ترحم أحدًا ، تداخلت كل تلك الأصوات مع دقات ساعة الجامعة المهيبة في أول يوم دراسة، تعلو فتعلو برعب حد إفزاعها في منتصف الليل.
أشعلت سيجارة، وأخذت تراقب أنفاسها الساخنة في هدوء شديد، بينما تحاول أنيسة إقناع عقلها الباطن أن انتقالها إلى القاهرة لم يكن السبب الرئيسي، هي وحيدة تحت سمائها، لكن هذا سخيف وطفولي، سواء اقتنعت بذلك داخليًا أم لا، لكنه الأكثر منطقية. مدت يدها تجاه هاتفها لتتصفح تطبيقاته المختلفة، لا توجد رسائل منه يا أنيسة، هكذا رد هاتفها باقتضاب، أغلقت أنيسة هاتفها تمامًا وتمنت لو أنها في حضن أمها الآن، شردت حتى السابعة صباحًا لم يغمض لها جفن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاتبة مصرية