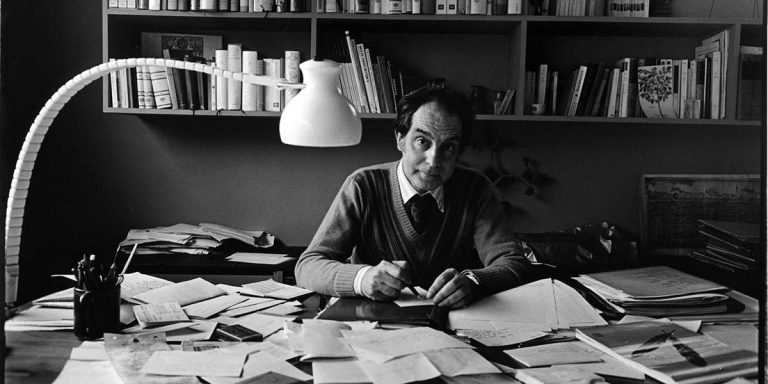تسخر من محاولتي لقراءته عبر ترجمة منذر عياشي قائلاً: “دون ذلك خرط القتاد”، كونك لم تهضمه بفرنسيتك السليمة دون وسيط. ولكنني أعرف أنك تشعر بالحنق لأنني أحاول فهمه بينما كففتُ عن محاولة فهمك منذ سنوات، ولأنه يعبد النص مخلصًا بينما تعبده أنت ليقربك إلى مآربك زلفى، ولأنه يعلن موتك كمؤلف ويحرر النص من قبضتك بينما تتشبث أنت بكتابتك وتلتصق بها كابن ترفض أن يخرج عن طوعك، ولأنه يرآني حين أرفع رأسي عن القراءة فيفهم أنني أعيد خلق النص في رأسي ويمنحني الفضل لذلك بينما لا تقيم أنت وزنًا لرأي قارئك وتجبره على رؤية ما ترى، لدرجة أنك أنفقت محاضرةً كاملة في مهاجمة إحدى فقراته التي يسلِّم فيها الراية للقارئ بعد قرونٍ من التبعية: “ألم يصادفكم قط وأنتم تقرأون كتابًا أن رفعتم رأسكم مرارًا عن القراءة ليس لأنكم لا تهتمون بما تقرأون ولكن بسبب دفق الأفكار وشدة الإثارة وكثرة التداعيات، باختصار، ألم يصادف أن قرأتم وأنتم للرأس رافعون؟ إن هذه القراءة بالذات، التي تتصف في وقتٍ واحد بقلة الاحترام لأنها تقطع النص، وتكون مفتونةً لأنها تعود إليه وتتغذى منه، هي التي أحاول أن أكتبها”[1].
حتى الآن لم أقرأ له سوى “هسهسة اللغة” و”لذة النص”، ولكنهما كانا كافييْن لأن أفهم أسباب كراهيتك له. أذكرُ ابتسامتك الهازئة من كلمة “هسهسة”، أعرفُ بفرنسيتي الكسيحة أن لكلمة “bruissement” ترجمةً أخرى وهي “حفيف”، ولكن منذر عياشي كان عبقريًّا باختياره “هسهسة”. ولأن اللغة بالنسبة لك ليست سوى عشيقة ينتهي دورها وتغيب ملامحها بمجرد بلوغك نصًّا جديدًا خاليًا من الحياة مثلك، لم تشعر بالمعاني البادية والخافية للكلمة.
ولم تكن في نظر رولان بارت كقارئ بأحسن حالاً منه كمؤلف، فقد عرف أنك من هؤلاء الذين لا يمارسون إلا “القراءات الآلية، التي تُعد ضرورة لاكتساب معرفةٍ ما، أو تقنيةٍ من التقنيات، والتي تختفي بموجبها بادرة القراءة تحت فعل التعلم”، وأنه لم يكن لديك يومًا “شبقية القراءة”، فأنت لست “القارئ-الذي يقرأ- حين ينغلق على نفسه لكي يقرأ ، ويجعل من القراءة حالةً معزولةً تمامًا، وسريةً يلغي العالم فيها كليةً، فإنه يتماهى مع ذاتيْن إنسانيتيْن أخرييْن – وللحق نقول إنهما قريبتان من بعضهما – تكتسب حالهما أيضًا انعزالاً عنيفًا: الذات العاشقة والذات الصوفية”[2]، فأنت لم تجرب العشق، كما أنك أبعد ما يكون عن التصوف. فضح رولان بارت عجزك عندما قال إن الذات الراغبة في القراءة هي الذات الراغبة في الكتابة، ولأنك لم تكن الذات الأولى فلن تكون الثانية، الرغبة هي ما تفتقد إليه، لأن المعيار الوحيد الذي يحكم علاقتك باللغة –وبالكون- هو الحاجة.
يحلو لك أن تلقبه بـ “الصابئ المتقلب الذي لم يرسُ يومًا على مذهب”، وهذه حقيقةٌ لا أجادلك فيها، فهو لم يثبت على موقف واحد، وتنقَّل بين المدارس والأفكار: غاص وطفا، وجرب وتعلم وعلم، وأخطأ وأصاب. ولكن، ألا يبدو ذلك إنسانيًّا يا إله النقد؟ يا أيها المتصلب الذي يتعاطى الكتابة ليمنح اسمه شيئًا من وهج قد انطفأ في روحه؟.
ماذا فعلت أنت بتعلمك آراء سوسير وبيرس ومن جاء من بعدهما؟ لا تفعل في محاضراتك سوى عرض الآراء النظرية دون أي محاولةٍ لتطبيقها على النصوص التي تعجز عن النفاذ إلى مراكز الحس لديك – ربما لأنها غير موجودة – ثم تتفرغ بعد ذلك لنقد تلك الآراء والنيل من أصحابها. لم تستطع يومًا أن تخلع عنك أسمال كاليبان ونظرته الحاقدة وذكرى جهله، وبعد أن تعلمت الكلام صرخت في وجه معلميك كما فعل: “الآن أستطيع أن ألعنكم”[3].
حسنًا، لن أكْذِبَك، ربما بالغ بارت قليلاً بإعلانه “موت المؤلف”، ولكن ماذا بإمكاني أن أفعل إزاء مؤلفٍ يصعد به أحد نصوصه إلى سدرة المنتهى ويهبط به آخر إلى أسفل سافلين؟ أو مؤلف يدير ظهره لمكتبه ليصرخ بآرائه في المجتمع أوالمرأة أوالجوائز أو المواقف السياسية حتى يتطاير الزبد من شدقيه ويقترب من هيئة رشدي القائل في لوثة “أنا بلوى سودا”، أو ذلك الذي يريد من قرائه أن يسبحوا باسمه آناء الليل وأطراف النهار؟ ليس أمامي يا عزيزي سوى أن أحيِّد المؤلف تمامًا وأخرجه من المشهد، وأترك نفسي للنص فإما أن يثبت نفسه بعيدًا عن أي مؤثرات أو يتوارى مع مؤلفه وراء الستار.
لهذا أحببتُ بارت، فقد صدَّق على رأيي الانطباعيّ الذي كوَّنته عن غير دراسة، ووقف إلى جواري يربت على كتفي بيد وبيده الأخرى سيجارة يرسم دخانها حروفًا غير الحروف، ويعزف نغماتٍ لا يسمعها سواي ومن مثلي الذين آثروا الابتعاد عن ساحات المعارك، ويعيرني نظرته التي تقول لكل المتشنجين: “وإذا كنتُ أقبل أن أحكم على نص بما تقتضيه اللذة، فأنا لا أستطيع أن أسمح لنفسي بالقول: إن هذا لجيد وإن هذا لسيء. إذ ليس ثمة قائمة للجوائز… فالنص (وينطبق الشيء نفسه على الصوت الذي يغني) لا يستطيع أن يقتلع مني غير هذاالحكم. وهو حكم لا يحمل أي نعت، هذا هو! وأكثر من هذا أيضًا، هذا بالنسبة إليّ.”[4].