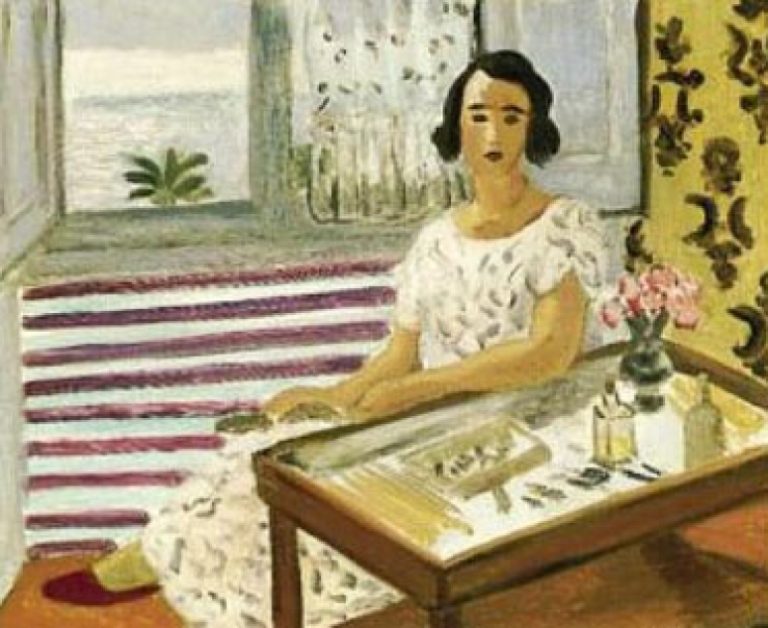رجب سعد السيد
أنهى معلمنا حكايته قائلاً: ” وهكذا، كان جزاؤه جزاء سنمار!”.
وكان يحدثنا عن إنســان اجتهد، وقام بعمله على الوجه الأكمل، ولكنه – في النهاية – لم يجد المقابل، بل على العكس، قوبل إتقانه لعمله بالجحود، ولحق به الأذى!
هالني أن أسمع هذه الحكاية ذات النهاية المؤسفة، فالعدالة تقول بأن الجزاء من جنس العمل.. من عمل خيراً فله حســن الجزاء، ومن عمل غير ذلك فعليه أن يتلقى عقابه.
استأذنت المعلم، فأذن لي بالكلام، قأبديت انزعاجي من أن يقع على إنسان مجتهد ظلم؛ وسألته: ” هل يعني ذلك المثل العربي الشائع (جـــزاء سنمار) أن مثل هذه الأحوال موجودة منذ الأزل، وأن بعض الناس – في مختلف الأزمنة والأمكنة – يجد شـــرَّ العقـاب على ذنب لم يقترفه؟! “.
قال المعلم، بحكمة بالغة: ” ليست الدنيـا خيراً خالصـاً، فللشــر وجــود.. وعمـاد الحيـاة الصــراع بين الخير والشر.. بين أنصـار العدل والظالمين! “.
سأل زميل بالصـــف: ” وهل كان سنمار هذا مظلوماً؟ “.
قال المعلم: ” حكاية سنمار طويلة، وقد انتهي وقت درسنا؛ ولمن يرغب في القراءة عن سنمار، أكتب لكم أسماء أربعة كتب، من عيــون الأدب العربي.. ستجدونها في مكتبة المدرسة (وكانت مكتبة المدرسة العباسية الثانوية في الإسكندرية عامرةً بالكتب).. ابحثوا فيها عن سنمار، حتى نلتقي في درس تال، نخصصه لأخبار سنمار! “.
وكتب معلم صفنا أسماء الكتب:
1 – البداية والنهاية، لابن كثير.
2 – معجم البلدان، لياقوت الحموي.
3 – ثمار القلوب في المضـاف والمنسـوب، للثعالبي.
4 – تاريخ الأمم والملوك، لمحمد بن جرير الطبري.
لم يهتم معظم الطلاب بالالتفات لأسماء الكتب، وأسرعوا يحملون حقائب كتبهم، لينطلقوا إلى بيوتهم، إذ كان جرس المدرسة يعلن انتهاء آخـر درس باليوم المدرسي. وكنت من القلة التي استمعت لنصيحة معلمنا، فنقلت أسماء الكتب في ورقة؛ وقضيت بعض الوقت أبحث عنها، وأقرأ فيها، حتى أصبحت ملماً بجانب كبير من قصة المثل العربي الســـــائر: ” جـــزاء ســــنمـار “. وكما وعدنا معلم الصــف، أفرد درســـه التالي لمناقشــة ما جــاء بالكتـب الأربعـة من ذكـرٍ لســنمار.
بدأ المعلم حديثه قائلاً: ” إن من يقرأ ما ذكرته الكتب التي اقترحت عليكم الرجوع إليها، عن سنمار وجزائه، يجد أن الرواة يختلفون حول التفاصيل، إلا أن أصل القصة واحد، وهو أن أحد ملوك الدولة الفارسية، واسمه ” ســـابـور “، كان له ابن أصابه مرض حيـر الأطباء، ووصـف له بعضهم أن ينتقل للعيش في مكان هواؤه نقي. وانتهي الرأي إلى أن أفضل مكان يفي بالغرض، يقع في أملاك أحد ملوك العرب، هو النعمان ابن امرئ القيس؛ فأرسل الملك الفارسي إلى الملك العربي، يناشده أن يأذن بإقامة صغيره المريض في الموقع المختـار، فاستجاب الملك العربي الكريم لطلب الملك سابور، وأمر ببناء قصر في المكان الذي حدده الأطباء وعلماء المناخ.
وكان أشهر المعماريين في ذلك الوقت مهندس من الروم يسمى ” ســنمار “، عهد إليه الملك النعمان ببناء القصر، الذي اختير له اسم (قصر الخورنق)، وقد استغرقت عملية البناء عشرين عاماً، وهو – كما ترون – زمن طويل، غير أن ثمة رواية أخرى تقول بأن زمن بناء ذلك القصر امتد إلى ستين عاماً!
هنا، توجهت بسؤالي للمعلم: وما سبب الخلاف حول زمن بناء القصر؟
أجابني: قد يكون التهويل في تباطؤ المهندس سنمار.. فقد كان الغرض من بناء القصر هو توفير إقامة أفضل لابن ملك الفرس، ليبرأ من مرضـه؛ غير أن الطفل المريض كان قد شــفي، بل لقد كبر وصــار رجــلاً، ولم يكن سنمار قد انتهي من يناء القصر، الذي تصفه كتب تاريخ الأدب العربي بأنه كان فريداً، ولم يُـر أعجـبُ منه، حتى أن الملك النعمان خشــي أن يبني سنمار لغيره مثل قصر الخورنق، فأمر بإلقاء المهندس العبقري من فوق أسوار القصر، فمات.
عدت أستأذن معلمنا في الحديث، فرحب، وأذن لي. قلت:
– ” لا أميل لهذه الرواية، التي تتهم الملك النعمان بالظلم والأنانية.. وأعتقد أن التقصير كان من جانب ســنمار، الذي لم ينجز ما كـلــف به من عمل في وقت مناسب، والذي كان – أيضاً – قد ركبه الغرور.. فقد جاء في كتاب (معجم البلدان)، لياقوت الحموي، أن سنمار لم يكن يعمل بانتظام، بل كان ينقطع عن عمله كثيراً.. كان يعمل لسنتين، ويغيب عن العمل خمســاً، فإذا سأله سائل عن سبب غيابه، كان يتحجج بأنه يتحـرى الجودة والإتقان؛ والحقيقة غير ذلك، إذ أنه أصبح مغروراً؛ وكان يعتقد أنه لن يحصل على ما يستحق من أجر؛ فقد قال لبعض رجال الملك النعمان: ” لو علمت أنكم توفوني أجري، وتصنعون بي ما أنا أهـل له، لكنت بنيت بنـــاءً يدور مع الشمس حيثما دارت!”.
ولم يكن سنمار مغروراً، فقط، بل يمكن أن ننعته بالحمق.. ففي يوم افتتاح القصـر، جـاء الملك النعمان، وأعجـب بحســن بناء القصر، فالخورنق لم يكن قصراً اعتيادياً.. كانت لـه أبراجه الشـاهقة، وكان الواقـف عند قمة الأبراج يري البحر والبر؛ وقد صـعد الملك النعمان إلى قمة أحد هذه الأبراج، ونظر فرأي البحر أمامه والبر خلفه، فهنَّـــأ المهندس ســنمار؛ وربما كان الملك – الذي صار شيخاً واهناً – قد غفر له تلكؤه، وخذلانه له أمـام ملك الفرس؛ فماذا كان رد ســنمار على تهنئة الملك؟. لقد اقترب متباهياً من الملك المتسامح معه، وتحـذلــق، قائلاً:
– ” أبيت اللعن.. والله، إني لأعـرف في هذا البناء موضع حجـرِ، لو زال لزال جميع البنيان! “.
قال النعمان: ” أوَ كـذلــك؟! “. عاد المهندس الغافل، تحت تأثير غروره وحمقه، يؤكـد: ” نعـــم! “.
ترى، أكان على الملك أن يتحمل كل هذا الغرور، بعد أن تغاضى عن التأخير الطويل في بناء القصر؟. أكان عليه أن يعلم بمثل هذا الســـرّ، الذي يهدد أمنه، ويسكت، ليبقي – طول الوقت – مهدداً بأن ينتقل ســرّ نقطة الضعف في ذلك البناء الفريد، من سنمار إلى عــدو يهمه أن يتهدم القصــر على من فيـه؟!.
وكان رد الملك حازماً وحاســماً، فأمر يإلقـاء ســنمار من فوق أعلــى نقطة بقصر الخورنق، الذي شيده في عشرين، أو ستين سنة!.
لقد تدخَّلَ من نقلوا إلينا هذه الحكاية تدخلاً سافراً في تفاصيلها، بلغ حدَّ تزييفها، واختصارها في كلمات قليلة تصنع مثلاً شاع بين العرب، ينعي حظَّ من يجتهد ولا يجد مقابلاً لاجتهاده إلا ضيماً يصل لحد الهلاك. ولم نتوقف كثيراً لنتقصى الحقيقة، مستسلمين للمنقول إلينا نقلاً تحكمت فيه أهواءُ الناقلين، وميلُ العقل العربي لتلقي الموروث ميلاً يتصاعد أحياناً إلى حد التقديس، وكأن إعمال العقل مفسدة!