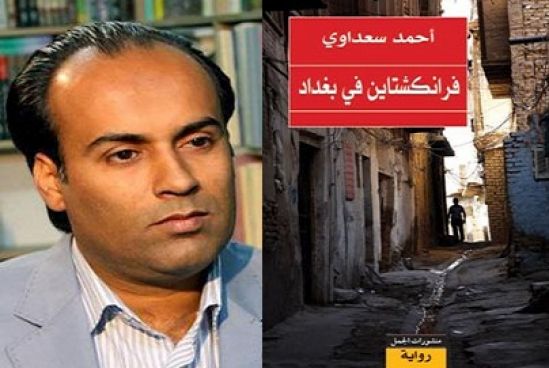حسن عبد الموجود
«لماذا لا تزرع شجرة» ليس عنواناً عادياً لرواية، ولكنه سؤال أحمد شافعى لنفسه، أو اقتراحه عليها، أو إدانته لها. فبرغم قضائه نصف حياته فى المدينة، لم يزل الريفى الذى نشأ قريباً من الزرع، ووسط غيطان حدودها السحاب والسماء والأحلام. ابتعد شافعى عن بلدته لأسباب تخصُّ الحياة، ولقمة العيش، والرغبة فى التغيير، ترك قريته الصغيرة «طحانوب»، وجاء إلى مدينته الكبرى «القاهرة»، ثم تركها إلى سلطنة عمان التى أتاحت له أن يكون بمفرده إذا شاء، مع بحر كامل، أو مع جبل، أو قطعة فضاء تناهز «طحانوب» نفسها، دون أن يخدش وحدته عابر، شخص أو حيوان، أو يحلِّق فوقه طائر، أو تضايقه ذبابة، وهذه هى الجنة لشخص متعته الكبرى أن يكون بمفرده.
شافعى صاحب الدعوة إلى زراعة الشجر، إن صدقنا عنوان الرواية، وصاحب الصرخة الإنسانية فى متنها، فيه إنسان وديع أحياناً، يمكن أن تتخيله خارجا من بيته فى القاهرة، أو من روايته فى رفِّ مكتبتك، فلاحاً يمسك بفأس، يطمئن أبو قردان على كتفه، ينهمك فى حرث الأرض وتعميرها بالشجر والسنابل والورد. لكنَّ فيه كذلك غضباً قد يجعلك تتخيله مكفهر الملامح، خارجاً على العالم وفى يده بلطة، قاتلاً لا تحركه الكراهية، ولكن الرغبة فى العزلة. فيه ما يحملك على الظن بأنه لو سنحت له فرصة للخلاص من البشرية، فلن يفلتها، ليبقى بمفرده، مؤتنساً بما يؤنسه. لعله الصمت، أو صفير الريح، أو ربما موسيقى شجر عملاق غير مهذب تتخلله تلك الريح، شجر سيبقى سنين دون أن تلمسه يد سوى يده هو، «الخالق» الصغير، المولود فى «77». مع ذلك يحب شافعى الناس، بطريقته، أو بقدر ما تسمح له نفسه، لكن المؤكد أنه يفضل الشجر.
ولهذا قصة قديمة..
كان لقرابة سبع سنوات، على خلاف يومى، أو أسبوعى فى أحسن الحالات مع أبيه، منذ بداية دراسته الثانوية تقريباً. كان أحمد يتردد على زاوية السنية (حتى قدموه لإمامتهم فى الصلاة ظناً منهم أنه أحفظهم للقرآن) فيغضب أبوه ويحاول أن يكشف له ضحالة خطابهم وخطورته أيضاً. كان أحمد كذلك يقضى وقت فراغه مع شعراء يتصادف أن منهم المكوجى والحلوانى ومدرس الابتدائى فيتذمر أبوه ويطالبه بالاقتصار على مخالطة أمثاله. يكتشف الأب أن ابنه مستمر فى التدخين فيثور. يراه يشترى الدواوين والروايات بدلاً من كتب الكلية فيضيِّق عليه فى المصروف. المهم أنهما لم يعدما، أحمد وأبوه، سبباً للخلاف طوال سنوات، وفى تلك الفترة توطدت علاقته بالخلاء. و«الخلاء فى طحانوب ليس قفراً بأى حال، وإنما جنة حقيقية، أو هكذا كان».
يحكى: «كنت إما فى غرفتى المنفصلة عن شقة الأسرة، أو فى الخلاء. لأسبوع مثلاً، ربما فى الصف الثانى الثانوى، لم آكل وجبة واحدة فى البيت، ولم يرنى أحد إلا عابراً، وصامتاً. معتمداً على مدخرات قليلة، بعضها من مصروفى وبعضها من مسابقات مدرسية كنت كثير الفوز بها، أردت أن أبرهن لأبى أننى قادر على الحياة برغم أى تضييق اقتصادى منه، فبدأت أشترى أرخص الطعام، والسجائر، وأحملها مع سجادة صلاة صغيرة، وأسير إلى أراضٍ كانت يوماً ما ملكاً لإقطاعى، وتحت صفصافة مجوَّفة الساق، قائمة عند تقاطع مسارات ضيقة وسط حقول ممتدة من العطر والياسمين، أجلس هناك، آكل وأدخن وأقرأ، ما بقى نور الشمس. كان بجوار تلك الصفصافة دائما آثار نار، فكنت على يقين أننى أرث بالنهار ما يملكه حارس بالليل، أو ربما لص».
أًصبحت تلك البقعة مكانه، حتى أنه كان يستقبل فيها زواراً من أصدقائه وزملائه. وهناك نشأت علاقة بينه وبين الشجر والزرع واليمام والغربان، وأهم منها جميعاً السكون. علاقة تركت فى نفسه حنيناً لا علاج له، وإحساساً دائماً ولا علاج له أيضاً بأنه فى المدينة، أى مدينة، ليس فى مكانه. إنما هو وضع مؤقت. عارض. خطأ: «تلك السنوات جعلت عينى شديدة الحساسية للقبح، والتلوث، أعنى الأرواح الملوثة، بالكراهية، بالحقد، وبالطموح أيضاً أو الانشغال بالمساعى التافهة».

الأرض والأب والشجر والثعابين
يكتب شافعى «من لا يملك حقاً فى قطعة من الأرض لا يملك الحق فى أن يزرع شجرة». و«أنا يا سيدى لا أملك حتى مساحة المتر فى متر التى ستتسع لجثتى. سأكون فى موتى عالة على أبى»، وفى هذين المقطعين تبدو تلك الثنائية البارزة فى الرواية، وكذلك فى حياة أحمد نفسه، ثنائية «الأرض والأب» وبينهما «الشجر».
يقول شافعى: «أظن أن جان جاك روسو قال إن مشكلة الإنسانية بدأت بأول شخص أقام سوراً حول قطعة أرض وادَّعى أنها ملكه. لكن، بعيداً عن طعن روسو فى الملكية، عندى يقين ـ وإن لم يستند إلى أى علم ـ بأن الأرض كانت ولم تزل كافية لكل من عليها. فيها ما يضمن ألا يوجد جائع أو عارٍ أو شريد، لولا تدخل الناس، واستغلال الأقوى قوته، والخوف من المستقبل الذى يدفع بعضنا إلى الجور على البعض».
توهم الرواية بأن مشكلة بطلها كامل كانت ستنتهى لو زرع شجرة، لكن شافعى لا يوافق على هذا، فلا أحد فى رأيه «ملزم أو مضطر إلى زرع شجرة، ولكن على كل إنسان أن يترك بصمته فى حياته»، وفى الرواية يستخدم الأقوياء الشجر لعزل أنفسهم خلف أسوار خضراء، لكن شافعى لا يرى الأمر أيضاً بهذه الصورة، فالشجر بالنسبة له «ليس جزءاً من مؤامرة على الإنسان، لأنه ما من مؤامرة أصلاً على الإنسان. طبعا هناك محاولات من الجميع لاستعمال الجميع، لسرقة أعمارهم، لكنها محاولات مفضوحة بصورة بائسة لكل من يستعمل عينيه وعقله ويرفض أن يسلم قياده لأحد».
لشافعى، مثل بطله كامل، ولع بشجرة الكافور: «أعرفها من قبل أن أعرف الكلام، أعرفها برائحتها، فى ازدهارها وشيخوختها، أعرف حتى التراب المحيط بجذوعها وأميِّزه عن أى تراب آخر، والمفارقة المؤلمة هى أن أحبَّ الشجر إلى نفسى تحبه أيضاً أبغض الكائنات إلى نفسى وبطلة كوابيسى، أعنى الثعابين، فمن المؤسف أنه لو أتيح لى يوماً أن أزرع شجرة فلن تكون شجرة كافور».
ومثل كامل أيضاً، يمثل الأب فى حياة شافعى شخصاً مركزياً: «لم يحدث أن استقامت علاقتى بأبى إلا متأخراً للغاية. ذهبت وأبى لخطبة زوجتى باعتبار ما سيكون. كنا معاً، أنا وهو فقط، للمرة الأولى منذ سنين. وفى طريق رجوعنا، قال لى فور أن استقررنا فى السيارة: أريد الآن أن أقول لك إنك كنت على حق. طوال سنين وأنت تختار بعناد عكس ما أختاره لك أو أنصحك به، أدعوك أن تتخصَّص فى الفرنسية وأنت فى الثانوى لأعينك على التفوق فيها، فتهرب منى إلى الألمانية، أختار لك الالتحاق بكلية التربية فتصر على كلية الآداب، أوفر لك عملاً كمدرس للإنجليزية فتؤثر عناء العمل مع لصوص مكاتب الترجمة، ألح عليك فى الزواج فترفض وتصر لسنوات على الرفض. لكننى بمرور السنوات، رأيتك تلتحق بعمل ثابت وترتقى فيه بسرعة، رأيتك تنشر ترجماتك وقصائدك فى الصحف، وتصدرها كتباً، رأيتك تختار فى الوقت الذى يناسبك من تريدها زوجة وتحسن الاختيار. أريد الآن أن أقول لك إنك كنت محقاً، كنت تعرف ما تريده وما تقدر على عمله. أنا مطمئن عليك».
يضيف: «لم أجد ما أردّ به. وإلى الآن، بينما أحكى لك هذا، تسرى قشعريرة فى بدنى كله. الآن أفهم أننى لم تكن لتعنينى شهادة كتلك من كائن على وجه الأرض لو لم أحصل عليها من أبى فى عصر ذلك اليوم البعيد من عام 2005. تلتْ ذلك سنوات صفاء قليلة، ولو كثرت لبقيت قليلة، إلى أن رحل أبى فى أواخر سنة الثورة. كثيراً ما أقول لنفسى إن أبى هو الحائل العظيم بينى وبين أن أرضى عن نفسى كأب لولدىّ. مهما بذلت من أجلهما يا أخى أظل أقول لنفسى: ليس بعد، حاول مرة أخرى، لم تزل المسافة بعيدة بينك وبين الرجل الذى كان أباك. صورته وهو يُجلِس خالى الميت بجواره فى السيارة لا تبارح خيالى، هذا رجل قادر حتى على مجالسة جثة ليؤدى واجبه ويفى بالتزامه. وهذا ما لا أظن أننى قد أقدر عليه يوماً».
أَجْلَسَ الجثة بجواره كأنها شخص حى
وراء إشارة شافعى إلى خاله قصة فارقة فى حياته. كانت «السبعينيات»، وهى بالنسبة له «عقد البهجة فى العالم»، قد انتهت دون أن يعيشها شافعى بوعى كافٍ، إذ ولد سنة 77، لكنه رآها مجسدة فى ذلك الخال: شديد الوسامة، غزير الشعر، الضاحك المضحك. حدث يوماً، ربما كما يليق بشخص يجسِّد جموح السبعينيات، أن استعار ذلك الخال دراجة نارية من صديق ليذهب بها إلى محافظة أخرى، ومات على الطريق. يحكى شافعى: «سمعت وصف أبى للمشهد، عثر عليه طريحاً وسط شجر، لم أزل أتخيل أنه شجر كافور صغير ونحيل مثلما ظهر فى أحلامى كثيراً. حكى أبى أيضاً عن شيخ أشفق على الشاب فنقل جثته بعيداً عن الطريق، وتدبر الاتصال بأهله. وحكى أبى أيضا المشهد الذى لا أنساه، قال إنه خشية أن تستوقفهم الشرطة، فتؤخر تكريم الراحل، أَجْلَسَ الجثة بجواره فى السيارة كأنها شخص حى».
سمع شافعى فى تلك الفترة للمرة الأولى تعبير «ابن الموت» الذى يوصف به الهائمون حباً فى الحياة، ويصف كيف ظل يستحضر صورة أبيه جالساً بجوار الخال الميت. يقول: «انتظرت لحظة «تحول» ما فى حياتى تنقلنى إلى طور «الرجل». ظل تصورى عن النضج أو الرشد أو الرجولة مرتبطاً بشىء كالقدرة على السفر مع جثة، بحدث جلل، بخبرة فارقة. شىء ما أقول لنفسى بعده: أنا الآن كبرت وأصبحت رجلاً. ولم يحدث ذلك. كل ما حدث أننى اكتشفت أن «الرجل» الذى أنتظر أن أتحول إليه ليس إلا طفلاً لم يعد الناس، لسبب يخصهم، يرونه طفلاً».
غيّرت تلك الوفاة عالم شافعى الصغير. كان عمر الخال عند وفاته 23 عاماً، فقسّمت شقيقاته عمره عليهن، وأخذت كل واحدة تقضى عنه الصلوات التى لم يصلها، وتصوم عنه ما لم يصمه. ثم اختفت من الجدران فى بيت شافعى لوحات الكنفاه التى كانت تحيكها أمه، ولم يحل محلها أى شىء، ولا حتى آيات من القرآن. توقفت إذاعة الشرق الأوسط عن ملء صباحات البيت بالبهجة، لصالح إذاعة القرآن الكريم. ولما حدث بمرور الوقت أن رجعت حياة كل من الخالات إلى ما كانت عليه، بقيت أمُّ شافعى مع إذاعة القرآن الكريم، وهو معها، يكتسبان مهارة تمييز أصوات المقرئين. ولم يتغير هذا إلا بعد سنوات، على عتبة المراهقة، عندما أضيف إلى هيامه بالمنشاوى هياماً موازياً بأم كلثوم وعبدالوهاب.
بإمكان القصص السابقة أن تعطى لمحة عن مصادر الكتابة لدى أحمد، لكننا فى احتياج إلى قصص أخرى لإكمال الصورة. كان شافعى ربما الطفل الوحيد فى العالم الذى يلحُّ عليه أبواه كى يلعب فى الشارع. يحكى: «لم ألعب فى الشارع لسبب يحلو لى أن أرجعه إلى حرصى على ألا أكسر نظارتى. كنت أعزف عن الألعاب الحركية عموماً، والمصادفات البحتة جعلت خالاً لى يرجع من العراق بكتب بديعة للأطفال من إصدارات وزارة الثقافة العراقية، أتذكر منها بشكل جيد كتاباً مصوَّراً بقصائد أحمد شوقى للأطفال، وآخر للشاعر سليمان العيسى، وكتابا آخر عنوانه «أبو أحمد والتمور». لم يستهلك أحد فى بيتنا هذه الكتب غيرى، ومبكراً جداً قرأت الروايات القليلة التى عثرت عليها وسط كتب أبى، ومنها روايات محفوظ التاريخية، ونسخة من الطبعة الأولى من «قصاقيص ورق» لصلاح جاهين و«رباعيات الخيام» بترجمة أحمد رامى. رأى أبى أننى لا أنزل للعب فى الشارع، فاشترى لى كتباً من «المكتبة الخضراء» وعشراً من روايات «المكتب رقم 19» لشريف شوقى، لكننى أيضاً كنت قد اكتشفت مكتبة المدرسة، وفى قرية مثل قريتنا لم تكن هناك مكتبة عامة إلا مكتبة المدرسة وكانت أكثر من كافية، وبخاصة فى وجود أمينات مكتبة، دائماً كن نساء، ودائماً كن طيبات معى وشديدات الحزم مع الآخرين، يحمين الكتب من أصابع زملائى الجاهلة ويقدمنها لى عن طيب خاطر، حتى الإنجيل عندما سألت عنه أمينة المكتبة وأنا فى ابتدائى جاءتنى به، لم يكن على الرف مثل بقية الكتب، جاءتنى به من خزانة، وفقط، كما أوضحتْ لى، لأننى أحفظ القرآن فهى لا تخشى علىَّ أن أقرأ الإنجيل، ولكننى لم أقرأه فعلاً إلا بعد سنين».

حين شاع فى العائلة أن شافعى أديب
بدأ شافعى يكتب حكايات وهو ربما فى الصف الثالث الابتدائى، وفى تلك السن المبكرة حقق أعظم ما يحلم به كاتب: جماهيرية مطلقة فى «صالة بيتنا». لم يعش لحظة نجاح ككاتب كالتى عاشها فى تلك الأيام، حين كان أخوته ينتظرون ـ بمثل اللهفة التى ينتظرون بها حلقة مسلسل البرادعى ـ الحلقة الجديدة التى سيكتبها أخوهم من «مغامرات عاصم وهادية» وهى تكاد تكون نسخة من «ألف ليلة وليلة» كما شاهدها فى التليفزيون. شاع عنه فى العائلة أنه «أديب» لدرجة أن جدته لأمه هنأته شخصياً بحصول محفوظ، باعتباره زميلاً، على جائزة نوبل. يقول: «ظللت لسنين مطالباً بنوبل فى الأدب. جدتى نفسها انتهزت الفرصة بعد سنوات قليلة لتؤكد مطالبتها لى بنوبل حينما فاز أحمد برادة بكأس العالم فى الإسكواش. قالت إنها تنتظر منى بطولة العالم فى الأدب».
مع حرب العراق والكويت كتب قصيدتين بالعامية كانت الموسيقى فيهما منضبطة إلى حد بعيد، لكنه تفرغ بعدهما مباشرة للمسرح الشعرى الفصيح، ولم يكن قد قرأ مسرحية شعرية أصلاً، وأيضاً جاءت مسرحيته الأولى فى أربع صفحات فولسكاب، مستوحاة من المأزق العربى بعد غزو العراق للكويت، وأقرب ما تكون إلى قمة عربية شعرية. اهتم أبوه بكتابته للشعر مثل اهتمامه بتحفيظه القرآن، فاصطحبه إلى مدرِّس فى القرية كان يعرف أنه شاعر وله كتب مطبوعة وسلمه له، فتعهده هذا المدرس بالرعاية منذ ذلك اليوم البعيد فى أوائل التسعينيات وحتى يومنا هذا. هو الشاعر والناقد الدكتور محمد السيد إسماعيل الذى ظل أستاذه إلى أن أصبح أستاذه وصديقه.
تعلم من مشاهدة التليفزيون ما يجعله يدين بالفضل فى تكوين جزء كبير من وعيه لمسلسلات أسامة أنور عكاشة المبكرة، وبرامج تيلى سينما ونادى السينما وأوسكار، والشيخ الشعراوى وندوة للرأى وحديث الروح. يقول شافعى إنه تعلم من التليفزيون والكتب ما يتعلمه غيره من الحياة والشارع، وربما لم يزل الوضع هكذا حتى الآن. يقول: «فى أولى ثانوى أهدتنى جدتى لأمى ترانزستور أحمر صغيراً سونى بعد أن أغناها عنه التليفزيون فأغنانى أنا عن التليفزيون. ارتبطت سنين بهذا المذياع الصغير. اكتشفت إذاعة البرنامج الثانى، الثقافى لاحقاً، وتقديم دكتور حسين فوزى للموسيقى الكلاسيكية، والمسرحيات العالمية التى أخرجها بهاء طاهر ومحمود مرسى وآخرون للإذاعة، اكتشفت برامج منتصف الليل فى إذاعة البرنامج العام، غواص فى بحر النغم لعمار الشريعى، وزيارة لمكتبة فلان لنادية صالح، وشاهد على العصر لعمر بطيشة، وصحبة وأنا معهم لآمال العمدة، وكتاب عربى علم العالم من إعداد الشاعر فوزى خضر، وبجانب الكتب طبعاً، كانت هذه جميعاً مصادر تثقيف حقيقية عالجت مشكلة ندرة الكتب وصعوبة الحصول عليها».
ليس ذلك فقط: «كان صدور أخبار الأدب إضافة أخرى. الملفات التى أعدتها الجريدة عن الأدب الصوفى مثلاً، وتحقيقات نهاية العام عن أهم الكتب الصادرة، وحوارات كتّاب الستينيات وشعراء السبعينيات، أرشدتنى إلى وضع مناهج للقراءة. أغلفة أخبار الأدب بدأت تثقيفى بصرياً وتعريفى بفنانين لم يزل بعضهم من الأثيرين عندى، بوتيرو، وماتيس، ومودليانى، وهوبر، كما منحتنى مجلة العربى مصدراً آخر، كنت أقص منها ومن مجلات زهيدة الأسعار جيدة الطباعة – مثل مجلة الكويت أو الصين الشعبية وغيرهما من الإصدارات النادرة التى كان تشق طريقها إلى الريف – صور لوحات لأعد كتالوجات لنفسى».
قصيدة مطوية فى جيب قميصه
عرف من أخبار الأدب أن فى مدينة شبين القناطر القريبة منه بيت ثقافة فيه ناد للأدب، وعرف موعد اجتماعه الأسبوعى، فذهب، بقصيدة مطوية فى جيب قميصه، لا بد أنه «فسكوز» على الموضة فى النصف الثانى من التسعينيات. (شاهدتُ صورة لأحمد يرتدى فيها «قميص فسكوز»، و«بنطلون بكسر» لا بد أنه استعطف الترزى ليزيدها بقدر المستطاع كما كنا نفعل جميعاً فى هذا الجيل لنباهى بها بعضنا البعض) هناك تعرف بالشاعر مسعود شومان. لم يجد فى «نادى الأدب المزعوم» شخصاً غيره فى ذلك اليوم. جلسا يتكلمان ويتعارفان، ثم انتقلا إلى المقهى، وفى آخر السهرة تصافحا والتفت كل إلى طريقه، ثم بعد أن افترقا ببضعة أمتار، ناداه شومان فالتفت إليه، صاح برقم هاتفه الأرضى، فحفظه شافعى. يقول: «ربما لا ألتقى الآن بمسعود إلا نادراً، لكننى لم أزل أحفظ رقم هاتفه الأرضى القديم، بأرقامه الست التى لا بد أنها زيدت رقماً».
صارا صديقين على الفور، رافقه إلى مقاهى وسط البلد، وتعرف على أصدقائه، كما عرفه شومان بالشاعر الراحل الكبير رفعت سلام فأتاح له تعلم بعض أهم دروس حياته فى الترجمة. عرَّفه شومان أيضاً بالراحل الكبير طلعت الشايب فعرض عليه شافعى قصائد ترجمها من الشعر الأفروأمريكى، وبدلاً من ملاحظات الشايب التى طلبها شافعى، فوجئ الأخير بترجماته منشورة فى «الديوان الصغير» وهو باب عظيم الأهمية فى «أدب ونقد» حين كانت من أهم الإصدارات الأدبية فى مصر. «كان مسعود شومان ولا يزال الصديق ابن البلد المحرِّض على العمل».
مضت الخطوات سلسة، تفضى إحداها إلى الأخرى، القصائد التى يترجمها للجرائد والمجلات تتراكم وتطالب بأن تتحول إلى كتب، الوقت الطويل الذى يضيع فى عمله الحكومى يضغط عليه كى يحسن استغلال سويعات الليل ليكتب ويترجم ما يعنيه، الإحباطات والتناقضات والتعاسات تتحول بسرعة إلى فن، فلا تتعفن بداخله. أصبحت القاهرة مدينة عمله وأصدقائه وحبيبته، وكل خيط كان يُضاف إلى الخيوط التى تربطه بهذه المدينة كان ينقطع من الخيوط التى تربطه بقريته. «حينما أرجع النظر أجد أن أغلب سعيى فى سنوات ما بين 99 و2005 كان هرباً من مصائر لا تحقيقاً لأهداف، كنت مرعوباً من أن أتحول إلى موظف فى هيئة الاستعلامات، أو إلى صعلوك فى وسط البلد. كنت أخاف أن يلهينى الضجيج عن الإنصات للصوت الذى يتردد داخل كل شاعر، الهمس الذى على الشاعر أن يرهف السمع كى يقتنصه. قصرت علاقتى بأصدقائى وبالمقاهى وبعالم وسط القاهرة كله على يوم، بل سويعات من يوم عمل عادى. واستطعت أن أصدر فى نهاية تلك السنوات خمسة كتب، ديوانى الأول «طريق جانبى ينتهى بنافورة»، وروايتى الأولى «رحلة سوسو»، وثلاثة كتب مترجمة ضمن المشروع القومى للترجمة».
ثم جاء تغيير..
حدث يوماً أن خرج شافعى غاضباً من مكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وكان سفيراً انتدب من الخارجية لرئاسة الهيئة، وشافعى ـ برغم صغر سنه نسبياً ـ كان أقدم الموظفين فى مكتبه. خرج من مكتبه غاضباً فكتب أول سيرة ذاتية فى حياته، لم يكن يعرف كيف تكتب أصلاً. فقط كتب بياناته وثبْتاً بأعماله المنشورة، وبعث السيرة إلى أهم الجرائد فى أربعة بلاد خليجية تَصوَّر أنه يمكن أن يعيش فيها، ولم تمض أسابيع إلا وقد تلقى عرضاً للعمل مترجماً فى جريدة عمان.
يحكى: «فاجأتنى مسقط بأنها حالة وسطى بين طحانوب والقاهرة. هى مدينة طبعاً، لكنها ليست بهمجية القاهرة. مدينة لكنها جميلة. مدينة لكن لها قلب. مدينة بوسعك فيها أن تنفرد بنفسك دون أن يكون ذلك بين أربعة جدران. منحتنى مسقط العزلة بلا كفاح من أجل العزلة. وفيها، استعدت علاقتى بالهواء الطلق بعد تنفس الهواء المستعمل فى القاهرة لسنوات. وبرغم أى عناء مما يعرفه المصريون، بالذات، بسبب الغربة أبقى مديناً لمسقط بأنها أتاحت لى كل وقت الدنيا لأقرأ وأترجم وأتعلم، ولأتواصل مع جنسيات كثيرة، فتغيَّر فى وعيى الكثير. لعل من أهم الدروس التى تعلمتها فى مسقط درساً سيجعلنى إلى أن ألقى الله لا أنظر إلى شخص باعتباره ممثلاً لبلد أو لعرق أو دين، وألا أقبل أبداً بمقولات عامة تنتقص من جماعة من البشر. فقدت بذوراً لشوفينية مقيتة كانت مغروسة فى نفسى فبت أمقت حتى ذكراها. تكسرت لدىَّ الصور النمطية الشائعة عن «الخلايجة» مثلاً، أو «الهنادوة»، وهذا أمر شديد الأهمية لا أغالى إذا قلت إنه يصلح حكماً على إنسانية أى إنسان».

دقة أيوب
بعد سنوات شارفت على العقد، عاد شافعى إلى القاهرة: «لا أعتقد أن شيئاً جوهرياً تغيّر فى حياتى خلال السنوات السبع الماضية منذ رجوعى إلى القاهرة. لم أزل أقضى أغلب وقتى فى العمل، وبقيته مع أسرتى. أتواصل مع أغلب أصدقائى عبر فيسبوك وما يماثله. طبعاً صرت أقرب إلى أصدقائى فى مصر، لكن لقاءاتنا نادرة للغاية. وهذا لا يمثل مشكلة حقيقية حينما تكون الصداقات نفسها حقيقية. صدقنى حينما أقول لك عن إن إيمان مرسال مثلاً، وهى من أثمن الصداقات فى حياتى، إننى أعرف أخبارها أولاً فى أحلامى، ثم أتثبت من صحة هذه الأخبار عبر رسائل نتبادلها، أو مكالمات أحياناً. كذلك لا ألتقى بكرم يوسف كثيراً، فقد تمر أسابيع دون تواصل، لكننى بطريقة غريبة حقاً لم أبحث لها أبداً عن تفسير، أجدها حاضرة فور أن يلزمنى صديق أبوح له بما يثقلنى. يفاجئنى اتصال منها، أو رسالة. وحتى تامر الصباغ، برغم صداقة عمرها أكثر من ربع قرن، لا أكاد أقابله أصلاً، لكننا معاً طوال الوقت بطريقتنا التى نعرفها. حتى أنا وأنت، فقدنا فى الوباء وتيرة لقاءاتنا المنتظمة، ولكننا لم نفقد حوارنا القائم منذ سنين قبل هذا الـ«حوار» وبعده وبغض النظر عنه».
لكن المفاجأة الكبيرة التى وجدها شافعى فى انتظاره بعد سنوات عمان هى عماد أبو صالح: «لم نصبح، عماد وأنا، صديقين إلا بعد عودتى للاستقرار فى مصر. قابلته مرة واحدة قبل سفرى فى 2005، وفى حين أتذكر تلك المقابلة تماماً، فإن عماد لا يتذكرها نهائياً! علاقتى بعماد فريدة بحق. هى ليست صداقة وحسب. كلمة الصداقة للمرة الأولى فى حياتى تبدو قليلة. علاقة فيها الأبوة، وفيها الأخوة، وفيها الزمالة. لا نلتقى كثيراً، ليس كل أسبوع مثلاً، ولا نتكلم كثيراً، ليس كل يوم، لكننا بمعنى من المعانى، لا نتوقف عن اللقاء. عماد أصبح القارئ الذى أتصوره وأنا أكتب، أو أترجم، ولا أرضى عن عمل لى ما لم يجتز امتحان قراءته. وأهم من ذلك أن الأمر يتجاوز أسئلة الكتابة والقراءة إلى أسئلة الحياة، الحياة اليومية، والوجود، يتجاوز علاقة كاتب بكاتب، إلى رفقة ومحبة بين إنسان وإنسان».
إذا كان شافعى قد تعلَّم شيئاً عبر سنوات عمره – التى جاوزت الأربعين – فهو أننا مساكين. وإن بدا هذا بسيطاً جداً، وقليلا، قياساً إلى رحلة إنسان فى الحياة. احتاج وقتاً طويلاً ليعرف أن كل إنسان، كل إنسان على وجه الأرض، يغلق فى نهاية اليوم عينيه على حقيقته العارية، على رفقته التى لا مهرب له منها، على خطاياه التى لا يعرفها غيره، ونقائصه التى لم يطلع عليها سواه. يسأل: «من الذى يمكن أن يفوز بجائزة أحط إنسان بين بنى البشر؟ هتلر مثلاً؟ هولاكو؟ لعل أهم ما تعلمته إن كنت قد تعلمت شيئاً من كل ما خبرته فى حياتى فهو هذا: أن أكره أعمال هتلر، وأشفق على هتلر. أشفق عليه لأنه، مثل كل إنسان آخر، بقى حتى اللحظة الأخيرة من حياته يخفى بكلامه وأفعاله وحركاته وسكناته حقيقة أنه لم يزل يبكى منذ خروجه من رحم أمه، يخفى حتى عن نفسه أنه لم يزل يعانى تلك الصدمة، لم يزل يعرف فى قرارة نفسه أنه صغير جداً على أن يكون وحده هكذا فى مكان غريب كهذا الذى اسمه الدنيا».
يتميز شافعى فى عمله بالدقة، وهذه الدقة وراءها صبر أيوب، فلا يمكن أن يرضى عن شىء لمجرد أنه بذل فيه جهداً كبيراً أو مضنياً، لا يمكن أن يقبل بأول نتيجة، أو حتى بالنتيجة العاشرة إن لم يشعر بالألفة معها، بأنها أقرب شىء يستطيعه إلى الكمال، يحكى: «كنت دون السادسة حينما قرأت سيرة ذاتية قصيرة لأحمد شوقى، وحفظتها مثلما حفظت قصائده للأطفال. ثم حدث فى الثانوية العامة أن درست كتاب د. شوقى ضيف عن أحمد شوقى، ووجدت العالم الجليل يثبت لأمير الشعراء سنة ميلاد غير التى حفظتها وأنا ولد صغير. وصدقنى: صعب علىَّ كثيراً أن أقبل صواب شوقى ضيف بديلاً لخطأ طفولتى. وهذا تحديداً ما يجعلنى أشقى قبل أن أنشر، محاولاً قدر استطاعتى أن أضبط لغتى وأوثِّق معلوماتى، خوفاً على طفل صغير لعله فى قرية بعيدة يقرأ ما أكتبه ويثق فيه باعتباره «الحقيقة». خوفى من سلطة الكلمة المطبوعة على كثير من الناس هو سر كل الوسوسة التى تسيطر علىَّ».
بصحبة كائنات مسحورة وأم كلثوم
يستيقظ أحمد فى الفجر تقريباً، يستمع إلى أحد أحبَّته من الشيوخ، الحصرى، المنشاوى، البنّا، ثم يبدأ الترجمة، هائماً بين أرض غير الأرض، وسماء غير السماء، وبشر غير البشر، يعيش مع كائنات مسحورة، ويواجه مع أبطال مؤلفين غيره أهوالاً، ويدخل معهم مغامرات، وقد يتعذب ساعات ليجد معنى هارباً، أو ليصطاد تشبيهاً، أو ليشعر بأن الرائحة فى هذه الكلمة هى رائحة زقاق فى حى فى مدينة فى بلد فى قارة بعيدة، ثم يمنح نفسه بعد ساعات من المشقة مكافأة، تبلغ ذروتها فى أكلة سمك، وأغنية لأم كلثوم، وقيلولة لا يمكن لبشرى أو جنىّ أن يوقظه منها، إذ يغلق هاتفه، ولو قامت القيامة فلن يعرف إلا حينما يستيقظ. لكن شافعى لا يخلو من غرابة، فقد يستيقظ متضايقاً، غاضباً، وحانقاً، وساخطاً، على كل شىء، على أوضاعه، وربما على أوضاع البشر، وهو شديد الحساسية فى التعاملات، ولا يقبل أبداً بخدش احترامه، حتى وإن بدا للبعض أنه يبالغ، وبسبب شىء بسيط للغاية، موقف عابر، كلمة عابرة، وربما إيماءة لم يحبها، قد يصيبه اكتئاب مزمن.. فيبتعد، وتبدأ الهواجس فى محاصرته، عن الفقد، خاصة فقد الأصدقاء فى خلافات الحياة العادية. يقول: «أظن أن الوضع الطبيعى للإنسان هو أن يكون غاضباً، أو لنقل رافضاً. فى علاقتى بالناس، ابتداء بأقربها وانتهاء بالمارة الذين أراهم أو يروننى، أعرف أننا جميعاً مؤقتون فى حياة بعضنا البعض، وأتصور أننا لا ينبغى أن نترك أثراً سلبياً. حين أشعر أننى عبء، أو أن أحداً يمثل عبئاً على روحى، أو يشتتنى عن نفسى، فإننى أبتعد. ولا أجد غضاضة فى أن يفعل الآخرون هذا معى. وأدين بفضل عظيم للنسيان، طبعاً هناك أوجاع تصطفيها الذاكرة وفق قوانين تعلمها هى ولا أعلمها، لكننى بصفة عامة أنسى. وصدقنى، بعد فترة لا تتجاوز الأشهر من انقطاع علاقى بشخص، لن أجد ما أجيب به لو سُئلت عن سبب هذا الانقطاع. أنسى فعلاً. لا يبقى فى ذاكرتى إلا علامة إكس على صورة الشخص، وطبعاً تكون العلامة بالأحمر».
هو كذلك صريح، بل إنه حاد فى صراحته، حاد فى آرائه، وإن كان أغلبها دقيقاً ومبنياً على قراءة صادقة، لا على ضغينة، أو مواقف سلبية من أصحابها. وهو لا يتوقف عن إبداء رأيه فى الكتابة الرديئة، بل يبدو أحياناً كمن يوفر طاقته فيقرر أن يعلن رأيه مرة واحدة فى جماعة كاملة من الكتاب الرديئين من باب توفير الوقت والإنجاز!
حدث أن استيقظتُ – ذات صباح – ووجدت ما يشبه رائحة شياط على الفيسبوك. كان هناك كثير من الشاعرات الغاضبات، يتوعدن شخصاً ما بالحرق، وعبثاً حاولتُ التوصل إلى اسم الشخص المقصود من التعليقات، فاتصلت بشافعى، وحدثته عن ثورة الشاعرات على شخص ما، وسألته بسذاجة: «تعرف يقصدوا مين؟!» فقال ضاحكاً: «أنا». لكنه لا يتذكر سبب تلك الواقعة. يقول: «لعلى على الأرجح كتبت شيئاً عن ندرة الشاعرات فى تاريخ الشعر العالمى. أو ربما تجاسرت وقلت رأياً فى فروغ فرخزاد مثلاً. لا أتذكر فعلاً. لكن ما لا أنساه هو أن قصائد لشمبوركسا وإيميلى ديكنسن وتسفاتييفا وأخماتوفا مهمة لى شخصياً بغض النظر عن أن كاتباتها نساء».
متعة أن تقول لأحدهم: يا ردىء!
هناك انطباع بأنه عدو للمرأة، لكنه لا يفرق فى آرائه بين الجنسين، وقد صار قلمه الأحمر علامة رعب لبعض الكتاب، إذا وضعه مفتوحاً بجوار رواية أو ديوان أو كتاب فى صورة على فيسبوك فهذا يعنى أن صاحبه سيتعرض لحقنة سامة، وهو لا يلقى بالاً للمحاولات العكسية للتقليل مما يفعله، ومحاولة الإيحاء بأنه «مصحح»، لا ناقد، وأنه يحاول أن يصير «بعبع الكتّاب»، لكنه حين يرى من يلمزه بمثل هذه الأوصاف لا يكف عن الضحك، محققاً متعة أخرى، بخلاف متعته الأساسية فى أن يقول للكاتب الردىء: «يا ردىء»!
يقول شافعى: «ليتنى كنت أمتلك من المعرفة والعلم ما يؤهلنى لأن أكون مصححاً. أنا للأسف لا أمتلك حيال اللغة إلا ذائقة تكونت من حفظ القرآن فى طفولتى. استعمالى للقلم الأحمر مجرد تفضيل شخصى، لا علاقة له بقلم المعلمين، أحب وأنا أقرأ أن أترك فى كتبى علامات واضحة، وليس أوضح من الأحمر، أحب أن أشير إلى عبارات جميلة، وأفكار جديرة بالرجوع إليها، وأتصور أحياناً أن هذه العلامات هى الإرث الوحيد الذى سوف أتركه لأبنائى. أشير أيضاً إلى الأخطاء، وأصححها أحياناً فى الهوامش، أخطاء النحو والإملاء، والعبارات الركيكة. أحاول أن أحمى ورثة هذه الكتب من اعتياد الخطأ. صدقنى حينما أقول لك إننى أعتبر الإسراف فى الخطأ إهانة شخصية لى. مرة أرسلت لى صديقة مخطوط قصة وبدأت أقرأها، وأنا مخلص جداً عند قراءة المخطوطات، وبعد بضعة سطور مليئة بأخطاء النحو واللغة بعثت أقول لها: إذا كنت أنت غير مهتمة بقصتك فلماذا تتوقعين أن أهتم أنا بها؟ وفعلاً، إذا كان إهمال الكاتب عدم مبالاةٍ بى كقارئ، فكيف ينتظر منى أن أقابل إساءته هذه بالصمت؟ رأيى أننا بحاجة كأدباء إلى أن نقسو قليلاً على كتب بعضنا، لأنها أصبحت تِكْسف».
والآن يمكنك أن تتخيل شافعى فى مشهد من فيلم كلاسيكى، بطلاً يمسك وردة، ينتزع بتلاتها واحدة تلو الأخرى، لكن عليك أن تحذف الوردة فى مشهدنا الواقعى وتضع بدلاً منها رواية. فهذا ما حدث بالفعل. ذات يوم قرر كما يفعل بشكل روتينى أن يقرأ رواية جديدة، قرأ صفحة أو اثنتين، ثم شعر بخفقان زائد عن الحد، وضربه التوتر، ولم يهدأ إلا حينما استقر على الطريقة المثلى لقراءة تلك الرواية: أن يقطع كل صفحة يقرأها ويرميها فى سلة القمامة، وحين ينتهى من القراءة لا تكون هناك رواية. لكنه لم يستطع أن يكمل منها إلا نصفها، ولا يزال النصف الناجى منها فى مكتبته إلى الآن، يستقر مائلاً مثل شخص معطوب نصف عارٍ وسط أشخاص موفورى الصحة لامعى الأغلفة!
اختفى مع رواية
ابتعدنا عن رواية شافعى مع أن حوارنا انطلق منها، أقول له ذلك فيبتسم، منتظراً على ما يبدو أى تسديدة منى ليصدَّها كحارس مرمى محنك!
حينما كتب شافعى «لماذا لا تزرع شجرة» كان فى أحد اختفاءاته، التى يخمن أصدقاؤه خلالها أنه ربما يصارع أفكاراً مقبضة عن الحياة والموت والخسة وفقدان الأمل واحتكار السعادة والاستيقاظ هلِعاً. لكن تبين أنه كان مختفياً مع رواية. جاءت روايته مثل صرخة غضب، أكثر منها صرخة خوف، رغم أن بطلها كامل كان مقيداً كحيوان فى كرسى، لا يستطيع حتى تحريك مقعدته، أو التبرز إلا بمساعدة خاطفه، ووضع كهذا جعلنى أغلق الرواية بعد صفحات، شاعراً بالاختناق، متخيلاً نفسى على كرسى مكبلاً بأغلال ثقيلة تلتف كثعابين حول جسدى.
تخيلت أن شافعى نقل إلينا ما كان يشعر به، لكن تصورى كان خاطئاً: «لم يراودنى هذا الإحساس بالاختناق وأنا أكتب، لكنه راودنى ومنعنى من قراءة روايات من قبل، لأسباب مماثلة للإحساس بالاختناق، صعب علىَّ أن أقرأ روايات مثل «المسخ» لكافكا أو «الغريب» لكامو، وللسبب نفسه تصعب علىَّ مشاهدة أفلام بعينها. لا يبارح ذاكرتى مثلاً دفن البطلة حيّة فى فيلم لتارنتينو. لذلك ألتمس كل العذر لقارئ قد يعجز عن إكمال روايتى لسبب مماثل، رغم أنى أتصور أن النص عندى حرص على الانتهاء من لحظة الخطف وتفاصيله بسرعة فى صفحات الرواية الأولى، وربما هذه نقطة ضعف، أقول ربما كان ينبغى إرجاء هذا الوصف، أو توزيعه على امتداد الرواية. برغم هذا، كل من كلمنى عن الرواية قال إنه أنهاها فى جلسة قراءة واحدة، فهل هذا حدث برغم الإحساس بالاختناق، أم أنه ينفى الإحساس بالاختناق أصلاً؟ أعتقد أن هذه ستكون إجابة كل قارئ».
واحدة من الأمور الخطيرة فى الرواية كذلك أنها لا تعطى أى إحساس بالأمل، كأن شافعى قرر أن تكون روايته متاهة كاملة، أو كابوساً خانقاً، لكنه مرة أخرى لا يوافقنى. يقول: «أتذكر كتاباً حوارياً قال فيه نجيب محفوظ لغالى شكرى: إياك أن تقول إننا باعة أوهام. الحقيقة لا أتذكر السؤال أو السياق، لكنى لا أنسى هذه الجملة، ولا أكف عن الاستعانة بها. مع ذلك، لست متأكداً من أن الرواية متشائمة، أو تغلق باب الأمل. ما أعرفه يقينا أنها تقول لكل إنسان إن عليه أن يمنح الأمل لنفسه، أن يكون الإله الذى ينبغى أن يكونه أو يبقى عبداً. ما حدث لكامل فى ظنى فرصة قلّ أن ينالها أحد. كان فى يد الخاطف الغاشمة حنان ما حين أتاح له فرصة التعرف على قيوده، أعنى قيوده الحقيقية من وجهة نظره، أى كامل، ومن ثمّ التخلص منها إن شاء. أما المتاهة فلا. فى ظنى أن فضيلة هذه الرواية بالنسبة لى كإنسان هو وضوحها. تسميتها الأشياء بأسمائها، وأنها لا تصنع متاهة بقدر ما تفضح وجودها».
أقول لشافعى إن الأدب يجب ألا يتخلى عن دور أو وظيفة ولو ثانوية، وقد تكون تلك الوظيفة البدائية هى منح ذلك الأمل فيرد: «لا يجب فرض أى وظيفة على الأدب، إلا أن يوجد، أن يكون إضافة للمخزون الإنسانى من الجمال، لكن يمكن أن أقول إن فعل كتابة الأدب فى ذاته جدير بأن يمنحنا الأمل. مجرد اقتطاع إنسان بعضاً من وقته وطاقته وروحه لممارسة عمل لا جزاء له إلا نفسه كأنه الصلاة، هذا ينبغى أن يمنحنا الأمل، فى عالم لا يعترف للأشياء بقيمتها ولا يعرف لها إلا أثمانها، ينبغى أن ننظر إلى فعل إنتاج الأدب بكتابته وبقراءته لا باعتباره وسيلة فقط لمنح الأمل بل باعتباره أداة يقاوم بها الإنسان تسلط القبح».
أسأله عن اللحظة التى خطرت له فيها فكرة الرواية: «اللحظة واضحة تماماً فى ذاكرتى. وجدت نفسى، فى سكون ليلة من رمضان، أتمتم بنص السؤال المتكرر فى الرواية. ربما كان سؤالاً منى لنفسى. أظن أننى كان ينبغى أن أحار حيرة «كامل» لولا أننى لم أكن مخطوفاً ولا مقيداً ولا مهدداً، على الأقل بالمعنى المادى للخطف والتقييد والتهديد. خرجت على روتينى المقدس فى ليالى رمضان، وبدأت أكتب، مثلما تُكتب قصيدة لا كما تُكتب رواية، بلا ملامح لحبكة، بلا معرفة لشخصيات ناهيك عن تاريخها ومآلاتها. كنت أكتب باندفاع، ولليالٍ متتابعة، مضيت أتعرف على كامل وأتوحد به وأتكلم باسمه. أصدق ما يمكن أن أقوله عن كتابة هذه الرواية هو ما قلته للتو: أنها كتبت مثلما تكتب قصيدة».
بطل كافكا فى «مستعمرة العقاب» كان يشاهد آلة التعذيب، ويستمع إلى شرح لما ينتظره من عذاب من خلالها، وقد كان هذا مخيفاً، لكن الأكثر إخافة، الأكثر رعباً، هو ما حدث مع بطل شافعى إذ لم يعرف ولم نعرف نحن أيضاً – فى أى لحظة – مصيره، لكن شافعى ينفى أن تكون روايته قد حاولت أن تضخّم الخوف أو أسبابه، لكنها «حاولت أن تقول ببساطة إن الجميع مقيدون ومختطفون ومهددون من قوة تبقى مجهولة إلى أن يواجه كل منا نفسه مثلما واجهها كامل. لم يعرف كامل شخص خاطفه المحدد، وربما لن يعرف أحد منا خاطفه، لكن كامل عرف ما أرجو أن أعرفه أو يعرفه قارئ الرواية، عرف كيف يمكن أن يتحرر، لا من عذاب واضح وجسدى ويتعلق بالألم المباشر والدم كما هو الحال فى مستعمرة العقاب، لكن من عذاب برىء وجميل براءة وجمال أبناء كامل وزوجته وأمه. طبعاً لا أقترح على أحد أن يجرب التحرر من القيود على طريقة كامل، لكن لا بد أن هناك طريقة تناسب كل شخص، أو هذا ما أعزى به نفسى».
تمنح الرواية الخاطف قدرة على التحكم بالطبع، وتمنحه كذلك صفات كبرى، كالإلمام التام بما يدور فى عقلية البطل، كأنه عالم نفس قدير، تمنحه كذلك قدرة واسعة على الخيال والتجريب، حتى وإن كان تجريب طرق جديدة للتعذيب. يستمع شافعى ثم يقول: «أظن أن خفاء هذا الخاطف هو أوضح صفاته وأهمها فيما يعنينى، وهى الصفة التى يمكن أن ترفعه عن بشريته وتجعله، فى قراءة ما للرواية، أقرب إلى قوة مهيمنة، ميتافيزيقية حتى، منه إلى إنسان. كل الصفات الأخرى التى قد يوصف بها الخاطف تكشف شخصية القارئ أو المخطوف أكثر مما تكشف شخصية الخاطف. هى تصورات القارئ أو كامل عن القوة والسلطة ولا ينبغى أن تكون بالضرورة تصورات صحيحة. الأمر أقرب ما يكون إلى تصورات المؤمنين بإله عن هذا الإله. السلفيون مثلاً فى الإسلام يرون الله من خلال الجنة والنار، العصا والجزرة، يعبدون الله خوفاً ورجاء، وهذا مشروع طبعا ومفهوم. غيرهم، الصوفية مثلاً، لا يرون الله بهذا الشكل، فهم يعبدونه حباً، يرونه جديراً بالمحبة والعبادة وإن لم يعدهم بجنة أو يخوفهم بنار. هذا هو الفارق بين نفس ونفس، بين إنسان يؤمن بأنه مخلوق من طين وإنسان يؤمن بأنه نفخة من روح الله».
تُنزع الخصوصية عن بطل شافعى مثل شخصيات بازولينى التى أُجبرت فى بعض الأحيان على أكل الغائط. يقول شافعى: «أتفهم تماماً النفور من مشاهد التغوط والتبول فى الرواية، لكنها فى تقديرى شديدة الأهمية. فعندما أستعيد الرواية الآن لا أكاد أتذكر غيرها يؤكد أن جريمة اختطاف قد ارتُكبت. مشاهد الإطعام أيضاً تؤكد أن الجريمة وقعت. وهذا ما يجعل حكاية الخطف أكثر من مجرد وهم توهمه كامل. ربما لم تسعفنى صنعة الروائيين المحترفين، وأنا لا أرى نفسى روائياً محترفاً، فأحقق هذا الإيهام بمزيد من الحيل أو بحيل أخرى. كنت بحاجة أيضاً إلى أن أضع «كامل» فى موضع يرى فيه قدر الإهانة الذى يتعرض له عسى أن يغضب ويقلع غماه بتعبير صلاح جاهين ويرفض يلف».
حكيت لأدهم ورامة عن بطلى
لم أحب اسم بطل الرواية «كامل» فقد بدا كأن شافعى أراد أن يحقق معنى مباشراً وعكسياً من خلاله مثل «النقصان». يقول: «لم يكن بطل الرواية، كما لا يخفى عليك، يحمل اسم كامل. عندما خطر لى السؤال المتكرر فى المرة الأولى خطر لى باسمك أنت، فقد كنا دائمى التواصل فى تلك الفترة. وظلت الرواية تحمل اسم «حسن» حتى فى عنوانها وبهذا الاسم قرأها مراجعى الثلاثة، أنت وعماد أبوصالح وتامر الصباغ. وعندما اطمأننت منكم على أن بين يدى رواية يمكن أن يتلقاها غيرى بدأت أقرأها فعلاً كما قد يقرأها غيرى، ورأيت أن أسخر بطريقتى من البطل، فسميته على سبيل التهكم باسمه هذا الذى تناقضه شخصيته. عندما سألنى أدهم ورامة عن كتابى الجديد حكيت لهما بينما أعد القهوة موجز هذه الرواية فسألانى عن رأيى فى كامل الذى لم يرجع فى النهاية إلى بيته وأولاده. وجدت نفسى أقول لهما ببساطة شديدة إنه شخص غير ناضج، وأوضحت: كان عليه أن يجد حريته دون أن يخلَّ بواجباته».
كانت رواية شافعى مغرية بأن تكون أكبر حجماً، لكنه لم يمنح كثيراً من شخصياتها حق التكلم. يقول: «هيمنجواى قال إن «الشيخ والبحر» كان يمكن أن تُكتب فى مثل حجم «موبى ديك»، وبالمثل كان يمكن أن تُكتب هذه الرواية فى أضعاف حجمها هذا، لكن بصيغة أخرى، أكثر اتساقاً مع أعراف الرواية التقليدية، وربما كانت فى نسختها المحتملة هذه لتحقق مزايا مهمة تنقصها فى نسختها الحالية، منها مثلاً، وفى المقام الأكبر، كما أشرت، أن يتكلم الآخرون. الأم والزوجة والأبناء وكل الذين أخرسهم كامل لينفرد وحده بالحق فى الكلام، لكنها كانت ستصبح رواية أخرى غير هذه الرواية التى منحتنى على المستوى الشخصى فرصة أن أرى العالم كما لم أره من قبل. والرواية على حجمها الصغير هذا أتاحت لى أن أتكلم عن الشجر وملامح الثمانينيات والتسعينيات وأن أستعرض بعض أفكارى عن الترجمة، وعن مؤسسة الزواج، حتى أنك يمكن أن تقرأ هذه الرواية من خلال كليشيه «الرواية ديوان العرب» سيئ السمعة عن حق، أو كليشيه «الأدب مرآة المجتمع»، الأسوأ سمعة، والأحق بسوء السمعة، فترى فيها تأريخاً ما لأسرة مصرية على مدار العقود الأربعة الماضية».
تبدو الرواية وكأنها تقول إن جميع البشر يتحولون إلى طغاة لو أتيحت لهم الفرصة، بدليل أن «كامل» نفسه تحرش فى صباه بفتاة معاقة، فهل هذا صحيح؟ يجيب شافعى: «لعل الإجابة الآمنة لهذا السؤال هى: نعم، كلنا جناة، وكلنا أبرياء. كلنا طغاة فى انتظار الفرصة. لكن صدقنى، صرت فى السنين الأخيرة جداً أكثر ثقة فى البشر، برغم أن كل ما يحيط بى يجب أن يدفع إلى العكس. صرت أحب أن أطمئن نفسى إلى أن فى هذا العالم أخياراً، لكن مشكلتى أننى لا أقابل غير أصحابى».
يضحك شافعى وأضحك. شافعى لا يفوّت فرصة للسخرية، ولو من نفسه ومن أصدقائه، لكن الفرصة هذا المرة سنحت لى أنا كى أسأله عن أصدقائه الذين قد يكتب عنهم أحياناً جملاً غامضة، أو واضحة، على فيسبوك، يبدو فيها كما لو أنه يوبِّخهم، يضايقهم، أو ليقول لهم جميعاً إنهم لم يعودوا أصدقاءه.
يقول: «تعلم أننى توقفت عن هذا، لأننى لم أحتمل أن يسىء أصدقائى فهمى. ومع ذلك، أستطيع أن أفكر أمامك الآن: هل فعلاً فقدت إيمانى بالصداقة؟ الحقيقة أنه بدا لى فى السنوات القليلة الأخيرة أنى فقدت الثقة فى الكثير. والثمين. فى أعمدة سبق أن قامت عليها حياتى فعلياً. الحب يا رجل نفسه أصبحت أنظر إليه فى شك. أظن ما يمكن أن أقوله هنا هو أن كثيراً من الخطابات الشائعة حول الحب والصداقة والأمومة والأبوة، وكذلك حول الوطن، فقدت صلاحيتها لدىَّ. أظن أن ما أكتبه طعناً فى الصداقة أو الحب، هو فى الحقيقة طعن فى الخطاب المؤسس لها أو له. ما أفعله فى ما آمل هو أننى على المستوى الإنسانى الشخصى بت أتأمل كل علاقة وحدها، وأقدِّرها وحدها، دون أن أثقلها بلافتة تضيِّقها أو تفرض عليها غاية أو غرضاً، دون حتى أن أسميها. لكن الحقيقة أننى شخص محظوظ بأصدقائه أو هكذا ظننت لأغلب عمرى. لم يكن لى أبداً أصدقاء كثيرون فى أى مرحلة، لم يتجاوز العدد أبداً أصابع اليد الواحدة لكنهم كانوا دائماً يغنوننى. وطبعاً، على مدار السنين، هناك خسارات، لكن بلا حسرات».
يعيش شافعى غالباً خلف قناع المترجم، وربما يضطر إلى تقديمه على كل الوجوه الأخرى، لأنه يمثل مصدر الرزق، ونادراً ما ستجد له حواراً عن الشعر أو الرواية، مع أنه شاعر وروائى مهم، كأن ظهوره للنور بوجه الكاتب يمكن أن يسبب له ضرراً نفسياً، أو كأنه اعتاد على قناع المترجم – وهو مترجم مرموق بالمناسبة – ونسى بسببه كل شىء، وهو يصدر الديوان أو الرواية ويمنح نسخاً لأصدقائه المعدودين ثم يختفى، فلا حوار، ولا ندوة، ولا حفل توقيع، وإن حدث وظهر فى مناسبة فإنه يظهر تحت إلحاح ناشره وأصدقائه، ويجلس طوال الوقت مكفهراً كأنه طفل أجبر على الذهاب مع أسرته إلى حفلة أو مكان لا يحبه. يقول: « يزعجنى كثيراً فى الندوات أنى أرى الكتَّاب يتنافسون، أيهم الأذكى، أو الأعمق. وفى رأيى أن المناقشة الطبيعية الصحية لكِتاب مكانها المقالة. فأمام الصفحة البيضاء تكون الفرصة أكبر لمحاورة أفكار الكِتاب وتحليلها، والاحتكام إلى ما كان يُعرف يوماً بالضمير. أما حفلات التوقيع أو أى أنشطة اجتماعية أخرى تتعلق بالكتب، فأشبه بحفلات الطهور والسبوع، أقبل وجودها، لكننى منذ طفولتى أتحاشاها. وقد حدث أن أقيمت حفلة توقيع لكتاب لى قبل سنوات، لكننى لم ولن أكرر التجربة»..
ولا يجد شافعى أى ضرر نفسى فى أن يظهر كشاعر وروائى. فكثير من نجاحه كمترجم أصلاً سببه، كما يقول، أنه كاتب، وينظر إلى الأمر بهذه البساطة: «أنا لم أبذل أى جهد ليثق البعض فى ترجماتى عدا جهد الترجمة العادى نفسه. ولن أبذل جهداً لأنال شيئاً لنفسى كشاعر أو روائى إلا أن أكتب قصائدى ورواياتى وأعمل على إتاحتها للناس، وهى وحظها. سأظل أطيع نفسى فأعرض عما أنفر منه، وأُقبل على ما أحبه، ولن أرغم نفسى على شىء».
أسأله عن كلمة تلخصه فيجيب: «الانتظار. أنا فى حالة انتظار دائم. أنتظر أن أرضى عن نفسى. أنتظر أن أجد إيمانى ماثلاً فى كل أعمالى. أنتظر أن أمتلك من القوة ما يجعلنى أسدد ديونى، فأعتذر لمن ينبغى أن أعتذر لهم». وأسأله إن كانت هذه الإجابة تمثل طموحه فى الحياة والكتابة فيقول: «فى الحياة ربما. أما فى الكتابة فلا. أنا لا أكتب لأعتذر. أكتب لأفهم ما لم أكن لأفهمه لولا الكتابة. ولأجد جمالاً لا أعثر عليه بطريقة أخرى. ولأن الكتابة هى الحيلة الوحيدة التى أعرفها لزرع شجرة».