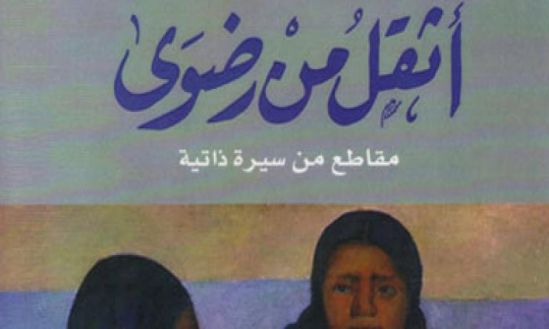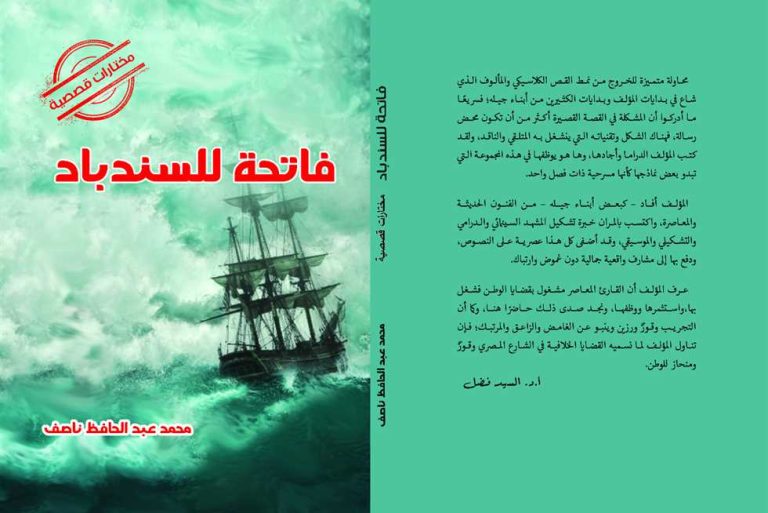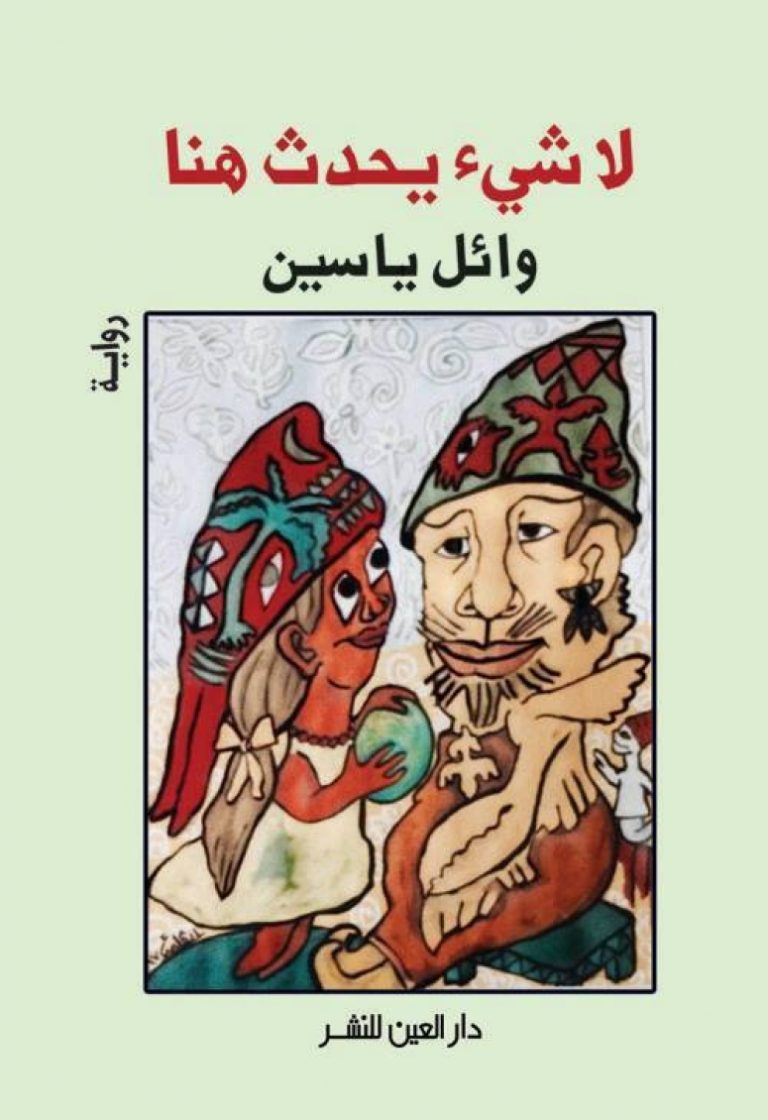في عملها الإبداعي الأحدث تواصل رضوى عاشور مشروعها الإبداعي في المقاومة بالكتابة واستعادة إرادة منفية. في تلك المقاطع من سيرتها الذاتية تقول الكاتبة: (قلت ذات مرة إن كل كتاباتي الروائية محاولة لاستعادة إرادة منفية. أنهيت رواية “ثلاثية غرناطة” بعبارة: “لا وحشة في قبر مريمة” وعلقت في محاضرة لي على ذلك قائلة: “ثلاثية غرناطة لها طعم المراثي، يسري فيها خوف امرأة من القرن العشرين دارت عليها وعلى جيلها الدوائر، فشهدت نهايات حقبة من التاريخ هو تاريخها. ولكن التاريخ لا يعرف الخوف، إنه صاحب حيلة ودهاء، له مساربه ودياميسه ومجاريه لا شئ يضيع، هكذا أعتقد. ولذلك أفهم الآن لماذا تنتهي بوصف قبر مريمة). على مدى ثلاثة وثلاثين فصلًا ومايقرب من أربعمائة صفحة تواصل رضوى عاشور المقاومة بالكتابة، وتعلن الحرب على كل ما يحاول أن يصادر إرادة البشر أو ينفيها، سواء على المستوى الشخصي الذاتي أو المجتمعي العام.
يُستهل السرد بحكاية المحامي الشاب “مصطفى عاشور” وزواجه من “ميّة” ابنة الدكتور “عبد الوهاب”. وبعدها تنتقل” الكاتبةالراويةالمروي عنها لتحكي عن إرهاصات مشروعها لكتابة سيرة ذاتية، وتعلن إدراكها أن السنوات ستُفلت حتمًا من حدودها… وتقفز بلا استئذان إلى ما قبلها أو ما حولها، وتمتد متشعبة في التاريخ والجغرافيا.” وبالفعل رغم التركيز على السنوات الثلاثة الأخيرة (من 2010 وحتى مايو 2013 ) تأتي تلك المقاطع من السيرة الذاتية لكاتبتها “تقفز بلا استئذان متشعبة في التاريخ والجغرافيا.” تتشابك خيوط الحكاية، تتوازى وتتقاطع، ولكنها تجتمع في النهاية في حكاية واحدة. تتقاطع فصول من رحلة العلاج خارج الوطن مع ثورة تندلع في الداخل، وتغضب الكاتبة لغيابها الاضطراري عن مصر في تلك الظروف.
تتنوع سبل المقاومة على المستوى الذاتي في النص بين التعالي على الألم والخوف بالسخرية وزيارة المتاحف ومحادثة الأصدقاء، حتى في أقسى مراحل العلاج وأدقها. بينما هي في واشنطن، تعاني أقسى درجات الخوف والانزعاج وتستعد لاستئصال ورم خطير، ترد الكاتبة على رسالة من صديقتها الكاتبة اللبنانية هدى بركات بما هو غير متوقع من إنسان يعاني كل هذا الألم والترقب: “عندي برتقالة في رأسي…. الجراحون هنا يبدءون باقتراح استئصال القلب والرأس والرئتين لأن ذلك أسلم، ويضمن ألا يصيب أيًا منها شئ في المستقبل. أي والله بيت الرعب في مدينة الملاهي.” وبالتأمل الاسترجاعي للأحداث ترى الكاتبة أن السخرية كانت من أسلحتها للدفاع عن النفس: “درعًا من نوع ما إزاء خطر قررت أن أفضل أسلوب لمواجهته هو التصغير من شأنه وتجاهل خطورته…. ولكني أرجٍٍح أنني كنت خائفة وإن لم أقر بذلك لا للأخرين ولا لنفسي.”
بعد جراحة حرجة وفي انتظار جراحة أخرى غير مضمونة العواقب، لا تستسلم رضوى للقلق والحزن والألم، إنما ترد على مكالمات الأصدقاء، تزور المتاحف، وتسخر من المرض وتتحداه:
“أذكر أنني تلقيت مكالمات هاتفية من بعض صديقاتي وأنا في هذا المتحف أو ذاك. أقول همسًا: لحظة. ثم أخرج من قاعة العرض وأنتحي جانبًا من ممر وأشرح أنني في متحف كذا…. أو: أنا في حديقة النباتات…. أنطلق في الحديث بتلقائية، ثم أنتبه للمفارقة بين القلق البادي في الصوت، رغم محاولة مداراته، وكلامي عن متحف ولوحة وزرع في معرض نباتات”. تدرك الكاتبة أنها “محاصرة بين جراحة تمت وجراحة على وشك، ومستقبل معلق على احتمالات متفاوتة قد يكون الموت أبسطها” ولكنها لا تملك سوى أن تُسلم أمرها لله وتواصل الحياة بعادية، لأنها “مخلوق آدمي طوّر على مدى آلاف السنين شيئًا ثمينًا اسمه الكبرياء”.
ومع تفاصيل رحلة العلاج الممتدة عبر السرد تتداخل تفاصيل ثورة 25 يناير 2011 وتداعياتها وتنوع سبل المقاومة لدى الشعب لاستعادة إرادته، سواء تلك التي تابعتها الكاتبة وأسرتها من مصادر الأخبار المختلفة أثناء رحلة العلاج خارج الوطن، أو تلك التي شاركت فيها بعد عودتها. ويتخلل ثنايا السرد حكايات عن أحداث الثورة وشبابها وشهدائها. وفي فصول أخرى تطل ذكريات الطفولة وبعض من السمات الشخصية للكاتبة، وتفاصيل اجتماع الأسرة أيام الجمعة في بيت العائلة بالمنيل والحديث عن الراحلين وعن الكبار والصغار من الأحياء، لتخرج من ذلك بأن “الموت تؤطره الحياة، فهي تسبقه وتليه، وتفرض حدوده…. النهايات ليست نهايات، لأنها تتشابك ببدايات جديدة.” وهكذا أيضًا يكون حال الشهداء، تظل قبورهم تطلق “رسائلها الباطنية تسري في الأرض، تروي البستان المكنون الذي يفاجئنا بطرحه.”
ويتخلل النص جوانب من المعارف الإنسانية في الفن والتاريخ تلقي بظلالها على الأحداث، ومنها ذلك الربط الآسر بين لوحة الجرنيكا لبيكاسو وأحداث محمد محمود، الأولى والثانية، وذلك الفصل الرائع “جرافيتي”، حيث استدعى الحديث عن الرسوم الجدارية المواكبة للثورة الحديث عن الفنان المكسيكي سيكييروس، ورفيقيه ريفييرا وأروسكو “الذين ارتبطوا بالثورة المكسيكية في الثلث الأول من القرن العشرين …. انشغلوا بجعل الفن مشاعًا على قارعة الطريق ولعابر السبيل، أنتجوا جداريات ونظروا لوظيفتها”.
يدور النص دورته ليعود إلى فصول تتواصل فيها رحلة العلاج خارج الوطن، وفي الختام يعود الحديث “عن اللقاء العائلي في بيت ميّة ومصطفى”. وقد تبدو فصول الكتاب للوهلة الأولى شذرات تتنقل بين الأمكنة والأزمنة والأحداث، تتخللها مشاهد استرجاعية وتأملات واستطرادات معرفية، ولكن كما أرادت الكاتبة، لفصل عن نسجية لوحيد القرن، أن تبقى الشذرات على حالها، تخضع سائر الفصول للأمر نفسه: “لتبق الشذرات تٌفلت من أي محاولة لربطها لأن القيد يلجم المعنى ويدفع به في اتجاه معلوم، وهذا ما لا أريده.”
“أثقل من رضوى” نص يجمع بين ملامح الرواية والسيرة الذاتية واليوميات والمقال، تتداخل فيه الأحداث وأنماط السرد، ويضئ جوانبه استطراد هنا وآخر هناك، تثريه ثقافة عميقة وخبرة إنسانية واسعة. وكما تقول الكاتبة في فصل بعنوان “مقال قصير عن الكتابة”: “تحمل الكلمات تاريخًا وجغرافيا، وطيات متراكبة من طبقات الأرض ودخائل البشر وتجاربهم ومصائرهم وأحلامهم وتهويمات خيالاتهم.”
وفي ختام هذا العمل الإبداعي الكبير تطلق رضوى عاشور رسالتها لكل البشر: “هناك احتمال آخر لتتويج مسعانا بغير الهزيمة، ما دمنا قررنا أننا لن نموت قبل أن نحاول أن نحيا.” وأخيرًا يبقى السؤال: هل يمكن لتلك المساحة المحدودة أن تحيط بكل هذا القدر من الصدق والثراء والعمق والجمال؟!